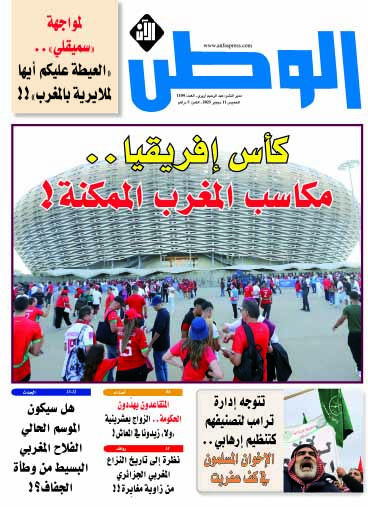إصلاح التقاعد في المغرب ليس مجرد بند في قانون المالية، بل هو رهان استراتيجي على الثقة بين الدولة والمجتمع
إصلاح التقاعد في المغرب ليس مجرد بند في قانون المالية، بل هو رهان استراتيجي على الثقة بين الدولة والمجتمع يتجه المغرب خلال شهر شتنبر الجاري إلى منعطف حاسم في تاريخه الاجتماعي والاقتصادي، مع إعلان الحكومة عن مخطط لإصلاح صناديق التقاعد. للوهلة الأولى، قد يبدو الأمر مجرد محاولة تقنية لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد من الانهيار، لكن في العمق نحن أمام سؤال أعمق: هل يتعلق الأمر بعملية إنقاذ محاسباتية ظرفية، أم بإعادة صياغة العقد الاجتماعي بما يضمن العدالة والكرامة والاستدامة؟
الأرقام وحدها تكشف عمق الأزمة:
الاحتياطي المالي للنظام المدني لم يتجاوز 65 مليار درهم نهاية 2024، بعدما كان يفقد سنويًا في المتوسط 6% من قيمته. ومنذ تسجيل أول عجز في 2014، تراكم ما يقارب 60 مليار درهم من الخسائر، نصفها في الخمس سنوات الأخيرة فقط. هذا التدهور يعكس هشاشة الإصلاحات السابقة، ويؤكد أن الوقت قد حان لحسم اختيارات استراتيجية بدل الاكتفاء بالترقيع.
تطرح حلولًا كلاسيكية:
رفع سن التقاعد وزيادة نسب الاقتطاعات. من زاوية مالية، قد يخفف ذلك من العجز، لكنه في الواقع تحميل مباشر للأجيال النشيطة فاتورة تأجيل الإصلاحات. فكيف يمكن لموظف يعاني من تضخم تجاوز في بعض الفترات 5% سنويًا، وتراجع قدرته الشرائية بشكل حاد، أن يتقبل اقتطاعات إضافية؟ وكيف نقنع مواطن مرهق بخدمات صحية وتعليمية متعثرة أن يواصل العمل بعد خمسة وستين سنة؟
هنا يبرز سؤال العدالة:
هل من المنصف أن يُطلب من جيل اليوم دفع ثمن أخطاء الأمس؟ إن معالجة الاختلالات الهيكلية تتطلب حلولًا شمولية لا تقتصر على المعادلات المالية. المطلوب إدماج فئات المهن الحرة والقطاع غير المهيكل، الذي يضم 86% من العمال بلا أي تغطية تقاعدية، في المنظومة الوطنية. فالاقتصاد غير المهيكل لم يعد مجرد إشكالية جانبية، بل هو ثقب أسود يبتلع أي مشروع إصلاحي.
كما أن ضعف الثقة بين المواطن والدولة يجعل أي قرار أحادي محفوفًا بالمخاطر. حين يطالب المتقاعدون اليوم بحقوقهم، فهم لا يتحدثون عن "مكاسب" بل عن "حقوق مكتسبة" نتاج عقود من المساهمة. وبالتالي، فإن فرض سقوف للمعاشات أو تقليص الامتيازات دون ضمان شفافية في الحكامة، سيُفسَّر كاعتداء على هذه الحقوق، لا كحل إنقاذي.
إلى جانب ذلك، لا بد من الاعتراف بأن إصلاح التقاعد مرتبط ارتباط وثيق بدينامية سوق الشغل. فزيادة سن التقاعد قد تخلق أثرا سلبيا على فرص تشغيل الشباب، الذين يواجهون أصلًا نسب بطالة مرتفعة تفوق 30% في صفوف حاملي الشهادات العليا. أي أننا أمام معادلة غير متوازنة: الدولة تسعى لتخفيف الضغط على صندوق التقاعد، لكنها في المقابل قد تُغلق أبواب العمل أمام آلاف الشباب الباحثين عن أول فرصة حياة.
ويُضاف إلى هذه المعادلة أن النقاش العمومي حول التقاعد غالبًا ما يختزل في لغة الأرقام والجداول، متجاهلًا البعد الإنساني. التقاعد ليس مجرد حساب سنوات الخدمة والاقتطاعات، بل هو مسألة كرامة بعد عمر من العطاء. والمواطن الذي يشعر أن سنوات عمله الطويلة لم توفر له سوى معاش هزيل بالكاد يغطي تكاليف المعيشة، لن يرى في الإصلاح سوى تكريسٍ للظلم الاجتماعي.
في هذا السياق، من المهم التذكير بأن 36% من المغاربة لا يتمتعون بأي تغطية تقاعدية، ما يعني أن الحديث عن إصلاح الصناديق الرسمية وحدها هو نقاش ناقص. كيف يمكن أن نبني منظومة عادلة بينما ثلث السكان خارجها أصلًا؟ الإصلاح الحقيقي يبدأ بطرح سؤال الإدماج: كيف نوفر تغطية للجميع، وليس فقط إنقاذ صندوق يعاني من نزيف؟
ثم إن أي إصلاح ينجح فقط حين يُبنى على توافق اجتماعي واسع. البرلمان قد يمرر القوانين بالأغلبية، لكن الشرعية الحقيقية تُستمد من قبول المواطنين. النقابات قد تكون أضعف مما كانت عليه سابقًا، لكنها ما زالت قادرة على تأطير احتجاجات، خصوصًا إذا لمس الموظفون والمتقاعدون أن الحكومة تسعى لحلول أحادية دون إشراكهم وقد يشكلون تنسيقات قد تشل القطاعات الحيوية كما وقع في قطاع التعليم سابقا. التحدي هنا ليس فقط تقنيًا، بل سياسي بامتياز.
الحكومة اليوم أمام امتحان مزدوج: إما أن تقدم مشروعًا يُوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية، أو أن تختار أسلوب الترقيع الذي سيؤجل الأزمة لسنوات قليلة قبل أن تنفجر بشكل أعنف. إصلاح التقاعد في المغرب ليس مجرد بند في قانون المالية، بل هو رهان استراتيجي على الثقة بين الدولة والمجتمع.
إن الأجيال المقبلة ستتذكر جيدًا ما إذا كان شتنبر 2025 لحظة لإعادة بناء العقد الاجتماعي على أسس جديدة، أم مجرد محطة أخرى في مسلسل الإصلاحات الجزئية التي تُغرقنا أكثر مما تنقذنا. وهنا يكمن جوهر الرهان: إما أن نُصلح من أجل المواطن، أو نُصلح على حسابه.