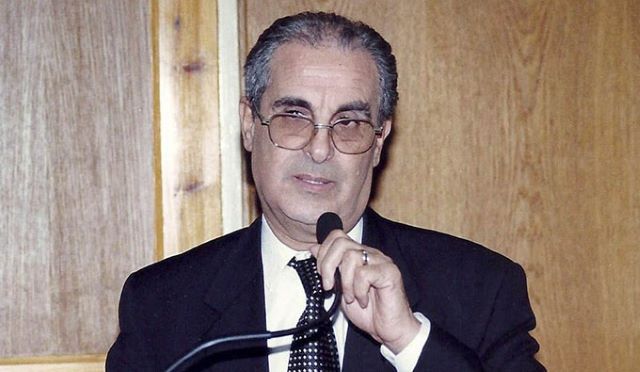في وقتنا الحالي أصبحت هندسة التنمية الترابية تتم على شكل ثالوث، إن جاز لنا استعارة هذا التوصيف من نظرية النمو الثالوثي The Trinity Growth Theory للخبير الاقتصادي بجامعة سنغافورة "تشونج ياه ليم" Chong Yah Lim، الذي يضم بحسبه ثلاث مكونات باعتبارها قطب رحى التنمية، وبشكل أكثر دقة نقصد بتعبير ثالوث هندسة التنمية الترابية أن هذه الأخيرة أصبحت تتأسس على ثلاثة محركات: أولا: المحرك الوطني/المركزي الذي تعتبر الدولة الفاعل المركزي فيه؛ ثانيا المحرك الإقليمي/الترابي وتعتبر الجماعات الترابية الفاعل المحوري فيه، ثالثا المحرك الإدماجي/التشاركي والذي تعتبر فيه جمعيات المجتمع المدني شريكا استراتيجيا للفاعل الرسمي، مع افتراض أنه كلما كانت العملية التشاركية/الإدماجية محددة بدقة ازدادت فرص ومؤشرات نجاح التنمية.
لقد شهدت الخدمة العمومية تجددا في آليات ومناهج اشتغالها، ذلك أنه في ظل تزايد حاجيات المرتفقين تجاه الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، شرعت الحكومات في التفكير في ضرورة التكيف مع المتغيرات الجديدة بتبني هندسة جديدة للتنمية، بدءا بتجديد مناهج التدخل العمومي واعتماد مقاربات تتوخى الفعالية والنجاعة، ذلك أن الخدمة العمومية أصبحت تتأسس على مبادئ الحكامة الجيدة والمساواة، والإنصاف في تغطية التراب الوطني واستمرارية المرافق العمومية في أداء نشاطها.
هذا، ويشكل مبدأ الإنصاف والمساواة في تغطية التراب الوطني بالشكل الذي يضع حدا للفوارق المجالية وتلبية متطلبات التنمية والحاجيات المتنامية للمرتفقين على المستوى الترابي، إحدى التحديات التي دفعت الحكومات للتفكير في العدول عن النموذج الفيبري في التدبير العمومي الذي من سلبياته البطء وتعقد المساطر الإدارية، بمقاربات وأساليب أكثر ملاءمة خاصة في ظل قصور النظام التمثيلي، حيث شكلت معضلة البيروقراطية نقطة انطلاق للتفكير في مصادر جديدة للشرعية بالموازاة مع البحث عن شركاء جدد للدولة.
هكذا، تم تبني هندسة جديدة للسياسات الترابية، بدءا بمنح الوحدات الإدارية اللامركزية المنتخبة العديد من الاختصاصات التي تتفرع منها مجموعة من الصلاحيات. ففي الوقت الذي عملت فيه بعض الدول على تبني نظام اللامركزية السياسية باعتبارها أسلوبا من أساليب الحكم السياسي داخل الدولة الفيدرالية تتمتع بمقتضاها الوحدات المحلية بسيادة داخلية تمكنها من ممارسة اختصاصات تشريعية وتنفيذية وأخرى قضائية بصورة مستقلة شريطة عدم تجاوز الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الدستور الفيدرالي الذي ينظم شؤون الاتحاد الفيدرالي داخل الدولة المركبة (أمريكا؛ سويسرا وألمانيا)، هناك دول أخرى تبنت واختارت نظام اللامركزية الإدارية باعتبارها نمطا من أنماط التنظيم الإداري يقوم على توزيع الوظيفة الإدارية بين المركز والمحيط، إما على أساس إقليمي وترابي تحت رقابة الدولة ووصايتها، وإما على أساس مرفقي باعتراف الدولة لمرفق عمومي بالشخصية الاعتبارية وتكليفه بنشاط معين وخضوعه لوصايتها.
فاللامركزية الترابية تقوم على تخصص جغرافي وإقليمي مع انتخاب المؤسسات التي تشرف عليه، في حين اللامركزية المرفقية تتأسس على تخصص وظيفي مع تعيين الأجهزة التي تسهر على تدبيره، ينضاف إلى ذلك كون اختصاص اللامركزية الترابية مقيد بنطاق ترابي لإقليم معين، في حين اختصاص اللامركزية المرفقية مرتبط بالغرض الذي أنشئت من أجله، وهو الأمر الذي يجعل اللامركزية الإدارية تختلف عن اللامركزية السياسية في كون الأولى تهم الوظيفة الإدارية دون السياسية، كما أنه يمكن تصور وجودها بالدول البسيطة والمركبة.
هذا، وبالرغم من تبني العديد من الدول لأسلوب اللامركزية السياسية، واللامركزية الإدارية بجانب عدم التركيز الإداري باعتباره الصورة الثانية للمركزية الإدارية، أو كما يسميه البعض المركزية الإدارية المخففة أو المعتدلة، التي تهدف إلى تخفيف العبء عن الحكومة المركزية عن طريق تقنية تفويض السلطة أو الإمضاء خاصة أمام تعقد الإجراءات والمساطر الإدارية وكثرة اتصال المرتفقين بالإدارة لقضاء مصالحهم، كما أن أزمة التدبير البيروقراطي المركزي وقصور الديمقراطية التمثيلية رافقتهما أيضا انتظارات وتطلعات المواطنين الذين أصبحوا غير راضين عن الخدمة الإدارية العمومية التي تقدمها المرافق العمومية التي تنظر لهم كزبناء خاضعين لمخرجاتها وقراراتها الإدارية، بل أصبحوا يرغبون في أن يكونوا شركاء لها في عملية صناعة القرار وفق منهجية تشاركية، وأن تكون الخدمات التي تقدمها لهم في مستوى تطلعاتهم، لأن الإدارة أساسا موضوعة لخدمة وتلبية حاجيات المرتفقين، كل هذه المعطيات كانت شبيهة بنقطة الزيت التي قد تسقط على جزء صغير من الورقة، إلا أنها سرعان ما تنتشر على مساحة كبيرة داخل الورقة. هكذا، كانت بداية شيوع مفهوم الديمقراطية التشاركية أو الدامجة التي تهدف إلى تذليل العقبات والصعوبات التي تحول دون المشاركة الفعلية للمواطنين والهيئات المدنية في صناعة وصياغة القرار الإداري والعمومي إلى جانب الفاعل الرسمي وتحقيق إدماج المجتمع المدني في هندسة التنمية بمستوييها الوطني والترابي.
أولا: الدولة باعتبارها الفاعل المركزي في هندسة التنمية الترابية: في الحاجة لهندسة لا متمركزة للتنمية؟
بموجب الفصل 89 من الدستور تعمل الحكومة، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين، والإدارة موضوعة تحت تصرفها. طبعا من خلال هذا الفصل يبدو جليا وواضحا أن أول وظيفة أساسية للحكومة تتجلى في تنفيذ البرنامج الحكومي باعتباره ميثاقا أخلاقيا وأدبيا يربطها بالناخبين، وبموجب الفصـل 93 من الدستور يعتبر الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية التي تشمل بمدلول الفصل 92 من الدستور السياسات العمومية والسياسات القطاعية باعتبارها الأجرأة الفعلية للسياسة العامة التي تقدمها الحكومة في مختلف المجالات، ولا يمكن مباشرتها إلا بعد حصول رئيس الحكومة على التعيين الملكي، وبعد تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان والتصويت عليه من لدن مجلس النواب بالأغلبية المطلقة، طبقا للفصـل 88 من الدستور. ومن الناحية المبدئية يتضمن البرنامج الحكومي الخطوط العريضة للعمل الذي تعتزم الحكومة القيام به في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
إن تدخل الحكومة في هندسة التنمية الترابية فرضته عدة مبررات، في مقدمتها تطور وظائف الدولة مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945، لتأخذ بعدا تصاعديا، حيث أصبحت تتدخل في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، كما حضر بشكل أساسي المحدد التنموي في وظائفها الإدارية، صحيح أن نظام المركزية ما زال يعتبر أسلوبا ضروريا لإدارة بعض المرافق العمومية سيما السيادية والحيوية التي يجب أن يبقى أمر تدبيرها مسنودا للدولة بصورة حصرية ونخص بالذكر مرفق الأمن والدفاع والقضاء والعلاقات الدولية، فضلا عن أن إشراف الدولة على هندسة التنمية الترابية، يُفترض فيه تحقيق المساواة والانصاف. وإذا كان إشراف الدولة على المرافق الحيوية له مبرراته السيادية والأمنية، فإن استمرارها في هندسة التنمية الترابية فَقَدَ حاليا بعضا من مبرراته الكلاسيكية، فمن الناحية السياسية فيه اشغال للإدارة المركزية بمسائل قليلة الأهمية وفيه حرمان للهيئات اللامركزية من المشاركة الفعلية في هندسة السياسات الترابية.
فاللامركزية الإدارية تتأسس على إشراك الساكنة في اختيار ممثليهم عن طريق الانتخاب وتخفيف العبء عن الإدارة المركزية، ويجعلها تتفرغ لأداء وقيادة الوظائف الإستراتيجية وإدارة المرافق العمومية الحساسة، فضلا عن أن نظام اللامركزية الإدارية هو الأقدر على مواجهة الأزمات الطارئة التي قد تظهر بشكل فجائي ويتطلب حلها تدخلا فوريا، وهذه المبررات هي التي تبرر توجه العديد من الدول إلى تبني فلسفة جديدة في توزيع الاختصاص بين الإدارة المركزية ومصالحها الخارجية وإعادة ضبط العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية. وهذا الأمر يمكن الوقوف عليه من خلال مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري الصادر في 26 دجنبر 2018، الذي تنطوي مقتضياته على فلسفة جديدة تتوخى حصر أدوار الإدارة المركزية، بموجب المادة 14، في المهام التي تكتسي طابعا وطنيا أو يتعذر إنجازها من قبل المصالح اللاممركزة، أي أن دور الإدارة المركزية يتحدد في بلورة التصور العام وتأطير السياسات العمومية، لكن مع ترك التنفيذ للمصالح اللاممركزة أو الخارجية، حيث أكدت مادته 5 على أن سياسة اللاتمركز الإداري تقوم على مرتكزين أساسيين، المرتكز الأول الجهة باعتبارها الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية في مجال اللاتمركز بالنظر لما تحتله من صدارة في التنظيم الإداري انسجاما مع روح الفصل 143 من الدستور الذي بوأ الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى.
والمرتكز الثاني: الدور المحوري لوالي الجهة باعتباره ممثلا للسلطة المركزية على المستوى الجهوي فيما يتعلق بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة والخارجية والسهر على حسن سيرها ومراقبتها تحت سلطة الوزراء المعنيين بالشكل الذي يحقق النجاعة والإلتقائية، على اعتبار أن الفصل 145 من الدستور منح ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات صلاحية تمثيل السلطة المركزية على مستوى الجماعات الترابية، والعمل باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، وممارسة المراقبة الإدارية، ومساعدة رؤساء الجماعات الترابية خاصة الجهات على تنفيذ المخططات التنموية، وتنسيق أنشطة المصالح الخارجية تحت سلطة الوزراء المعنيين.
ثانيا: دور الجماعات الترابية في هندسة التنمية الترابية: الإكراهات والصعوبات
بحسب الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من دستور 2011، التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة. وبموجب الفصـل 137 من الدستور تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة وكذا في إعداد السياسات الترابية، وبناء على الفصل 140 منه للجماعات الترابية، بناء على مبدإ التفريع، اختصاصات ذاتية؛ وأخرى مشتركة مع الدولة وأخرى منقولة إليها من الدولة، وهي نفس الهندسة الوظيفية التي تمت أجرأتها من خلال: القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات؛ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ثم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وإذا كان الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية واضحة في تحديد اختصاصات كل صنف من الأصناف الثلاثة للجماعات الترابية في ما يتعلق بهندسة التنمية الترابية، فإنه انطلاقا من فكرة أن القانون الفعلي هو الذي تختبره الممارسة فقد أظهرت التجربة أن تدخل الجماعات الترابية في هندسة التنمية الترابية داخل مجالها الجغرافي يصطدم بعدة صعوبات منها الصعوبات المالية أساسا.
صحيح أنه بموجب الفصـل 141 من الدستور تتوفر الجماعات الترابية، على موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة، وصحيح أن كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد المالية المطابقة له، بيد أن أغلب الجماعات الترابية تعاني خصاصا ملحوظا في الموارد المالية باعتبارها أداة لتمويل البرامج التنموية، ذلك أن أغلب الموارد الذاتية للجماعات الترابية يبقى مصدرها الأساسي هو الرسوم المستحقة لفائدة الأخيرة بموجب القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، كما وقع تغييره وتتميمه، فالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات محصورة بموجب المادة 2 منه والتي تتكون من 11 رسما أهمها الرسم المهني؛ رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية؛ ثم الرسوم المستحقة لفائدة العمالات والأقاليم وهي المحصورة في المادة 3 منه وهي ثلاثة أنواع، ونفس الأمر بالنسبة للجهات ثلاث رسوم محددة في المادة 4 من هذا القانون، غير أن تمويل أغلب المشاريع التنموية بالجماعات الترابية في أمر الواقع تواجهه عدة تحديات منها عدم كفاية الموارد الذاتية المتأتية من عائدات الرسوم المحلية خاصة بالنسبة للجماعات القاعدية وبشكل أخص التي توجد في مناطق نائية، تحديات جعلت تمويل المشاريع والبرامج التنموية يتوقف على صنفين من التمويل:
الصنف الأول: يتمثل أساسا في حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، التي تحولها لها وزارة الداخلية، فبالرغم من أن الحكومة الحالية في إطار تعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية، قامت بموجب قانون المالية 2025 برفع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة من %30 إلى %32، ابتداء من سنة 2025، وصحيح أنه طبقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، تُرصد للجهات نسبة %5 من حصيلة الضريبة على الشركات، ونسبة 5% من حصيلة الضريبة على الدخل، غير أن هذا الأمر يجعل مداخيل الجماعات الترابية ترتكز بنسبة أساسية على تحويلات الدولة، سيما المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة، مما يؤثر على الاستقلالية والاستدامة الماليتين للجماعات الترابية، خاصة إذا ما علمنا بأن ميزانية هذه الجماعات تتكون %40.3 منها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، بحسب نشرة الخزينة العامة للمملكة في أواخر أكتوبر 2024.
الصنف الثاني: صندوق التجهيز الجماعي الذي أحدث عام 1959، حيث يقدم الأخير للجماعات الترابية المساعدة التقنية والمالية في شكل قروض وسلفات مالية، غير أن مساهمته في تمويل مشاريع الجماعات الترابية تبقى ضئيلة جدا وخاضعة لشروط صارمة ولا تتعدى نسبتها أكثر من %5 من نسبة التمويل المحلي، فضلا عن عدم انجاز العديد من البرامج، وذلك بسبب تَوَقُّع تمويلها من قبل هذا الصندوق الذي رفض توقيع عقود قروض مع بعض الجماعات التي لا تتوفر على مؤشرات استدانة مقبولة داخل ميزانيتها العامة، بحسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2015، ص 144، وتقرير المجلس الأعلى للحسابات 2023 ص 200.
فبالرغم من أهمية الصنفين الأول والثاني باعتبارهما آليتين لتمويل البرامج على مستوى الجماعات الترابية، إلا أنهما يطرحان مشكلتين: الأولى تهم الاستقلال المالي للجماعات الترابية، والثانية تتعلق بانعدام الاستدامة المالية مما يؤثر على القدرات المالية للجماعات الترابية، خصوصا المتمركزة في مناطق نائية، ذلك لأن الصنفين فيهما ارتهان كبير إلى التحويلات المالية المتأتية من الدولة والقروض المالية التي يمنحها صندوق التجهيز الجماعي، مما يجعلها تفتقد لروح المبادرة في تمويل مشاريعها، صحيح أن الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة يشكل خطوة إيجابية، إلا أنها لا تعالج المشاكل التمويلية على مستوى العديد من الجماعات القاعدية النائية، التي تجد صعوبات في أداء أجور الموظفين والمستخدمين، كلها إشكاليات تنضاف لمشكلة الباقي استخلاصه وما يطرحه من صعوبات تتعلق بتحصيله التي تحفها العديد من المشاكل والتحديات الواقعية التي تحول دون الرفع من حصيلة الموارد الذاتية للجماعات الترابية.
لقد شهدت الخدمة العمومية تجددا في آليات ومناهج اشتغالها، ذلك أنه في ظل تزايد حاجيات المرتفقين تجاه الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، شرعت الحكومات في التفكير في ضرورة التكيف مع المتغيرات الجديدة بتبني هندسة جديدة للتنمية، بدءا بتجديد مناهج التدخل العمومي واعتماد مقاربات تتوخى الفعالية والنجاعة، ذلك أن الخدمة العمومية أصبحت تتأسس على مبادئ الحكامة الجيدة والمساواة، والإنصاف في تغطية التراب الوطني واستمرارية المرافق العمومية في أداء نشاطها.
هذا، ويشكل مبدأ الإنصاف والمساواة في تغطية التراب الوطني بالشكل الذي يضع حدا للفوارق المجالية وتلبية متطلبات التنمية والحاجيات المتنامية للمرتفقين على المستوى الترابي، إحدى التحديات التي دفعت الحكومات للتفكير في العدول عن النموذج الفيبري في التدبير العمومي الذي من سلبياته البطء وتعقد المساطر الإدارية، بمقاربات وأساليب أكثر ملاءمة خاصة في ظل قصور النظام التمثيلي، حيث شكلت معضلة البيروقراطية نقطة انطلاق للتفكير في مصادر جديدة للشرعية بالموازاة مع البحث عن شركاء جدد للدولة.
هكذا، تم تبني هندسة جديدة للسياسات الترابية، بدءا بمنح الوحدات الإدارية اللامركزية المنتخبة العديد من الاختصاصات التي تتفرع منها مجموعة من الصلاحيات. ففي الوقت الذي عملت فيه بعض الدول على تبني نظام اللامركزية السياسية باعتبارها أسلوبا من أساليب الحكم السياسي داخل الدولة الفيدرالية تتمتع بمقتضاها الوحدات المحلية بسيادة داخلية تمكنها من ممارسة اختصاصات تشريعية وتنفيذية وأخرى قضائية بصورة مستقلة شريطة عدم تجاوز الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الدستور الفيدرالي الذي ينظم شؤون الاتحاد الفيدرالي داخل الدولة المركبة (أمريكا؛ سويسرا وألمانيا)، هناك دول أخرى تبنت واختارت نظام اللامركزية الإدارية باعتبارها نمطا من أنماط التنظيم الإداري يقوم على توزيع الوظيفة الإدارية بين المركز والمحيط، إما على أساس إقليمي وترابي تحت رقابة الدولة ووصايتها، وإما على أساس مرفقي باعتراف الدولة لمرفق عمومي بالشخصية الاعتبارية وتكليفه بنشاط معين وخضوعه لوصايتها.
فاللامركزية الترابية تقوم على تخصص جغرافي وإقليمي مع انتخاب المؤسسات التي تشرف عليه، في حين اللامركزية المرفقية تتأسس على تخصص وظيفي مع تعيين الأجهزة التي تسهر على تدبيره، ينضاف إلى ذلك كون اختصاص اللامركزية الترابية مقيد بنطاق ترابي لإقليم معين، في حين اختصاص اللامركزية المرفقية مرتبط بالغرض الذي أنشئت من أجله، وهو الأمر الذي يجعل اللامركزية الإدارية تختلف عن اللامركزية السياسية في كون الأولى تهم الوظيفة الإدارية دون السياسية، كما أنه يمكن تصور وجودها بالدول البسيطة والمركبة.
هذا، وبالرغم من تبني العديد من الدول لأسلوب اللامركزية السياسية، واللامركزية الإدارية بجانب عدم التركيز الإداري باعتباره الصورة الثانية للمركزية الإدارية، أو كما يسميه البعض المركزية الإدارية المخففة أو المعتدلة، التي تهدف إلى تخفيف العبء عن الحكومة المركزية عن طريق تقنية تفويض السلطة أو الإمضاء خاصة أمام تعقد الإجراءات والمساطر الإدارية وكثرة اتصال المرتفقين بالإدارة لقضاء مصالحهم، كما أن أزمة التدبير البيروقراطي المركزي وقصور الديمقراطية التمثيلية رافقتهما أيضا انتظارات وتطلعات المواطنين الذين أصبحوا غير راضين عن الخدمة الإدارية العمومية التي تقدمها المرافق العمومية التي تنظر لهم كزبناء خاضعين لمخرجاتها وقراراتها الإدارية، بل أصبحوا يرغبون في أن يكونوا شركاء لها في عملية صناعة القرار وفق منهجية تشاركية، وأن تكون الخدمات التي تقدمها لهم في مستوى تطلعاتهم، لأن الإدارة أساسا موضوعة لخدمة وتلبية حاجيات المرتفقين، كل هذه المعطيات كانت شبيهة بنقطة الزيت التي قد تسقط على جزء صغير من الورقة، إلا أنها سرعان ما تنتشر على مساحة كبيرة داخل الورقة. هكذا، كانت بداية شيوع مفهوم الديمقراطية التشاركية أو الدامجة التي تهدف إلى تذليل العقبات والصعوبات التي تحول دون المشاركة الفعلية للمواطنين والهيئات المدنية في صناعة وصياغة القرار الإداري والعمومي إلى جانب الفاعل الرسمي وتحقيق إدماج المجتمع المدني في هندسة التنمية بمستوييها الوطني والترابي.
أولا: الدولة باعتبارها الفاعل المركزي في هندسة التنمية الترابية: في الحاجة لهندسة لا متمركزة للتنمية؟
بموجب الفصل 89 من الدستور تعمل الحكومة، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين، والإدارة موضوعة تحت تصرفها. طبعا من خلال هذا الفصل يبدو جليا وواضحا أن أول وظيفة أساسية للحكومة تتجلى في تنفيذ البرنامج الحكومي باعتباره ميثاقا أخلاقيا وأدبيا يربطها بالناخبين، وبموجب الفصـل 93 من الدستور يعتبر الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية التي تشمل بمدلول الفصل 92 من الدستور السياسات العمومية والسياسات القطاعية باعتبارها الأجرأة الفعلية للسياسة العامة التي تقدمها الحكومة في مختلف المجالات، ولا يمكن مباشرتها إلا بعد حصول رئيس الحكومة على التعيين الملكي، وبعد تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان والتصويت عليه من لدن مجلس النواب بالأغلبية المطلقة، طبقا للفصـل 88 من الدستور. ومن الناحية المبدئية يتضمن البرنامج الحكومي الخطوط العريضة للعمل الذي تعتزم الحكومة القيام به في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
إن تدخل الحكومة في هندسة التنمية الترابية فرضته عدة مبررات، في مقدمتها تطور وظائف الدولة مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945، لتأخذ بعدا تصاعديا، حيث أصبحت تتدخل في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، كما حضر بشكل أساسي المحدد التنموي في وظائفها الإدارية، صحيح أن نظام المركزية ما زال يعتبر أسلوبا ضروريا لإدارة بعض المرافق العمومية سيما السيادية والحيوية التي يجب أن يبقى أمر تدبيرها مسنودا للدولة بصورة حصرية ونخص بالذكر مرفق الأمن والدفاع والقضاء والعلاقات الدولية، فضلا عن أن إشراف الدولة على هندسة التنمية الترابية، يُفترض فيه تحقيق المساواة والانصاف. وإذا كان إشراف الدولة على المرافق الحيوية له مبرراته السيادية والأمنية، فإن استمرارها في هندسة التنمية الترابية فَقَدَ حاليا بعضا من مبرراته الكلاسيكية، فمن الناحية السياسية فيه اشغال للإدارة المركزية بمسائل قليلة الأهمية وفيه حرمان للهيئات اللامركزية من المشاركة الفعلية في هندسة السياسات الترابية.
فاللامركزية الإدارية تتأسس على إشراك الساكنة في اختيار ممثليهم عن طريق الانتخاب وتخفيف العبء عن الإدارة المركزية، ويجعلها تتفرغ لأداء وقيادة الوظائف الإستراتيجية وإدارة المرافق العمومية الحساسة، فضلا عن أن نظام اللامركزية الإدارية هو الأقدر على مواجهة الأزمات الطارئة التي قد تظهر بشكل فجائي ويتطلب حلها تدخلا فوريا، وهذه المبررات هي التي تبرر توجه العديد من الدول إلى تبني فلسفة جديدة في توزيع الاختصاص بين الإدارة المركزية ومصالحها الخارجية وإعادة ضبط العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية. وهذا الأمر يمكن الوقوف عليه من خلال مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري الصادر في 26 دجنبر 2018، الذي تنطوي مقتضياته على فلسفة جديدة تتوخى حصر أدوار الإدارة المركزية، بموجب المادة 14، في المهام التي تكتسي طابعا وطنيا أو يتعذر إنجازها من قبل المصالح اللاممركزة، أي أن دور الإدارة المركزية يتحدد في بلورة التصور العام وتأطير السياسات العمومية، لكن مع ترك التنفيذ للمصالح اللاممركزة أو الخارجية، حيث أكدت مادته 5 على أن سياسة اللاتمركز الإداري تقوم على مرتكزين أساسيين، المرتكز الأول الجهة باعتبارها الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية في مجال اللاتمركز بالنظر لما تحتله من صدارة في التنظيم الإداري انسجاما مع روح الفصل 143 من الدستور الذي بوأ الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى.
والمرتكز الثاني: الدور المحوري لوالي الجهة باعتباره ممثلا للسلطة المركزية على المستوى الجهوي فيما يتعلق بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة والخارجية والسهر على حسن سيرها ومراقبتها تحت سلطة الوزراء المعنيين بالشكل الذي يحقق النجاعة والإلتقائية، على اعتبار أن الفصل 145 من الدستور منح ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات صلاحية تمثيل السلطة المركزية على مستوى الجماعات الترابية، والعمل باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، وممارسة المراقبة الإدارية، ومساعدة رؤساء الجماعات الترابية خاصة الجهات على تنفيذ المخططات التنموية، وتنسيق أنشطة المصالح الخارجية تحت سلطة الوزراء المعنيين.
ثانيا: دور الجماعات الترابية في هندسة التنمية الترابية: الإكراهات والصعوبات
بحسب الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من دستور 2011، التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة. وبموجب الفصـل 137 من الدستور تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة وكذا في إعداد السياسات الترابية، وبناء على الفصل 140 منه للجماعات الترابية، بناء على مبدإ التفريع، اختصاصات ذاتية؛ وأخرى مشتركة مع الدولة وأخرى منقولة إليها من الدولة، وهي نفس الهندسة الوظيفية التي تمت أجرأتها من خلال: القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات؛ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ثم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وإذا كان الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية واضحة في تحديد اختصاصات كل صنف من الأصناف الثلاثة للجماعات الترابية في ما يتعلق بهندسة التنمية الترابية، فإنه انطلاقا من فكرة أن القانون الفعلي هو الذي تختبره الممارسة فقد أظهرت التجربة أن تدخل الجماعات الترابية في هندسة التنمية الترابية داخل مجالها الجغرافي يصطدم بعدة صعوبات منها الصعوبات المالية أساسا.
صحيح أنه بموجب الفصـل 141 من الدستور تتوفر الجماعات الترابية، على موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة، وصحيح أن كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد المالية المطابقة له، بيد أن أغلب الجماعات الترابية تعاني خصاصا ملحوظا في الموارد المالية باعتبارها أداة لتمويل البرامج التنموية، ذلك أن أغلب الموارد الذاتية للجماعات الترابية يبقى مصدرها الأساسي هو الرسوم المستحقة لفائدة الأخيرة بموجب القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، كما وقع تغييره وتتميمه، فالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات محصورة بموجب المادة 2 منه والتي تتكون من 11 رسما أهمها الرسم المهني؛ رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية؛ ثم الرسوم المستحقة لفائدة العمالات والأقاليم وهي المحصورة في المادة 3 منه وهي ثلاثة أنواع، ونفس الأمر بالنسبة للجهات ثلاث رسوم محددة في المادة 4 من هذا القانون، غير أن تمويل أغلب المشاريع التنموية بالجماعات الترابية في أمر الواقع تواجهه عدة تحديات منها عدم كفاية الموارد الذاتية المتأتية من عائدات الرسوم المحلية خاصة بالنسبة للجماعات القاعدية وبشكل أخص التي توجد في مناطق نائية، تحديات جعلت تمويل المشاريع والبرامج التنموية يتوقف على صنفين من التمويل:
الصنف الأول: يتمثل أساسا في حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، التي تحولها لها وزارة الداخلية، فبالرغم من أن الحكومة الحالية في إطار تعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية، قامت بموجب قانون المالية 2025 برفع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة من %30 إلى %32، ابتداء من سنة 2025، وصحيح أنه طبقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، تُرصد للجهات نسبة %5 من حصيلة الضريبة على الشركات، ونسبة 5% من حصيلة الضريبة على الدخل، غير أن هذا الأمر يجعل مداخيل الجماعات الترابية ترتكز بنسبة أساسية على تحويلات الدولة، سيما المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة، مما يؤثر على الاستقلالية والاستدامة الماليتين للجماعات الترابية، خاصة إذا ما علمنا بأن ميزانية هذه الجماعات تتكون %40.3 منها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، بحسب نشرة الخزينة العامة للمملكة في أواخر أكتوبر 2024.
الصنف الثاني: صندوق التجهيز الجماعي الذي أحدث عام 1959، حيث يقدم الأخير للجماعات الترابية المساعدة التقنية والمالية في شكل قروض وسلفات مالية، غير أن مساهمته في تمويل مشاريع الجماعات الترابية تبقى ضئيلة جدا وخاضعة لشروط صارمة ولا تتعدى نسبتها أكثر من %5 من نسبة التمويل المحلي، فضلا عن عدم انجاز العديد من البرامج، وذلك بسبب تَوَقُّع تمويلها من قبل هذا الصندوق الذي رفض توقيع عقود قروض مع بعض الجماعات التي لا تتوفر على مؤشرات استدانة مقبولة داخل ميزانيتها العامة، بحسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2015، ص 144، وتقرير المجلس الأعلى للحسابات 2023 ص 200.
فبالرغم من أهمية الصنفين الأول والثاني باعتبارهما آليتين لتمويل البرامج على مستوى الجماعات الترابية، إلا أنهما يطرحان مشكلتين: الأولى تهم الاستقلال المالي للجماعات الترابية، والثانية تتعلق بانعدام الاستدامة المالية مما يؤثر على القدرات المالية للجماعات الترابية، خصوصا المتمركزة في مناطق نائية، ذلك لأن الصنفين فيهما ارتهان كبير إلى التحويلات المالية المتأتية من الدولة والقروض المالية التي يمنحها صندوق التجهيز الجماعي، مما يجعلها تفتقد لروح المبادرة في تمويل مشاريعها، صحيح أن الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة يشكل خطوة إيجابية، إلا أنها لا تعالج المشاكل التمويلية على مستوى العديد من الجماعات القاعدية النائية، التي تجد صعوبات في أداء أجور الموظفين والمستخدمين، كلها إشكاليات تنضاف لمشكلة الباقي استخلاصه وما يطرحه من صعوبات تتعلق بتحصيله التي تحفها العديد من المشاكل والتحديات الواقعية التي تحول دون الرفع من حصيلة الموارد الذاتية للجماعات الترابية.
ثالثا: المجتمع المدني شريك استراتيجي للدولة في هندسة التنمية الترابية
لا بد من التذكير بأن السياق الذي تولدت فيه الأحزاب السياسية في الغرب جاء كمحصلة لفكرة (مونتسكيو) القائلة: “بأن الشعب إن كان غير قادر على حكم نفسه بطريقة مباشرة فهو قادر على اختيار ممثليه الذين ينوبون عنه في صناعة القرار العمومي”. وفي هذا الشأن لعبت الأحزاب السياسية دورا هاما في تأطير المواطنين وتمثيلهم باعتبارها التنظيم السياسي والقانوني الذي من خلاله يعبر الأفراد عن مواقفهم وآرائهم السياسية، وتعني وظيفة التمثيل السياسي قدرة الحزب على نقل مطالب المواطنين وإعطائها طابعا مُؤَسَّسِيا.
بيد أنه مع مرور الوقت أصبحت الأحزاب السياسية عاجزة عن الدفاع عن مطالب الناخبين، حيث أضحت الأحزاب عاجزة على القيام بدورها في التمثيل السياسي، كما أن “النخب الاقتصادية” نجحت في إحكام قبضتها على الأحزاب السياسية ومعه تحولت الديمقراطية التمثيلية من آلية لإشراك المواطنين في الحكم إلى ديمقراطية “شكلانية”. وفي هذا السياق، ظهرت الديمقراطية التشاركية باعتبارها نمطا جديدا للحكم له مرجعياته الدستورية وآلياته الإجرائية، وقد عملت أغلب الدساتير الحديثة على تنظيم كيفيات ممارسة الديمقراطية التشاركية، كما هو الحال بالنسبة الدستور المغربي لسنة 2011، الذي أكد فصله 12 على أنه تُؤسس جمعيات المجتمع المدني وتمارس أنشطتها بحرية، كما تُساهم هذه الجمعيات، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية التي يقع على عاتقها تنظيم كيفيات هذه المشاركة. ولم يكتف الدستور المغربي بالتنصيص على وظيفة الجمعيات المهتمة بالشأن العام، بل أكد في فصله 13 على ضرورة قيام السلطات العمومية بإحداث هيئات للتشاور قصد إشراك الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية، وفي نفس الوقت مَكَّنَ الفصـل 136 منه السكان من المشاركة في تدبير شؤونهم على المستوى الترابي، وأكثر من ذلك يجب أن تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية، آليات للحوار والتشاور قصد تيسير مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية، كما أعطى للجمعيات صلاحية تقديم عرائض ومطالبة المجلس بإدراجها ضمن جدول أعماله طبقا للفصل 139.
وتفعيلا للمقتضيات الدستورية الناظمة والمؤطرة للديمقراطية التشاركية، صدر القانون التنظيمي رقم 14.44 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، والقانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، وهذا الإطار القانون الذي يتوزع بين الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية والعادية يزكي ويعضد شرعية الكم الهائل من الجمعيات الذي يتوفر عليه المغرب، ذلك أنه عرف منذ زمن وبالضبط في مرحلة السبعينات ميلاد أول إطار مدني للدفاع عن حقوق الإنسان، وتوالت بعد ذلك مسألة تأسيس الجمعيات طبقا للمسطرة المحددة في الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نوفمبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، وهذا الأمر جعل المغرب يعتبر في مقدمة دول الجوار بتوفره على أكبر عدد من هيئات المجتمع المدني، التي أصبحت تتحرك بشكل ملفت للانتباه وتتابع عن قرب قضايا الشأن العام، صحيح أن العديد منها تابع لأحزاب سياسية وتتبنى علنا أو ضمنيا إيديولوجيا معينة، إلا أنها استطاعت أن تتجاوز مسألة الصراع على السلطة السياسية مركزة اهتماماتها بشكل كبير في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وقضايا التنمية الترابية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
ولعل ما يزكي ذلك، هو كثرة البلاغات أو الإعلانات التي نصادفها عبر قنوات التواصل الاجتماعي وقنوات الإعلام العمومي الرسمي، التي مفادها توقيع اتفاقيات شراكة أو تعاون بين المرافق العمومية، ممثلة في الإدارات العمومية أو المحاكم أو الجهات والجماعات الترابية الأخرى، أو الأجهزة العمومية والمقاولات العمومية سيما تلك الخاضعة للقانون العام كطرف أول، وجمعيات المجتمع المدني كطرف ثاني، تفعيلا للأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني التي خصها بها دستور 2011، وتفعيلا لتوصيات الحوار الوطني بشأن تقوية قدرات الجمعيات وتعزيز الدعم العمومي الموجه لها بناء طبقا لدورية الوزير الأول 7/2003 بتاريخ 27 يونيو 2003 بشأن الشراكة بين الدولة والجمعيات لتوظيف الموارد المالية لتقديم خدمات اجتماعية وإنجاز مشاريع وخدمات ذات نفع جماعي وتحقيق سياسة القرب.
من الناحية الكمية أو العددية يتوفر المغرب، وفقا للمعطيات والأرقام الرسمية الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان للعام 2023 الصادر في فبراير 2024، فإن عدد الجمعيات النشيطة والمؤسسة بصفة قانونية يصل إلى ما مجموعه 259 ألف جمعية برسم سنة 2022 تتوزع مجالات اشتغالها على مجالات مختلفة كحقوق الإنسان؛ البيئة؛ الرياضة؛ حماية الطفولة والمرأة؛ التعليم؛ الصحة؛ ومحاربة العنف الأسري ...، وهذا التطور الكمي والنوعي يفسر الوعي والاهتمام المتزايدين بأهمية العمل الجمعوي في تحقيق التنمية الترابية، تطور كمي دفع الحكومة للتفاعل الإيجابي مع مطالب المجتمع المدني والرفع من الدعم العمومي قصد تمكينها من انجاز مشاريعها التنموية، وهذه الحقيقة يكشفها التقريرين السنويين للشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنتي 2022 و2023، اللذان قدمهما في ماي 2025 الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والذي صرح بأن حجم الإعانات التي استفادت منها الجمعيات بلغ ما مجموعه 13 مليار درهم، وهو غلاف مالي لا يستهان به، ينضاف إلى المساعدات المالية التي تحصلت عليها بعض الجمعيات من جهات أجنبية خلال سنة 2024 والمحددة في 80 مليار سنتيم، استنادا للمعلومات التي صرح بها الأمين العام للحكومة في نونبر 2024 بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للقطاع أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بناء على التصاريح التلقائية التي توصلت بها الأمانة العامة للحكومة من قبل 308 جمعية، وهو المبلغ الذي من المرجح أن يكون أكثر من ذلك بكثير، سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن بعض الجمعيات بما في ذلك الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة لا تصرح لمصالح للأمانة العامة للحكومة بالدعم المالي أو العيني التي تتوصل به من جهات أجنبية، طبقا لمنطوق الفصل 32 المكرر من الظهير الشريف للجمعيات لعام 1958.
لكن، بالرغم من الدعم العمومي أو الأجنبي التي تتوصل به الجمعيات، إلا أنه ومع كامل الأسف يمكن تسجيل العديد من الملاحظات السلبية بشأن مساهمة جمعيات المجتمع المدني في قضايا التنمية على المستوى الترابي، ذلك أنه بالإضافة إلى الفوارق والتفاوتات المجالية والجغرافية التي طبعت منهجية تدخل الدولة والأحزاب السياسية في تدبير وهندسة التنمية الترابية، نجد الجمعيات بدورها تعيد إنتاج نفس السلوكيات التي ترسخ وتكرس الفوارق المجالية، وهذا السلوك تعاني منه بشكل أخص المناطق الجبلية والقروية والدواوير النائية، ذلك أن أغلب أنشطة الجمعيات المدنية تتمركز بشكل أساسي في المجال الحضري وفي جهات ترابية كبرى كجهة الدار البيضاء سطات؛ جهة الرباط سلا القنيطرة؛ جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ جهة مراكش أسفي، مما يجعل جمعيات المجتمع المدني بدورها تنظيمات حضرية بامتياز وتتمركز داخل التراب الوطني بشكل غير متكافئ خاصة الوسط الحضري على شاكلة الأحزاب السياسية، ذلك أنه للأسف حتى هذه الجمعيات تفضل برمجة مشاريعها التي تحصل من خلالها على الدعم المالي في المدن الكبرى، إذ قليلة هي الجمعيات التي تنشط في المجالات القروية والجبلية، التي تشكل محورا جغرافيا وترابيا للنشاط الموسمي (الحملات الانتخابية بالنسبة للأحزاب السياسية) والكوارث الطبيعية (كالزلازل؛ الفيضانات؛ موجات البرد القارس...) بالنسبة لبعض جمعيات المجتمع المدني.
خاتمة:
ختاما يمكن القول، بأنه بقدر ما نحتاج للمساواة والإنصاف في تغطية المجال الترابي للدولة بكامله حتى وإن قامت الأخيرة مؤخرا بتخصيص منحة ترابية بموجب القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، قصد دعم المشاريع الاستثمارية في المناطقة النائية تتراوح نسبتها ما بين %10 و%15 من المبلغ الإجمالي للاستثمار تهم العديد من عمالات وأقاليم المملكة، من أجل تكريس البعد الترابي والجهوي للاستثمار وتقليص الفوارق المجالية من حيث جلب الاستثمارات، وبقدر ما نحتاج مساواة وانصاف في تغطية التراب الوطني من جانب الأحزاب السياسية التي تعمل بموجب الفصـل 7 من الدستور على تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام من داخل الدولة والجماعات الترابية، فإننا بالقدر نفسه نحتاج لإنصاف مماثل من جانب جمعيات المجتمع المدني، وذلك لتنمية المناطق النائية التي تبقى مستبعدة أو مغيبة من أجندة الدولة والجماعات الترابية والأحزاب السياسية.
عبد الغني السرار؛ أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالجديدة