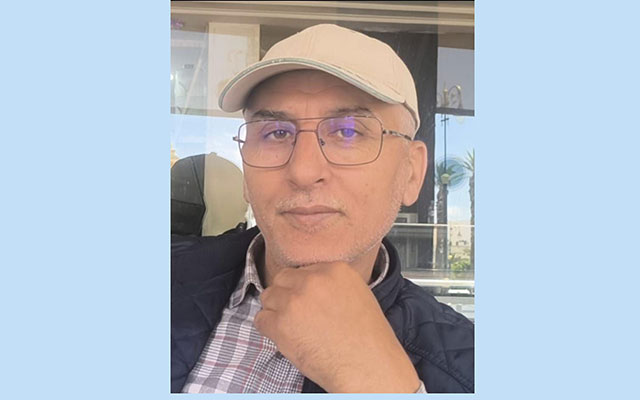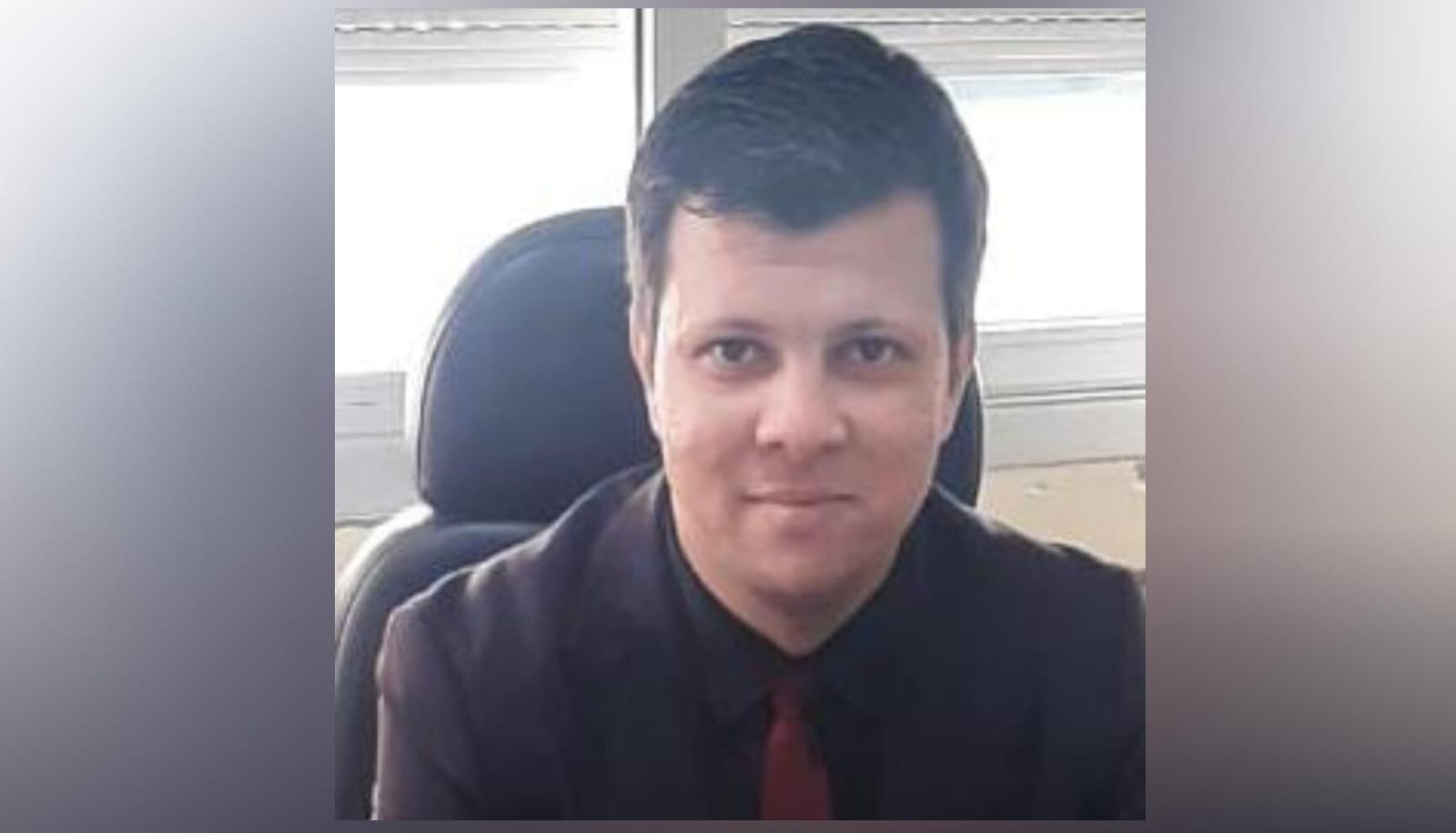نظمت شعبة الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط بتعاون مع مركز روافد للدراسات والأبحاث في حضارة المغرب وتراث المتوسط " ومؤسسة فهارس لخدمات الكتاب، ندوة تكريمية للأستاذ كمال عبد اللطيف، وذلك يوم الأربعاء 14 ماي 2025 بمدرج الشريف الإدريسي قدمت خلالها العديد من المداخلات والشهادات تضمنها كتاب جماعي بعنوان: "التنوير أفقا" قدم له ذ. محمد نور الدين أفاية. تنشر "أنفاس بريس" النص الكامل لكلمة المحتفى به ذ. كمال عبد اللطيف التي أختار لها كعنوان: "التغيير والتنوير و الشبكات".
أيتها السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم
اسمحوا لي في البداية أن أعبر عن سمو اللحظة التي تجمعنا اليوم، داخل مؤسسة احتضنتنا طلبة نهاية ستينيات القرن الماضي، ومنحتنا أعزّ ما يُطلب، مؤسسة تعلمنا في قلبها ووسط ساحاتها أصول الحوار وقواعد الاختلاف، قواعد التداول والتشارك والتنافس في زمن بلا وسائط ولا فضاءات، تفيض بما يقطع الأنفاس ويخنق.. عندما كان الاتحاد الوطني لطلبة المغرب مؤسسة لتعميم الوعي بدون شواهد، وبدون أحكام مُسبقة..
أيتها السيدات والسادة
اسمحوا لي أن أشدَّ بحرارة على أيدي الزملاء في شعبتنا وقد اختاروا اليوم أن تُشكّل ندوات فكر واعتراف أفقاً جديداً في العمل يسمح بمزيد من تعزيز ثقافة الاعتراف وقيم الوفاء وتعزيز درس الفلسفة في جامعتنا.. إن مبادرة تروم استعادة جوانب من الحضور والإشعاع الذي كان لشعبتنا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. إنني أشكرهم جزيل الشكر، وأعلن أن موضوع مداخلة ترتّب عن العنوان الذي اختاروه للمجموع المهدى لي "التنوير أفقاً"، فقد اخترت أن أقدم عرضاً بعنوان: في التغيير والتنوير والشبكات.
نتصوَّر أن أي محاولة لإعادة التفكير اليوم في مبادئ وقيم الأنوار، وفي طرق مواصلة إعادة بنائها في المحيط الثقافي العربي، يستدعي الانتباه إلى ثلاثة مؤشرات كبرى. يتعلق المؤشر الأول بالمرجعية النظرية والتاريخية التي تبلورت وتطورت هذه القيم في إطارها، ضمن صيرورة تاريخية نظرية معقَّدة. ونقصد بذلك صيرورة التاريخ السياسي الأوروبي الحديث والمعاصر، في شقه النظري والفلسفي على وجه الخصوص، وفي تمظهراته التاريخية والدينية والسياسية المتعددة والمتنوعة، وكذا في مستوى الثورات العلمية التي واكبته، وانعكست على آثارها في كثير من تجلياته. لا يعني الاستئناس برصيد هذه التجربة في التاريخ الأوروبي الحديث والمعاصر، أننا نروم استنساخها أو تحويلها إلى نموذج كوني مغلق، إن الاستئناس المقصود هنا، يُفْضِي إلى ضرورة استخلاص أهم المعطيات التي أفرزتها صيرورتها التاريخية وأهلتها للمساهمة في بناء أرصدة نظرية وتاريخية، مؤسِّسة لكثيرٍ من أَوْجُه وتجليات الفكر الحديث والمعاصر.
أما المؤشر الثاني، فيتعلق بالمحصّلات الكبرى لنوعية التفاعل الحاصل في ثقافتنا السياسية النهضوية، مع إشكالات ومفاهيم وقيم فلسفات التنوير. وإذا كنا نعي أن تفاعل ثقافتنا مع فلسفة الأنوار استغرق ما يقرب من قرنين، وأنه ما يزال متواصلاً إلى يومنا هذا، أدركنا أهمية المعطيات المترتبة عن التفاعل المذكور. ونحن نفترض أن فكرنا اليوم، يعي أهمية الأنوار وأدوارها في التاريخ، ويعي في الوقت نفسه حدودها.. ويُمَكِّنُنا الوعي العربي الجديد بأهمية الأنوار وبحدودها في الآن نفسه، من التخلص من طرق التفكير بالمثال، أي بنموذج الأنوار كما تبلور في التاريخ الأوروبي، لنتجه نحو آليات أخرى في النظر، تسمح لنا بتوسيع صوَّر استلهامنا لمختلف مكاسبها كما انتقلت إلى ثقافتنا، وكما تمت في أنماط التلقي الأخرى داخل القارة الأوروبية وفي آسيا، الأمر الذي يتيح لنا إمكانية الإحاطة بعوائقها ومنجزاتها، ومختلف صوَّر التحول والتطور التي لحقتها.
يتصل المؤشر الثالث بمجال المتغيرات التي ما فتئت تصنع اليوم؛ سياقات جديدة للتفكير في أسئلة التنوير وضرورتها في الحاضر العربي. فلم يعد هناك من يجادل في كون التحولات التي يعرفها العالم، في موضوع الموقف من أشكال التوظيف التي تُمَارَس لتحويل المُقَدَّس إلى أداة من أدوات الحرب، تدفع إلى مزيد من معاينة الجهود الفكرية الجديدة، التي تواكب ثورات التنوير وثورات المعرفة في عصرنا، لاستثمار مآثرها والتعلُّم، من عوائقها وصعوباتها، في عالم يتجه للقطع مع تصورات ومواقف معينة، من مسألة حضور المقدس في المجال العام، حيث يعرف المهتمُّون بالفلسفة السياسية والأخلاقية المعاصرة، أن بعض أعلام الفكر الأخلاقي والسياسي المعاصر. لا يحملون حماسة الأنوار الرامية إلى استبعاد إمكانية حضور الدين في المجال العام، وذلك انطلاقاً من وعيهم بضرورة التمييز بين علمنة الدولة وعلمنة المجتمع. وضمن هذا السياق، المُسْتَوْعِب لجوانب من متغيرات عالمنا، يعلنون رفضهم سواء لمسألة تقديس الدولة أو بناء لاهوت سياسي، مع ضرورة قبول صور التنوُّع والتعدُّد في العقائد داخل المجتمعات المعاصرة. ويمكن أن نتبيَّن في مثل هذه المواقف، ما يفيد نوعاً من تطوير أدبيات التنوير في الموضوع نفسه، وجعلها أكثر قرباً من متغيرات عالمنا، وأكثر بعداً عن لغة القطع والإطلاق والإقصاء.
1 - لا تنفصل معارك المجال الثقافي والديني، الحاصلة في مجتمعاتنا اليوم، عن مشروع ترسيخ مقدمات الأنوار وقيمها في فكرنا. وضمن هذا السياق، نؤكد أن انتشار دعاوى تيارات التطرُّف، ودعاوى تيارات التكفير والعنف في ثقافتنا ومجتمعنا، يمنحنا مناسبة تاريخية جديدة، لإطلاق مجابهات نقدية يكون بإمكانها أن تَكشف وتُبرز فقر ومحدودية وغُرْبَة التصورات المتصلة بهذه التيارات، عن مختلف التطلعات التي نرسم لمستقبلنا، الأمر الذي يتيح لنا بناء الفكر المبدع، أي إنشاء خيارات مطابقة لتطلعاتنا في النهضة والتقدم..
2 - لا يتعلق الأمر في موضوع دفاعنا عن قيم التنوير في ثقافتنا ومجتمعنا، ونحن نفكر في سؤال التغيير، بعملية نسخ لتجربة تمت في تاريخ غيرنا، وثقافة عصر الأنوار ما تزال مطلبًا كونيًا بامتياز، ذلك أن هذه القيم التي نشأت في سياق تاريخي محدد، في القرنين السابع عشر والثامن عشر في أوروبا، وهي تتعرض، اليوم، لامتحانات عميقة في سياق تاريخها المحلي، وسياقات تاريخها الكوني، بحكم الطابع العام لمبادئها، وبحكم تشابه تجارب البشر في التاريخ، وتشابه عوالمهم الروحية والمادية وعوالمهم التاريخية، في كثير من مظاهرها وتجلياتها.
3 - ترتبط حاجتنا إلى التنوير بأسئلة واقعنا، كما ترتبط بكيفيات تعاملنا مع قيمنا الروحية. وإذا ما كنا نعرف أن المبدأ الأكبر، الذي وجه فكر الأنوار، يتمثل في الدفاع عن عدم قصور الإنسان، والسعي إلى إبراز قدرته على تعقل ذاته ومصيره، بهدف فك مغالق الكون والحياة، فإنه لا يمكن لأحد أن يجادل في أهمية هذا المبدأ، الذي يمنح العقل البشري مكان الصدارة في العالم، ويمنح الإنسان مسؤولية صناعة حاضره ومستقبله.
4 - لا ينبغي أن نغفل التأكيد هنا، أننا لا نتصور سهولة المعركة التي تنتظرنا، فالتغيير الذي نتطلَّع إليه ليس أمرًا سهلًا، وطريقنا نحوه مفتوح على مشروع منازلات كبرى في مجالات عديدة، بهدف تعويد الذات على مواجهة أسئلة التاريخ والإصلاح، تعويدها المواجهة بالتضحيات، التي تنذر الغالي والنفيس للانتصار على أعباء التاريخ، وما سيصنع لحظة حصول التغيير الذي نتطلع إليه، سَيُعَدُّ في البداية والنهاية، بمثابة محصلة لتراكم تاريخي، قد لا نكون اليوم على بيّنةٍ تامة من مختلف أبعاده وأفعاله.
5 - لم يعد بإمكاننا أن نواصل النظر إلى منتوج هذه الثقافة وفي قلبه فكر التنوير، باعتباره خارجًا نشأ وتطوَّر بمحاذاة ثقافتنا، بل إنه يعتبر اليوم رافدًا هامًا من روافد ذاتنا التاريخية المتحوِّلة، وهو خلاصة لأشكال من المثاقفة حصلت بيننا وبين الآخرين، ويتواصل اليوم حصولها بصور وأشكال عديدة في حاضرنا، مثله في ذلك مثل روافد أخرى شملت ثقافتنا أيضًا، بمآثر ومكاسب ساهمت في إغناء وتطوير أنماط وعينا بالعالم وبذواتنا في التاريخ. نقول هذا بلغة ومنطق التاريخ، وذلك رغم كل مظاهر العنف الرمزي والمادي، التي واكبت عمليات انتقال المنتوج المذكور إلى ثقافتنا، سواء في الماضي أو في الحاضر، مع فارق هام يتعلق بكون صور مثاقفتنا في الماضي كانت مرتبطة بقوتنا وفتوحاتنا، وأن صورها في الماضي القريب اقترنت بلحظات تأخرنا التاريخي. ونتأكد من أهمية هذه المسألة، عندما نُعايِن اليوم أنماط اللغة والوعي الجديدين في ثقافتنا المعاصرة.
6 - نتصوَّر أن التنوير في الفكر والسياسة، كما رُكِّبت أسئلته ومفاهيمه ونصوصه الكبرى، في الغرب الأوروبي خلال القرون الأربعة الماضية، وإن أفضى إلى جملة من النتائج المتناقضة، إلا أنه ساهم في خلخلة كثير من اليقينيات. لقد ظل في روحه العامة مجرد أفق في النظر، مستوعب لجوانب من تحولات الفكر والسياسة كما حصلت في التاريخ. إنه ليس عقيدة، رغم أن فلسفات التنوير بلورت جهودًا في النظر إلى الطبيعة والإنسان والدين، مختلفة في كثير من أوجُهها عن تلك التي رسخت أنماطها أشكال الفكر السكولائي (المدرسيّ)، التي سادت فلسفات العصور الوسطى، سواء في أوروبا أو في باقي أنحاء العالم.
7 - يُواجِه العالم في الآونة الأخيرة، جملةً من التحوُّلات التي تنبئ أننا أمام بدايات عالم جديد، في طور الانبثاق والتَّشَكُّل. لا تشمل هذه التحوُّلات مراكز القوة والتقدم التقني، بل تنطبق أيضاً على مختلف ظواهر الاقتصاد والثقافة والسياسة والمجتمع. وإذا كنا نؤمن بأن دينامية التَّعَوْلُم قد ساهمت في تعميم مظاهر التحوُّل التي لحقت المجتمعات البشرية في العقود الأخيرة، فإن تداعيات ما حصل، أدت إلى تعميم هيمنة طقوس المجتمع الاستهلاكي على جميع مختلف أَوْجُه الحياة، صانعةً عوالم تطغى فيها العناية بالمظاهر على حساب القيم والمبادئ السامية. وفي ضوء ما سبق، لم يعد ممكناً التفكير في القضايا المذكورة، انطلاقاً من رؤية فلسفية واحدة مغلقة، فقد تلاشت بصور ملحوظة، الهيمنة التي كانت تمارسها السرديات الكبرى، في مقاربة تحوُّلات العالم وأسئلته.
8 - تُعَدُّ الشبكات في عالمنا اليوم العنوان الأكبر لعالم بلا حدود، وهي تُعَدُّ بمثابة البنية الاجتماعية لعصرنا، الذي أصبح موجَّهاً بفعل شبكات الإنتاج والقوة والتجربة بتعبير الباحث الاجتماعي إيمانويل كاستلز، حيث تقوم الشبكات ببناء عوالم افتراضية في إطار تدفق المعلومات المتعولم، متجاوزة بذلك تصوُّرنا عن الزمان والمكان، وقد ترتب عن ذلك اختراق جميع المجتمعات بالأفعال الجارفة للمجتمع الشبكي وثقافته.
9 - نفترض أن سؤال تحديث المجتمعات العربية، لا يُعَدُّ اليوم مفتاحاً لتيار سياسي بعينه، إنه سؤال يتعلق بطور من أطوار تحوُّل المجتمعات البشرية في التاريخ، ولأن العرب يُواجِهون في حاضرهم محاولات في نشر أفكار قادمة من أزمنة خَلَت، فستكون مختلف طلائعه بمختلف تلويناتها السياسية، مطالِبة بالدفاع عن التنوير باعتباره الطريق المناسب للانخراط في عمليات بناء تاريخ جديد، مرتبطٍ بصيرورة تطوُّر الفكر والمجتمع والسياسة والتقنية.
10 - تخطت شبكات التقليد عتبات واقعنا، واتجهت لاكتساح عوالمنا الافتراضية، منجزةً هيمنة غير مسبوقة على مجتمعاتنا وعلى متخيلنا. فقد مَكَّنَت الفتوحات التقنية في عالم التواصل، من إبداع آليات تسمح بنشر وتعميم مواقف وتصوُّرات لا علاقة لها بالمشترك التاريخي الإنساني. فأصبحنا أمام شبكات تخترق الأمكنة وتستقطب التابعين من كل القارات، حيث تتم عمليات نشر وتعميم تصوُّرات غريبة عن الإسلام والحرب، وأخرى عن الدنيا والآخرة وما بينهما.
11 - نتصوَّر أنه لا توجد في التاريخ هُوِيَّة دائرية مغلقة إلا في الأذهان، ويعلمنا التاريخ والفكر المعاصرين، أن زمن الثبات في التصوُّر الهوياتي انتهى، ذلك أن عصر التحوُّلات المتوالية والثورات المتلاحقة صنع ما يعرف اليوم بالهويات المتحولة والمركَّبة.. وإذا كنا نؤمن بأن تاريخ البشر في تعدُّده وتنوُّعه يُعَدُّ واحداً، فإن الاختلافات داخل صيرورته لا تصنع الخصوصيات التي تتعالى على وحدته العميقة. ولعل الخصوصيات في تعدُّدها وفي صيرورتها ترتبط بمسارات التحول التي لا تنقطع إلا لتنطبق مجدَّداً، وهي تحصل في التاريخ بحساب الجوامع المشتركة بين البشر، الجوامع التي تصنع لها اليوم الآفاق المشتركة للتعايش والتعاون.
12 - اعتاد الذين يناهضون قيم التنوير في فكرنا العربي وصف المتنورين في ثقافتنا بِنَقَلَةِ فكرٍ لا علاقة له بتاريخنا ولا بثقافتنا ومجتمعنا. وتناسوا حاجة مجتمعنا إلى مبادئ الأنوار وقيمه، وقد تأكد هذا في العقود الأخيرة من القرن الماضي، ويزداد تأكداً اليوم، وسط ما نعانيه في مجتمعاتنا من تنامي تيارات التطرّف الديني، بمختلف أشكاله وألوانه، وأمام زحف التقليدي المتزايد فقد أصبحنا في حاجة إلى تحرير الدين.
13 - يتجه اليوم جيل من الأنواريين الجدد، وقد استعانوا بالمكاسب الجديدة لدروس الفلسفة والاجتماع، إلى قَبُول فكرةِ حيويةِ الدين في المجال العمومي. كما يتجه آخرون للدعوة إلى ضرورة تطوير منظومة الأنوار، ومواصلة التفكير والبحث في الحرية والعدالة بأدوات عقلانية، الأمر الذي نتصوَّر أنه يساهم بقوة في تطوير عقلانية الأنوار ومنظومتها القِيَمِيَّة.
ويمكن أن نُدرج ضمن هذا السياق، خيارات هابرماس ورولز حيث شَكَّلت عقلانية هابرماس التواصلية بديلاً للعقلانية الأداتية، التي تعرضت لكثير من النقد في القرنين الأخيرين.
14 - إذا كان كانط قد أبرز في كتابه الدين في حدود مجرد العقل، أن المؤسسات الدينية تُعَدُّ بمثابة بُؤرٍ للاستبداد الروحي، وأنها تساهم في تدمير الحرية، فنحن اليوم جميعاً، مطالبون في ضوء التحولات الجديدة، التي لحقت الدين والمجتمع طيلة القرنين الماضيين، لمواصلة التفكير في حرية العقيدة وفي الدين المدني، دون إغفال التفكير أيضاً، في صوَّر العَوْدات الجديدة، الرامية إلى استحضار المُقَدَّس وتبرير استمراريته في حاضرنا، بصوَّر وأشكال لا حصر لها.
15 - إن إيماننا التاريخي بالتنوير ومآثره، يرتبط بكوننا ننظر إليها كأفق فكري تاريخي مفتوح على ممكنات الإبداع الذاتي في التاريخ، إنها ليست نموذجاً تاريخياً مطلقاً، وهو يتحدَّد أساساً كمقابل للتقليد، حيث لا يمكن تصور إمكانية تَحَقُّقِها بالتقليد. إن سؤال التنوير في أصوله ومبادئه الفكرية والتاريخية العامة، يعد باستمرار ثورة على مختلف أشكال التقليد.