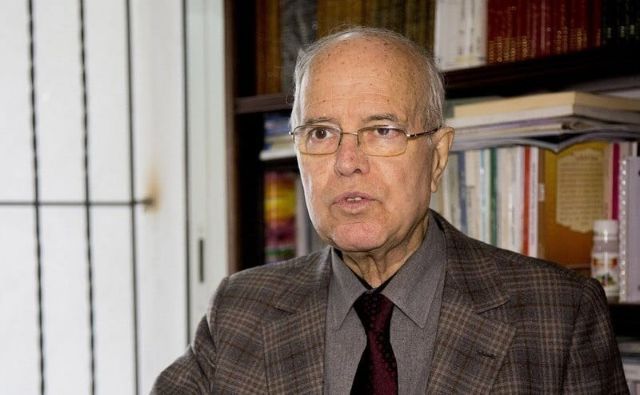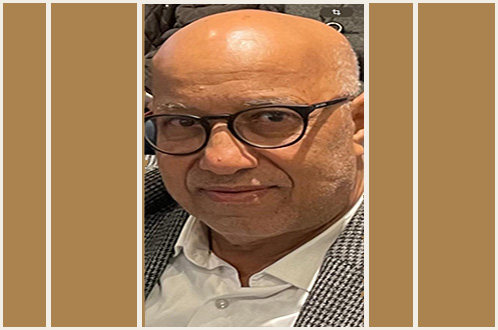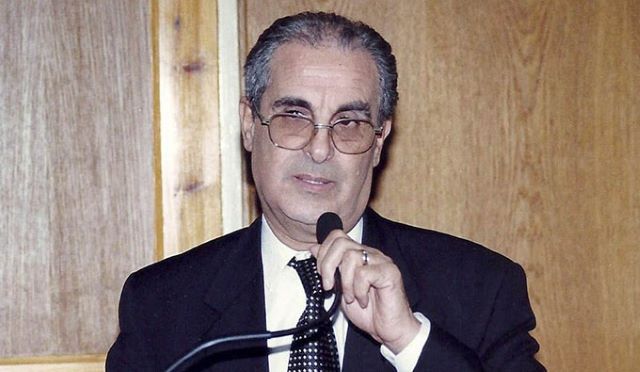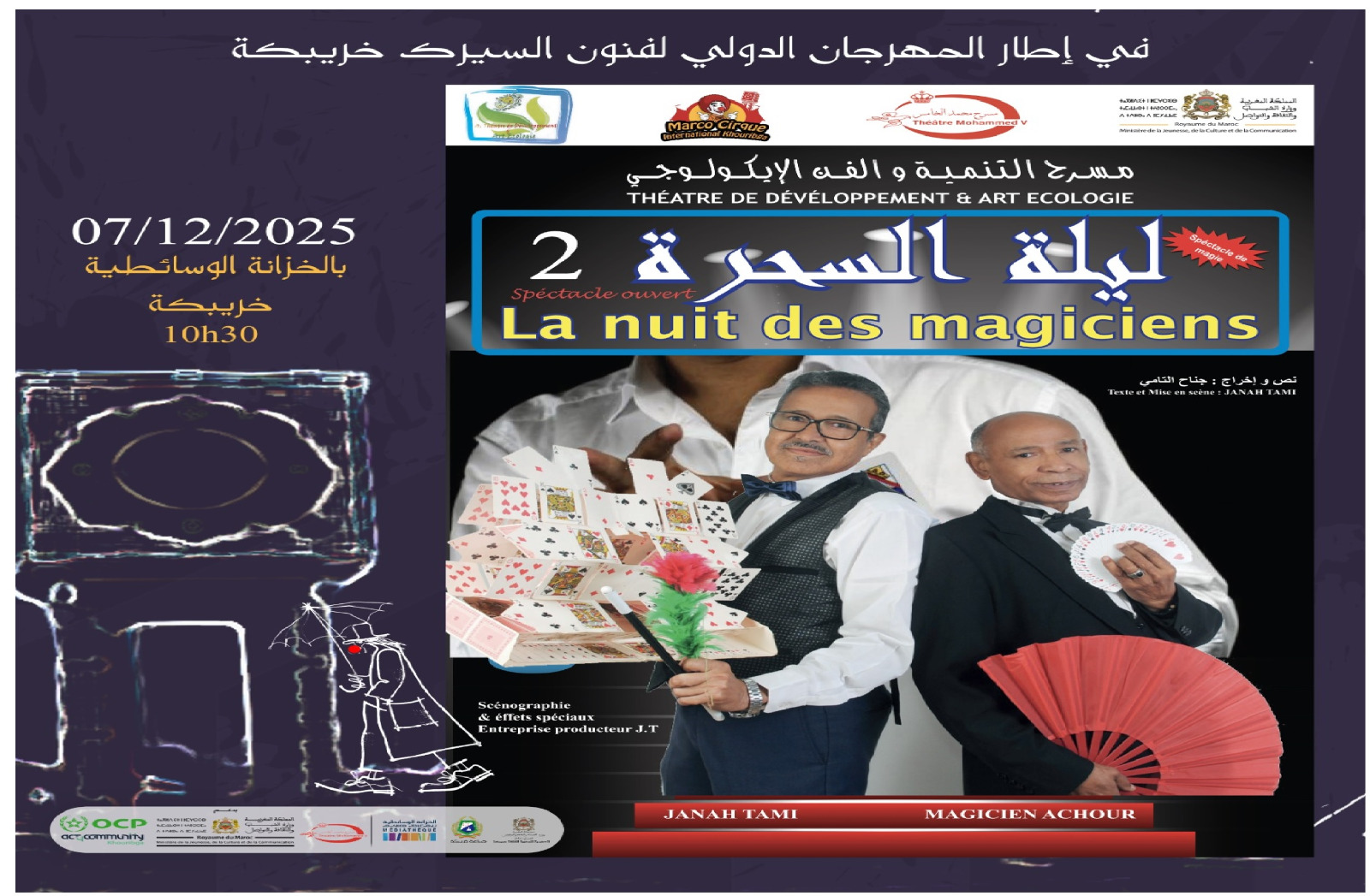الغضب الشعبي ظاهرة متجددة في المجتمعات الحديثة، خصوصًا عندما يتراكم الخلل في توزيع الموارد وفي الأداءات الحكومية، وعدم قدرتها على ترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسات.
في المغرب، لهذه الظاهرة خصائص مميزة تتعلق بالتركيبة الاجتماعية في مستوياتها الطبقية والفكرية المتعددة، وبالنظام السياسي، وكذلك في العلاقة بين الدولة والمجتمع. وانطلاقًا من هذا التأطير، ستحاول هذه المقالة عرض بعض المداخل لفهم هذه الظاهرة من زوايا متعددة: السياسة، والسوسيولوجيا السياسية، وعلم النفس الاجتماعي، والعلوم الأمنية، وكذلك محاولة تأطيرها علميًا من منظور الفكر الثوري المعاصر الذي ينظر إلى الغضب الشعبي كمجال وفرصة لتحقيق التغيير الجذري والانتقال نحو الحرية والمدنية.
سنحاول قبل كل شيء الوقوف عند بعض المفاهيم، ومنها اصطلاحًا المفهوم العام للغضب الشعبي، الذي يعني في القواميس ذلك التعبير الاجتماعي المنظَّم وأحيانًا غير المنظَّم، الذي يُفصح عن الاستياء والسخط بطريقة سلمية أو تواجهية عنيفة، وذلك بعد ملامسة الوعي المجتمعي العام لاختلالات محسوسة في العيش المشترك، وفي العدالة الاجتماعية، وفي الحقوق الأساسية (الصحة، والتعليم، والتشغيل، وباقي الخدمات العمومية).
وبتخصيص أدق، يُنظَر إلى الغضب الشعبي، من منظور حقل السوسيولوجيا السياسية، على أنه سلوك اجتماعي أو تفاعل رَفضي مع السلطة والمؤسسات السياسية، من خلال مطالب أو مقاومة يُعبَّر من خلالها عن هوية وموقف جماعي تجاه القوانين والقرارات العمومية في الفضاء العام. أما في علم السياسة، فنحن أمام مفهوم منفلت عن أدوار الوسطاء الاجتماعيين في الحقل السياسي، أي الأحزاب والنقابات وباقي هيئات المجتمع المدني، ناتج عن خلل حقيقي في العلاقة بين الآليات الديمقراطية وشرعية ممارسات الحكم التي يُعبَّر عنها بالتمثيل النيابي والوساطة.
ومن زاوية علم النفس الاجتماعي، فالغضب الشعبي هو انفعال جماعي ينبع من إدراك مشترك لأي ظلم أو إهانة تهاجمان هوية المجموعة وكرامتها، انفعال بدوافع نفسية جماعية لاسترجاع الهيبة واستعادة القوة والفعالية ورد الاعتبار، أو أحيانًا الانتقام كآلية تعويضية ترفع مستوى الاستعداد للتحرك الجماعي بغرض الثأر.
أما في العلوم الأمنية، التي تحاول بناء إطار نظري مستقل عن المداخل السابقة، فنحن أمام مساطر تدخلية للدولة وبروتوكولات نظامية من خلال أجهزة قمعية مشروعة للسيطرة على حالات الانفلات الأمني الناتجة عن غضب جماعي قد يُشكّل اختلالًا يمسّ بالأمن العام، وجب السيطرة عليه لإعادة التوازن والاستقرار في إطار مؤسساتي عام يضمن حقوق التعبير وباقي الحريات الدستورية.
الغضب الشعبي، من منظور متعدد المداخل، كان دائمًا في تاريخ الفكر الإنساني أسلوبًا ثوريًا جماعيًا، عبّر عنه الفكر الثوري بكونه تشبيكًا للحلول الجماعية من أجل تغيير جذري لمواجهة الظلم والاضطهاد والتمييز والعبودية، من خلال التنظيم في حركات اجتماعية غايتها تغيير النظام الاجتماعي والسياسي وتحرير المجتمع من قيود التسلط عبر التمرد والمواجهة.
من خلال هذه المقاربات المفاهيمية، كيف يمكن أن ننظر إلى الغضب الشعبي في المغرب اليوم؟ خصوصًا أمام وضع موسوم بارتفاع نسبة بطالة الشباب من حملة الشهادات، وغلاء المعيشة بعد الارتفاع المهول للأسعار الذي تجاوز القدرة الشرائية للطبقات الشعبية والوسطى، وكذلك النقص المهول في الخدمات العمومية: الصحة، والتعليم، وتجهيزات البنية التحتية في المناطق النائية. فضلًا عن تنامي الإحساس بالظلم والفساد بعد ارتفاع ممارسات المحسوبية والتمييز في فرص الشغل، وضعف الشفافية والتمهين والتدبير العقلاني للمنظومات الإنتاجية.
أضف إلى ذلك التفاوتات المناطقيـة والمجالية التي جعلت المغرب يسير بسرعتين: سرعة القطار السريع، وركود تنموي في المناطق المهمشة والهشة، لاسيما أمام استيطان وتمدد واستنزاف نيوليبرالي مفترس يزيد من قوة التحشيد الشعبي للمقاومة الوطنية ضد أشكال التطبيع والاستعمار الجديد. وهي كلها عوامل حفزت الغضب الشعبي والسخط العارم لدى الطبقات الشعبية الواسعة والطبقة الوسطى على طرق التدبير العمومي للشؤون العامة بأساليب انتهازية مصلحية، مع ممارسات وتأويلات نكوصية رجعية للوثيقة التعاقدية الدستورية لعام 2011.
تراكم هذه المعضلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ساهم في تكوين "بنية الاحتقان المركب"، كما يسميها علماء الاجتماع السياسي، حيث تتقاطع هشاشة سوق العمل مع الإنهاك اليومي الناتج عن الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة لتنتج سخطًا واسعًا لدى الشباب والطبقات الوسطى، وتضخمًا في مشاعر الإحساس بالإقصاء من ثروات الوطن.
كذلك، ومن منظور سياسي وأمني، أصبحنا أمام أوضاع رسّخت شعورًا جماعيًا بانعدام العدالة، وحوّلت الشرارات الاحتجاجية الصغيرة إلى مجال رحب لتفريغ غضب مكبوت ومؤجل في مستويات بسيكو-اجتماعية لاشعورية دفينة ومعقدة. كما أن التفاوت الصارخ بين المركز المختزل في صورة التحديث السريع والمشاريع العملاقة، وبين هامش يسوده الركود وانعدام الخدمات، فاقم الشعور المجتمعي بعدم الانتماء، وأجّج رغبة الجمهور في التنبيه والإشعار والانتقام من مظاهر العيش الفاحش للطبقة المستفيدة من هذه الوضعية.
ولا ننسى أن تركيز السياسات الليبرالية المتوحشة ورأس المال الأجنبي وتحالفاته الإقليمية على الاستنزاف البراغماتي للموارد الوطنية، واحتضانها لنمط إنتاجي مخزني غارق في الريع والفساد على حساب الحاجات الاجتماعية الملحة، كان سياسةً عمياء لم تنتبه إلى أن الممارسات السلوكية المتفاخرة بالثروة والاستهلاك الفاخر كانت تصبّ الزيت يوميًا على حطب الاحتقان الشعبي.
في هذا السياق، يصبح الغضب الشعبي في المغرب ليس مجرد انفعال ظرفي بالمعنى الليبرالي، وإنما مسارًا نفسيًا-اجتماعيًا-سياسيًا طويل المدى، يتغذى من الفشل البنيوي في التوزيع العادل للثروة والحق في الولوج العادل للخدمات، ومن غياب عقد اجتماعي جديد قادر على استيعاب طموحات الأجيال الصاعدة وضمان اندماجها في دورة التنمية الوطنية.
الغضب الشعبي في المغرب واعٍ كذلك بأزمة التمثيل السياسي والثقة، ويعتبر أن ضعف الأحزاب السياسية كنظام وساطة وتأطير مدني وسياسي بين الدولة والمجتمع لم يعد قادرًا على أداء هذه الأدوار. بل يرى أن الوسطاء مجرد شرذمة انتهازية تتوخى الانخراط في كوكبة زبناء وسماسرة النظام النيوليبرالي الافتراسي.
لقد تراكم شعور مجتمعي عام بأن المؤسسات المنتخبة لم تكن في يوم من الأيام جزءًا من الوجدان المواطناتي، كما أن مفهوم المواطنة نفسه ظل مؤجلًا بسبب بطء الإحساس الجماعي بالعيش المشترك والمدنية، وفي ظل الحضور التاريخي لفكرة "رعايا السلطان". كل ذلك يتم ضمن منظومة معقدة ومتشابكة لعوامل ثقافية وإعلامية واجتماعية ودينية.
الوعي الاجتماعي الذي أصبح يتعزز عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن الغضب الشعبي والمطالبة بالتغيير، ما زال غارقًا في اعتبارات ترتبط بالهوية والخصوصية المحلية، مما جعل تراكم الأزمات يؤدي إلى شرارات فئوية مناطقية محدودة: كوفاة محسن فكري (حراك الحسيمة)، أو احتجاجات جرادة بشأن مشاكل بيئية واقتصادية.
وقبلها بسنوات، فإن الموجة الاحتجاجية لحراك 20 فبراير، التي ولدتها ظرفية إقليمية مرتبطة برياح "الربيع الشمال إفريقي"، لم تتمكن بدورها من إخصاب نضج اجتماعي داخلي أو تجذير المطلبية الاجتماعية كرغبة شعبية في التحرر الجماعي، أو على الأقل كوعي اجتماعي عام يعكس تصورًا مجتمعيًا للدولة العصرية.
ولم تتمكن من إنضاج شروط الملكية البرلمانية كنظام سياسي عقلاني في إطار دولة حديثة. ولعل هذا ما يفسر التراجع السريع لما حققه الغضب الشعبي من تأثير على مفهوم عصرنة الدولة وتسريع الانتقال الديمقراطي في المغرب، وما يدعو اليوم إلى إعادة قراءة الغضب الشعبي المغربي من منظور عقلاني يُسائل الحاجات والعوامل الكفيلة ببناء وعي اجتماعي جماعي راسخ ومتجذر بتجربة وقدرات مطلبية محسوسة ومدركة في الوعي العام لدى النسيج الاجتماعي المحلي، منظور عقلاني قادر على الاستمرارية والتمأسس والمطالبة باستمرار مسيرة الانتقال زيد وزيد إلى الأمام، كما يسميه المغاربة، أو حرف Z بالمعنى الذي صوّره فيلم "Z" للمخرج كوستا غافراس، كرمز سياسي ونفسي عميق.
ينبغي أن يتقاسمه ويناقشه الشباب على منصة "الديسكور"، كي يتمكن جيل "زيد" من تمثل حرف Z كصرخة ضد القمع السياسي وتزوير الحقيقة بعد اغتيال شخصيات تاريخية من أجيال X و*Y*، وكي تتذكر "جينزيد" تضحيات الأجيال السابقة من أجل التحرر.
لذلك، فإن "جينزيد 212" يمكن أن تعكس بقوة إرادة واعية للجماهير في مواجهة الاستبداد، وأن الحياة السياسية لا تُمحى باغتيال جيل أو فرد أو خنق صوت معين في مرحلة تاريخية معينة.
يمكن أن ينجح حراكها التحرري إذا اشتغلت بأساليبها الخاصة على تعميق التجذر والحضور، ومن خلال الإحساس بآلام الشعب المغربي بقدرة ذكية على تطوير ملفها المطلبي والصمود، وتحليل الوضع الوطني في علاقته بالدولي وبكافة المتغيرات الجيوستراتيجية.
فهل يمكن للغضب الشعبي "Z" أن يكون بمثابة دعوة للاستمرار في إيقاظ الغضب الشعبي للمطالبة بالحرية والعدالة، وفك القيود والأثقال التي وُضعت في طريق الانتقال الديمقراطي؟ وهل يمكن للحراك الشعبي "Z" أن يعبر في نهاية المطاف عن موقف نفسي-اجتماعي جامع لكل الأجيال ما بعد استقلال المغرب، كي لا يُغتَال الأمل من جديد كما اغتيل واختُطِف وهُجّر قسرًا في مراحل تاريخية من استقلال البلاد؟
ولعل استدعاء "Z" بالمعنى الذي طرحه كوستا غافراس هو استدعاء لذاكرة أجيال سابقة، واستدعاء لوعي متجذر مجتمعيا وميكرو-مجتمعيا قادر على تحويل الغضب الشعبي إلى مسار ثوري دائم لمراقبة المؤسسات والأحزاب وباقي الهياكل الراعية للعيش المشترك، من منظور فكر ثوري دائم ومستدام، قد يطالب في مراحل معينة بتحسين الخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم)، لكنه مدعو في مراحل متقدمة إلى مراقبة التعاقد الاجتماعي وتوزيع السلط وتوسيع المشاركة وتتبع الخروقات في موضوع الشفافية وتضارب المصالح.