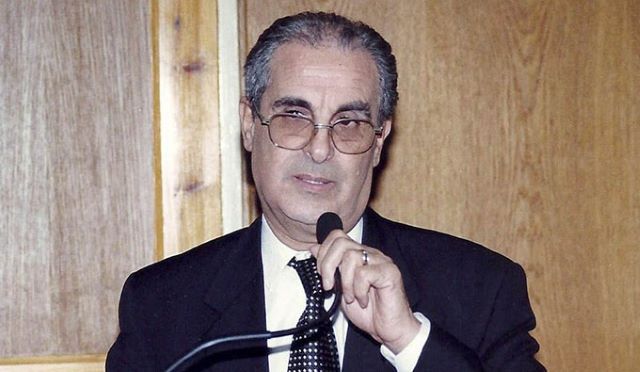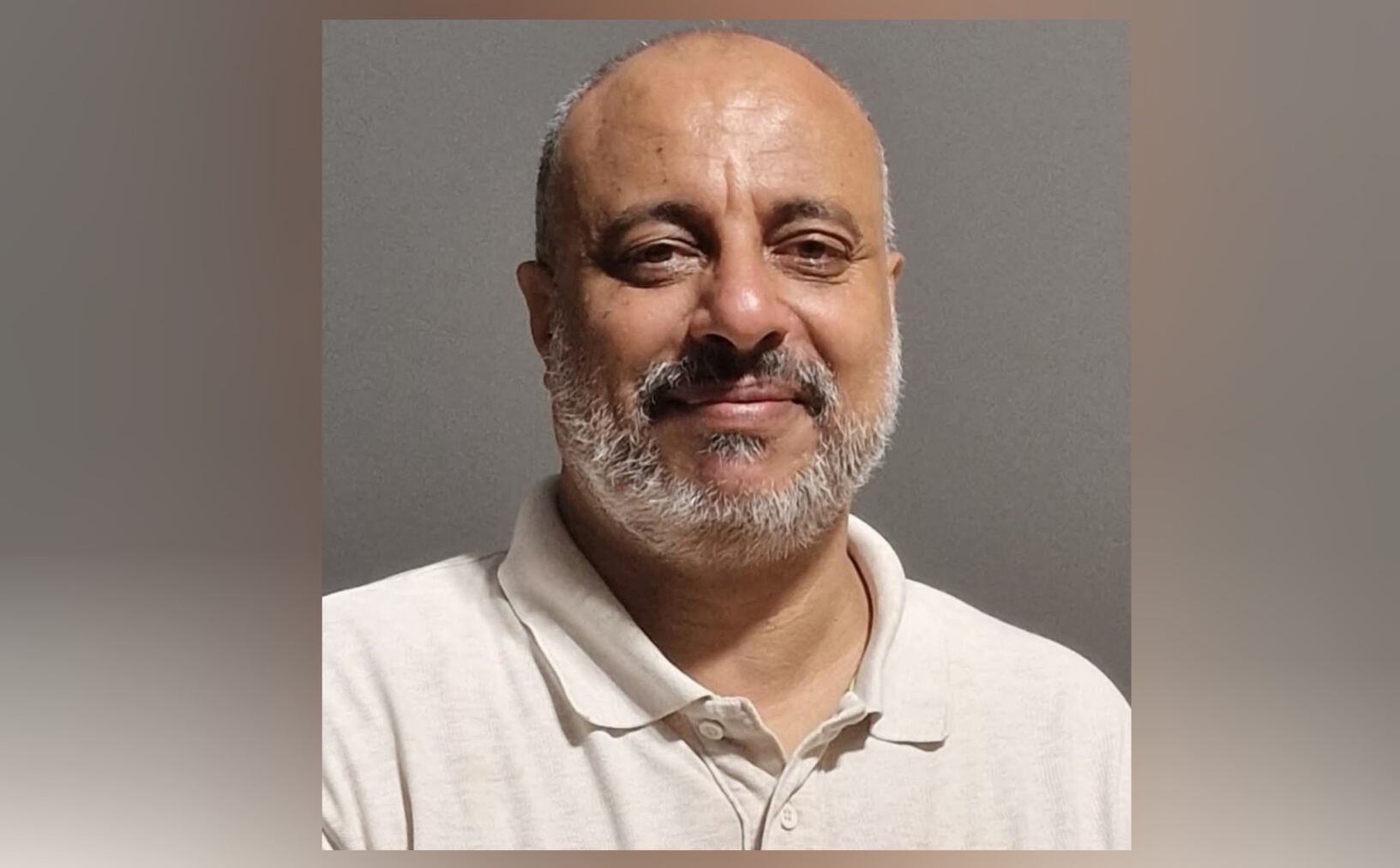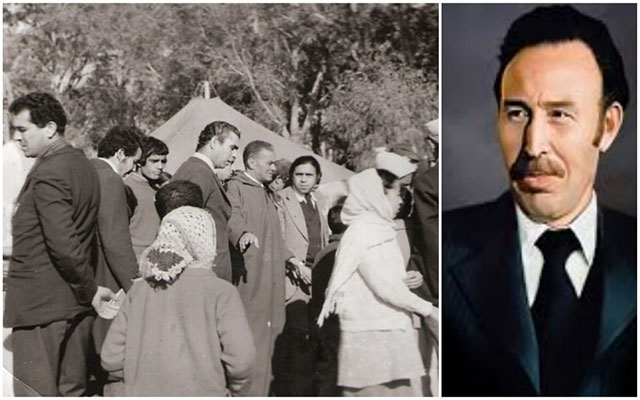مقدمة: ظاهرة تستحق وقفة نقدية
منذ أواخر سبتمبر 2025 تحول الشارع المغربي إلى مساحة احتقان؛ خرج شبان يرفعون شعارات تطالب بتحسين الصحة والتعليم والتشغيل، ومحاسبة الفساد، وتحول عدد من الوقفات إلى مواجهات عنيفة في بعض المدن مع تسجيل حالات وفاة وإصابات واعتقالات. هذه الأحداث جاءت مدفوعة بحراك شبابي لامركزي عرف بشعار «GenZ 212» أو «جيل زد-212»، ومن اللافت أنها اتسقت زمنيا مع موجة نشر مكثفة على منصات التواصل، حيث تبدو الدعوات أحيانا منسقة عبر حسابات ومجموعات رقمية متعددة.
أعرض في هذا المقال قراءة مركبة تجمع بين الملاحظة الميدانية، التحليل السيميائي للرموز (الزي، الحقيبة، صور الأنمي لبروفايلات فيسبوكية)، والتتبع الرقمي لاستراتيجيات الانتشار — مع إدراج تجربة شخصية اشتغلت فيها مباشرة على مواجهة ما اعتبرته بروفايلات مشبوهة قد تستخف بوعي الشباب وتحولهم إلى أدوات نشرية، كما أستند في التفسير النظري إلى أجوبة مفكرين مغاربة وعالميين حول العلاقة بين الشباب، الإعلام، والسياسة.
ما ترويه الصورة: الزي والإشارة الاجتماعية كرموز احتجاجية
يمكن تمييز بعض المشاركين في الميادين الاحتجاجية قبل أن يبدأ الإحتجاج: أحذية رياضية، سراويل شبابية، حقائب ظهر مدرسية، وقبعات تغطي الرأس، هذا الزي لا يقتصر على ميزة جمالية أو تعبير عن ذوق؛ بل يعمل كرمز انتماء وإشارة تنسيقية: الحقيبة لتلميذ غادر لتوه حجرة الدراسة ويبدء في التنقل كمجموعة صغيرة، والقبعة تقي من الرصد البصري المباشر (الكاميرات والهواتف). تفكيك هذه الدلالات يرفض تبسيط الاحتجاج إلى «عنف بلا سبب» أو «تخريب منفلت»، لكنه يكشف عن بناء رمزي يسهم في تنظيم السلوك المجتمعي ويمكن ناشري الدعوات من توجيه والتحكم في انفعالات الشباب.
التحليل السوسيولوجي للزي الاجتماعي يتماشى وأن العلامات البصرية تعمل كـ«رموز تمييز» داخل الحشد؛ تستجيب لطبيعة الميدان الرقمي حيث يسهل تنسيق الجماعات الصغيرة قبل التصعيد، في هذا الإطار، يؤكد تحليل البروفايلات وما تبثه من صور في أغلبها للأنمي ومخيلة صاحبه بالقوة الخارقة وبالتالي فإنها ليست بريئة أو محض تعبير فردي، بل تم توظيفها كأدوات رمزية تستعمل لجذب فئات محددة من الشباب (الطلبة، التلاميذ، مشجعي الفرق، مجموعات البيع والشراء). هذا ينسجم مع قراءة لخبراء التربية الاجتماعية الذين يرصدون كيف تتحول الصورة إلى رسالة موجهة لا إلى الجمهور فقط بل إلى منسق الشبكة نفسها.
تسلسل الأحداث: لماذا تتحول الوقفة إلى مواجهة؟
الملاحظة الميدانية المتكررة التي تحتاج تفسيرا منهجيا هي التسلسل: شعارات عامة ثم مسيرة ثم رشق بالحجارة ثم تخريب ممتلكات. ليس كل هذا بالضرورة نتيجة «تلقائية» مفردة؛ إذ قد يتضافر فيه: انفعال جمعي غير مؤطر، ودور الحسابات الرقمية التي تصنع صورا معبرة عن العنف وتقوي توقع العنف بين المشاركين. التحول هذا يعكس أيضا ضعفا في قنوات التعبير المنظمة لدى الشباب: عندما يخفق مسار المطالبة في الوصول إلى فضاء تفاوضي فعال، ينقلب التعبير إلى شكل بصري عن الإحباط — أحيانا يتخذ شكل المواجهة. تقارير عديدة ربطت هذا النمط بانتشار الوسائط الرقمية ونقص آليات الحوار المؤسساتية.
جيل زد مفهوم أم مجرَّد تسمية؟
تسمية «جيل زد» اصطلاح شائع إعلاميا وغربيا لوصف فئة شبابية ولِدت في حقبة رقمية، لكن تصنيف الأجيال عبر حروف أبجدية يحمل مخاطرات معرفية: فهو يختزل الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية داخل فئة واسعة، وقد يوحي — خطأ — بأن التاريخ قد «توقف» عند هذه الفئة، هذا ما تنتبه إليه بريجيت بروت في دراستها عن الجيل Z؛ فهي تحذر من اختزالات تنمي تصورات نمطية عن دوافع الشباب وتهمش أبعادهم المركبة (التربوية والاجتماعية والنفسية).
من زاوية فلسفية-سياسية، يحافظ مفكرون مغاربة على نقد الأساليب الانطباعية في قراءة الشباب فعبد الله العروي يؤكد على أهمية إدماج البعد التاريخي والبنيوي في فهم الظواهر الاجتماعية بدل الاكتفاء بالقوالب الجاهزة؛ أما محمد عابد الجابري يحذر من قراءة الظواهر السياسية بسرديات سطحية تفصلها عن عقلها السياسي؛ أما طه عبد الرحمن فيدعو إلى تأسيس قراءة نقدية تتجاوز التلقين الاستهلاكي. هذه المراجع الفكرية تنبهنا إلى ضرورة التمييز بين توصيف شبابي سطحي وقراءة تحيل إلى بنى أعمق.
البروفايلات الوهمية وصور الأنمي: المادّة الرمزية وما وراءها
من ملاحظاتي الرقمية المضبوطة (تجربة أنشرها أمينا أدناه) أن عشرات الدعوات للاحتجاج نشرتها حسابات تبدو «فارغة» أو «مختصرة المحتوى»؛ بعضها مقفل خلف إعدادات الخصوصية، وبعضها يكرر صورا ومقاطع فيديو مأخوذة من أحداث خارجية أو معدلة بصريا، لافت أيضا استخدام رموز الأنمي (شخصيات كرتونية ذات صفات خارقة) كصور للملف: هذه الصور تؤسس لغة رمزية توحي بالقوة الخارقة والتمويه، وهي مغرية لفئات شبابية تبحث عن هوية وتريد الانضمام إلى «قصة كبرى» تمنحها مكانة. في الأدبيات الثقافية، تؤدي هذه الصور بوظيفتين متعاكستين: تزود المشتركين بمجال رمزي للهروب، لكنها تفرغهم من الانخراط النقدي العملي في صياغة مطالب قابلة للتحقق.
(تجربتي الشخصية): كيف تصرفت رقميّا ولماذا؟
في اليومين السابقين، ومع ازدياد خطورة ما يتم تداوله رقميا، قررت تنوير الشباب الذين قد يكونون أدوات لبروفايلات خارج التراب الوطني، دخلت إلى صفحات تدعو للاحتجاج وبدأت بالرد المنهجي على المنشورات التي تحرض على التخريب، وعلى التعليقات التي تساوي بين الاحتجاج كـ«صوت شبابي» وبين التخريب المعرض لحياة الناس، وفي كل مرة يصل النقاش إلى نقطتين حاسمتين — هل الدعوة للإصلاح تبرر التخريب؟ وهل من المقبول أن نعبر عن رفض سياسة قطاع ما بتعريض الناس والملكيات للخطر؟ — ينتهي الحوار إما بحجب حسابي أو حظر متبادل أو حذف التعليق والمنشور. هذا النمط التفاعلي تكرر مع حسابات كثيرة، ثم لاحظت بعد ذلك اختفاء شبه تام للبروفايلات التي كانت تكثر من الدعوات والفيديوهات (خصوصا حسابات بدأت تنشر من قبل)، وبقاء عدد محدود جدا من الأشخاص العاديين الذين ظلوا متمسكين بممارسة احتجاجية سلمية ومعلقة على حقها في التعبير.
هذا التبدل الرقمي، في ظني، يمكن تفسيره بعدة سيناريوهات: إشراف ذاتي لحسابات أجنبية على تقليل ظهور منشوراتها باستخدام خاصيات الخصوصية أو خوارزميات ترويجية، أو أن الوقت لم يعد صالحا لتصعيد نقاش ثنائي مع متابعين حاصلين على وعي نقدي أعلى؛ لذا صارت الاستراتيجية تقتضي غزوا لمجموعات محلية عامة (مجموعات طبخ، بيع وشراء، جماهير كرة، الخ) لنشر رسائلها هناك بسرعة وبكثافة. هذه الاستراتيجية الأخيرة تبدو منطقية آليا: استغلال مجموعات ذات نشاط كبير لكن موضوعي غير سياسي لتسريب دعوات الاحتجاج إلى أوساط غير متوقعة. ملاحظة مهمة: تحريات الأجهزة الأمنية المحلية مؤخرا أظهرت حالات اعتقال لأشخاص متهمين بإدارة حسابات عدة لتضليل الجمهور، مما يضع فرضية وجود شبكات منسقة على الطاولة.
لماذا ينجح هذا النمط؟ تفسيرات نظرية وتربوية
أ- ضعف التربية الإعلامية: ضعف مهارات التحقق من المصدر لدى شريحة واسعة من الشباب يجعلها عرضة للاستقطاب. هذا ما تحدثت عنه بروت في كتابها جيل زد حين ربطت ميل الجيل الرقمي إلى الاستجابات الفورية باحتياجه إلى تدريب على النقد والاستدلال.
ب- فراغ الأفق التفاوضي: غياب قنوات فعالة للاستماع والتحاور يجعل الشارع هو الملاذ الوحيد، فتتحول المطالب إلى فعلية متسرعة دون صيغ مؤسساتية للتفاوض. هذا ما أشار إليه مراقبون محليون ومؤسسات وطنية في بياناتها الأخيرة التي دعت إلى الحوار كمسلك أساسي لتجاوز الأزمة.
ج- استغلال شبكات معلوماتية عبر حدودية: وجود شبكات تستخدم حسابات متعددة، أو حسابات مؤتمتة/مزيفة، يضاعف من فعالية الرسائل العاطفية ويصنع وهم كتلة داعمة، بينما الواقع الميداني قد يكون أقل تماسكا، كما أن التحقيقات المحلية أظهرت اعتقالات على خلفية استخدام حسابات متعددة لنشر فيديوهات مضللة عن أحداث محلية
اقتباسات فكرية مغربية تشكل إطارين تحليليين
أستند في بناء استراتيجي لحل هذه المعضلة إلى رؤى مفكرين مغاربة:
- عبد الله العروي: يدعونا إلى قراءة التاريخ والبنى الاجتماعية لمعرفة جذور الظواهر الراهنة، لا الاقتصار على قراءة سطحية للحوادث. هذه المنهجية تقود إلى ربط الاحتجاج بالهياكل المؤسسية وعدم الاكتفاء بالقراءات الإعلامية
- المهدي المنجرة: نبه إلى مخاطر هندسة المشاعر الجماهيرية و"هندسة الفوضى" كأداة سياسية وثقافية، ما يدعونا إلى اليقظة أمام محاولات توظيف العاطفة لا الوعي. (انطباعي على الملاحظة الرقمية).
- محمد عابد الجابري وطه عبد الرحمن: يحثان على تأسيس قراءة نقدية ومنهجية للقضايا السياسية تجمع بين العقل التحليلي والمعرفة الثقافية، وتمنع السقوط في السرديات البسيطة.
خارطة طريق لتجاوز الاحتجاجات كيف نحوّل الغضب إلى سياسة اقتراحية؟
اليوم لم يعد كافيا أن نكتفي بالشعارات في الشارع، ولا أن نستنزف طاقة الشباب في مواجهات تنتهي غالبا بلا مكاسب دائمة، ما نحتاجه فعلا هو خطة واقعية تحول الغضب إلى اقتراح، والاحتجاج إلى قوة ضغط منظمة.
أول خطوة يمكن أن تبدأ من المدرسة والجامعة عبر حملة وطنية للتربية الإعلامية. الهدف منها بسيط لكنه حاسم: أن يتعلم التلميذ والطالب كيف يتحقق من المعلومة، كيف يقرأ ما وراء الخوارزميات، وكيف يكتشف الحسابات المزيفة التي تدفعه إلى المجهول. الباحثة الفرنسية بريجيت بروت، التي درست ما يسمى بجيل Z، شددت على أن الشباب يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى روح النقد الإعلامي بدل الاستسلام لسطوة الشاشة. أما الخطوة الثانية والتي لا تقل أهمية فهي فتح قنوات محلية للحوار تجمع المطالب وتحولها من شعارات عامة إلى خطط عملية يمكن قياس نتائجها فالشفافية هنا تعني استعادة الثقة قبل كل شيء.
التحدي الأكبر يبقى في العالم الرقمي، حيث تعمل شبكات التضليل بحسابات وهمية وصور مضللة لجر الشباب نحو المواجهة، التعاون بين المنصات والسلطات بات ضروريا لملاحقة هذه الحسابات، مع ضمان الحق المشروع في التعبير السلمي. وقد أظهرت تحقيقات إعلامية وأمنية أخيرة أن بعض الاعتقالات طالت أشخاصاً كانوا يديرون حسابات وهمية متخصصة في بث مقاطع وصور مفبركة.
وأخيرا، يبقى الحل الأهم في المشاركة المباشرة. لماذا لا نفتح الباب أمام الشباب من مختلف الفئات — تلاميذ، طلبة، معطلين، موظفين، وحتى حاملي شهادات الدكتوراه — ليكتبوا مقترحاتهم ويضعوها على طاولة النقاش الوطني؟ كلمات بسيطة قد تتحول إلى مشروع، واقتراح صغير قد يغير سياسة قطاع بأكمله. إنها فرصة حقيقية: بدل أن يضيع صوت الشباب في صخب الشارع، يمكن أن يتحول إلى قوة اقتراحية تضع الصحة والتعليم والشغل في صدارة الأولويات. وحدها المشاركة الواعية ستجعل من الغضب طاقة بناء، لا مجرد شرارة مؤقتة.
فرصة وطنية لمواطنة المسؤولة
تجربتي المباشرة في الرد على منشورات الدعوة للاحتجاج والكشف التدريجي عن أنماط بروفايلات مشبوهة علمتني درسا عمليا: لا يكفي أن نستنكر العنف ونطالب بالحلول فيسقط الشباب فريسة لسرديات جاهزة؛ بل يجب أن نشتغل على تكريس وعي نقدي عملي، وأن نوفر قنوات حقيقية للاستماع والتفاوض. الحوار الوطني والمنظم وحدهما قادران على تحويل الغضب إلى اقتراحات قابلة للتنفيذ، فنحن أما فرصة وطنية تاريخية.


 (1).png)