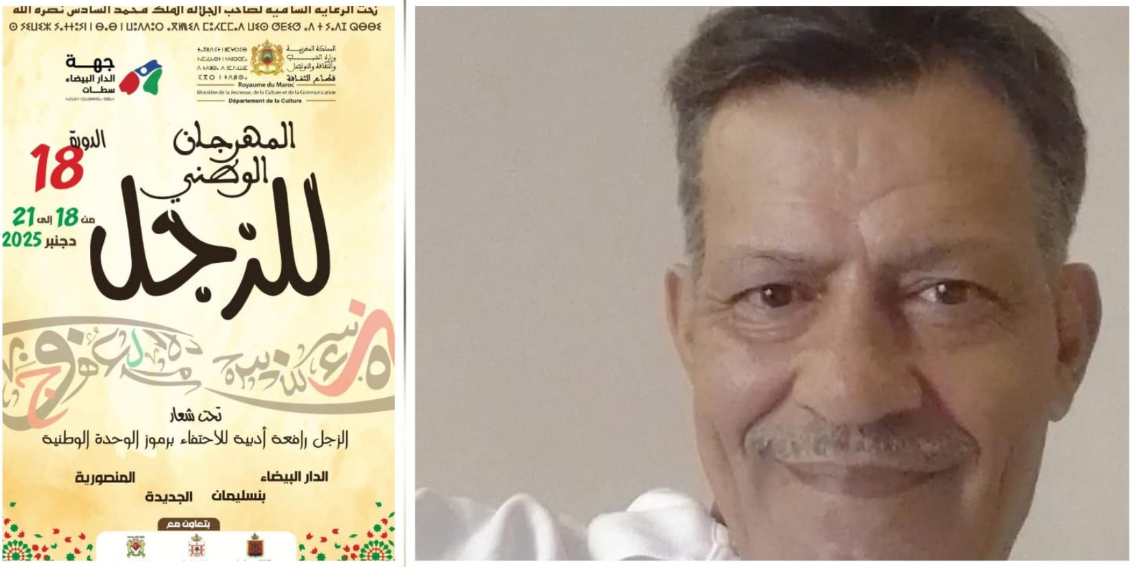منذ قرن تقريبًا، تشكّلت الدولة الوطنية في العالمين العربي والإسلامي على أنقاض الإمبراطوريات التقليدية، وفي ظلّ استعمار مباشر أو وصاية غير مباشرة. ورغم كل ما رافق نشأتها من عيوب بنيوية واختلالات تاريخية، فإنها أصبحت اليوم الإطار السياسي الوحيد الممكن لتنظيم الاجتماع البشري، وحماية السيادة، وضمان الحدّ الأدنى من الاستقرار . غير أنّ هذا الإطار نفسه بات، في العقود الأخيرة، محاصَرًا بتناقضات داخلية عميقة، في مقدّمتها صعود تيارات "الإسلام السياسي"، بتعدّدها، وتباينها، بل وتناحرها أحيانًا، ما جعل السؤال عن مصير الدولة الوطنية سؤالًا فلسفيًا ومقاصديًا بامتياز، لا يمكن اختزاله في الأمن أو السياسة وحدهما .
"الإسلام السياسي" ليس كتلة واحدة، بل أطياف متصارعة: من الإخواني البراغماتي الذي يقبل الدولة مرحليًا ويعمل على اختراقها من الداخل، إلى السلفي الحركي الذي يشكّك أصلًا في شرعية الدولة الوطنية باعتبارها “بدعة غربية”، إلى الجهادي التكفيري العنيف الذي يرى في الدولة الحديثة عدوًا يجب هدمه، وصولًا إلى صيغ هجينة تحاول التوفيق بين الخطاب الدعوي والعمل الحزبي، دون حسم فكري أو فقهي. هذا التعدّد لم يُنتج ثراءً، بل فوضى في المرجعيات، وارتباكًا في المفاهيم، وتآكلًا في الثقة بين المجتمع والدولة .
في العمق، لا يكمن الإشكال في “الدين” ولا في “التديّن”، بل في غياب فلسفة سياسية إسلامية حديثة تعترف بالدولة الوطنية كمعطى تاريخي نهائي، لا كمرحلة عابرة في انتظار “الخلافة”. معظم تيارات "الإسلام السياسي" تعاملت مع الدولة بمنطق الغنيمة أو الأداة: إمّا السيطرة عليها، أو تعطيلها، أو تقويضها، لكنها نادرًا ما تعاملت معها كفضاء مشترك، وكعقد اجتماعي جامع، وكإطار مقاصدي لحفظ الدين والنفس والعقل والمال والكرامة .
هنا تبرز المعضلة الكبرى: هل نحتاج إلى إعادة تشكيل المجال الديني والسياسي؟ أم إلى فلسفة جديدة للحكم؟ أم إلى فقه جديد يواكب زمن الذكاء الاصطناعي والتحولات العلمية؟ في الحقيقة، نحن نحتاج إلى كل ذلك معًا، ولكن ضمن رؤية تركيبية لا ترقيعية. فإعادة تشكيل المجال الديني لا تعني قمعه ولا تهميشه، بل تحريره من التوظيف الأيديولوجي، وإعادته إلى وظيفته الأخلاقية والتربوية، بوصفه رافدًا للقيم لا مصنعًا للشرعيات السياسية المتنازعة.
أما المجال السياسي، فقد آن له أن يتحرر من عقدة “الشرعية الدينية” التي استنزفته، ومن وهم استنساخ نماذج ماضوية في سياق عالمي مختلف جذريًا. الدولة الحديثة تُدار بالمؤسسات، والقانون، والعقلانية، والمساءلة، لا بالموعظة والإرشاد ولا بالشعارات . وكل محاولة لأسلمة السياسة دون تحديث الفقه السياسي، هي في الحقيقة تديين للفشل، لا أسلمة للنجاح .
الفلسفة المطلوبة اليوم ليست فلسفة مستوردة بالكامل، ولا انغلاقًا هوياتيًا دفاعيًا، بل فلسفة مقاصدية عقلانية، تعيد طرح الأسئلة الكبرى: ما غاية الدولة؟ ما حدود السلطة؟ ما معنى الشرعية؟ كيف نوازن بين القيم والنجاعة؟ وكيف نحمي الإنسان، لا بوصفه تابعًا لجماعة، بل مواطنًا كامل الحقوق والواجبات؟ هذه الأسئلة لا تجيب عنها النصوص وحدها، بل الاجتهاد المقاصدي المتجدد، القادر على فهم روح العصر دون التفريط في الثوابت .
لقد كشف صعود "الإسلام السياسي" ، ثم تعثره أو سقوطه في أكثر من تجربة، عن مأزق عميق: غياب فقه الدولة . فقه العبادات متين، وفقه المعاملات الكلاسيكية حاضر، لكن فقه الدولة، بمعناه الحديث، ظلّ إما مؤجّلًا أو مشوّهًا. الدولة ليست مسجدًا كبيرًا، ولا حزبًا دينيا، ولا جماعة دعوية، بل كيان معقّد يدير التنوع، ويحتكر العنف المشروع، ويوازن بين المصالح المتعارضة، ويخضع لمنطق الزمن والتطور.
في زمن الذكاء الاصطناعي، تتضاعف التحديات . لم يعد السؤال فقط: من يحكم؟ بل كيف يحكم؟ وكيف تُتخذ القرارات؟ وكيف تُحمى الخصوصية؟ وكيف تُوزّع الثروة في اقتصاد رقمي؟ وكيف يُصان العقل في زمن الخوارزميات؟ تيارات "الإسلام السياسي" في معظمها، ما زالت تناقش قضايا الهوية والرموز، بينما العالم ينتقل إلى نقاشات السيادة الرقمية، والأخلاقيات التقنية، ومستقبل العمل، ومعنى الإنسان نفسه . هذا الفارق الزمني ليس بسيطًا؛ إنه فجوة حضارية.
الفقه المطلوب اليوم ليس فقه التكفير والتحريم، ولا فقه التبرير السياسي، بل فقه المآلات، وفقه الأولويات، وفقه الموازنات..فقه يعترف بأن الدولة الوطنية، رغم عيوبها، هي شرط الاستقرار، وأن تفكيكها باسم “الأمة” لا ينتج إلا دويلات فاشلة، وحروبًا أهلية، واستباحة للخارج . الأمة قيمة حضارية وأفق ثقافي، لكنها لا تُدار سياسيًا خارج الدولة .
إن مصير الدولة الوطنية في العالم العربي والإسلامي سيتحدد بقدرتها على تجديد شرعيتها، لا بالقمع ولا بالشعارات، بل بالعدالة، والكرامة، والتنمية، وحماية المجال الديني من التسييس، وحماية السياسة من التديين . كما سيتحدد بقدرة النخب الفكرية والدينية على إنتاج وعي جديد، يتجاوز ثنائية “الدولة ضد الدين” و”الدين ضد الدولة”، نحو شراكة مقاصدية عقلانية، يكون فيها الدين ضميرًا أخلاقيًا، والدولة إطارًا قانونيًا، والسياسة فنًّا لإدارة الممكن .
لسنا في حاجة إلى “إسلام سياسي” جديد، بل إلى سياسة عاقلة بقيم إسلامية إنسانية عامة: العدل، الأمانة، حفظ الكرامة، ترشيد السلطة.. ولسنا في حاجة إلى دولة دينية، ولا إلى دولة معادية للدين، بل إلى دولة مدنية بمرجعية قيمية واضحة، تستوعب الدين دون أن تختطفه، وتحمي التعدد دون أن تميّعه .
في النهاية، السؤال الحقيقي ليس: هل ستصمد الدولة الوطنية؟ بل: أي دولة وطنية نريد؟ دولة هشة تُستعمل كغنيمة أيديولوجية؟ أم دولة راشدة، تعي تعقيد العصر، وتستثمر في العقل، وتؤمن بأن أعظم مقاصد الشريعة اليوم هو حفظ الإنسان من الفوضى، ومن الاستبداد، ومن العبث باسم النصوص المقدسة. هذا هو التحدي، وهذه هي المعركة الفكرية الحقيقية في زمن التحولات الكبرى .
"الإسلام السياسي" ليس كتلة واحدة، بل أطياف متصارعة: من الإخواني البراغماتي الذي يقبل الدولة مرحليًا ويعمل على اختراقها من الداخل، إلى السلفي الحركي الذي يشكّك أصلًا في شرعية الدولة الوطنية باعتبارها “بدعة غربية”، إلى الجهادي التكفيري العنيف الذي يرى في الدولة الحديثة عدوًا يجب هدمه، وصولًا إلى صيغ هجينة تحاول التوفيق بين الخطاب الدعوي والعمل الحزبي، دون حسم فكري أو فقهي. هذا التعدّد لم يُنتج ثراءً، بل فوضى في المرجعيات، وارتباكًا في المفاهيم، وتآكلًا في الثقة بين المجتمع والدولة .
في العمق، لا يكمن الإشكال في “الدين” ولا في “التديّن”، بل في غياب فلسفة سياسية إسلامية حديثة تعترف بالدولة الوطنية كمعطى تاريخي نهائي، لا كمرحلة عابرة في انتظار “الخلافة”. معظم تيارات "الإسلام السياسي" تعاملت مع الدولة بمنطق الغنيمة أو الأداة: إمّا السيطرة عليها، أو تعطيلها، أو تقويضها، لكنها نادرًا ما تعاملت معها كفضاء مشترك، وكعقد اجتماعي جامع، وكإطار مقاصدي لحفظ الدين والنفس والعقل والمال والكرامة .
هنا تبرز المعضلة الكبرى: هل نحتاج إلى إعادة تشكيل المجال الديني والسياسي؟ أم إلى فلسفة جديدة للحكم؟ أم إلى فقه جديد يواكب زمن الذكاء الاصطناعي والتحولات العلمية؟ في الحقيقة، نحن نحتاج إلى كل ذلك معًا، ولكن ضمن رؤية تركيبية لا ترقيعية. فإعادة تشكيل المجال الديني لا تعني قمعه ولا تهميشه، بل تحريره من التوظيف الأيديولوجي، وإعادته إلى وظيفته الأخلاقية والتربوية، بوصفه رافدًا للقيم لا مصنعًا للشرعيات السياسية المتنازعة.
أما المجال السياسي، فقد آن له أن يتحرر من عقدة “الشرعية الدينية” التي استنزفته، ومن وهم استنساخ نماذج ماضوية في سياق عالمي مختلف جذريًا. الدولة الحديثة تُدار بالمؤسسات، والقانون، والعقلانية، والمساءلة، لا بالموعظة والإرشاد ولا بالشعارات . وكل محاولة لأسلمة السياسة دون تحديث الفقه السياسي، هي في الحقيقة تديين للفشل، لا أسلمة للنجاح .
الفلسفة المطلوبة اليوم ليست فلسفة مستوردة بالكامل، ولا انغلاقًا هوياتيًا دفاعيًا، بل فلسفة مقاصدية عقلانية، تعيد طرح الأسئلة الكبرى: ما غاية الدولة؟ ما حدود السلطة؟ ما معنى الشرعية؟ كيف نوازن بين القيم والنجاعة؟ وكيف نحمي الإنسان، لا بوصفه تابعًا لجماعة، بل مواطنًا كامل الحقوق والواجبات؟ هذه الأسئلة لا تجيب عنها النصوص وحدها، بل الاجتهاد المقاصدي المتجدد، القادر على فهم روح العصر دون التفريط في الثوابت .
لقد كشف صعود "الإسلام السياسي" ، ثم تعثره أو سقوطه في أكثر من تجربة، عن مأزق عميق: غياب فقه الدولة . فقه العبادات متين، وفقه المعاملات الكلاسيكية حاضر، لكن فقه الدولة، بمعناه الحديث، ظلّ إما مؤجّلًا أو مشوّهًا. الدولة ليست مسجدًا كبيرًا، ولا حزبًا دينيا، ولا جماعة دعوية، بل كيان معقّد يدير التنوع، ويحتكر العنف المشروع، ويوازن بين المصالح المتعارضة، ويخضع لمنطق الزمن والتطور.
في زمن الذكاء الاصطناعي، تتضاعف التحديات . لم يعد السؤال فقط: من يحكم؟ بل كيف يحكم؟ وكيف تُتخذ القرارات؟ وكيف تُحمى الخصوصية؟ وكيف تُوزّع الثروة في اقتصاد رقمي؟ وكيف يُصان العقل في زمن الخوارزميات؟ تيارات "الإسلام السياسي" في معظمها، ما زالت تناقش قضايا الهوية والرموز، بينما العالم ينتقل إلى نقاشات السيادة الرقمية، والأخلاقيات التقنية، ومستقبل العمل، ومعنى الإنسان نفسه . هذا الفارق الزمني ليس بسيطًا؛ إنه فجوة حضارية.
الفقه المطلوب اليوم ليس فقه التكفير والتحريم، ولا فقه التبرير السياسي، بل فقه المآلات، وفقه الأولويات، وفقه الموازنات..فقه يعترف بأن الدولة الوطنية، رغم عيوبها، هي شرط الاستقرار، وأن تفكيكها باسم “الأمة” لا ينتج إلا دويلات فاشلة، وحروبًا أهلية، واستباحة للخارج . الأمة قيمة حضارية وأفق ثقافي، لكنها لا تُدار سياسيًا خارج الدولة .
إن مصير الدولة الوطنية في العالم العربي والإسلامي سيتحدد بقدرتها على تجديد شرعيتها، لا بالقمع ولا بالشعارات، بل بالعدالة، والكرامة، والتنمية، وحماية المجال الديني من التسييس، وحماية السياسة من التديين . كما سيتحدد بقدرة النخب الفكرية والدينية على إنتاج وعي جديد، يتجاوز ثنائية “الدولة ضد الدين” و”الدين ضد الدولة”، نحو شراكة مقاصدية عقلانية، يكون فيها الدين ضميرًا أخلاقيًا، والدولة إطارًا قانونيًا، والسياسة فنًّا لإدارة الممكن .
لسنا في حاجة إلى “إسلام سياسي” جديد، بل إلى سياسة عاقلة بقيم إسلامية إنسانية عامة: العدل، الأمانة، حفظ الكرامة، ترشيد السلطة.. ولسنا في حاجة إلى دولة دينية، ولا إلى دولة معادية للدين، بل إلى دولة مدنية بمرجعية قيمية واضحة، تستوعب الدين دون أن تختطفه، وتحمي التعدد دون أن تميّعه .
في النهاية، السؤال الحقيقي ليس: هل ستصمد الدولة الوطنية؟ بل: أي دولة وطنية نريد؟ دولة هشة تُستعمل كغنيمة أيديولوجية؟ أم دولة راشدة، تعي تعقيد العصر، وتستثمر في العقل، وتؤمن بأن أعظم مقاصد الشريعة اليوم هو حفظ الإنسان من الفوضى، ومن الاستبداد، ومن العبث باسم النصوص المقدسة. هذا هو التحدي، وهذه هي المعركة الفكرية الحقيقية في زمن التحولات الكبرى .
الصادق العثماني - أمين عام رابطة علماء المسلمين بأمريكا اللاتينية