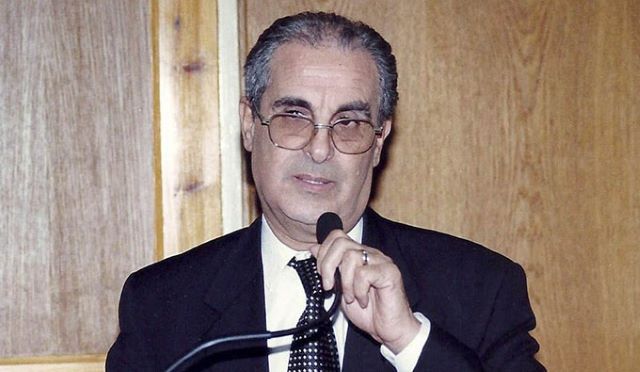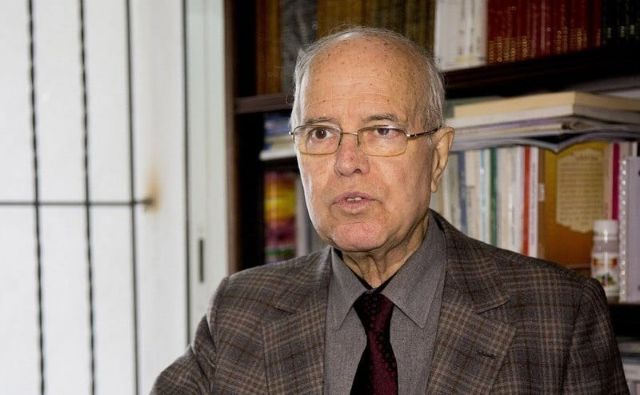عنوان هذه المقالة يفرض علينا طرحَ سؤالين مهمَّين. السؤال الأول هو : "ما هو هذا الكلام الذي نسمعه في أحاديثنا اليوميةِ"؟ والسؤال الثاني : "لماذا كثيرٌ من هذا الكلام غير منطقي"؟
جوابا على السؤال الأول، الكلام الذي نسمعه في أحاديثنا اليومية له علاقة بما هو متعارف عليه في اللغة المتداولة ب"المكتوب". والمكتوب، كما يفهمه عامة الناس، هو أن كلَّ خطوة، في حياة البشر، منذ ولادتهم، بل منذ وجودهم في أرحام أمَّهاتِهم، إلى مماتِهم، مخطَّطٌ لها مسبقا من طرف خالق الكون، أي الله، سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى، كل تصرُّف يقوم به الإنسان في حياتِه اليومية، ليس إلا تعبيرٌ عن ما رسمه له، عزَّ وجلَّ، مسبقا.
وهذا الإدراك لِما يُسمى "المكتوب"، خاطئ على طول الخط ويتناقض مع ما جاء في القرآن الكريم الذي يُبيِّن بوضوح أن اللهَ، سبحانه وتعالى، لما منحَ العقلَ لبني آدم، منَحَه لهم ليُميِّزهم عن باقي مخلوقاته الحية، والأهمُّ، هو أن يكونوا، بواسطة عقولِهم، أحرارا ولهم الاختيار بين ما لهم فيه خيرٌ في حياتهم الدنيوية ويتجنَّبوا كلَّ ما يُدخِل التعاسة أو أيَّ نوع من الشرور في هذه الحياة الدنيوية.
أما الجوابُ على السؤال الثاني الذي نصُّه : "لماذا كثيرٌ من هذا الكلام غير منطقي"؟ غير منطقي، أي لا تقبلُه عقولٌ سليمةٌ، نيِّرَةٌ ومستنيرَة. وقبل الدخول في تفاصيل هذا الجواب، هناك توضيحٌ لا غنى عنه لإدراك ما سأقولُه في الفقرات الموالية.
فحينما ميَّز الله، سبحانه وتعالى، بني آدمَ عن باقي المخلوقات الحيَّة الأخرى، بالعقل والنُّطق، فهذا التَّمييزُ ليس صدفةً من الصُّدف. بل إنه تمييزٌ مقصودٌ أراد، من خلاله، عزَّ وجلَّ، أن يعيشَ الناسُ داخل مجتمعات منظَّمة وليكونَ العقلُ البشري هو مُنشِئ ومدبِّرُ هذا التنظيم، مصداقا لقولِه، سبحانه وتعالى : "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ" (الحجرات، 13).
والدليل على أنه، عزَّ وجلَّ، لا يخلقُ الأشياء عبثاً، أي بدون غاية، قولُه، سبحانه وتعالى : "الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَـٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ" (آل عمران، 191).
والدليل على أنه، عزَّ وجلَّ، لا يخلقُ الأشياء عبثاً، أي بدون غاية، قولُه، سبحانه وتعالى : "الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَـٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ" (آل عمران، 191).
والتنظيم الذي يُنشِئُه ويُدبِّره العقل البشري لخَّصه اللهُ، سبحانه وتعالى، في فعلِ "لِتَعَارَفُوا". ومباشرةً بعد فعل "لِتَعَارَفُوا"، قال، عزَّ وجلَّ : "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ". و"أَتْقَاكُمْ" تعني، في هذه الآية، مَن يخشى اللهَ من الناس ويتبع ما أمرَ به من خيرٍ للبلاد والعباد.
وهنا، لا بدَّ من التذكير أنه من ضرب المستحيل أن يعيشَ الناسُ في مجتمعات sociétés غير منظمة اجتماعياً وأخلاقياً، على الخصوص. والتنظيم يكون عن طريق القوانين les lois. والقوانين يمكن أن تكونَ وضعيةً عُرفِيةً lois coutumières، أي غير مكتوبة، أو بعبارة أوضح، شفهية. كما يمكن أن تكونَ وَضْعيةً مكتوبةً. وفي كلتي الحالتين، فهي قوانين، مصدرُها بشري، مُتَّفقٌ عليها جماعيا ويُحتَكم إليها عند الضرورة، أي في حالة الصراعات أو الخلافات أو القضايا المختلفة… علما أن العقلَ البشري، كما سبق الذكرُ، هو مَن يُنتِج هذا التنظيم، ومن خلالِه، القوانين. ولعلَّ أسمى القوانين التي تُنظِّم حياةَ الناس، هي الدساتير les Constitutions.
انطلاقا من الاعتبارات السابقة، هناك أسئلةٌ تفرض نفسَها علينا. من بين هذه الأسئلة، أخصُّ بالذكر ما يلي :
1."فهل يُعقَل أن يقولَ عامَّة الناس أن حياتَهم مُبرمجة مُسبقاً من طَرَف العليِّ القدير، وهو، سبحانه وتعالى، وهبهم العقل ليكونوا أحرارا في حياتهم وفي تصرُّفاتِهم طيلةَ هذه الحياة"؟
2.وهل يُعقل أن يهب اللهُ، سبحانه وتعالى، العقلَ للناس لينظِّموا أنفُسَهم بأنفُسِهم، وفي المقابل، يرسُمَ لهم حياةً أخرى غير التي أراد أن يُنظِّموها بأنفسِهم؟
قبل الإجابة على هذين السؤالين، أدعو القارئَ للاطِّلاع على مقالة خصَّصتُها لحرية التَّصرُّف عند الإنسان العاقل، نشرتُها، بتاريخ 18 غشت 2024، على صفحتي بالفيسبوك تحت عنوان "الإنسانُ، خلقَه الله، سبحانه وتعالى، حرّاً". ونشرتُها كذلك على صفحتي في مِنصَّة "الأنطولوجيا"، بتاريخ 17 غشت 2024، تحت نفس العنوان.
وجوابا على السؤالين المُشار إليهما أعلاه، سآخذُ مثالاً حيا من الحياة اليومية. لنفرض أن شخصا ما خرج من منزلِه وأثناء سيره، تعرَّض لحادثة سيرٍ وألحَقَت به أضرارا في جسمِه. فهل تُحسَب الحادثة على "المكتوب" أو لعدم احترام قانون السير؟
المنطق يقول إن الحادثةَ ناتِجةٌ عن عدم احترام قانون السير. لماذا؟ لأنه، لو نَسَبناها ل"المكتوب"، لأصبح اللهُ، سبحانه وتعالى، ظالِما للناس لأنه اختار هذا الشخص من دون الناس وعرَّضه لحادثة سيرٍ. وحاشا أن يكونَ اللهُ، سبحانه وتعالى، ظالِما لعباده، وهو يريد لهم الخيرَ، مصداقا لقولِه، سبحانه وتعالى : "إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَـٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ" (يونس، 44).
إذن، حوادث السير مشكلاتٌ اجتماعية ناتجة عن عدم احترام التنظيم الاجتماعي والأخلاقي الذي يفرضُه تساكنُ الناس وتعايُشُهم في مجتمعات منظَّمة. وفي حالة حادثة سيرٍ، عدمُ احترام التنظيم الاجتماعي والأخلاقي يتمثَّل في عدم احترام قانون السير. بل لا يمكن، منطقياً، نسبُها إلى "المكتوب".
يُضاف إلى هذه الاعتبارات أن كثيرا من الناس لا يفرِّقون بين "كَتَبَ اللهُ علينا" و"كَتَبَ اللهُ لنا".
"كَتَبَ اللهُ علينا" فيها إلزامٌ وأمرٌ وفرضٌ و واجبُ… بمعنى أن المسلمين، كَتَبَ "عليهم" اللهُ، سبحانه وتعالى، الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج لمَن استطاع إليه سبيلا. كما كتب "على" المسلمين عدمَ أكل لحم الخنزير وعدم الاعتداء على الغير وحرَّم النَّميمة والظلم…، مصداقا، مثلاً، لقولِه، سبحانه وتعالى : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (البقرة، 283). والإلزامُ، في هذه الآية، جاء عن طريق "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ" وليس كُتِبَ لكم. أو مصداقا لقولِه، عزَّ وجلَّ : "وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ" (البقرة، 43). الإلزام، في هذه الآية، جاء عن طريق أفعال الأمر التي هي : "وَأَقِيمُوا" و"وَآتُوا" و"وَارْكَعُوا".
أما "كَتَبَ اللهُ لنا" فتعني أن اللهَ، سبحانه وتعالى، خلق وقوعَ "حادثة سيرٍ" وخلق عدمَ وقوعها، أي خلق الشيءَ وضدَّه، مصداقا لقولِه، عزَّ وجلَّ : "وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" (الذاريات، 49). لماذا خلق اللهُ، سبحانه وتعالى، الشيءَ وضدَّه؟
لأن الله، عزَّ وجل، لا يمكن، على الإطلاق، أن يتناقض مع نفسِه. أي يريد أن يكون الناسُ، بواسطة عقولهم، أحراراً في تصرُّفاتِهم، ويفرض عليهم حياةً مضادة لإرادته.
يقول، سبحانه وتعالى، في الآية رقم 78 من سورة النساء : "أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَـٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَـٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَالِ هَـٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا" (النساء، 78).
في هذه الآية، عندما قال، عزَّ وجلَّ، "...قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ…"، المقصود هو أن الحسنةَ والسَّيِّئةَ كلاهما من عند الله، أي أن اللهَ، سبحانه وتعالى، هو الذي خلق "الحسنةَ" وخلق ضدَّها "السَّيِّئة"، والعقل البشري هو الذي يختار ما يُناسبه، مصداقا لقولِه، سبحانه وتعالى : "مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا (النساء، 79).
هذه الآية تبيِّن، بوضوحٍ، أن الإنسانَ هو الذي يختار بين الحسنة والسيِّئة. ولهذا، فكل مخالفةٍ للتنظيم الاجتماعي والأخلاقي للمجتمعات، فالإنسان هو الذي يتحمَّل عواقبَ اختياره. ولهذا، عندما يتعرَّض شخصٌ لحادثة سير، إما هو، نفسُه، الذي لم يحترم قانونَ السير الذي هو عَقدٌ اجتماعي pacte social، أي مُتَّفقٌ عليه جماعياً. وإما شخصٌ آخرَ لم يحترم قانونَ السير، فيكونُ سببا في وقوعِ حادثةِ سيرٍ للغير.
ولهذا، كل إخلالٍ بالتَّنظيم الاجتماعي، لا يمكنُ نَسبُ عواقبه، حسب القرآن الكريم، ل"المكتوب". لماذا؟
لأن اللهَ، سبحانه وتعالى، بيَّن للناس، في القرآن الكريم، ما لهم فيه خيرُ وما قد يصيبُهم من شر. والخيرُ والشرُّ خلقهما وبيَّنهما، سبحانه وتعالى، في كتابِه المُحكَمِ الآيات، فما على الإنسان إلا أن يختارَ بينهما. ولهذا قال، عزَّ وجلَّ، في الآية رقم 195 من سورة البقرة : "أَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ".
في هذه الآية الكريمة، "التَّهْلُكَةِ" تعني كل ما يسبِّب للناس الضررَ. و "الْمُحْسِنِينَ" تعني الناسَ الذين يُتقنون أو يُحكِمون القولَ والفعلَ طِبقا لما تمَّ الاتفاقُ عليه جماعياً. فحينما يحترم الناسُ التنظيمَ الاجتماعي والأخلاقي للمجتمعات، فإنهم يُحسَبون من فئة المُحسِنين.
غير أن تنظيمَ المجتمعات، نفسُه، لا يمكن أن يبقى جامدا إلى الأبد. فكلما تطوَّرت المجتمعات وتقدَّمت، وبالخصوص، علمياً، تكنولوجياً واقتصادياً، فمن المفروض أن تتغيَّرَ، كذلك، تنظِيماتُها الاجتماعية والأخلاقية. وتطوُّر وتقدُّم المجتمعات هما اللذان يرفضونَهما كثيرٌ من علماء وفقهاء الدين، المتشبِّثون بقوانين أو تشريعات تجاوزها الزمان ولم تعُد صالِحة للعصر الحديث.