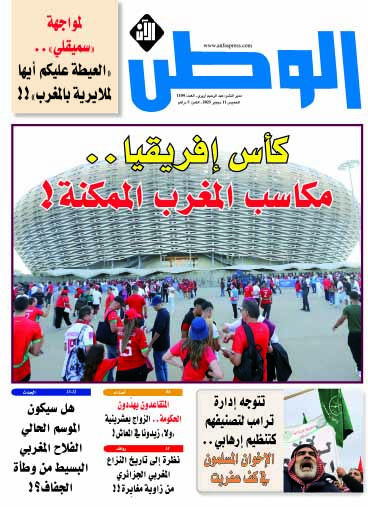حين قدّم أكيرا كوروساوا فيلم راشومون عام 1950، بدا وكأنه لا يروي جريمة، بل يفتح أبوابًا على لغز الوجود نفسه. المطر ينهمر بلا توقف، البوابة المهدّمة تستقبل المارة كجدار أطلال، والغابة الكثيفة تخفي في أحشائها فعلاً غامضًا: اغتصابًا وقتلاً. أربعة شهود يتناوبون على رواية الحادثة: قاطع الطريق، الزوجة، الزوج المقتول عبر وسيط روحي، ثم الحطاب. كل شهادة تدّعي الحقيقة المطلقة، لكن تداخلها يكشف أن الحقيقة ليست وحدة، بل تبعثر متعدّد يتوزّع بين الروايات والنظرات. ليست الغاية أن نصل إلى النسخة الصحيحة، بل أن ندرك أنّ الحقيقة لا تسكن التطابق بل تتجلى في وعي الإنسان بتشظيها.
قد تتحدى الكتابة السينمائية واقعا مغمورا
الغابة في راشومون فضاء أسطوري قبل أن تكون موقعًا للجريمة. أشعة الشمس تتفتت بين الأغصان، الظلال تتكرر، المسار يتحوّل إلى متاهة. الطبيعة نفسها تدخل في لعبة التعدد، وكأنها تهيئنا لفقدان الحقيقة. هذا يذكّرنا بالمتاهة الإغريقية حيث ضاع ثيسيوس قبل أن يواجه المينوتور: المكان نفسه كان امتحانًا، يضلل قبل أن يكشف. وفي الثقافة العربية، نجد الصدى في التيه الصحراوي: فقدان الطريق ليس مجرد ضياع، بل تجربة وجودية، تجعل الإنسان يواجه ذاته وحدها. الغابة إذن ليست خلفية محايدة، بل صورة رمزية لتفكك الحقيقة: الطبيعة مكسورة، فما بالك بالرواية الإنسانية؟
يستعمل كوروساوا عدة تقنيات سينمائية ليدخلنا في قلب هذا التشظي :
تعدد الرواة وبنية القصة
- الشهادات الأربع: الراوي ليس واحداً بل أربعة (قاطع الطريق، الزوجة، روح الزوج، والحطّاب).
- الحكايات المتداخلة: كل راوٍ يعيد سرد الحادثة نفسها من زاوية مختلفة، فيتولد تضارب ينسف فكرة “الحقيقة الواحدة”.
- هذه البنية الدائرية تجعل المتفرّج يشارك في البحث عن الحقيقة ثم يكتشف أن لا نتيجة نهائية.
الراوي غير الموثوق
- كل شهادة مشبعة برغبات الراوي: الدفاع عن النفس، تبرير العار، أو استعراض البطولة.
- كوروساوا يعرض تناقضاتهم ببرود، فلا يمنح أيّ رواية شرعية أكثر من الأخرى.
التقطيع البصري والمونتاج
- إعادة المشهد نفسه: يستخدم المونتاج لإعادة اللقطة من زوايا متعدّدة، بزمن مختلف أحياناً، لتذكيرنا بأن الكاميرا نفسها لا تملك الحقيقة.
- القطع السريع بين الغابة الموحية والوجوه المقرّبة يضاعف الإحساس بالضياع.
الضوء والظلال
- تصوير في غابة كثيفة، أشعة الشمس تتخللها مثل شفرات، رمزٌ لتشقق الواقع.
- الضوء لا يكشف بل يخلق مزيداً من الالتباس: الظلال تتحرك، الوجوه نصف غارقة في العتمة.
الصوت والموسيقى
- الإيقاع الموسيقي يتغيّر مع كل رواية: أحياناً ملحمي، أحياناً هادئ، فيعكس مزاج الراوي.
- الصمت المفاجئ في لحظات معينة يترك المجال لتأمل المشاهد وشكه.
الإطار الحاضر
- الحطاب، الكاهن والرجل العابر يجلسون في بوابة “راشومون” يعلّقون على الحكايات.
- هذا “المستوى الميتاسردي” يذكّرنا أننا أمام قصة تُحكى، لا أمام واقع ثابت.
كوروساوا يحوّل الجريمة إلى مرآة لفشل الإنسان في امتلاك الحقيقة. التعدد السردي، الراوي غير الموثوق، المونتاج المتكرر، واللعب بالضوء والظل، كل هذا يصنع تجربة حيث الحقيقة نفسها تصبح شخصية غائبة
الروايات متعارضة فيما بينها و مع نفسها – أصوات المرايا
قاطع الطريق، الزوجة، الزوج الميت، الحطاب. كل راوٍ يعرض حكايته كأنها الوحيدة الصحيحة. لكن الروايات تتقاطع وتتصادم: الحقيقة لا تسكن أيًّا منها، بل تتولد من انكسارها جميعًا في وجه بعضها. في الأساطير الإغريقية، كان الكورس (الجوقة) يعكس تعدد الأصوات في التراجيديا، يعلّق دون أنيمنح جوابًا نهائيًا. وفي التراث العربي، نرى المشهد في ألف ليلة وليلة: القصة الواحدة تُروى عدة المرات، وكل راوٍ يعيد تشكيلها بحسب حاجته، كأن الحكاية كائن حيّ يتبدل باستمرار، فكلما قصّت شهرزاد حكاية، ولّدت أخرى، حتى صار الليل نفسه مرآة لتشقق الحكايات.
هذا التشظي السردي نلمسه أيضًا في الأدب العالمي. ففي الصخب والعنف (Le Bruit et la fureur) لويليام فوكنر، نتابع مأساة عائلة كومبسون عبر أربعة أصوات مختلفة، كل صوت يقدّم زمنه ورؤيته الخاصة، دون أن يكتمل أي منها بمفرده. كما في راشومون، الحقيقة عند فوكنر ليست ما حدث، بل كيفية روايته: أصوات متنافرة، متداخلة، يضيّع القارئ معها الطريق لكنه يكتشف أن الضياع نفسه هو الحقيقة.لا توجد حقيقة واحدة، بل لحظات تتفتت كقطع زجاج، كل عين تراها من زاوية مختلفة. هكذا يلتقي الفيلم الياباني مع الرواية الأمريكية في قلب فكرة واحدة: الحقيقة ليست في تطابق الروايات، بل في وعي الإنسان بشتاتها.
ومن الغابة اليابانية إلى الجنوب الأمريكي، ومن الجوقة الإغريقية إلى ألف ليلة وليلة، يظل السرد البشري مرآة متكسّرة، لا تعكس وحدة بقدر ما تكشف غنى التناقض. هكذا يصبح راشومون مرآة لهذا الإرث الكوني: الحقيقة ليست رواية موحّدة، بل شبكة من السرديات المتضاربة، كل منها يضيء زاوية ويظلم أخرى.
لعبة الغياب والغربة يتسرّبان إلى الفيلم في أكثر من مستوى، وكأنّ كل شخصية تروي حادثة وقعت «في مكان آخر» لا يمكنها الوصول إليه تماماً.
1. غربة عن الحدث
- كل راوٍ يتكلم وكأنه لم يكن هناك: حتى الحاضرون في الواقعة يبدون كمتفرجين على نسخة داخلية منها، فيمسحون ما عاشوه ويعيدون خلقه.
- شهاداتهم أقرب إلى أساطير ذاتية منها إلى ذكريات، كأن الحقيقة الأصلية انسحبت وتركت فراغاً.
2. غربة بين الرواة
- لا رابط إنساني بينهم: قاطع الطريق، الزوجة، الروح المستحضَرة، الحطاب…
- يجتمعون فقط عبر فعل الحكي أمام البوابة، لكنهم يبقون جزرًا منفصلة؛ لا ثقة، لا تعاطف، لا رغبة في التفاهم.
3. فضاء الغابة كبُعد غائب
- الغابة ليست مكاناً محدداً بل متاهة رمزية.
- الضوء المتقطّع والظلال الكثيفة يوحيان أن ما جرى قد حدث في “لا مكان”، فضاء منسيّ خارج الزمن.
4. الغياب كموضوع
- الجريمة بلا يقين، الجثة بلا حقيقة، والطفل (في نهاية الفيلم) يصبح أول رابط حي يعيد شيئاً من الألفة، فيُقابَل بحركة تبنّي الحطاب.
- كأنّ الفيلم يلمّح أن الأمل الوحيد في كسر هذه الغربة هو فعل إنساني بسيط، لا السرد ولا الشهادة.
كوروساوا لا يكتفي بتشظية الحقيقة؛ إنه يزرع إحساساً بأن الحقيقة نفسها رحلت. الرواة غرباء عن بعضهم وعما جرى، ونحن كمشاهدين نصبح غرباء بدورنا، نبحث عن حدثٍ غائب لا يعود.
قد تصبح الكاميرا عيونا مكسرة
السينما نفسها تدخل اللعبة. الكاميرا عند كوروساوا لا تنقل الحقيقة، بل تصوغها من زاوية معينة. حين يرفعها نحو السماء، نرى الضوء متشظيًا بين الأغصان، في لقطات أصبحت شهيرة عالميًا. هذا الانكسار البصري ليس صدفة، بل استعارة عن الحقيقة التي تنقسم كلما نظرت إليها عين جديدة. الفكر السفسطائي الإغريقي قال: الإنسان مقياس كل شيء. الحقيقة هنا ليست ما يحدث، بل ما تُبصره كل عين. وفي الأمثال العربية نقرأ: الحق كالسيف، يلمع في كل جهة. النظرة ليست نافذة محايدة، بل مرآة تفتت المشهد وتعيد ترتيبه. بهذا، تصبح العين راوٍ آخر، والكاميرا أداة تكشف أن الرؤية نفسها تصوغ روايتها. فالإخراج عند كوروساوا لا يكتفي بعرض شهادات متناقضة
إنه يصوغ اللغة البصرية والتمثيلية بحيث يجعل كل رواية تبدو كمرآة لذات الراوي، لا كنسخة محايدة من الواقع.
عدة عناصر تظهر هذا «التلاعب» الذي يدعم الذاتية والتكسير:
1. أداء الممثلين المتحوّل
- نبرة وصوت وإيماءات مختلفة:
- قاطع الطريق (توشيرو ميفوني) يُقدَّم مرةً كوحش بطريقة مبالغ فيها، وأخرى كمقاتل فخور، بحسب من يروي.
- الزوجة تظهر تارةً ضحية خائفة، وتارةً فاتنة متحكمة.
- كوروساوا طلب من الممثلين أن يعيدوا تمثيل المشهد نفسه بإيقاع ونبرة مختلفين لكل شهادة، فيصبح التمثيل ذاته دليلاً على نسبية “الحقيقة”.
2. حركة الكاميرا والزوايا
- لقطات متكررة بزوايا متباينة: الغابة تُصوَّر أحياناً من علٍ، أحياناً من مستوى الأرض، مع مسارات متشابكة للكاميرا.
- هذا الاختلاف يزرع الشك في «عين» المتفرّج: ما نراه يتبدّل مثلما يتبدّل السرد.
3. الإضاءة والظل
- اللعب القوي بين الشمس المخترِقة والأوراق الكثيفة يخلق ظلالاً متكسّرة، توحي بأن الضوء نفسه غير موثوق.
- الوجه نصف مضاء نصف مظلم يعكس انقسام الراوي الداخلي.
4. المونتاج والإيقاع
- يكرّر مقص المونتاج المشهد الواحد بقطع مختلف، فيتحول الزمن إلى شظايا.
- الانتقالات المفاجئة بين روايات تزيد الإحساس بأن الحدث «ينكسر» كلما حُكي.
5. المستوى الميتاسردي
- الشخصيات الجالسة عند بوابة “راشومون” (الحطاب، الكاهن، العابر) تُصوَّر بهدوء ثابت، في مقابل فوضى الشهادات.
- هذا التباين يجعل الحكايات الداخلية أقرب إلى «مسرحيات» يبتكرها كل راوٍ.
كوروساوا يعامل الممثل والكاميرا والمونتاج كعناصر روائية لا كأدوات محايدة.
كل شهادة تُعاد صياغتها بتمثيل وإضاءة وزوايا خاصة، فيدرك المشاهد أن ما يراه ليس “الواقعة”، بل إسقاط ذاتي متكرر.
وعي الإنسان بالتشظي
حين يعود السرد إلى بوابة راشومون، تحت المطر، نجد أنفسنا أمام عتبة رمزية: معبد متهدم، بين الداخل والخارج، بين الخراب والحياة. المكان يذكّرنا ببرسيفوني الإغريقية التي تعيش بين عالمين، كما يذكّرنا بالمقامات العربية حيث النص يتأرجح بين الجد والهزل، بين الواقع والخيال. الوعي هنا ليس في اختيار رواية على حساب أخرى، بل في إدراك أن كل رواية شظية من حقيقة أكبر لا تُمسك كاملة. وهنا يتحول الإنسان من باحث عن الحقيقة إلى شاهد على هشاشتها.
راشومون ليس فيلمًا عن جريمة غامضة بقدر ما هو تأمل في هشاشة الحقيقة وتفتتها. الغابة متاهة بصرية، الشهادات مرايا متقابلة، الكاميرا عيون متكسّرة، والبوابة المهدّمة عتبة رمزية للحقيقة. في النهاية، لا رواية صحيحة وأخرى خاطئة: كلها مجتمعة ترسم صورة الإنسان وهو يواجه تعدد السرديات دون أن يمتلك يقينًا مطلقًا.
قد نتساءل في النهاية: من الأضعف، الواقعة أم الحكاية؟ فلكي تكتسب الحادثة الآنية والعشوائية حضوراً اجتماعياً، علينا أن نلزمها بنَسَقٍ سردي خطّي. وهنا يبدأ التشظّي: الراوي يختار ويُهمل، والسامع يعيد التشكيل، فتذوب الحقيقة كشبح غائب. ومع ذلك يبقى السرد، سلاحاً تتبناه الذات لتسكن اضطرابات الحياة. ربما لهذا يصبح الحكي ضرورة نفسية، لا مجرّد ترفٍ فني.
إذا كان فيلم "راشومون" يُعلّمنا تجزئة الواقع، فربما لأنه يكشف عن خلل أعمق بكثير: الهشاشة الوجودية للحقيقة نفسها. لا يُظهر الفيلم شخصياتٍ تتصارع على حقيقةٍ راسخةٍ تُشوّهها. بل على العكس، يُظهر أن الحقيقة شبحٌ غائب، شمسٌ لا تُمحى. ما هو متينٌ وقويٌّ ومرنٌ هو الرواية. صُممت للحماية، أو التمجيد، أو التضحية، وهي الدرع السردي الذي تصنعه الأنا للنجاة من فوضى الوجود. لم يعد السؤال إذن "ما هي الحقيقة؟" بل "ما هو هدف هذه القصة؟ لماذا هي ضروريةٌ للبقاء النفسي لراويها؟"
الحقيقة المتشظّية في زمن الأخبار المتعددة
- اليوم تتناسل الروايات حول كل حدث: شبكات اجتماعية، منصّات إعلامية، شهادات متضاربة.
- مثل شهود Rashōmon، كل طرف يقدّم «حقيقته» ملوّنة برغباته ومصالحه.
- الإنترنت شبيه بالغابة التي صوّرها كوروساوا: مسارات متقاطعة، أشعة معلومات متكسّرة، وظلال يصعب التحقق منها.
- المتصفّح، مثل المشاهد، مطالب بأن يكون المحقّق والحَكَم.
- كثرة القنوات لم تُلغِ الغربة: كل مستخدم يعيش في فقاعة، كما عاش الرواة في عزلاتهم.
- هنا يصبح تبنّي “الطفل” في الخاتمة رمزًا لأي فعل تضامن بشري يتجاوز ضوضاء السرديات.
بعد سبعين عامًا من Rashōmon، نعيش بدورنا داخل بوابة إلكترونية لا تنتهي. كل حادثة تلد عشرات الشهادات، وكل شاشة غابةٌ من ضوء وظل. ربما كان كوروساوا يحدّثنا عن حاضرنا أكثر مما نحسب، حين جعل الحقيقة شبحًا لا يُمسَك، والرحمة البشرية آخر خيط يربطنا ببعضنا.
يتردد صدى تحليل فيلم "راشومون" أبعد من القضايا السياسية والإعلامية. فهو يُسلّط الضوء بدقةٍ فائقة على أكثر آلياتنا النفسية حميمية. ألم نشعر قط، عند محاولة سرد حلمٍ لعدة أشخاص، بذلك الشعور الحاد بخيانة التجربة الأصلية؟ مع كل إعادة سرد، نُبرز تفصيلاً، وننسى آخر، ونُكيّف النبرة مع جمهورنا. الحلم، هو واقعٌ مُعاشٌ يتصدّع بشكلٍ لا يُمكن إصلاحه بمجرد محاولتنا استيعابه من خلال اللغة ومشاركته. من قاعة المحكمة إلى خصوصية غرفة نومنا، يكشف فيلم كوروساوا عن قانونٍ عالمي: الذاكرة سرد، وكل سرد تفسير. وهكذا، فإن تجزئة الواقع ليست لعنةً حديثة، بل هي حالةٌ أساسيةٌ من حالات التجربة الإنسانية، يُخلّدها فيلم "راشومون" بكآبةٍ مُتألقة.