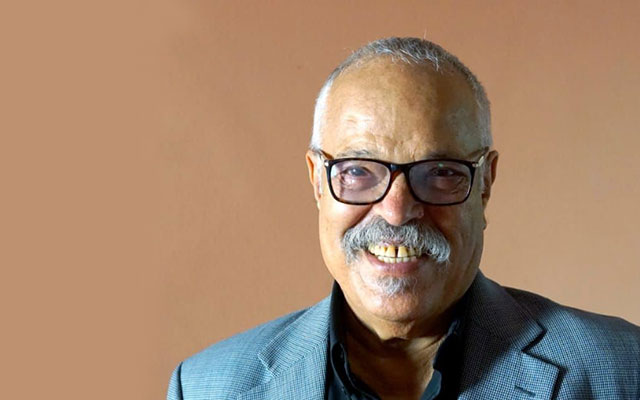التقيت بها كأنني اصطدمت بمرآة الحقيقة. لم تكن موظفة عمومية، ولا منتمية لنقابة، ولا حاملة لشهادة. وليست من معارف عزيز، كانت "كسّالة" في حمام شعبي، امرأة بنصف جسد، ونصف حياة، وكل التعب. تتحرك بصعوبة، وقد التصق الوجع بركبتها كما يلتصق الصابون البلدي بجدار الحمام. تنقل الماء الساخن من الحوض، تسكبه، تفرك الجسد، تتلقى الأوامر، وتكتم الألم.
سألتها إن كانت تملك تأمينا صحيا، فضحكت كما لو أني سألتها إن كانت تملك حسابا في بنك سويسري. "ما عنديش"، قالتها ببساطة جارحة. سألتها إن كانت تستفيد من أي دعم، من جهة ما، من مؤسسة اجتماعية، من مبادرة ملكية، من وزارة تضامن، من شيء ما، فقالت وهي تبتسم بحسرة: "المؤشر ديما طالع... واخا عيشتنا ديما هابطة".
لم تكن تشتكي. كانت تصف الواقع، كما هو، مجردا من الزينة والأرقام. كانت تشتغل اثنتي عشرة ساعة متواصلة داخل أبخرة الحمام، لا يقطع عنها التعب إلا صوت أحد أبنائها حين يتصل بها عبر الهاتف، الذي كانت تفكر في بيعه. لم يكن الحنين هو ما يمنعها من ذلك، بل الضرورة. كانت تفكر فيه كأداة اتصال ضروري، لا كترف، لا كوسيلة ترفيه، بل كجسر الحياة بينها وبين من تبقى من عائلتها خارج جدران الحمام.
تحدثتُ معها طويلاً، وأخبرتني أن صديقتها، التي اشتغلت معها في نفس الحمام الشعبي، توفيت فجأة بعد معاناة صامتة مع المرض. كانت تشتكي من ألم في صدرها، ولم يُنصت لها أحد. اشتغلت حتى سقطت، وماتت حتى نُسيت. خلفت وراءها أبناءً لا معين لهم، ولا ملفاً في وزارة، ولا بطاقة "راميد"، ولا عزاء وطنياً. لا جريدة كتبت عنها، ولا قناة سلطت الضوء، ولا مسؤول تحرك. ماتت وانتهت القصة. لكن شبيهاتها ما زلن على قيد الألم.
هؤلاء النساء لا يظهرن في تقارير التشغيل، ولا يُحسبن ضمن الاقتصاد الوطني، ولا يمثلن فئة سياسية تستحق التفاوض أو الحماية أو حتى الإحصاء. إنهن يشتغلن في مهن غير مصنّفة، لا تخضع لقانون، ولا تحظى بأي هيكلة. وهن كثيرات: كسّالات، عاملات تنظيف، مساعدات منزليات، بائعات الخبز، حاملات البضائع، حارسات ليليات... نساء في هامش الهامش، لا يحمين أجسادهن، بل يُفرطن فيها من أجل العيش.
الحمام الشعبي، الذي يُقدّم في الأدبيات التراثية كفضاء نسوي للراحة والنظافة، ريخفي في داخله واحدة من أبشع صور استغلال الجسد مقابل البقاء. حرارة خانقة، بخار كثيف، ساعات طويلة من الوقوف والانحناء، أمراض جلدية وتنفسية وآلام مزمنة، دون تغطية صحية، دون عقود، دون حد أدنى للأجر، دون راحة أسبوعية، دون تقاعد، دون إنسانية قانونية.
ومع ذلك، ما تزال "الكسالة" واقفة، لا تسأل شيئاً، لا تطلب صدقة، فقط تواصل العمل، كما لو أن الجَلدَ صار خياراً. وبينما تتحدث الحكومة عن مؤشرات التنمية، وعن التشغيل، وعن الصعود الاقتصادي، هناك نساء يُفركن واقعهن بأظافرهن، في صمتٍ مطبق.
أين أنتم أيها المدافعون عن حكومة أخنوش؟ أين أنتم من هؤلاء؟
أنتم الذين تكتبون عن الاستثمارات والعلاقات وشبكة المال، هل تتذكرون من يغسل ظهورنا ليعيش؟
هل تدخلون الحمام يوما دون أن تفكروا في من يسكب الماء، ويفرك الأجساد، ويكتم ألمه في الزاوية؟
ليس الخطر في الاستثمار، بل في أن تتحول الحكومة إلى صندوق استثماري بلا إنسان. ليس العيب في النجاح، بل في النسيان. أي نموذج تنموي هذا الذي لا يُدرج من يموت في البخار؟ أي إصلاح اجتماعي هذا الذي لا يحمي من تعمل بلا صوت، بلا قانون، بلا تمثيلية؟
نحن في بلاد تُرتب أولوياتها من الأعلى، وتغفل القاعدة. في بلاد تُهلل للاستثمار في العقار والفلاحة والسياحة، لكنها تنسى أن تستثمر في ضمان كرامة من يشتغلون داخل المهن غير المنظمة.
نحن في بلاد يتحدث فيها رئيس الحكومة عن "معرفته لمعظم الفاعلين"، فيما لا يعرف أحد اسم المرأة التي ماتت في الحمام الشعبي بعد خدمة وطنية صامتة.
هذا ليس مقالا.
هذا تذكير بأن تحت هذا الوطن نساء، كثيرات، لا ينمن إلا حين يُغمى عليهن، ولا يُدوّن وجعهن في تقرير، ولا يذكرن في نشرة الأخبار.
من يدلك ظهر الكادحات؟
من يسمع وجع الركبة التي لم تعد تتحمل ثقل العمل؟
من يجيب حين تسألنا الكسالة في آخر النهار: “فين غاديين بهاذ البلاد؟”