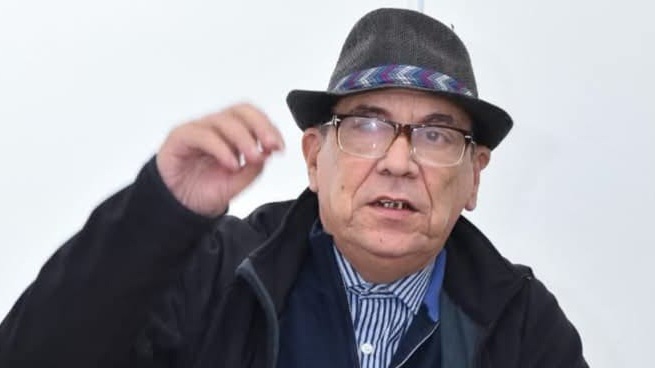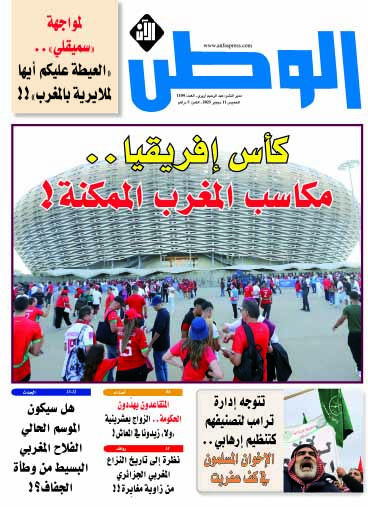في مرحلةٍ تتكاثر فيها مؤسسات الوساطة وتتنوع أشكالها بين أحزابٍ سياسية ونقاباتٍ مهنية وشبيباتٍ تنظيمية وجمعياتٍ مدنية ومؤسساتٍ دستورية، يبدو المشهد للوهلة الأولى وكأنه شبكة متينة قادرة على تمثيل المواطن وإيصال صوته إلى مراكز القرار غير أنّ الواقع يكشف صورةً مغايرة تماما فهذا التعدد الكمي لم يتحول إلى قوةٍ نوعية، ولم يثمر ثقةً متبادلة بين المجتمع ومؤسساته، بل تزامن مع تفاقم الأزمات وتآكل الثقة وفقدان الإحساس بجدوى الوساطة نفسها لقد تحوّلت هذه القنوات، التي كان يُفترض أن تكون جسرًا للتواصل، إلى فضاءاتٍ مثقلة بالبيروقراطية والمصالح الضيقة، فعجزت عن ترجمة نبض الشارع إلى رؤيةٍ مؤسساتية، وعن تحويل المطالب الاجتماعية إلى قراراتٍ ملموسة، تاركة المواطن يتأرجح بين صمت الدولة وضجيج الشارع.
الأحزاب التي كانت تُقدَّم يومًا باعتبارها مدرسة للمواطنة والتنشئة السياسية، انزلقت تدريجيًا نحو دورٍ انتخابي ضيق، تتحرك وفق إيقاع الحملات الموسمية أكثر مما تُعبّر عن نبض المجتمع غابت عنها وظيفة التأطير والتكوين، وحلّت محلها لغة الحسابات والمواقع، حتى باتت في نظر فئات واسعة من المواطنين مؤسساتٍ تبحث عن المقاعد أكثر مما تبحث عن المعنى.
أما النقابات، التي راكمت تاريخًا نضاليًا حافلًا، فقد أصابها الوهن التنظيمي والتشتت الداخلي، وفقدت كثيرًا من قدرتها على الدفاع عن الطبقات الشغيلة في ظل تحولات سوق العمل واتساع رقعة الهشاشة المهنية لم تعد قادرة على تأطير الغضب الاجتماعي أو بلورته في مشاريع تفاوضية حقيقية.
في المقابل، وجدت المنظمات الجمعوية نفسها بين مطرقة الطموح وسندان التبعية، إذ أضعف التمويل المشروط واستنساخ الخطاب الحزبي استقلاليتها، فتراجعت روح المبادرة والمساءلة لصالح الولاء التنظيمي وهكذا، بدل أن تكون هذه التنظيمات الجماهيرية رافعة لتجديد النخب وربط السياسة بالمجتمع، تحولت إلى مساحات مكررة تُعيد إنتاج نفس أعطاب الوساطة التقليدية.
وحتى مؤسسة وسيط المملكة، على الرغم من رمزيتها الدستورية ومكانتها كآلية لحماية الحقوق، ما زالت تتحرك في هامشٍ ضيقٍ من الفعل والتأثير فصلاحياتها المحدودة تجعلها تصطدم، في كثير من الأحيان، بجدار البيروقراطية الإدارية وبطء تفاعل المؤسسات مع توصياتها لا جدال في أنها أسهمت في ترسيخ ثقافة الإنصاف الإداري وإعادة الاعتبار لمفهوم العدالة في العلاقة بين المواطن والإدارة، غير أنّ دورها يبقى أقرب إلى التنبيه الأخلاقي منه إلى التدخل الفعلي القادر على معالجة الاختلالات البنيوية التي تُنتج المظالم وتُعيد إنتاجها.
ولذلك، فإنّ حضورها الإيجابي في المشهد المؤسسي لا يعفي من طرح السؤال الجوهري هل نريد وسيطًا يُذكّر، أم وسيطًا يُغيّر؟
هكذا نجد أنفسنا اليوم أمام تعددٍ في مؤسسات الوساطة دون تناغمٍ أو تكاملٍ حقيقي، وأمام فيضٍ من الخطابات والشعارات يقابله فقرٌ في الفعل والنتائج المواطن لم يعد يرى في هذه المؤسسات صدىً لمعاناته ولا ترجمانًا لهمومه اليومية فاختار أن يبحث عن صوته خارجها؛ في الشارع حينًا، أو في الفضاء الرقمي حينًا آخر، حيث تتسع مساحة التعبير وتضيق مساحة الإصغاء.
لكنّ الشارع، مهما علا فيه الهتاف، لا يصنع السياسات، والفضاء الافتراضي، مهما كان صاخبًا، لا يبني البدائل الواقعية وبين هذين المستويين تضيع القضايا الكبرى، ويتحول الغضب الجماعي إلى طقسٍ دوريٍّ من التنفيس بدل أن يكون خطوة نحو التغيير والإصلاح.
إنّ المشكل لا يكمن في غياب مؤسسات الوساطة، بل في فقدانها لمعناها ووظيفتها الأصلية أن تكون جسرًا للتواصل لا جدارًا للعزلة وأداةً للربط لا وسيلةً للفصل فحين تتحول هذه المؤسسات إلى آلياتٍ شكلية لتصريف الأزمات بدل معالجتها يصبح تعددها عبئًا على الديمقراطية بدل أن يكون ضمانةً لها.
الحل لا يمر عبر خلق مؤسسات جديدة، بل عبر إعادة بناء الثقة في الوسائط القائمة، من خلال دمقرطتها وتجديد نخبها وربط المسؤولية بالمحاسبة فالمغرب وهو يواجه تحدياتٍ اقتصادية واجتماعية متشابكة، بحاجة إلى وساطةٍ صادقة وفاعلة تُعيد الوصل بين المواطن والدولة، وتحوّل الاحتجاج إلى اقتراح، والتوتر إلى تفاوض، واليأس إلى أملٍ في التغيير الممكن.