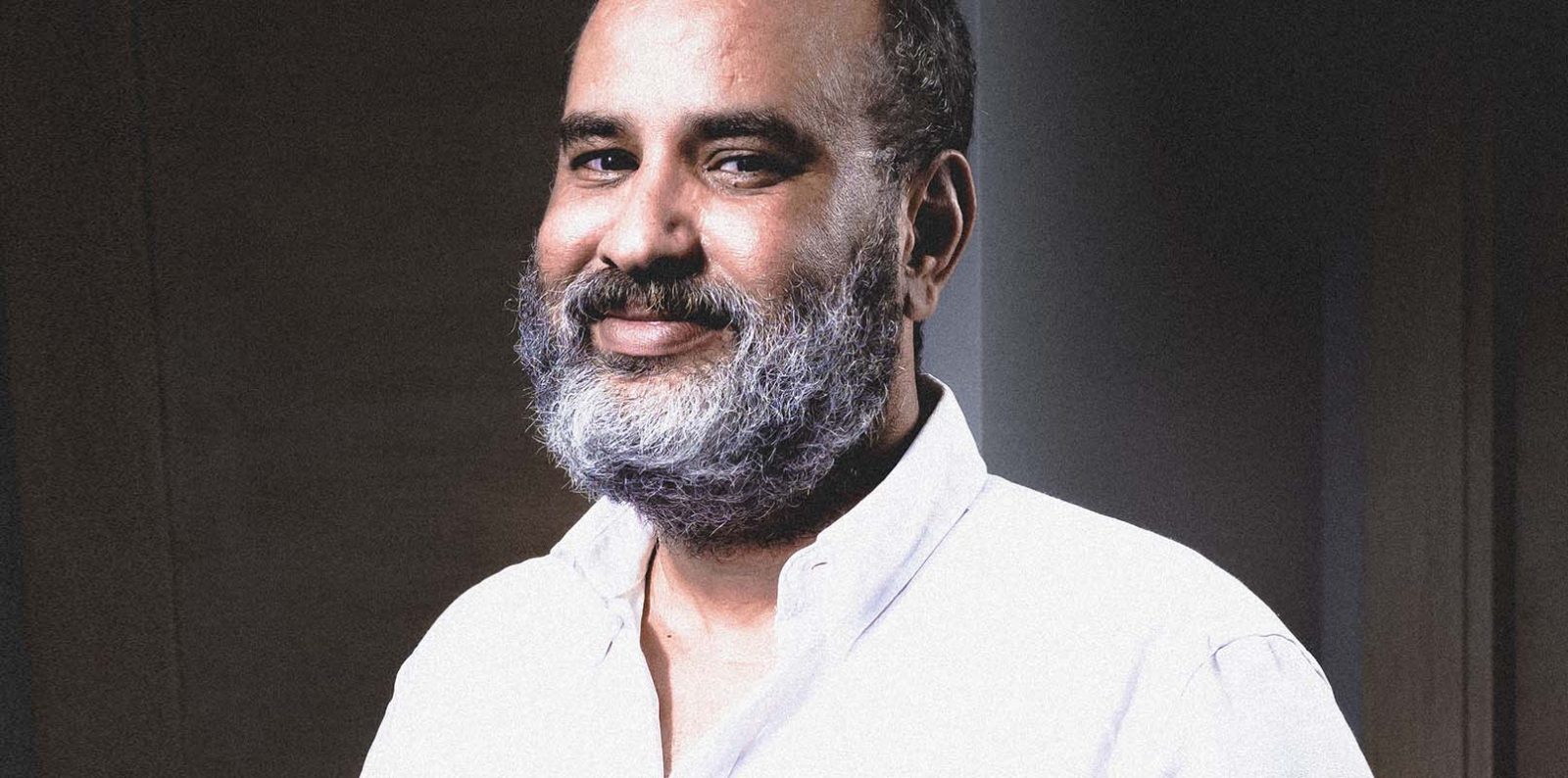لم يعد قطاع الثقافة في المغرب يعيش أزمة عابرة أو عجزًا مرحليًا في الرؤية، بل أصبح يختنق تحت وطأة العبث والسطحية، بعدما انحرفت بوصلته عن مهامها الأساسية في بناء الإنسان، وتنوير العقول، وترسيخ قيم الجمال والمعرفة، نحو مشاريع تسويقية فارغة وشعارات رقمية لا طائل من ورائها.
منذ سنوات، تعيش الساحة الثقافية المغربية على وقع انكماش حاد، تجسد في غياب الاستراتيجية الواضحة، وتراجع الدعم العمومي، وغياب العدالة المجالية في توزيع المشاريع والبنيات التحتية. إلا أن ما يثير القلق اليوم هو أن هذا التدهور لم يعد نتيجة الإهمال أو ضعف الكفاءة فقط، بل أصبح توجهًا ممنهجًا نحو “تلميع الصورة” على حساب “المضمون”.
من الثقافة إلى الترفيه التسويقي
تحولت وزارة الثقافة في عهدها الحالي إلى منصة دعاية رقمية أكثر منها مؤسسة مسؤولة عن السياسات الثقافية. الوزير محمد المهدي بنسعيد، الذي كان من الممكن أن يترك بصمة إصلاحية في قطاع يعاني من الركود، اختار لنفسه أن يكون “وزير الصورة”، منشغلًا بتجريب المفاهيم الطنانة: “الألعاب الإلكترونية”، “الميتافيرس”، “الذكاء الاصطناعي”، وغيرها من المصطلحات التي تبدو براقة في المؤتمرات، لكنها لا تجد أثرًا في الواقع الثقافي الهش للمغرب.
في الوقت الذي تُغلق فيه دور الثقافة بالأحياء الشعبية، وتتحول المكتبات العمومية إلى قاعات خاوية، ويعيش الفنانون على فتات الدعم، يطل الوزير على الجمهور من منصات رقمية يتحدث فيها عن “تكامل السينما مع صناعة الألعاب”، وكأن البلاد تجاوزت مشاكل القراءة والإبداع والتمويل وباتت مؤهلة لدخول عالم ما بعد الحداثة الثقافية.
فقر البنية وغياب العدالة الثقافية
لا يمكن لأي مشروع ثقافي أن ينجح دون قاعدة صلبة من البنية التحتية والتخطيط الإقليمي المتوازن. المغرب اليوم يعرف تفاوتًا مهولًا في توزيع المؤسسات الثقافية: مدن كبيرة بلا مسارح، أقاليم بكاملها بلا مكتبات، مراكز ثقافية تحولت إلى أطلال. في المقابل، تُنفق الملايين على مهرجانات مؤقتة تُقام لالتقاط الصور ونيل التصفيق، ثم تُنسى بعد انتهاء الحدث.
إن الثقافة ليست ترفًا للمدن الكبرى ولا زينة للبروتوكولات الرسمية، بل حق أساسي للمواطن في كل ربوع المملكة. فحين يُغلق فضاء ثقافي في قرية أو حي شعبي، فإن ذلك يعني إغلاق نافذة نحو الأمل، وترك الشباب في مواجهة الفراغ، والتطرف، والانحراف.
الفنانون بين البيروقراطية والإذلال
يعاني الفنانون المغاربة من بيروقراطية الدعم، وتأخر المستحقات، وغياب رؤية حقيقية للنهوض بالصناعات الإبداعية. كثيرون منهم يعيشون أوضاعًا مأساوية في ظل غياب الحماية الاجتماعية والثقافية. لا أحد يناقش اليوم مصير الفرق المسرحية التي اندثرت، أو الكتّاب الذين هجروا الكتابة لغياب الدعم والتقدير، أو المبدعين الذين يبحثون عن اعتراف في الخارج بعدما ضاقت بهم أرضهم.
في ظل هذا الوضع، تتحول وزارة الثقافة إلى راعٍ للمهرجانات وواجهة للبروتوكولات الرسمية أكثر من كونها حاضنة للمبدعين. بينما كان الأجدر بها أن تكون بيتًا للمثقفين، تدعمهم، وتستمع إليهم، وتمنحهم مكانة تليق برسالتهم في بناء الوعي الجمعي.
تسويق الصورة بدل بناء المشروع
الخلل الأكبر في السياسة الثقافية الحالية هو تحوّلها إلى مجرد عملية “تسويق سياسي”. فبدل النقاش حول المضامين التربوية والثقافية، أصبح التركيز على الواجهات البصرية والمشاريع المؤقتة: إطلاق تطبيق هنا، توقيع شراكة هناك، تنظيم مهرجان ضخم، نشر صورة مع فنان… في حين يظل الجوهر الثقافي في حالة موت سريري.
الثقافة ليست حدثًا ظرفيًا بل سيرورة مجتمعية، تتطلب تخطيطًا طويل الأمد، وإشراك المثقفين، والجامعيين، والفاعلين المحليين. لا يمكن إصلاح الثقافة عبر “تغريدة” أو “مؤتمر”، بل من خلال سياسة واضحة تستند إلى العدالة المجالية، وحماية التراث، وتشجيع القراءة، وتطوير الصناعات الإبداعية بشكل متوازن بين الربح والقيمة.
نحو نهضة ثقافية جديدة
إذا أراد المغرب استعادة إشعاعه الثقافي، فعليه أن يعيد تعريف الثقافة باعتبارها أداة للتنمية لا للزينة. المطلوب ليس المزيد من المهرجانات، بل فتح المسارح، وتزويد المدارس بمكتبات، وتحفيز القراءة، وإعادة الاعتبار للكتاب والمفكرين والمسرحيين والرسامين والموسيقيين. فبهم تُقاس حيوية الأمم لا بعدد المؤتمرات ولا بتغريدات المسؤولين.
الثقافة المغربية تستحق أكثر من هذا العبث. تحتاج إلى رؤية وطنية جديدة تُعيد للثقافة مكانتها كقوة ناعمة، قادرة على صناعة الإنسان قبل الحدث، وعلى بناء الوعي قبل الصورة. فالأمم لا تنهض بالضجيج، بل بما يترسخ في وجدانها من فكر وجمال وإبداع.