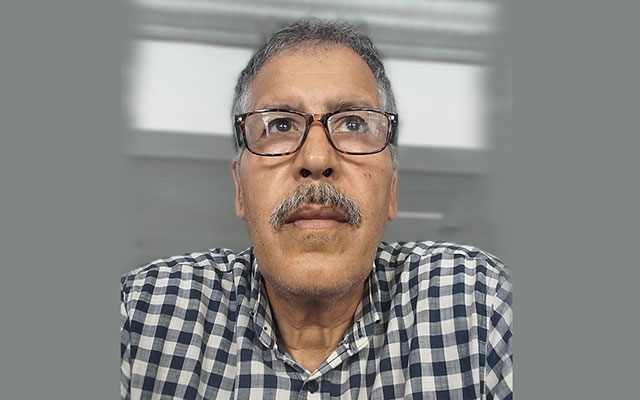ليست هذه الصفحات محاولة لشرح الصمت، فالصمت لا يُشرح — بل يُعاش.
ولا هي بحث في النظر بمعناه البصريّ وحده، بل تأمل في العيون التي تبصر من الداخل، وفي اللغة حين تتخفّف من الحروف لتصير ضوءًا.
لقد صار العالم ضجيجًا من الأصوات والصور، لكنّ ما نفتقده ليس اللغة، بل المسافة بين الكلمات.
في تلك المسافة يولد الفنّ، وتنبض المعرفة، ويعود الإنسان إلى ذاته الأولى —تلك التي كانت تُصغي قبل أن تتكلّم.
من هنا يبدأ هذا النص:
من رغبةٍ في إعادة الإصغاء إلى ما لم يُقل، إلى ذلك الجزء من الوجود الذي لا يمرّ عبر الفم ولا عبر الكاميرا، بل عبر السكوت الذي يرى.
إنّ الصمت في جوهره ليس انقطاعًا عن الكلام، بل عودةٌ إلى أصله؛ هو رحمُ اللغة ومصدر النور في الرؤية.
وحين يلتقي الصمت بالنظر، يحدث في الداخل نوعٌ من التواطؤ بين الإدراك والإشراق،
حيث تتحوّل العين إلى لسانٍ من نور، والجسد إلى أذنٍ من طين.
ولهذا يتنقّل هذا العمل بين الفنّ والتصوّف:
بين لقطةٍ طويلة لتاركوفسكي تتنفّس في الضوء، ونظرةٍ لناسك صامتٍ يرى الله في انعكاس الماء.
فيهما كليهما، يصبح المعنى ممكنًا فقط حين يتوقّف الكلام.
هذه الصفحات ليست بحثًا أكاديميًا، بل سفرٌ في الإحساس، حيث يتجاور أوزو وبرغمان مع ابن عربي والرومي، وحيث تتحدّث الأفلام باللطف نفسه الذي يتحدث به الذكر الصوفيّ.
كلّ فصل هنا يفتح بابًا: الصمت، النظر، الجسد، ثمّ النور الذي يتكلّم.
أربعة طرقٍ مختلفة نحو مقصدٍ واحد: أن نتعلّم الإصغاء إلى ما لا يُقال، وأن نرى ما لا يُرى.
الصمت – لغة ما قبل اللغة
في البدء لم تكن الكلمة، بل كان الصمت الذي يحتضنها.
الصمت ليس ضدّ اللغة، بل سبيلها الأول، هو الهواء الذي تتنفّسه قبل أن تتشكل على الشفاه.
فحين يقول المتصوف «كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة»، فهو لا يعلن عجز اللغة، بل امتلاءها حتى الفيض، حين يصير القول غير كافٍ للحضور، وحين تحتاج الروح إلى وسيلةٍ أخرى للكلام: السكوت.
الصمت في جوهره معرفةٌ غير لفظية، هو تلك اللحظة التي تتوقف فيها الكلمات عن أداء وظيفتها، ويبدأ القلب في الإصغاء لما وراءها.
في الصمت، تنكشف حقيقة الوجود كما هي، بلا وساطة، كما ترى العينُ النور لا صورته.
عند النفّري، الصمت مقامٌ من مقامات العارفين، وفيه يتعلّم السالك كيف يترك الكلمة لتقول نفسها دون تدخّل.
وفي حديثه يقول:
«كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة، وكلما ضاقت العبارة اتسع الصمت.»
فالصمت إذًا ليس توقفًا، بل انتقالٌ من السمع إلى البصر، من الفهم إلى الشهود.
وكما في التصوف، كذلك في السينما —
اللغة الحقيقية لا تُقال، بل تُرى.
المخرج الياباني ياسوجيرو أوزو، في فيلم" قصة طوكيو ". يترك الكاميرا واقفة بعد رحيل الشخصيات، كأنّها تصغي إلى ما تبقّى من حضورهم في المكان.
في تلك الثواني الفارغة، يتكلّم الصمت ببلاغةٍ لا يملكها أي حوار. ذلك ما يجعل المشهد صلاةً بصرية: لا حدث فيه، لكنّ الوجود كله يمرّ أمام العينين.
أما أندريه تاركوفسكي، في الحنين (Nostalghia)،
فقد جعل من الصمت مادّة للفكر نفسه. لا أحد يتكلّم إلا ببطء، لكنّ الأصوات المائية، هدير الزمن، وحركة الكاميرا البطيئة — كلها تقول ما يتجاوز اللغة.
إنه صمتٌ من الداخل، صمت الذكرى، وصمت الوعي حين يلمس اللامحدود.
يبدو الفيلم كله كصلاة طويلة لا يُذكر فيها اسم، لكن هناك حضور في الضوء، في الضباب، في تنفّس الممثلين.
وفي الأدب، نجد هذا الصمت يتسرّب إلى الكلمات نفسها. عند كافكا، في رسائله ومواقفه، يتحدث النصّ بصوتٍ مختنقٍ متردّد، كأن كل جملةٍ تبحث عن مخرج من المعنى.
وفي «الطاعون» لألبير كامو، الصمت هو البطل الخفيّ: يُخيم على المدينة، ويحوّل الخوف إلى تأمل.
هناك لحظات لا يتكلّم فيها أحد، لكنّنا نسمع كل شيء — صوت الإنسان في هشاشته، وصوت الله تعالى في غيابه.
الصمت إذًا ليـس انقطاعًا عن التواصل، بل أرقى أشكاله. فهو يُحرّر المعنى من أسر اللغة، كما يحرّر الضوء الصورة من الظلّ.
الصمت هو ما يجعل الجملة شعرًا، والمشهد وصلا، والنظرة معرفة.
وهكذا، يصبح الصمت لغة ما قبل اللغة، وحين نصمت — نصغي، لا نغيب.
الثرثرة لا تقتل الصمت فحسب، بل تمنع النظر من أن يرى حقًّا. فالكلام حين يزداد، يملأ المسافة التي تحتاجها العين لتفكّر.
في السينما، الثرثرة تُفسد الصورة، لأنّ الصورة وُجدت لتتكلّم بلغتها الخاصة: لغة الضوء والإيقاع والظلّ.
تاركوفسكي كان يقول: «الكلمة الزائدة تحجب النور». ولهذا كان يترك الكاميرا تُطيل النظر، حتى يتحوّل الزمن نفسه إلى أداةٍ للرؤية.
إنّ الثرثرة تمنعنا من دخول العمق، لأنها تزيّن السطح وتترك الجوهر مغلقًا. بينما الصمت يفتح العيون من الداخل، يُعيدنا إلى ما قبل اللغة، إلى النقطة التي يتلاقى فيها النور بالوعي.
ففي الفنّ كما في التصوف، الكثرة لا تزيد المعنى بل تشتّته، والبلاغة لا تُغني عن الصمت الذي منه تُولَد الرؤية. حين يطول الكلام، يعمى البصر. وحين يصمت العالم، يتكلّم النور.
النظر – العين ككلمةٍ من نور
النظر هو شكل آخر من أشكال الإصغاء. العين ليست مجرّد نافذة على العالم، بل وسيطٌ بين الغيب والشهادة، بين ما يُرى وما يُستشعَر. فحين يصمت الفم، تبدأ العين بالكلام —
تقول ما لا يُنطق، وتشهد ما لا يُفسَّر.
في التجربة الصوفية، النظر فعل عبادة. يقول ابن عربي في الفتوحات:
«ما رأيت شيئًا إلا رأيت الله قبله وبعده ومعه.»
فالرؤية عنده ليست وظيفةً جسدية، بل مقام شهودٍ يفيض عن حدود العين.
العين هنا تتذكّر أكثر مما ترى، ترى بالله تعالى لا بالنفس، ولهذا لا تلتقط الأشكال، بل الأنوار التي خلفها.
النظر الصوفي ليس نظرة مراقبة، بل نظرة مشاركة. إنه فعل حبّ: أن ترى الوجود كما يُحبّ أن يُرى.
وهكذا يصبح النظر دعاء كلّما ازداد صفاء البصيرة، ازداد اتّساع الرؤية.
في السينما: العين التي تتكلّم
منذ بداياتها، كانت السينما تجربة نظرٍ قبل أن تكون تجربة حكي. فالعدسة — كالعين الصوفية — تلتقط ما يعجز الكلام عن قوله.
في أفلام كارل تيودور دراير، وخاصة في «آلام جان دارك»، تغدو العين مسرح الروح.
الكاميرا تقترب من وجه البطلة حتى يختفي العالم كله، ولا يبقى سوى دمعةٌ تتدلّى كاعتراف.
لا حوار هنا، بل تضرع صامت في شكل نظرة.
أما روبر بريسون، في «Journal d’un curé de campagne»، فيجعل الكاميرا تلتقط ما بين الوجوه لا ما عليها. تبدو الشخصيات وكأنها تهمس في صمتها الداخلي، والعين تُفصح دون أن تنطق: التعب، التسليم، والرجاء الذي لا يقال.
وفي «Les Ailes du Désir» لفيم فندرز، الملائكة لا تتكلم، بل تنظر. وجودها نظرة طويلة على البشر، نظرة لا حكم فيها ولا فضول، بل إحاطة رحبة — عين تعرف دون أن تجرح، وتحبّ دون أن تمتلك.
هنا يتجسّد المعنى الصوفيّ للنظر: أن ترى المخلوق بعين الرحمة لا بعين الفرز.
بين النظر والكلمة
النظر الحقيقي لا يكتفي برؤية الأشياء، بل يفتح لها مجال الوجود. فحين تنظر العين بصفاء، تصير كلّ الأشياء جديرةً بأن تُرى. وهذا هو المعنى الصوفيّ للخلق:
في الفنّ، كما في التصوف، العين ليست شاهدة فحسب، بل خالقة. كلّ نظرةٍ تحمل إمكانية البعث، وكلّ مشهدٍ جميلٍ هو أثر من آثار النظر الإلهيّ الأول.
اللغة تحاول القبض على المعنى، لكنّ العين تطلقه في الفضاء. فبين الصمت والنظر تكتمل الدائرة: الأول يصون السرّ، والثاني يكشفه دون أن يفضحه.
حين يصمت الفم، تتكلم العين
هناك لحظة لا يتكلم فيها الفم، لكنّ المعنى لا يتوقف — ينتقل ببساطة من الشفاه إلى العين.
النظر، في تلك اللحظة، يصير امتدادًا للصمت، لغة أخرى من الضوء، تتكلّم بالمسافة، بالوميض، بالانكسار.
الصمت لا ينفصل عن العين، فكلاهما ينتمي إلى مملكة الإصغاء.
الصمت يصغي إلى الداخل، والنظر يصغي إلى الخارج، لكنّهما يلتقيان في القلب —في تلك البقعة التي يسمّيها المتصوفة مقام الحضور.
يقول الرومي:
«حين يغدو النظر صافيًا، يصبح كلّ شيء رسالة.» وفي ذلك الصفاء، تصمت الحواس، لا لأنّها فقدت أدواتها، بل لأنها بلغت نضجها.
في السينما: اللغة التي تتحدث بالعيون
حين يصمت الفم في السينما، تبدأ الكاميرا في الإصغاء.
هناك مشاهد لا تُنسى لأنها لا تقول شيئًا.
في In the Mood for Love لوونغ كار واي، تتبادل الشخصيتان نظراتٍ تملأ الشاشة أكثر من أي حوار. العينان تتكلّمان بخوفٍ، برغبةٍ، بندمٍ، كأنهما تكتبان روايةً لا تُروى. كلّ نظرة تأجيلٌ لبوحٍ لا يحتمل العالم سماعه. هنا يصبح الصمت فعلًا من أفعال الشجاعة، ويصير النظر اللغة الوحيدة المسموح بها للحبّ الممنوع.
في Nostalghia لتاركوفسكي، لا حاجة للكلمات أمام النار والماء والوجه البشريّ. في اللقطات الطويلة، حيث يقف الممثل وحيدًا في الضباب، تتحول العين إلى منارةٍ في الفراغ. كلّ رمشةٍ نداء، وكلّ سكونٍ تسليم.
إنها صلاة البصر — أن ترى كي تُشفى.
أما إنغمار برغمان، في Persona، فقد جعل من النظرة سلاحًا وجوديًّا. امرأتان في صمتٍ طويل، تتواجهان بعيونٍ تفضح أكثر مما تصون. النظر هنا ليس تواصلًا بل مواجهة، كأن كلّ واحدة ترى في الأخرى صورتها الصامتة. فالكاميرا، كما العين الصوفية، تكشف وتجرح في آنٍ واحد.
في التجربة الصوفية: العين تتكلم بلغةٍ من نارٍ وماء
في المقامات العليا، العين تصبح لسان القلب. نظرة الشيخ إلى مريده ليست مجرّد لقاء، بل إيصالٌ للمعرفة بلا لفظٍ ولا شرح.
يُقال في الأدب الصوفي:
«من نظر إلى وليٍّ صادقٍ، نال نصيبًا من نوره.»
لأنّ النظر هنا فعلُ انتقال، كأن الضوء نفسه يحمل معنى لا يمكن ترجمته إلى حروف.
وفي هذا المعنى، تشترك السينما والتصوف في سرٍّ واحد: كلاهما يعلّمنا أنّ الرؤية قد تكون أبلغ من النطق.
أنّ العين تعرف ما لا تعرفه الأذن، وأنّ الصمت ليس انقطاعًا، بل عبورٌ من سمعٍ خارجيّ إلى سمعٍ بصريّ.
تواطؤ الضوء والصمت
حين يصمت الفم، تتكلم العين، وحين تتكلم العين، يصمت العالم.
في تلك اللحظة، لا يبقى سوى الضوء —
ضوء يمرّ من النظرة إلى النظرة، من الشاشة إلى القلب، من الله إلى الإنسان.
كلّ نظرة صادقة هي نوعٌ من الشهادة: تشهد على ما لا يُقال، وتترك للمتلقي حرّية الإصغاء إلى ما لا يُسمع.
وهكذا، يتجلّى الصمت في النظر، والنظر في الصمت، كجناحين يطيران في جهة واحدة: جهة الحضور.
الجسد بين الصمت والنظر
هنا تصبح الحواس كلها طريقًا إلى الروح، وفيه يتبدى الصمت في الحركة، ويتحوّل النظر إلى لمسٍ من الضوء. الجسد ليس ضدّ الروح كما ظنّ المتزهدون، ولا هو قيدها كما يعتقد العقلانيّون.
إنه أداةُ معرفةٍ صامتة، لغةٌ ناطقة بلا حروف، تقول ما لا يُقال، وتشهد بما لا يُرى.
الصمت يسكن الجسد قبل أن يسكن اللسان، حين تهدأ الأنفاس، وحين تتحول الحركة إلى حضور.
ذلك هو الرجاء الجسديّ: أن يتمنّى الجسد ما لا يمكن التعبير عنه، أن يدعو وهو واقف، نائم، أو حتى ساكتٌ في الظلّ.
في التجربة الصوفية، الجسد هو مرآةُ السرّ. في دوران الدراويش، لا يُراد الرقص لذاته، بل لتفريغ الثقل من الجسد كي يصير خفيفًا بما يكفي ليستقبل النور.
كلّ التفافةٍ حول نفسه هي إعلانُ ولادةٍ جديدة: حركةٌ بلا هدفٍ إلا العودة إلى المركز.
وهنا، لا يفرّق الجسد بين النظر والصمت: العين ترى من الداخل، والجسد يصغي من الخارج، كأنّ كلّ خليةٍ فيه تتحوّل إلى أذنٍ أو إلى عينٍ .
في السينما: الجسد كأداةِ صمتٍ وبصيرة
في الفنّ السينمائي، الجسد الصامت هو أحد أعظم وسائل التعبير.
في فيلمLe Piano لجين كامبيون، تعيش البطلة في صمتٍ مطلق، لكنها تعبّر عن عالمٍ داخليٍّ كامل من خلال يديها على مفاتيح البيانو. كلّ حركةٍ منها انتقال بين العشق والإيمان، بين الجرح والرجاء. إنها لا تتكلم، بل تُسمِع العالمَ بما تشعر به.
أما عند تاركوفسكي في Stalker، فالجسد ليس سوى ظلّ يمشي بين الماء والسماء، يتردّد بين الإرادة والاستسلام. الوجوه المبتلّة، الخطى البطيئة، كلّها تفعل ما يفعله الذكر الصوفيّ: تتكرّر حتى تفقد معناها الحرفي، وتدخل في حالةٍ من الوعي الحركيّ، حيث الجسد لا يؤدي دورًا، بل يعيش الحقيقة.
وفي Persona لبرغمان، تتقابل امرأتان في صمتٍ كثيفٍ يشبه الاعتراف، وجسدهما هما اللذان يتكلمان: تعبُر النظرات، تتبدّل الملامح، ويختلط الصمت بالأنفاس، كأنّ الروح تتحدّث من خلال الوجه.
كلّ رعشةٍ، كلّ رمشةٍ، هي جملةٌ غير منطوقة، شهادةٌ على أن الجسد يعرف ما لا تستطيع اللغة حمله.
الجسد في التجربة الصوفية
في الرقصة التي لا تنتهي، كما في صلاة السكون، يتحوّل الجسد إلى وسيلةِ معرفةٍ بالوجود.
المتصوف لا يهرب من جسده، بل يسمعه — فهو كتابٌ من لحمٍ ودم، كتبه الله بلغةٍ لا تُقرأ إلا بالحضور.
حين يهدأ الجسد، يبدأ الصمت في الارتفاع.
وحين يفتح عينيه، يبدأ النور في الانهمار.
في تلك اللحظة، يصبح الجسد نفسه قصيدةً من نظرٍ وصمتٍ متلاحمين، قصيدةً تُقال بلا حروف، وتُسمع بلا صوت.
تواطؤ النور والمادة
في السينما كما في التصوف، الجسد هو مكان التجلي.
الضوء يسقط عليه ليكشف ما لا تستطيع الكلمة.
الصمت لا ينفصل عنه، بل يسكن عضلاته، في حركةٍ أو سكونٍ أو ارتعاشٍ خفيف.
وهكذا، يتحوّل الجسد إلى وسيطٍ بين العالمين:
بين المعنى والصورة،
بين اللامرئيّ والمرئيّ.
وهكذا يكتمل المثلث: الصمت، النظر، والجسد.
فحين يلتقي الثلاثة في لحظةٍ واحدة، يتحوّل الإنسان إلى مرآةٍ كونية، إلى حضورٍ خالصٍ يعبّر عن الله من غير أن يقول شيئًا.
النور الذي يتكلّم
في النهاية، لا يعود الصمت مجرّد غيابٍ للكلام، بل لغة النور حين تتكلّم بلا صوت. وحين تصغي العين، وحين يهدأ الجسد، وحين يتلاشى الفرق بين الداخل والخارج —يحدث ما يشبه الوحي الهادئ: أن يُفصح الوجود عن ذاته بنغمةٍ من سكون.
لقد بدأنا بالصمت كلغةٍ ما قبل اللغة، ثمّ رأينا كيف يُصبح النظر ترجمانَه المرئي، وكيف يتحوّل الجسد إلى طريقٍ ثالثٍ بين القول والرؤية، حتى اكتشفنا أنّ كلّ هذه المقامات ليست سوى وجوهٍ مختلفةٍ لشيءٍ واحد: الإنصات إلى اللامرئيّ.
في السينما كما في التصوف، النور هو الصوت الأخير، الصوت الذي لا يُسمع بل يُرى.
حين تسقط الأشعة على وجهٍ صامت، أو ينعكس الضوء على دمعة، يتحوّل المشهد إلى معنى —
والعين إلى قلب.
وحين يُدرك الإنسان أن النور لا يحتاج إلى كلماتٍ ليُفهم، ولا الصمت إلى تبريرٍ ليُسمَع، يعرف أنّه بلغ عتبة الحضور، العتبة التي لا تحتاج لشيءٍ سوى أن تكون. فالصمت لا يختتم القول، بل يفتحه من جديد.
والعين لا ترى نهاية النور، بل بدايته في كلّ ومضةٍ جديدة.
أما الجسد، فيظلّ واقفًا هناك، مثل شاهدٍ طيبٍ على السرّ...