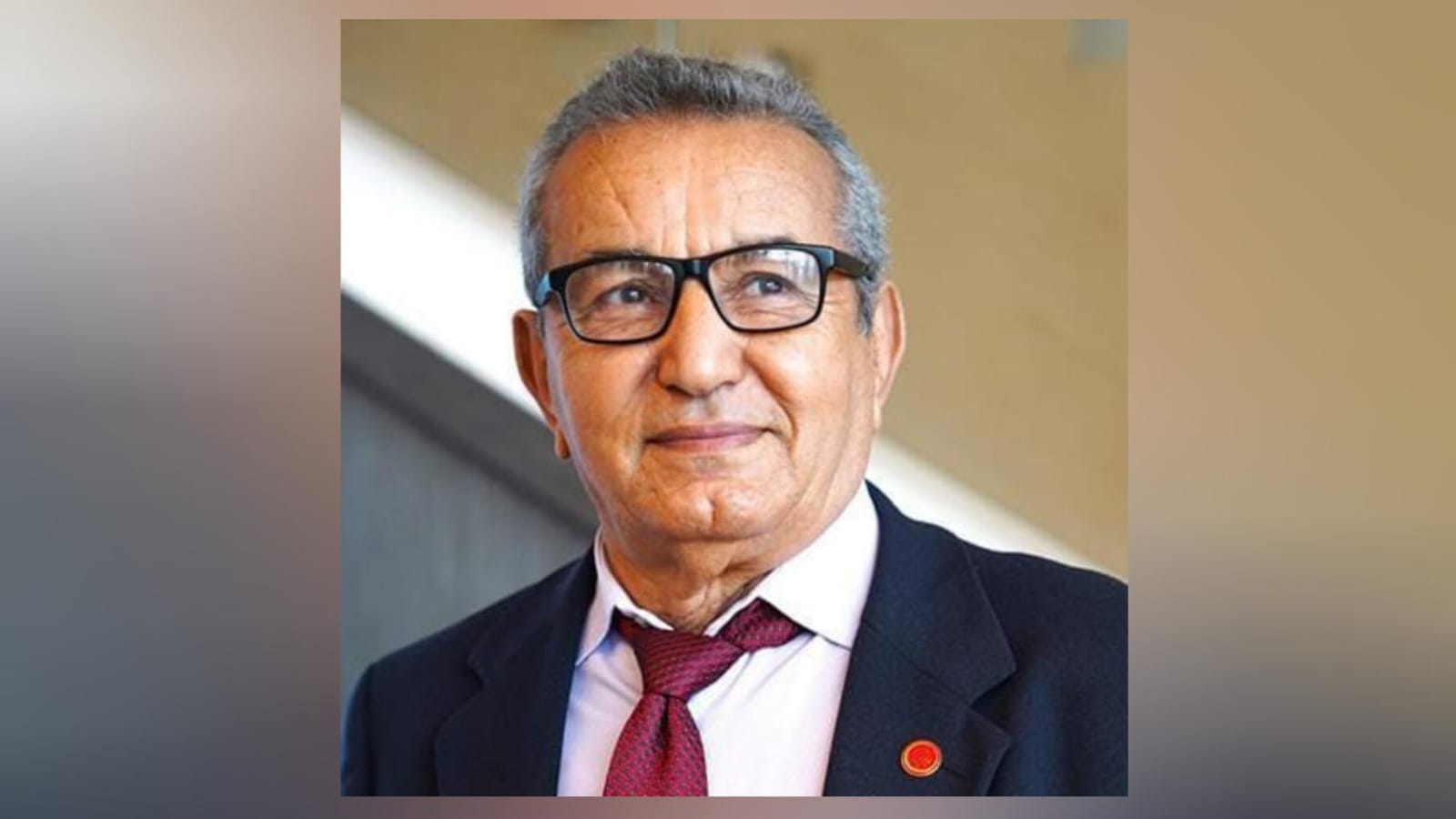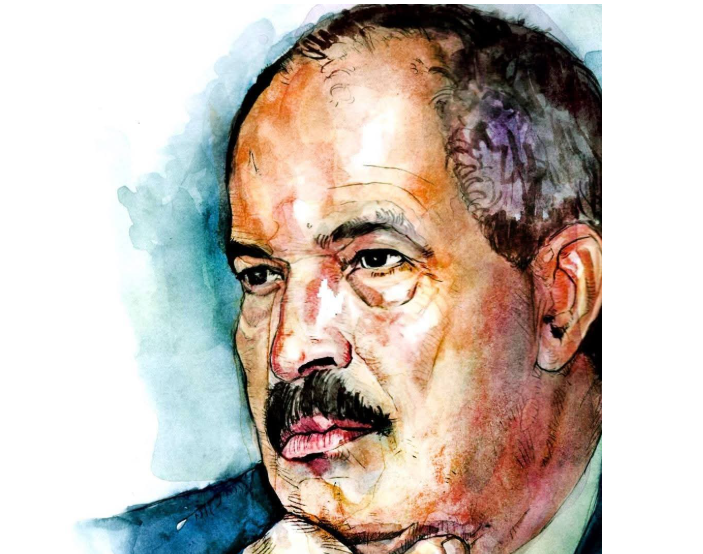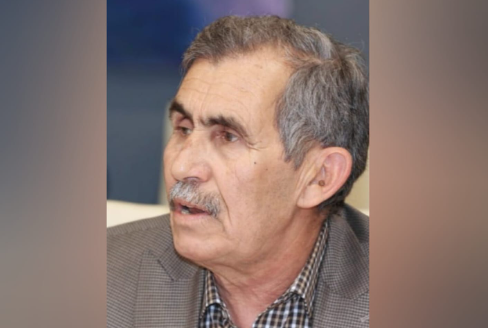في خضمّ التحوّلات التي أعادت تشكيل علاقة المرأة بالرجل، بدا أن الأدوار بدأت تتداخل، وأن التوازن الذي كان يمنح العلاقة معناها بدأ يختلّ شيئا فشيئا.
فالمساواة التي رُفعت يوما شعارا للعدل بينهما، لم تعد مجرد فكرة تُردَّد في الخطابات، بل أصبحت واقعا حاضرا في التربية والعمل والقوانين. غير أن هذا الواقع ابتعد عن معناه الإنساني، فتحوّلت المساواة إلى تطابقٍ في الأعباء والمسؤوليات، وتماثلٍ في المكاسب المادية، بدل أن تكون تمايزا يُغني العلاقة. وهكذا تحوّل الوعد بالعدل إلى سباق مُرهق، تُقاس فيه قيمة المرأة بقدرتها على منافسة الرجل، لا بما يضيفه اختلافها من معنى وانسجام.
وينعكس أثر هذا الاختلال منذ الصغر في طريقة تربية الفتيات، إذ كثير منهن يُنشأن على رسائل تجعل قوتهن في الاستغناء. تُربّى البنت على أن مكانتها تكمن في عدم حاجتها إلى رعاية من أحد، وأن خلاصها مرهون بقدرتها على أن تصبح مستقلة ماديا. المشكلة ليست في سعيها للعمل، سواء كان طموحا أو ضرورة، بل في أن تُقنعها هذه الرسائل بأن القيمة المالية هي الوحيدة المعترف بها، والوسيلة الوحيدة لتحقيق ذاتها.
وهنا يطفو سؤالٌ مربك: أأصبح تكريم المرأة يُعدّ انتقاصا، ورعايتها تُحسب ضعفا؟
ولا يقتصر أثر هذه التربية على الفتاة وحدها، بل يمتدّ ليشكل وعي الفتى أيضا. يكبر وهو يشهد الأم تتحمّل أعباءً مزدوجة، ويرى الأخت تُعَدّ للغرض ذاته، فتختلط عليه ملامح الأدوار، وتتسرب إلى وعيه قناعة تجعل المسؤولية عبئا موزَّعا، بدل أن تبقى معنى راسخا لديه. على هذا النحو تُزرع داخله ـ وهو يُعَدّ لرجل المستقبل ـ هشاشةٌ خفيّة تميل به إلى الاتكالية على شريكة الحياة، بدل أن يراها رفيقة تُكمل المعنى وتثري المسار.
كما أن التحولات الاجتماعية قد أسهمت في ترسيخ هذا الواقع، فبعدما دخلت المرأة سوق العمل بقوة، وتحملت مسؤوليات مضاعفة بين البيت والخارج، دعمتها تشريعات واستراتيجيات ركّزت على الحقوق المادية وعلى تعزيز التمكين الاقتصادي، من دون أن يواكبها وعيٌ ثقافي وتربوي يحفظ التوازن بين الأدوار. وفي المقابل، غذّى الإعلام صورة المرأة المستقلة، أو ما يُسوَّق عالميًا بمصطلح independent woman، مُكرسا إيّاها كنموذج أقوى.
خلف بريق هذه التحولات، تبدّلت المعاني، وانزلقت الشراكة بين الجنسين إلى المجاراة والندية، بدل أن تُرى كأدوار يتكامل بعضها مع بعض. والحقيقة أن العلاقة لا تستقيم إلا بالاعتراف بالفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة، فلكل طرف دور ينسجم مع فطرته ويمنحه المعنى في مكانه الصحيح.
الخلل إذن ليس في مشاركة المرأة ولا في سعيها للإسهام، بل في الخطاب الذي يصوّر قوتها في التمركز حول الذات، ويدفعها إلى الفردانية وإنكار حاجتها الفطرية للاحتواء. وفي المقابل يرسّخ في وعي الرجل أن دوره لم يعد التزاما أصيلا، بل عبئا قابلا للتخفيف، وربما للهروب أحيانا.
ولعلّ ما نراه اليوم من تفاقم الطلاق وتوتّر العلاقات الأسرية، ليس إلا نتيجة تغيّر نظرتنا لجوهر العلاقة، وتأثُّرنا بنماذج غربية لا تشبه واقعنا. وربما لم نبلغ بعد ما تعرفه بعض المجتمعات من تفكك أسري وضياع في القيم، غير أنّ استمرار الخلل في ميزان العلاقة بين الرجل والمرأة قد يدفعنا تدريجيا بعيدا عمّا كان يمنح بيوتنا تماسكها ودفئها.
فالمجتمعات لا تستقيم بالقوانين وحدها، بل بالوعي الذي يصون اختلاف مهام أفرادها دون أن يجعلها درجات تفاضل. أن تُربّى الفتاة على أن عطاؤها في الحياة أوسع من حساب الأرقام، وأن يُنشَّأ الفتى على أن مسؤوليته ثابتة، وأن رعايته جزءٌ من رجولته لا خيارا يمكن الاستغناء عنه.
حينها لا تستقيم الأدوار فحسب، بل تستعيد الأسرة معناها وجذورها، ويقوى المجتمع بتماسكه وروابطه، فيمضي أكثر استقرارا وأقل تفككا.