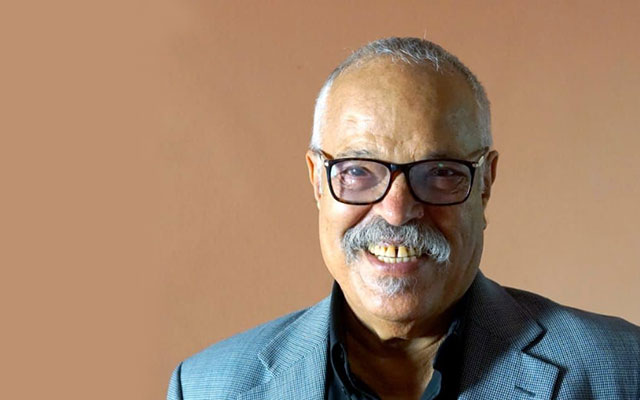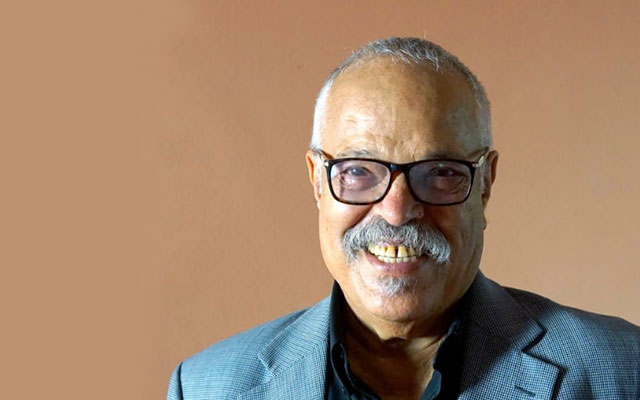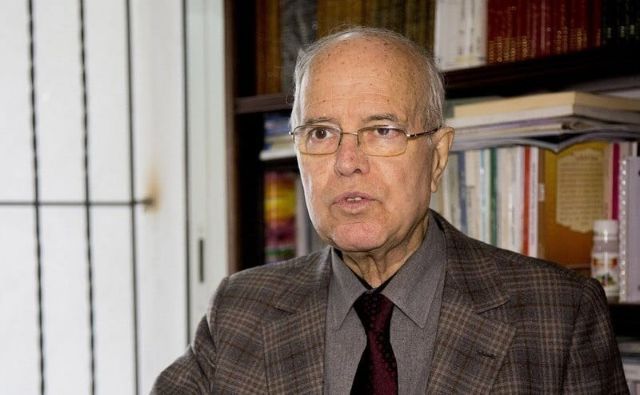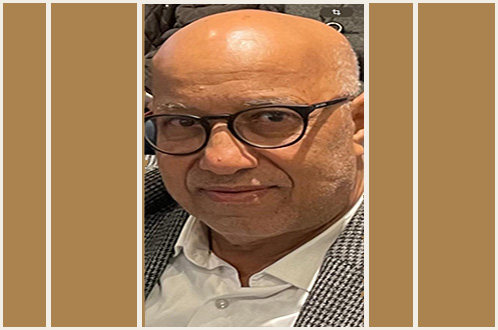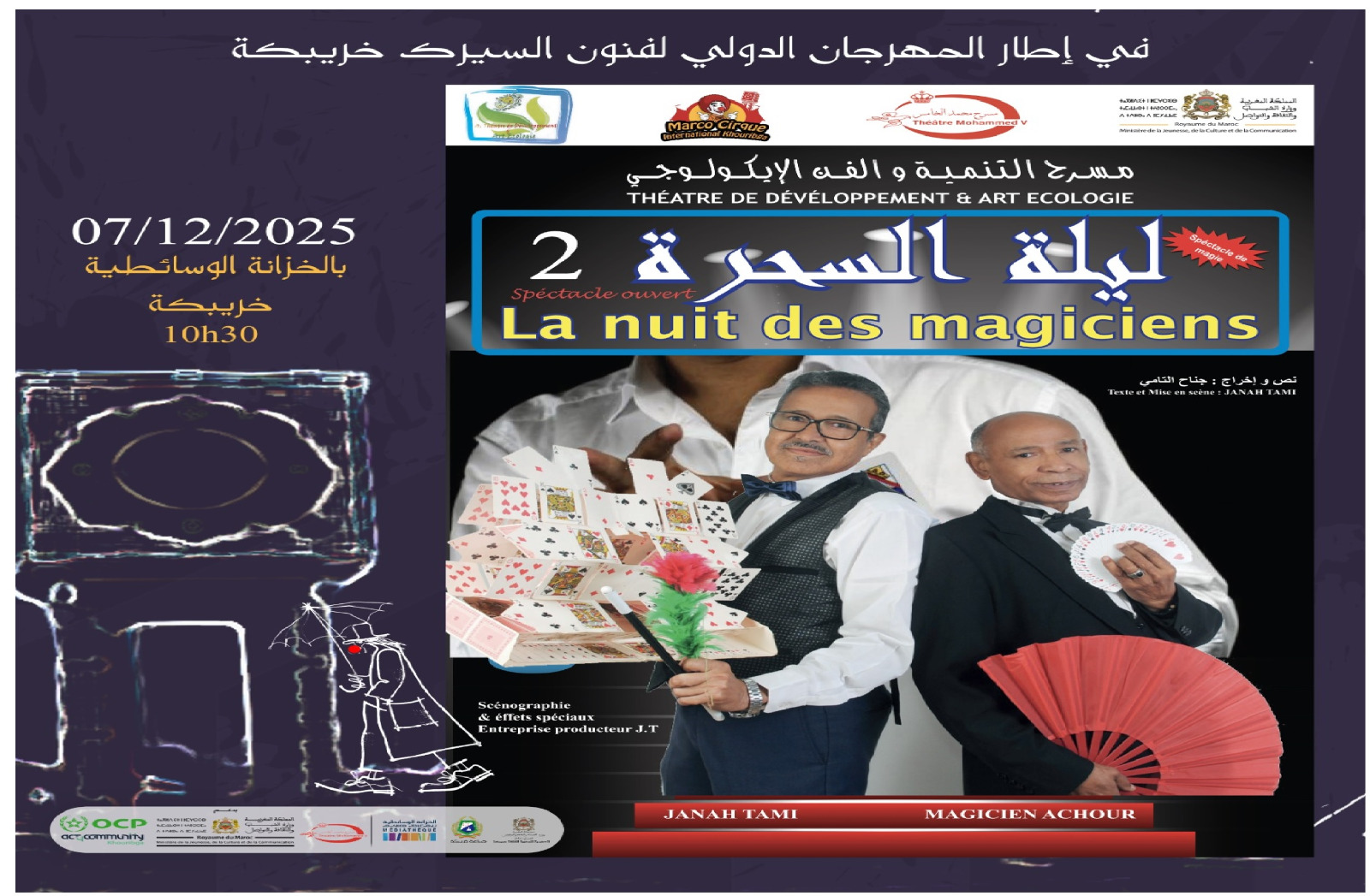بنية تحتية للمعنى الإنساني المشت
لا يرى مارتن هايدغر الجسر مجرد أداة وظيفية تربط بين ضفتين موجودتين مسبقا، بل يعتبر أن الجسر هو ما يظهر الضفتين كضفتين، ليشكل الفضاء الذي يجعلهما تتقابلان وتدخلان في علاقة. عندما نقول إذن إن الترجمة جسر بين لغتين، فإننا نعني أنها ليست ما يصل بين لغتين موجودتين سلفا، بل هي ما يولد اللغتين بوصفهما فضاءين مختلفين، ويولد علاقة بينهما.
على هذا النحو، فإن الترجمة ليست فعلا ثانويا أو لاحقا، بل هي ما يمنح اللغات حدودها، ويظهرها كذوات مستقلة تدخل في حوار. في هذا المعنى، هي تسبق الفصل بين اللغات. إنها ليست مجرد "قنطرة"، بل الشرط الوجودي الذي يجعل من الممكن الحديث عن ضفتين، عن لغة وأخرى، عن ذات وآخر.
تمازج هجين
ليست الترجمة، في معناها العميق، انتقالا من ضفة إلى أخرى، بل هي إقامة على الجسر. إنها البين-بين، حيث لا تكون هي اللغة "ا" ولا اللغة "ب"، بل تكون تمازجا هجينا، أو قل لحظة يتعرى فيها المعنى من ثباته وينكشف في تعدديته، وقلقه، وانفتاحه. ذلك أنها لا تقرب فحسب، بل تزعزع أيضا، لا تنقل المعنى، بل تعيد تكوينه، لا تلغي المسافة، بل تسكنها.
هذا البين-بين هو ما أطلق عليه هومي بابا "الفضاء الثالث" (Third Space) ، حيث يعاد صوغ الهويات والخطابات بعيدا من الثنائية الصلبة للذات والآخر. في مقاله "مهمة المترجم"، يتحدث فالتر بنيامين عن "اللغة الخالصة" التي لا تنتمي الى أي لغة قومية، بل تنكشف عبر الترجمة بوصفها كشفا للنية.
ليست الترجمة مجرد وسيلة، بل هي اللغة حين تكشف عن طاقتها الأعمق، حين تغادر حدودها المألوفة لتدخل في علاقة، في انفتاح، في حوار لا ينتهي. الترجمة في هذا المعنى تصبح فعلا أنطولوجيا، لا وظيفيا فقط. إنها ليست حركة من لغة إلى أخرى، بل من ذات إلى ذات، من أفق ثقافي إلى آخر. إنها اللحظة التي تفقد فيها اللغة وهم الاكتفاء بذاتها، وتدرك أنها لا توجد إلا مع الآخر، ومن خلاله. الترجمة في هذا المعنى حركة تفكير مستمرة، حيث لا يوجد معنى مستقر، بل معان تتشكل، تتغير، ويعاد صوغها مع كل تجربة لغوية. كأن الإنسان، عبر اللغة، لا يعبر فقط، بل يعيد اختراع لغته في كل مرة يتكلم فيها. الترجمة ليست عبورا من معنى إلى معنى، بل هي اهتزاز المعنى نفسه، وانكشافه على تعدد ممكناته.
توضيحا لهذا المفهوم عن الترجمة، ينبغي ربطه بمفهوم الازدواجية أو التعدد الثقافي. هذا الربط بين الترجمة كـ"بين بين" ومفهوم الازدواجية أو التعدد الثقافي يفتح الترجمة على فضاء وجودي وثقافي أوسع، يتجاوز النصوص إلى الذوات، ويجعل من المترجم أو المتعدد الثقافة كائنا ترجمانيا بامتياز.
في التعدد الثقافي، كما في الترجمة، يعيش الإنسان في حالة لاانتماء مزدوج: لا ينتمي بالكامل الى الثقافة "الأصلية"، ولا يندمج بالكامل في الثقافة "المضيفة"، بل يعيش على التخوم، في الهامش الخلاق، حيث تنبت الأسئلة، لا الأجوبة. تماما كما تفعل الترجمة: لا تعيد إنتاج النص، ولا تبتكره من عدم، بل "تتفاوض" عليه، وتكتبه من موقع المتردد.
مزدوج اللغة، ليس مجرد شخص يتحدث لغتين، بل هو كائن يعيش بينهما، في حالة ترجمة دائمة، ليس فقط بين الكلمات، بل بين رؤى العالم التي تحملها كل لغة. إنه لا يضع حدودا صلبة بين اللغات، بل يجعلها تتجاور، تتلاقح، تتحاور و"تتثاقف". هذه الترجمة المستمرة ليست مجرد نقل للمعنى، بل هي إعادة خلق، لأن كل لغة تحمل بنية فكرية مختلفة، وعندما تحاول الترجمة الجمع بين لغتين، فهي في الحقيقة تعيد تشكيل التجربة الإنسانية عبرهما.
لغة ثالثة
لا يكتفي مزدوج اللغة بفهم لغتين، بل ينتج لغة ثالثة، هي فضاء مشترك بينهما، حيث تتسلل لغة إلى أخرى، فتغير في نبرتها، في مجازاتها، وحتى في موسيقاها. كتب إيميه سيزير: "أقول إنه كما توجد عمليات قرصنة إذاعية، هناك أيضا استخدام قرصاني للغة، وهذا بالضبط ما يكون عليه "الأدب الأقلي". نعم، في معنى ما، فإن الأدب الزنجي المكتوب بالفرنسية هو أيضا قرصنة أدبية. وبالطبع، فإن هذا التعريف لا يستنفده تماما. تحديدا، لا ينبغي لنا أن نقنع بملاحظة أن هناك اختطافا للغة وتحريفا لها. بل يجب أن نتحمل عناء دراسة ما أصبحت عليه اللغة بين أيدي أولئك الذين استولوا عليها، وما إذا كانت، في النهاية، هي اللغة نفسها التي نتحدث عنها، أو، على الأقل، النظام اللغوي نفسه. إنها لغة محرفة: بلا شك. لغة منحرفة: بالتأكيد. لكنها أيضا لغة مشحونة ربما، ومحملة بالطاقة".
فنحن لا نفكر إلا بلغات ليست لغاتنا بالكامل، ولا نعبر إلا بكلمات لا تطابق ما نشعر به تماما. وهنا تنشأ فجوة المعنى، تلك المسافة التي نحاول دوما ردمها ولا ننجح إلا نسبيا. لذلك، فإن كل قول هو ترجمة ناقصة، وكل فهم هو تأويل مؤقت. الازدواجية الثقافية ترجمة مستمرة للذات إلى الذات. أن تكون مزدوجا أو متعدد الثقافة هو ألا تنفك عن الترجمة: تعيد قول نفسك بلغة الآخر، وتعيد قول الآخر بلغة ذاتك، وتعيش صراع الترجمة، حيث لا شيء ينقل كما هو، ولا شيء يترك كما كان. الترجمان كائن "بين بين" بامتياز. كما أن الترجمة كفعل لغوي تنزع إلى "اللااستقرار"، فإن الذات المتعددة تنزع إلى "التجذر في الهجنة". وهذا ما يجعلها ليست ضائعة كما يظن، بل غنية، قلقة، مفتوحة، خصبة.
كان صاحب كتاب "بعد بابل" قد عنون فصله الأول بعبارة "أن تفكر هو أن تترجم". هذا التوحيد بين الفكر والترجمة يجعل الإنسان بما هو كائن مفكر، كائنا يعيش وضعية ترجمة لا تتوقف، إن الإنسان لا يفكر من داخل لغة نقية أو هوية خالصة، بل دائما من داخل التوسط، من قلب الترجمة، في البين-بين. ليس فقط بين اللغات، بل حتى داخل اللغة الواحدة. حين تفكر، فأنت تترجم العالم الداخلي إلى لغة. وحين تفهم الآخر، فأنت تترجمه إلى نفسك. وحين تكتب، فأنت تترجم فوضى الفكر إلى نظام علامات. هذا ما يجعل الفكر ذاته ترجمة: ترجمة من الإحساس إلى المفهوم، من التجربة إلى اللغة. من الذات إلى الآخر، من الفوضى إلى شيء من المعنى.
نحن نعيش في وضعية ترجمة لا تنتهي لأننا لا نقبض على المعنى أبدا دفعة واحدة. المعنى يولد دائما في المسافة: بين ما نريد قوله وما نقوله، بين ما نقوله وما يفهم، بين ما نفهمه الآن وما سنفهمه لاحقا.
الترجمة داخل الترجمة
الترجمة إذن ليست نشاطا لغويا جزئيا، بل هي البنية التحتية لكل فكر، بل لكل وجود إنساني. الإنسان كائن ترجمان، لا لأنه يترجم من لغة إلى أخرى، بل لأنه لا يعيش إلا في الترجمة: بين اللغات، بين الثقافات، بين الذوات، بين الداخل والخارج، بين ما يقصد وما يقال.
الإنسان يعيش إذن وضعية ترجمة لا تتوقف، وهو لا ينفك يترجم، وهذا حتى داخل اللغة الواحدة. وربما لذلك هناك قواميس تنقل المفردات إلى مرادفاتها داخل اللغة نفسها. وهذا ما يجعلنا نعيد التفكير في طبيعة اللغة نفسها: فاللغة ليست وسطا شفافا نمر عبره نحو المعنى، بل هي سلسلة لا نهائية من الترجمة داخل الترجمة. كل كلمة هي ظل لكلمة أخرى، وكل معنى هو اقتراح مؤقت لمعنى أوسع أو أعمق أو مختلف. فحتى داخل اللغة الواحدة: نحتاج القواميس لا لفهم لغة غريبة، بل لفهم لغتنا نفسها، وكأننا نترجم العربية إلى العربية، أو الفرنسية إلى الفرنسية. نبحث عن المرادف، لكنه ليس أبدا مطابقا، بل هو تحويل، تأويل، استنساخ متغير. كل كلمة تحيل إلى شبكة من الكلمات الأخرى، وكل فهم يستدعي ترجمة جديدة لما فهمناه من قبل.
اللغة ليست كيانا ثابتا، بل هي نسيج زمني متراكب، وكل متحدث هو في الحقيقة حامل لذاكرة لغوية تتجاوز زمنه الخاص. عندما نكتب أو نتحدث، فإننا لا نستعمل لغة نقية منتمية الى لحظة واحدة، بل نعيد تركيب مستويات لغوية متداخلة، بعضها قادم من نصوص قديمة، وبعضها من كلام يومي، وبعضها من تأثيرات ثقافية معاصرة. في هذا المعنى، حتى داخل اللغة الواحدة، نحن متعددو اللغات زمنيا، أي أننا نتحرك داخل الزمن اللغوي، ننتقي تعبيرات، نستدعي ظلال كلمات قديمة، ونجددها في سياقات جديدة. ليس التعدد انفصاما، إنه جوهر اللغة ذاتها. فليست هناك لغة "واحدة" بالمعنى الميتافيزيقي بل شبكة أصوات وزمنيات وسياقات تتداخل، وتشكل في كل لحظة كيانا متحركا.
مجمل القول إذن إن اللغة نفسها غير مكتفية بذاتها. إنها تحيا فقط عبر الترجمة، تتغذى من "نقصها"، وتنتج المعنى لا كيقين، بل كمحاولة مستمرة للقول. نحن لا نقول الشيء ذاته أبدا مرتين بالشكل نفسه، لا لأننا نعجز عن الدقة، بل لأن المعنى حي، دائم التحول، والترجمة هي اللغة التي نطارده بها.
في هذا المعنى، ربما ليست الازدواجية اللغوية حتى حالة استثنائية، بل هي الحالة الأصلية لكل متحدث. فنحن لا نعيش بلغة واحدة، بل بلغات متحاورة داخل وعينا، سواء كنا ننتقل بين لغات مختلفة أو نعيد تشكيل مستويات اللغة داخل خطابنا. كتب المفكر السنغالي سليمان بشير دياني: "لغة أوروبا هي الترجمة: هذا التصريح لأمبرتو إيكو يتكرر كثيرا. أما تصريح نغوجي واثيونغو فهو بالتأكيد أقل شهرة لكنه أكثر عمقا، وهو يقول: "الترجمة هي لغة اللغات، إنها اللغة التي تتيح لكل اللغات أن تتحدث مع بعضها". وباعتبارها "لغة اللغات"، تفتح الترجمة أفقا تأويليا خصبا يتجاوز الفهم الأداتي لها كعملية نقل من لغة إلى أخرى، لتصبح فضاء للحوار بين الثقافات، و"بنية تحتية" للمعنى الإنساني المشترك.
عن مجلة:" المجلة "