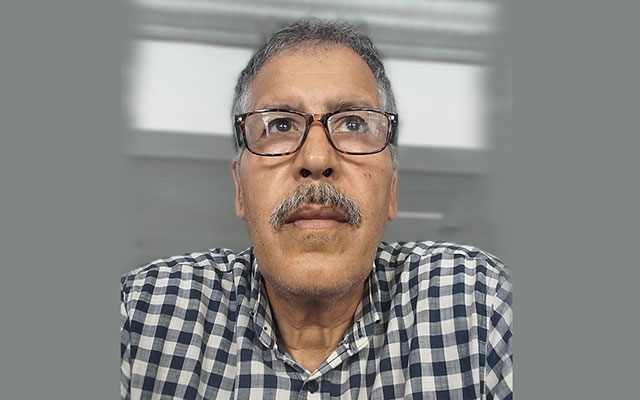تقديم عام:
في ظل التطورات الحديثة التي يعيشها مرفق العدالة على الصعيدين الإقليمي والدولي وأساسا التحولات المرتبطة ببنية صياغة التشريع في علاقته بالمحيط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وبيئة التفاعلات بين السلطات والمؤسسات، وكنتيجة لهذه السيرورة ظهر مفهوم "الأمن القانوني" كأحد المحددات الأساسية لضمان وضوح القاعدة القانونية وقابليتها للتوقع وإنتاج الأثر الملموس والمباشر بغية الحفاظ على استقرار المراكز القانونية للأفراد وزرع ثقة المواطن في التشريع.
في ظل التطورات الحديثة التي يعيشها مرفق العدالة على الصعيدين الإقليمي والدولي وأساسا التحولات المرتبطة ببنية صياغة التشريع في علاقته بالمحيط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وبيئة التفاعلات بين السلطات والمؤسسات، وكنتيجة لهذه السيرورة ظهر مفهوم "الأمن القانوني" كأحد المحددات الأساسية لضمان وضوح القاعدة القانونية وقابليتها للتوقع وإنتاج الأثر الملموس والمباشر بغية الحفاظ على استقرار المراكز القانونية للأفراد وزرع ثقة المواطن في التشريع.
ولمبدأ الأمن القانوني صلة وطيدة ووثيقة بمفاهيم أخرى كالحكامة التشريعية وجودة التشريع، وهي مفاهيم أصبحت ضرورة في ظل العلاقات الدولية المنفتحة وتبادل الاستثمارات بين الدول، إذ أن وجود الأمن القانوني من عدمه هو أول معطى يطرح في العلاقات الاستثمارية بين الدول.
بل إن التشريع بات جزءا من ملف العرض الاستثماري والتنموي الموجه لمختلف الفاعلين، وهو تحول كبير جعل القاعدة القانونية تنتقل من صبغة الغموض إلى الوضوح والتفاعل. وكنتيجة لذلك، بدأت الدول تولي اهتماما بالغا بفلسفة وطريقة صياغة التشريع قبل اعتماده، بهدف خلق عناصر الثقة والتوقع والاستقرار والاستمرار في القاعدة القانونية.
وفي صلب هذه المفاهيم، نجد مجموعة من المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق الأهداف ذاتها، كل وفق اختصاصه. ومن بين هذه المؤسسات التي تؤطر جودة التشريع في علاقته بالمبادئ الدستورية الموجهة، نجد المحكمة الدستورية، التي تمارس رقابتها على دستورية القوانين. وتشمل هذه الرقابة أشكالًا متعددة: الرقابة القبلية، سواء كانت إلزامية أو اختيارية، والرقابة البعدية عبر مسطرة الدفع بعدم الدستورية.
ويعد قانون المسطرة المدنية الركيزة الأساسية للقانون المسطري وأساس القواعد الإجرائية للتقاضي أمام المحاكم. فهو يمثل عصب الولوج المستنير لمرفق العدالة، حيث يوجه المتقاضي لاقتضاء حقوقه، ويعين القاضي على ضمان سلامة الإجراءات وحسن سير العدالة. ومن خلاله، يتحقق مرفق قضائي مبني على استقلالية القضاء، وقواعد المحاكمة العادلة، مع ضمان المرونة، والتبسيط، والسرعة، وبدون تكلفة باهظة. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الأهداف يظل رهينا بوجود تشريع ذي جودة، وحكامة، وفعالية، تشريع مؤسس على احترام الدستور في قواعده وفلسفته وموجهاته.
وهنا جاء القرار المؤسس للمحكمة الدستورية رقم 255/25، الذي يعد سابقة في القضاء الدستوري المغربي، سواء من حيث القواعد المنهجية التي أفرزها وطبقها، أو من حيث الأسئلة التي أثارها واحتدم النقاش حولها، وستُبرز هذه الدراسة أهم المحاور المتعلقة بهذا القرار، مع تسليط الضوء على القواعد المنهجية التي اعتمدها، والآثار القانونية المترتبة عليه.
القواعد المنهجية المؤطرة لشكليات إصدار قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون المسطرة المدنية
بالرجوع لقرار المحكمة الدستورية نجد أن أصل تحريك مسطرة فحص دستورية قانون المسطرة المدنية هو الإحالة الاختيارية التي قام بها رئيس مجلس النواب وفقا للاختصاص الممنوح له تبعا لمقتضيات الفصل 132 من الدستور، ومادام أن قانون المسطرة المدنية ليس قانونا تنظيميا مكملا للدستور فيظل باب الرقابة الدستورية عليه أمرا غير ملزما قبل الأمر بتنفيذ القانون، ورئيس مجلس النواب ونظرا للنقاش القانوني والسياسي الذي كان مطروحا أثناء المناقشة والتصويت على القانون المذكور خصوصا في علاقته باحترام قواعد الدستور، قرر أن يحيل القانون على القضاء الدستوري ليبت في مطابقته للدستور، وهو أمر محمود بل ومرغوب في ظل شح تحريك مسطرة الرقابة القبلية بالمغرب، حيث سبق لرئيس المحكمة الدستورية الحالي أن أشار إلى ذلك في إحدى محاضراته العلمية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
لكن بتفحص صلب قرار المحكمة الدستورية نجد أن رئيس مجلس النواب قد قام بإحالة قانون المسطرة المدنية المصادق عليه من طرف مجلس النواب وهو خلل شكلي نبهت له المحكمة الدستورية حيث اعتبرت أن الصيغة النهائية للقانون هي التي صادق عليها مجلس المستشارين ولو لم تتم إضافة أي جديد من طرف مجلس المستشارين أو كان المضاف هو إصلاح أخطاء مادية أو غيرها من الأمور الطفيفة، وكان تدخل القضاء الدستوري لمعالجة هذا الخلل تدخلا إيجابيا حيث قامت المحكمة وبشكل ذاتي "باستحضار الصيغة النهائية" للقانون رغم أنها لم تفسر مفهوم وطريقة الاستحضار، لكن مادام الإجراء كان هدفه هو تفادي عدم قبول إحالة الرقابة القبلية وهي قاعدة منهجية مؤسسة تروم لتحقيق المرونة والفعالية في تدخل القضاء الدستوري.
جاء في قرار المحكمة الدستورية أن إحالة رئيس مجلس النواب "لم تتطرق إلى مآخذ تتعلق بمقتضيات النص المعروض على نحو محدد"، وهو معطى نجد له تبريرا وتفسيرا في المركز القانوني والرمزي لرئيس مجلس النواب الذي يفترض فيه أن يكون رئيسا لجميع أعضاء مجلس النواب سواء كانوا في صف الأغلبية أو المعارضة، وطابع التحفظ الذي يمليه منصب رئيس مجلس النواب على المعني بالأمر يجعله يميل إلى الحياد والوسطية في جميع القرارات وهو عمق فلسفة منصب الرئاسة ولو أن الرئيس يحتفظ بحقه كنائب ينتمي لتوجه سياسي انتخب باسمه ويمارس على إثر ذلك جميع حقوقه كنائب برلماني ويصرف مواقفه السياسية في كل إجراء يقوم به، وكذا أن المشرع الدستوري منح حق الإحالة الاختيارية لرئيس مجلس النواب وكذلك لأعضاء نفس المجلس عند توفر النصاب، أي أن هناك تمييز بين الاختصاصات.
وهو ما جعل من وجهة نظرنا رئيس مجلس النواب يحيل النص دون ذكر أي مادة يتعين فحصها مما يجعل طلبه هو فحص النص بأكمله مادة بمادة، ونعتقد أن إرفاق رئيس مجلس النواب للنص المحال على المحكمة الدستورية بالمحاضر المبينة لمراحل المناقشة والتعديل والتصويت سواء في الجلسات العامة أو في داخل لجنة العدل والتشريع سواء في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين يغنيه عن ذكر المواد المراد فحصها، نظرا لأن المحكمة الدستورية وفي ديباجة القرار أقرت "باطلاعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف"، رغم أنها لم تبين طبيعة هذه الوثائق ومضمونها، والتي لن تخرج عن محاضر الجلسات بالمجلسين والتي ضمن فيها النقاش حول دستورية بعض المواد في قانون المسطرة المدنية والتي يمكن للمحكمة الدستورية الاستئناس بها لفحص دستورية القانون.
ونجد أن ديباجة قرار المحكمة الدستورية أيضا يشير إلى أن المحكمة الدستورية قد "اطلعت على الملاحظات الكتابية التي أدلى بها البعض من السادة أعضاء مجلسي البرلمان والسيد رئيس الحكومة"، وهو الإجراء المنصوص عليه في المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وهذه الملاحظات الكتابية المتوصل بها لن تخرج عن دفوعات كل من المعارضة والأغلبية ووزارة العدل بخصوص بعض مواد القانون المتنازع حول دستوريتها.
ورغم أن هناك قاعدة قضائية تقول أن القاضي يبت في حدود الطلبات ورئيس مجلس النواب جاء طلبه عاما مبهما معتقدا من خلاله أنه يمارس نفس الإحالة الإلزامية التي يقوم بها بخصوص إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب على المحكمة الدستورية، لكن المحكمة الدستورية ورغم توصلها بالإحالة الكاملة للنص وتوصلها بالوثائق المرفقة بالملف وتوصلها بالملاحظات الكتابية من أعضاء مجلسي البرلمان ورئيس الحكومة فقد أنتجت لنا قاعدة منهجية أخرى تنتصر فيه لنظرية العلم الصريح بالمواد التي يطلب رئيس مجلس النواب البت في مطابقتها للدستور وتتفادى الاعتماد على نظرية العلم اليقيني للقاضي الدستوري بالمقتضيات محل الخلاف حول مطابقتها للدستور.
إذ اعتبرت أن هناك فرق بين الإحالة الإلزامية التي تكون فيها المحكمة الدستورية أمام فحص دستورية النص بكامله والإحالة الاختيارية الواجب من خلالها على الجهة المحيلة تبيان المواد المراد فحصها بدقة وتفادي ما يسميه الفقه الدستوري بالإحالة البيضاء، نظرا لأن هذا النمط من الرقابة الدستورية على القوانين تقتسمها مجموعة من الجهات مع المواطن الذي له أيضا حق الدفع بعدم دستورية القانون المطبق عليه وهو ما سنبينه في المحور الثاني من هذه الدراسة.
القواعد المنهجية المؤطرة لمسطرة الرقابة القبلية للمحكمة الدستورية على قانون المسطرة المدنية
بتفحص قرار المحكمة الدستورية نجد أن طريقة تعاطي القضاء الدستوري مع إحالة رئيس مجلس النواب التي لم تحدد المقتضيات المطلوب مراقبة مطابقتها للدستور، كان تعاطيا منهجيا حديثا، إذ صرحت المحكمة في صلب قرارها على أنها "في إطار مراقبتها لدستورية هذا القانون تراءئ لها أن تثير فقط، المواد والمقتضيات التي بدت لها بشكل جلي وبين أنها غير مطابقة للدستور أو مخالفة له"، رغم أنها لم توضح الطريقة التي من خلالها وصلت لنتيجة الجلاء والبيان وكذا طريقة الفرز والانتقاء للأحكام المخالفة أو غير المطابقة للدستور، ورغم أن في ديباجة القرار هناك إشارة إلى أن المحكمة قامت بالاستماع إلى تقرير العضو المقرر، فهل العضو المقرر هو الذي قام بعملية انتقاء المواد التي في صلب القرار وهو المعلوم أن دوره بعد تعيينه من طرف رئيس المحكمة الدستورية ينحصر في تجهيز الملف وعرضه لتقريره على أنظار المحكمة قبل المداولة، أم أن المحكمة هي التي قامت أثناء المداولة بعملية البحث عن المواد الواضحة أنها غير دستورية.
ويجب الإشارة إلى أن هناك خصوصية للقضاء الدستوري التي تعتبر جلساتها غير علنية كأصل، على عكس القضاء العادي الذي يعتبر فيه الأصل هو الجلسة العلنية، وأن تقرير القاضي المقرر أمام محاكم الاستئناف تتم تلاوته إلا إذا قام رئيس الجلسة بإعفاء القاضي المقرر من قراءة تقريره ولم يعارض في ذلك الأطراف حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، لكن كما سبق وأن قلنا أن القضاء الدستوري ولو أن له صبغة قضائية شكلية إلا أن له خصوصيات مسطرية يمتاز بها وأخرى لم تتم الإشارة إلى تفاصيلها كما هو الحال بالنسبة لتقرير القاضي المقرر.
فبخصوص هذا النقاش المرتبط بطريقة تعامل القضاء الدستوري مع عملية انتقاء المواد التي تم فحص مدى دستوريتها، كانت هناك آراء متعددة، فهناك من اعتبر أن المحكمة الدستورية قد بينت عن موقفها من الإحالة البيضاء كأحد النظريات الفقهية في القانون الدستوري، والتي تعامل معها بحدة أيضا القضاء الدستوري الألماني وبشكل متوازن القضاء الدستوري الفرنسي الذي يقبل ويرفض الإحالة البيضاء حسب سياق وقيمة القانون المراد فحص دستوريته، بينما القضاء الدستوري البلجيكي يشترط ضرورة ذكر مآخذ الإحالة على الأقل لقبول الإحالة البيضاء.
وهناك توجه أخر اعتبر أن المحكمة الدستورية سنت منهجا جديدا يقوم على نظرية الخرق الدستوري البين، وأن المحكمة الدستورية تكون بذلك قد قامت بمراقبة بالإهمال والترك لباقي مواد القانون غير المشمولة بالفحص، بينما هناك من فسر قرار المحكمة الدستورية بالاعتماد على نظرية اقتصاد الوسائل التي يستعملها القضاء الدستوري الفرنسي للاعتماد على علة واحدة او علل معينة للحكم بعدم مطابقة القانون للدستور، وهناك من يمكن أن يفسر ذلك بعدد مواد القانون التي تتجاوز أكثر من 600 مادة، وحيث أن الفصل 132 من الدستور ينص على بت المحكمة الدستورية في مدى مطابقة قانون للدستور "داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة. غير أن هذا الأجل يُخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام، بطلب من الحكومة."، وهو ما يبين أن مدة شهر يمكن أن تكون غير كافية للفحص الدقيق والمتبصر لمدى دستورية كل مادة على حدة خصوصا وأن الأجل يمكن تخفيضه ولا يمكن الزيادة فيه.
كلها توجهات لها قيمة علمية لتفسير طريقة عمل المحكمة الدستورية من خلال قراراها بشأن قانون المسطرة المدنية، لكن المتمعن لنص القرار سيتضح له على أن المحكمة الدستورية قد جمعت بين مجموعة من المناهج لتحقيق غاية واحدة، حيث أنها قي المنطوق لم تتطرق لإمكانية نشر القانون بفصل المواد غير المطابقة للدستور وهي الإمكانية المتاحة لها وفقا للمادة 27 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية.
وهو ما يفهم من خلاله أن المحكمة فعلا تبنت منهجية اقتصاد الوسائل لكن مع ربطها بمنهجية أخرى وهي نظرية التكامل الرقابي، بين الرقابة القبلية والرقابة البعدية، حيث جاء في صلب القرار "وحيث إن المشرع الدستوري إنما رام ضمان التكامل بين الرقابتين القبلية الاختيارية والبعدية في إطار الدفع بعدم دستورية القوانين، تحقيقا لسمو الدستور وحماية للحريات والحقوق الأساسية التي يكفلها بموجب أحكامه، ولا سيما بالنسبة للنص المعروض الذي تنتظم به إجراءات الدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية"، وبهذه العبارة تكون المحكمة الدستورية تهدف لضمان حق المواطن المرتفق للعدالة في الدفع بعدم الدستورية الإجرائي كضمانة دستورية فرعية عن ضمانات المحاكمة العادلة، وهي منهجية حديثة وسابقة في القضاء الدستوري المغربي تسموا بشرعية المواطنة عن شرعية التمثيل النيابي، وترجع أصل الرقابة للمواطن قبل المؤسسات، وهو عمق الاختيار الديموقراطي بمظهره التشاركي كما نص على ذلك الدستور.
وهو أيضا معطى يجب فهمه في سياقه، حيث أن المحكمة الدستورية بذلك تتطلع لضرورة التعجيل بإصدار القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية الذي لازال لم يصدر بعد، نظرا للمسطرة الطويلة التي مر منها.
خاتمة:
نخلص من خلال هذه الدراسة الموجزة التي تم من خلالها التطرق للقواعد المنهجية الحديثة لتعامل القضاء الدستوري مع مسطرة الرقابة القبلية للقوانين عن طريق الإحالة الاختيارية، إلى أن القضاء الدستوري كان تدخله إيجابيا لمعالجة مجموعة من الاختلالات الشكلية والموضوعية الموجودة في إحالة رئيس مجلس النواب، وبذلك سنت المحكمة الدستورية قواعد منهجية حديثة انتصرت فيها لكينونة الدستور وأساسا للتكامل بين الرقابتين القبلية والبعدية وحق المواطن الذي يلج لمرفق القضاء في الدفع بعدم دستورية الإجراءات المطبقة.
لكن تظل بعد الأسئلة الأخرى مفتوحة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية أهمها مصير القانون، هل ينشر بدون المواد التي شملتها عدم المطابقة أو المخالفة للدستور أو يرجع للمسطرة التشريعية لتعديل المواد غير الدستورية، وهل السلطة التشريعية يجب أن تتقيد في مسطرة ما بعد القرار بتعديل فقط المواد المنصوص عليها في القرار، وهل يمكن أن يحيل رئيس مجلس النواب القانون بعد التعديل والتصويت على المحكمة الدستورية وهل الإحالة هنا اختيارية أو إلزامية نظرا لأن القانون سبق وأن كان محل مراقبة من لدن المحكمة الدستورية.
فوجبت الإشارة إلى أن أصل إحالة قانون المسطرة المدنية هو اختياري وليس فيه ما يلزم بإحالته على المحكمة الدستورية، وبالتبعية فليس هناك ما يلزم إعادة إحالته مرة ثانية على المحكمة الدستورية بعد تعديل المقتضيات غير الدستورية، إذ يبقى اختيار الإحالة قائما لجميع من له حق الإحالة طبقا للدستور، أما بخصوص تعامل المشرع مع القانون بعد القرار فليس هناك ما يمنع من تعديل مقتضيات أخرى لم يشملها القرار لأن ذلك من اختصاص السلطة التشريعية ولها السلطة التقديرية في ذلك، ويظل القانون محلا للرقابتين القبلية أو البعدية بما في ذلك المواد التي لم يشملها قرار المحكمة الدستورية أي التي خرجت عن نطاق المراقبة الدستورية، إذ لا يمكن اعتبارها دستورية بالإهمال أو الترك نظرا لأن المحكمة الدستورية وكما سبقت الإشارة إليه تريد ضمان حق الرقابة البعدية عن طريق الدفع بعدم الدستورية.
وسيظل بذلك النقاش مفتوحا حول مجموعة من المقتضيات الأخرى التي كان ولازال هنالك اختلاف حول دستوريتها والتي تهم أساسا الطعون والدفوع ومقاضاة الدولة واستقلالية القضاء ومجانية التقاضي وغيرها من المواضيع الأخرى التي تحتاج لنقاش رزين ومسؤول.
رضوان الحيان / باحث في الدراسات القانونية