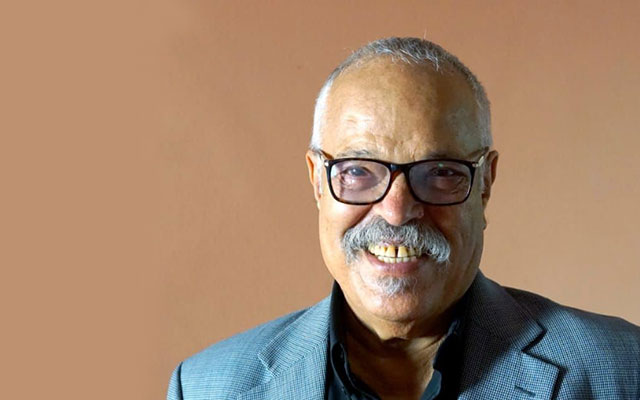عرف النظام الدولي منذ عام 1945 مسعىً منظماً لإخضاع العلاقات بين الدول لقواعد قانونية ملزمة، تجسدت أساساً في ميثاق وما تفرع عنه من اتفاقيات ومعاهدات دولية. وقد قام هذا البناء على مبادئ جوهرية، في مقدمتها سيادة الدول، والمساواة القانونية بينها، وحظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها في العلاقات الدولية، باعتبار ذلك شرطاً لازماً لحفظ السلم والأمن الدوليين. غير أن تطور الممارسة الدولية خلال العقود الأخيرة كشف عن فجوة متزايدة بين النصوص القانونية والواقع السياسي، بما يعكس أزمة عميقة في الشرعية الدولية.
ينص ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة (2/4)، على الحظر المطلق لاستخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي، ولا يجيز الخروج عن هذا المبدأ إلا في حالتين محددتين حصراً: ممارسة حق الدفاع الشرعي عن النفس وفق المادة (51)، أو صدور تفويض صريح من مجلس الأمن في إطار الفصل السابع. ويُستفاد من هذا التأطير أن الأصل في العلاقات الدولية هو منطق القانون، بينما يشكل اللجوء إلى القوة استثناءً ضيقاً يخضع لرقابة جماعية صارمة. غير أن هذا التوازن المعياري تعرض لاختلال متزايد بفعل ممارسات أحادية أعادت الاعتبار لمنطق القوة على حساب الشرعية.
وقد مثّلت محطات كبرى، مثل غزو سنة 2003، والتدخل العسكري في ليبيا عام 2011، ثم العمليات المتعددة على أراضي ، منعطفات حاسمة في مسار النظام الدولي، حيث جرى توظيف مبررات سياسية أو إنسانية خارج الضوابط الصارمة التي يفرضها القانون الدولي. وأسهم هذا المسار في تكريس قراءة انتقائية للشرعية الدولية، تُفعَّل فيها القواعد حين تخدم مصالح قوى بعينها، وتُهمَّش عندما تتعارض معها.
في هذا السياق، يثير أي تهديد أو تخطيط لاستخدام القوة ضد دولة ذات سيادة، مثل ، أو المساس بقيادتها السياسية، بما في ذلك رئيسها ، إشكالات قانونية خطيرة تتجاوز الحالة الخاصة إلى بنية النظام الدولي برمّتها. فمثل هذه الأفعال تنتهك مبدأ تساوي الدول في السيادة، وتفتح الباب أمام شرعنة التدخلات والانقلابات، كما تقوّض الثقة في فكرة الأمن الجماعي التي قام عليها نظام الأمم المتحدة.
ويزداد هذا الوضع تعقيداً في ظل العجز البنيوي الذي يعاني منه مجلس الأمن، نتيجة هيمنة الدول دائمة العضوية، واستعمال حق النقض (الفيتو) لتعطيل القرارات، ما أدى إلى شلل وظيفي في مواجهة أزمات دولية جسيمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وقد أسهم هذا الشلل في دفع بعض الدول إلى تبرير العمل الأحادي باعتباره بديلاً عملياً عن مساطر الشرعية الدولية، الأمر الذي عمّق من حالة الفوضى المعيارية داخل النظام الدولي.
إن ما يشهده العالم اليوم يمكن توصيفه بمرحلة تآكل المعيارية القانونية وصعود منطق القوة، حيث لم يعد القانون الدولي مرجعية ضابطة للسلوك الدولي بقدر ما أصبح أداة انتقائية خاضعة لموازين القوى. غير أن هذا الواقع لا يعني نهاية القانون الدولي، بقدر ما يعكس أزمة التزام سياسي وأخلاقي بتطبيقه. فإعادة الاعتبار للشرعية الدولية تظل رهينة بتفعيل آليات المساءلة، وتعزيز دور القضاء الدولي، وتكتل الدول المتوسطة والصغرى دفاعاً عن التعددية، فضلاً عن إصلاح منظومة مجلس الأمن بما يحد من إساءة استعمال الفيتو.
وخلاصة القول، إن الأزمة الراهنة ليست أزمة نصوص أو فراغاً قانونياً، بل هي أزمة إرادة في احترام القواعد التي ارتضتها الدول نفسها. واستمرار هذا المسار يهدد بتحويل النظام الدولي من نظام قائم على القانون إلى فضاء تحكمه موازين القوة، وهو ما يشكل خطراً ليس على الدول الضعيفة فحسب، بل على استقرار النظام الدولي ومستقبل الإنسانية جمعاء.
د. محمد السباعي، خبير في حقوق الإنسان