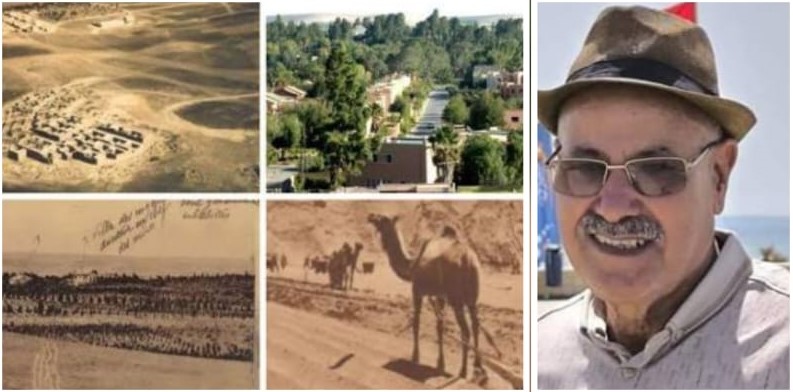أعادت واقعة اقتحام غرفة الجنيرال عبد العزيز بناني، بالمستشفى العسكري فال دوغراس بباريس، من طرف الضابط السابق مصطفى أديب، يوم 18 يونيو الجاري، عقارب الساعة إلى الزمن الصفر في العلاقات المغربية الفرنسية، لا فقط لأنها شكلت اعتداء ماديا ورمزيا على عسكري مغربي في حال الاستشفاء. ولكن أساسا لأنها تنتظم داخل سياق تنازلي جعل المغرب يتلقى الإهانة تلو الإهانة، ضمن غلاف زمني لا يتعدى خمسة أشهر (من فبراير إلى يونيو الجاري). فمن واقعة قيام الشرطة الفرنسية بمحاصرة بيت السفير المغربي بباريس في فبراير الماضي من أجل استدعاء مدير مديرية مراقبة التراب الوطني «الديستي» من طرف القضاء هناك للاستماع إليه في ملف مزعوم حول التعذيب، إلى واقعة التصريح المشين للمندوب الفرنسي في الأمم المتحدة في حق المغرب، المنشور بجريدة لوموند بتاريخ 20 من الشهر نفسه، والوارد ضم مقابلة مع الممثل الإسباني خافيير بارديم، حيث نسب إلى الدبلوماسي الفرنسي قوله «إن المغرب يشبه العشيقة التي نجامعها كل ليلة، رغم أننا لسنا بالضرورة مغرمين بها، لكننا ملزمون بالدفاع عنها»، إلى واقعة إخضاع وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، يوم 26 مارس الماضي، للتفتيش المهين بمطار شارل دوغول، وهو في طريق العودة إلى المغرب، بعد مشاركته في القمة الثانية حول الأمن النووي بلاهاي، وذلك في خرق سافر لكل الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، وانتهاء بالزيارة الوقحة والجبابة التي قام بها أديب إلى المستشفى الفرنسي. يقودنا هذا التوالي في مسلسل الإهانة مرة أخرى إلى مساءلة طبيعة العلاقات بين البلدين، وحقيقة هذا الإصرار في «تمريغ» السيادة المغربية في التراب. خاصة أن لا أحد يمكنه أن يقتنع بأن كل هذه الحوادث معزولة، وذات طابع فردي، مادامت تتم في زمن متقارب ومتواتر. أولى الملاحظات، بهذا الخصوص أن تلك الوقائع تتم في زمن حكم الاشتراكيين، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول ماذا يريد هولند ورفاقه من المغرب بالضبط؟ علما بأن هذا السلوك غير مسبوق بتاتا. فحتى حين بلغ توتر العلاقات بين المغرب وفرنسا أشده أيام فرانسوا متيران في مطلع ثمانينات
القرن الماضي، كان الأمر لا يخرج عن مناوشات تهم أساسا المجال الحقوقي،دون تجاوزه لما يمس رمزية السيادة المغربية. وقد كان ذلك مفهوما، بمعنى من المعاني، بالنظر إلى الحماس الذي رافق الصعود الأول للاشتراكيين في بداية الثمانينات، واحتداد الخطاب الدولي حول حقوق الإنسان من جهة،وبالنظر من جهة ثانية إلى انغلاق المغرب وقتها على المنظومة الكونية لحقوق الإنسان. أما اشتراكيو اليوم فيبدون في حالة ارتباك مزدوج: المصالح الإدارية الفرنسية (الأمنية والقضائية وغيرها) تتصرف بهذا المنطق الشاذ. ثم تطلع بيانات المسؤولين الحكوميين لتؤكد فردية ذلك المنطق، وحرصهم الشفوي على سلامة العلاقات بين البلدين. بل إن الرئيس الفرنسي تدخل شخصيا في واقعة محاصرة مقر إقامة السفير المغربي للاتصال بجلالة الملك في الموضوع. وجه المفارقة يتمثل بوضوح في كون هؤلاء المسؤولين هم الرؤساء التنفيذيون لتلك المصالح. وهذا ما يؤجج السؤال الذي ما فتئنا نطرحه دائما: إما أن الحكومة هناك لا تدير البلاد، أو أن ثمة نية لابتزاز المغرب، وللنيل من سيادته وكرامته، مما يعطي الانطباع بأن فرنسا لا تزال تتصرف معنا كمستعمرة فاقدة للرشد. جميع الحالات، وما دامت الوقائع تتكرر بنفس الشراسة، فالمؤكد، في حالة أخذ الموقف الرسمي على محمل الجد، أن جهات ما داخل الإدارة الفرنسية تلعب في الماء القذر. ولا عنوان لهذه الجهات موضوعيا سوى الاستسلام لإرادة خصوم المغرب الجزائريين وأتباعهم الانفصاليين الذين يجنون وحدهم ثمار هذا اللعب في الماء القذر. ما يدفعنا إلى هذه القراءة، ليس فقط تراخي الحكومة الفرنسية، وسلبية مواقفها مما يجري على ترابها، ولكن كذلك التقاء كل وقائع الإهانة حول نقطة واحدة: التشويش على صورة المغرب حقوقيا، بما يتناغم مع مجهود الجزائر والانفصاليين أمميا في نفس الاتجاه. وليس صدفة أن كل الوقائع تتم متزامنة مع الاستحقاق السابق المتعلق بتمديد فترة «المينورسو»، والتي ناضل خلالها الخصوم، دون جدوى، من أجل إدراج آلية مراقبة حقوق الإنسان في
الصحراء ضمن مهام هذه الهيئة الأممية، ومتزامنة كذلك مع تقدم المغرب موضوعيا في الحل النسبي لأغلب معضلات الشأن الحقوقي على كامل ترابه الوطني.
السؤال مرة أخرى: لماذا يقابل المغرب مواقف فرنسا بنفس التردد الذي يطبع هذه المواقف، تماما كما لو كانت فرنسا هي البلد الوحيد في العالم؟ ولماذا لا تتبنى الرباط ردود فعل حازمة، حيث كان قرار تعليق جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، في الأسبوع الأخير من فبراير الماضي،أقصى المواقف، في حين تتيح العلاقات بين الدول عددا من الإمكانيات التي من شأنها حفظ كرامة الوجه بما يليق بمكانة المغرب وتاريخه. يحق لنا كإعلاميين، وكمواطنين أولا أن نتساءل حول ماذا سيخسر المغرب لو راجع رسميا فكرة العلاقة مع فرنسا، أو على الأقل ترتيبها في منظومة العلاقات مع دول العالم، ليتحرر من سطوة المفهوم التقليدي للشراكة الذي يربطنا بذلك البلد. ولسنا في مأمورية تقديم الدروس في مجال العلاقات الدولية. إن مسعى جديدا لتطوير علاقات المغرب بدول المعمور، حيث تتعايش أكثر من عشرين دولة قوية ليست فرنسا في جميع الحالات أقواها، سيخلق معادلات جديدة بكل تأكيد. إن الانفتاح على ألمانيا وبريطانيا مثلا، وعلى دول آسيا وأمريكا اللاتينية يمكن أن يجلب خيرات كبرى للمغرب، سواء بالنظر إلى اعتبارات التقدم التكنولوجي، أو الوزن السياسي والاقتصادي، أو بالنظر أيضا إلى البعد الاستراتيجي كما نتصور ذلك في التعامل مع الاقتصاديات الصاعدة. يلزمنا فقط لتحقيق هذا المسعى أن نستعيد الثقة بإمكانيات المغرب، وبتطوره السياسي والدستوري، وبطاقاته الواعدة على مستوى مشروعه التنموي والديموقراطي الذي يحظى بالتفاف كل القوى المغربية الحية. لا خيار للمغرب بهذا الخصوص سوى المواجهة الحاسمة، وإلا فمسلسل «التمريغ» ماض في اتجاه مزيد من «بهدلة» المغرب والمغاربة. السياسة الكبرى في مثل هذا المقام لا تمارس فقط بردود الفعل!
Copyright © 2014 - 2025 ( Ariri Abderrahim ) - أنفاس بريس جريدة إلكترونية مغربية. Tous droits réservés.