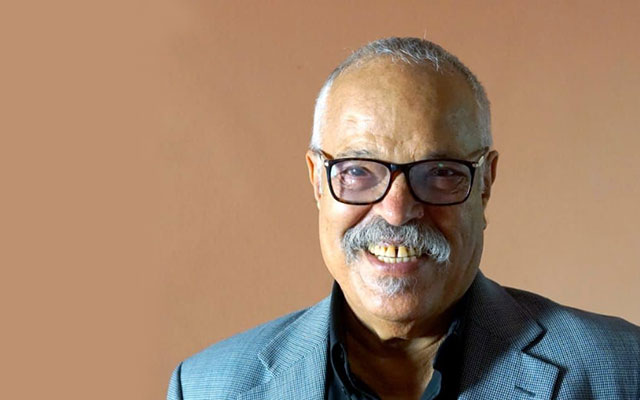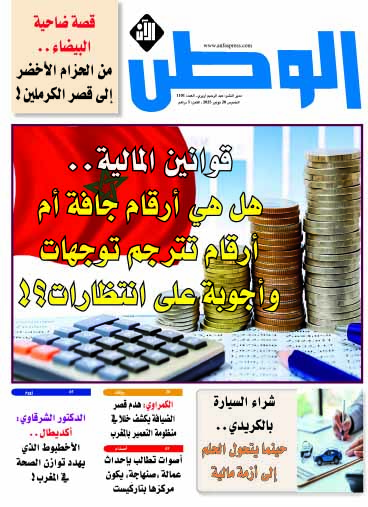احتل كتاب "البُخَلاَء" للجاحظ مكانةً فريدةً في الأدب: فكثيرًا ما يُختزل إلى مجموعةٍ من الحكايات الطريفة عن سفاسف الأمور، إلا أنه يتجاوز مجرد التجميع الأخلاقي والترفيه البريء. ما يقرأه المرء فيه لا يقتصر على ما يُروى فحسب، بل على كيفية عرضه أيضًا - في مشاهد موجزة، متوترة، تكاد تكون صامتة، حيث تكفي إيماءة أو صمت أو شيء في غير محله للكشف عن نظامٍ كاملٍ من العلاقات الاجتماعية.
لطالما اعتُبرت مشاهد "البُخَلاَء" مجرد نوادر - قصص قصيرة، مؤثرة، وفكاهية في كثير من الأحيان - إلا أنها في الواقع تُمثل عروضًا دراميةً مصغرة، لا يُعلن فيها البخل علنًا، بل يُكشف عما يُكتم، وما يُترك، وما يُطمح إليه دون جدوى. لا يُدين الجاحظ البخيل؛ بل يُصوّره، باقتصادٍ في الوسائل، ما يُذكّر بالمسرح المُبسّط: طاولة (الوجبة)، شخصيّتان (المُضيف والضيف)، شيءٌ مرغوبٌ فيه (خبز، ملح، ملابس)، وصمتٌ مُثقلٌ بالكلمات الصامتة.
في هذه المسرحية المنضبطة تحديدًا، وهذا اللجوء إلى الصمت المُجدي، يكمن ما يُمكن تسميته بـ"اللحظة" الجاحظية: هذه نقطة التحوّل التي يكفّ فيها النص عن تصوير رذيلةٍ ما، ويصبح أداةً نقديةً كامنة، حيث لا تُقال الحقيقة الاجتماعية، بل تُصبح مرئية. بعيدًا عن تقديم درسٍ أخلاقي، يُنشئ الجاحظ مناظر يصبح فيها القارئ مُشاهدًا - وسرعان ما يُصبح شريكًا - في إدراكٍ صامت: إدراك للآليات الاعتيادية للحجب، والتهذيب المُصطنع، وفرص التبادل الضائعة.
تُركّز هذه الدراسة على تحوّل "النادرة" إلى مُقتطف معرفي. تقترح قراءة كتاب "البُخلاء" ليس كمرآة للعادات، بل كأداة لرصد المجتمع من خلال تمثيل لحظات صمته. كيف، في هذه المشاهد القصيرة، تحل الإيماءة محل الخطاب؟ كيف يصبح الصمت أبلغ من أيّ إدانة؟ والأهم من ذلك كله: كيف تُشكل هذه دراماتيكية للرفض الاعتيادي منهجًا فكريًا أصيلًا، فريدًا من نوعه لدى الجاحظ؟
النادرة: ما وراء الحكاية الأخلاقية
يُخفي مُصطلح "النادرة" بحد ذاته خصوصية ما يصنعه الجاحظ منها في "كتاب البخلاء". فالنادرة عنده لا تهدف إلى العظة بالقدوة، ولا إلى التسلية بالمُغالاة: إنها تعمل بالاختزال، فتكثف في بضعة أسطر وضعًا اجتماعيًا كاملًا، حيث تَحمل كل كلمة وكل حركة وكل صمت وزنا كدليل. بخلاف "الحكاية" التي تنبسط في الزمن السردي، أو "المَثَل" الذي يُحَدِّدُ خلاصة أخلاقية، فإن النادرة الجاحظية تنبسط في فضاء مشهدي. ليس لها ماضٍ ولا مستقبل: إنها توجد بكليتها في حاضر المواجهة، أو الوليمة المُقْطوعة، أو العطية الممنوعة من غير نطق.
هذه الخصوصية الشكلية تجعلها أقرب إلى المسرحية القصيرة منها إلى"الحكاية الشعبية". وكما في المسرح، كل شيء فيها يتعلق بالتمركز المكاني، والإيقاع الحواري، والحركة الدالة. حين يروي الجاحظ أن بخيلًا "«لما رأى أيدي ضيوفه تمتد نحو الصحفة، قربها إليه قائلًا: هذه أمسكها لغد»"، فهو لا يقص حدثًا، بل يضع صراعًا على الخشبة. فالمكان محدد (المائدة)، والأدوار موزعة (المضيف، الضيوف)، وموضوع الرغبة حاضر (الصحفة)، والتوتر ينبعث من حركة طفيفة — إزاحة — ترافقها عبارة مهذبة تُعطِّل أي اعتراض. لا شيء مُفْرَط، ولا شيء فَجّ؛ ومع ذلك، فكل شيء قد قيل. ليس الباعث على الصدمة هو الخبث، بل هي اعتيادية الانسحاب.
ما يُميّز النادرة الجاحظية جوهريًا عن المجموعات الوعظية في عصره — كتلك التي لابن قتيبة أو للجاحظ نفسه في مؤلفات أخرى — هو أنها لا تختتم أبدًا. لا تنتهي بحكمة، ولا بعبرة، ولا حتى بحكم ضمني من الراوي. يتوقف النص حيث يبدأ القارئ: في اللحظة بالضبط التي يتعرف فيها على المشهد، ليس بوصفه استثناء، بل بوصفه نوعا مألوفًا للرفض الاجتماعي. وهذا الانزياح — من الحكم إلى الإدراك — هو الذي يشكل العتبة الأولى للحظة الجاحظية. والضحك، حين يَحْدُث، ليس ساخرًا: إنه ضحك متواطئ ومقلق، لأنه ينبع من الوعي المفاجئ بأن المرء نفسه قد شارك، ذات يوم، في مثل هذا المشهد — إما بالكتمان، أو بالانتظار.
هكذا، لا تعمل النادرة كتوضيح لحقيقة خارجية، بل كتجربة فكرية متجسدة. إنها لا تقول "البخلاء هكذا"؛ بل تُري كيف يعمل البخل في ثنايا اليومي، عبر حركات مبتذلة إلى حدٍّ تفلت معه الإدانة الأخلاقية. وبالضبط لأنها تمتنع عن أي توضيح، تصبح النادرة نقدًا: إنها تترك الاجتماعي ليفضح نفسه، في اقتصاد تمثيله ذاته.
درامية الصمت: الحركة، الشيء، والمسكوت عنه في المشهد الجاحظي
إذا كانت النادرة الجاحظية مشهدًا، فإن بطلها الحقيقي غالبًا ما لا يكون البخيل ولا الضيف، بل ما لم يَحدث: كسرة الخبز التي لم تُمَدَّد، وكأس الماء التي لم تُملأ، والمكان الذي لم يُعْرَض. ما يلفت الانتباه في قراءة "كتاب البخلاء" ليس ما تقوله الشخصيات بقدر ما هو ما لا يفعلونه — والأهم، ما يتركون الآخر ينتظره عبثًا. يصبح الصمت هنا استراتيجية، لا ثغرة؛ نمط فعل سلبي، لا يقل فاعلية عن الكلمة.
يتقن الجاحظ اقتصاد المسكوت عنه برقة تجعله أكثر من مجرد مراقب: إنه مُخْرِج للفراغ الاجتماعي. خذ المثال الشهير لأهل الكوفة، الذين "إذا دخل الرجل على أحدهم في وقت الطعام لم يطعموه خبزًا ولا ملحًا ولا ماء — وإذا انصرف قالوا له: جزاك الله عنا خيرًا على زيارتك!". لا شيء في هذا المشهد مرفوض صراحة. لا توجَّه أي كلمة جارحة. ومع ذلك، فالعطاء غائب في كل حركة من حركاته. ليس الصمت هو ما يفضح البخل؛ بل الصمت المُنَظَّم، المُؤطَّر، الطقوسي— كقاعدة مضمرة يعرفها الضيف نفسه ويحترمها. لا حاجة لأن يُصَرَّح بالرفض: إنه مُشَفَّرٌ في الانتظار المُتقطع، في الفراغ حول الصحفة، في العبارة المهذبة التي تختم تفاعلًا لم يُتبادل فيه شيء.
الأكثر دلالة هو دور الحركة الطفيفة. عند الجاحظ، تكفي حركة بسيطة باليد لعكس المعنى الكامل للمشهد. هكذا، حين يقول البصري "يقرب الصحفة إليه قائلًا: هذه أمسكها لغد"، ليست العبارة هي المهمة — فهي عادية، تكاد تكون محايدة — بل الحركة التي ترافقها: انسحاب، إزاحة لمركز الوليمة نحو الذات. هذه الحركة تلغي الوعد الضمني للمائدة المشتركة. هي لا تنتهك أي قاعدة؛ بل تتحايل عليها بأناقة تجعل الضيف عاجزًا عن الاعتراض دون أن يبدو فظًا. والصمت الذي يلي ليس محرجًا: إنه متواطئ. يختم ميثاقًا ضمنيًا: أنت لن تعطي، وأنا لن أطلب.
تلعب الأشياء هنا دور فاعلين مستقلين. الخبز، الملح، الثوب، المصباح — كلها وسائط مادية تُعْرَض عليها دراما العطاء الفائت. وجودها نفسه يصبح غامضًا: هي هناك، مرئية، قابلة للوصول ظاهريًا... لكنها غير قابلة للوصول عمليًا. الملح "مستهلك"، والخبز "مُحتفظ به"، والثوب "قيد الاستخدام". لم يعد الشيء وسيلة للمشاركة، بل شاشة يُسقط عليها الرفض. وفي هذا التوتر بين الظهور وعدم الوصول، يكتسب الصمت كثافته الدرامية.
ما يضعه الجاحظ على الخشبة، إذن، ليس البخل كرذيلة فردية، بل البخل كممارسة اجتماعية مشتركة، حيث يشكل الصمت والحركة والشيء ثلاثية للامتناع العادي. لا يضحك القارئ من خبث شخصية، بل من التعرف المفاجئ على شفرة يعرفها جيدًا — تلك التي تمكنه من عدم العطاء مع البقاء مهذبًا، وعدم المشاركة مع البقاء مضيفًا.
هنا تبلغ الـعقدة الجاحظية ذروتها: النص لا يندد بالبخل — بل يجعله يُعْرَض أمام أعيننا، في كل وضوحه الهادئ. وفي هذا المسرح الصامت "اليومي" يولد النقد الاجتماعي، ليس من صوت الواعظ، بل من صمت المشهد نفسه.
من الفرد إلى المدينة: البخل كشفرة ثقافية مشتركة
عند الجاحظ، لا يتوقف البخل عند عتبة الفرد. إنه ينتشر، يتطبع، وينتهي به المطاف إلى هيكلة العلاقة بالعالم برمتها — إلى درجة أن مدنًا بأكملها تصبح تجسيدًا حيًا له. لذا لا يكتفي "كتاب البخلاء" برسم بخَلاء منعزلين؛ بل يبني، بتراكم المشاهد المقتضبة، جغرافية أخلاقية حيث تمتلك كل مدينة أسلوبها الخاص في الامتناع، وطقوسها في عدم العطاء، وطريقتها في جعل الصمت قاعدة اجتماعية.
أهل الكوفة يقدمون المثال الأبرز. يروي الجاحظ أنهم "يُقَدِّمون للضيف كسرة خبز واحدة، وحبة ملح، وجرعة ماء — ويَعتبرون أنفسهم كرماء". لكن ما يميز هذا المشهد عن مجرد صورة كاريكاتورية، هو أن الضيف نفسه لا يحتج. إنه يقبل هذه الحصة الضئيلة لا كإهانة، بل كمعيار متشارَك. البخل الكوفي لا يُعاش كخطيئة، بل كتدبير للرابط الاجتماعي: لا تُقْطَع العلاقات، بل تُخَفَّض إلى أدنى تعبير طقسي لها. والصمت المحيط بالوليمة ليس فراغًا محرجًا؛ إنه فضاء مُشَفَّر، يعرف فيه كل واحد بالضبط ما يمكن أن يتوقعه — والأهم، ما لا يجدر به أن يطلبه.
على العكس، فإن أهل البصرة — كما يوضح الجاحظ بسخرية ملطَّفة بعطف — يمارسون بخلًا راقيًا، شبه غير مرئي. تخصصهم: محاكاة الكرم دون إنجازه أبدًا. يحضرون وليمة شهية، يضعون الضيف في أفضل مكان، يستخدمون عبارات ترحيب حارة — لكن، في اللحظة بالضبط التي تمتد فيها اليد، تُزاح الصحفة، وتُـحْجَز أفضل قطعة، ويُؤَجَّل العطاء. هنا، لا يسود الصمت، بل اللغة المُلْتَوِية: كلمات الترحيب تستخدم لتعطيل الانتظار، لا لتحقيقه. البصري لا يرفض أبدًا علنًا؛ بل يُفْسِخ العطاء قبل حدوثه، بأناقة تجعل الضيف يخرج شاكرًا... وإن لم يكن قد نال شيئًا.
هذا التباين ليس عشوائيًا. إنه يظهر أن البخل، عند الجاحظ، ليس جوهرًا، بل أسلوب — طريقة في التواجد في العالم، وإدارة المسافة، والتفاوض على الرابطة. والأهم، أنه يكشف أن المدينة نفسها تصبح فاعلًا اجتماعيًا. لم يعد يُقال "فلان بخيل"، بل "أهل الكوفة يفعلون كذا"، كما لو أن البخل كان منقوشًا في المناخ، والعادات، ولغة المدينة نفسها. وكأن الضمير الجمعي ("أهل الكوفة..."، "البصريون...") وصيغة المضارع المعتاد يمنحان هذه الممارسات قيمة كونية ولا زمنية: فهي لم تعد تنتمي للاستثناء، بل للحقيقة الثقافية المسلَّم بها.
وهذا البناء الإثنوغرافي ليس أبدًا مجردا. فبمقابلته بين الكوفة والبصرة، لا يحكم الجاحظ — بل يضع على الخشبة نسبية المعايير الاجتماعية. القارئ، سواء كان من بغداد أو دمشق أو البصرة نفسها، يُدْعَى ليتعرف على نفسه في إحدى هذه الصور، أو فيما بينها. والضحك الناشئ ليس إذن ضحك التفوق، بل ضحك التعرف الذاتي المقلق: "ألا نفعل جميعنا هكذا، بطريقتنا؟"
في هذا التحول من "النادرة" إلى مرآة جماعية، تكمن إحدى أبرز سمات المنهج الجاحظي. النص لا يصف البخل فحسب؛ بل يظهر كيف تُعَرِّف الجماعات نفسها بما ترفض أن تعطيه، وبالطريقة التي تجعل بها هذا الرفض غير مرئي — بل ومحترمًا حتى.
هذه القدرة على تحويل التفاصيل العادية إلى موطن"الحقيقة الاجتماعية" تقود إلى سؤال أعمق: كيف تشكل هذه الطريقة في الرؤية — حيث يسبق الضحك التأمل — لدى الجاحظ، نظرية معرفية حقيقية للأدب؟
الضحك كمنهج: نحو نظرية معرفية للأدب"
الضحك الذي يخترق "كتاب البخلاء" ليس بريئًا. لا ينبع من سخرية سهلة، ولا من مبالغة هزلية، بل من انزياح دقيق بين المظهر والممارسة، بين المعيار المُصَرَّح به والفعل. هذا الانزياح — الطفيف، اليومي، شبه غير المحسوس — هو ما يلتقطه الجاحظ بحدة إثنوغرافية نادرة، وهو ما يثير في القارئ ذلك الضحك المعلَّق، المتواطئ والقلق في آن. هذا الضحك لا يُوَجَّه ضد الآخر، بل ضد الألفة ذاتها للحركة الملاحظة: "لقد فعلتها، أنا أيضًا."
هنا تتجاوز النادرة وظيفتها السردية لتصبح أداة للمعرفة. بخلاف الخطاب الوعظي، الذي يفرض حقيقة خارجية، فإن الجاحظ لا يقول شيئًا: إنه يُري. لا يدين البخيل؛ بل يتركه يفضح نفسه في حركة، أو عبارة، أو صمت. وبالضبط لأنه يمتنع عن أي تعليق، يُجْبَر القارئ على أن يصبح حاكمًا على ما يراه — ليس بإلزام أخلاقي، بل من خلال إدراك تلقائي. يصبح الضحك عندئذ عتبة الوعي: إنه يعلّم اللحظة التي يتوقف فيها المرء عن اعتبار البخل رذيلة غريبة ليتعرف عليه كصيغة عادية للرابط الاجتماعي.
هذا المنهج — الإيضاح عوض القول، إضحاك للتفكير — يشكل ما يمكن تسميته إبستمولوجيا "الأدب". عند الجاحظ، معرفة الاجتماعي لا تمر عبر التجريد، بل عبر التصغير الدرامي: مائدة، شخصيتان، شيء مرغوب. المعرفة الحقيقية ليست في التعميم، بل في التفصيل العَرَضي — حبة الملح الغائبة، الخط المرسوم في الأرز، العبارة المهذبة التي تسحب ما بدا أنها تقدمه. لا يتعلم القارئ ما هو البخل؛ بل يتعرف عليه في ممارسته الخاصة للرفض المقنن، والكرم المؤجل، والأدب بلا عطاء.
وهذا ما يفرق الجاحظ جذريًا عن جامعي الأخبار في عصره. حيث يجمع الآخرون أمثلة لتوضيح أخلاقيات سابقة الوجود، هو يبني مشاهد تتهاوى فيها الأخلاقية ذاتيًا، كاشفة مكانها منظرًا اجتماعيًا معقدًا، غامضًا، وإنسانيًا بعمق. الضحك ليس، إذن، غاية النادرة: بل هو بدايتها النقدية.
في هذا تبلغ "عقدة" الجاحظ بعدها الكامل: النص لا يحتوي على حقيقة — بل يثيرها. لا يقدم عظة — بل يخلق وضعية تفكير، حيث يجد القارئ نفسه، وهو يضحك، فجأة أمام مرآة صمته الخاص.
وهكذا، بعيدًا عن كونه مجرد مجموعة من الحكايات عن تفاهات البشر، يُظهر كتاب البُخلاء نفسه كمختبر دقيق للملاحظة الاجتماعية، حيث يُصبح شكل السرد نفسه - البسيط، المسرحي، الصامت - موضع نقدٍ جوهري للروابط الإنسانية.
لا يُمكن حصر كتاب "البُخلاء" للجاحظ في الفئات التقليدية للحكايات الأخلاقية، أو السخرية الاجتماعية، أو الترفيه القصصي. ما يجعله أصيلًا هو أن النقد لا يُصرّح به صراحةً قط - بل يقدّم. من خلال نوادر قصيرة، متوترة، وصامتة في أغلب الأحيان، يبني الجاحظ مشاهد لا يُعلن فيها البخل، بل يُكشف عنها في لفتة مكبوتة، أو شيء في غير محله، أو صمت مشترك. إن الطابع المسرحي لهذه النوادر. بعيدًا عن كونه مجرد جمالية، يُشكل جوهر منهجه: فهو يُحوّل القارئ إلى مُشاهد، ثم إلى شاهد مُتواطئ، وأخيرًا إلى قاضٍ على نفسه.
ما يُسمى "الجوهر" الجاحظي - تلك النقطة المحورية التي يكف فيها النص عن كونه عاديًا - يكمن تحديدًا في هذا الاقتصاد في الكشف: لا شيء يُشرح، كل شيء مكشوف. الضحك الذي ينشأ ليس ساخرًا ولا تافهًا؛ إنه علامة على إدراك حميم، علامة على قانون اجتماعي يُمارسه المرء بنفسه، بأشكال مُتفاوتة الرقي. سواءٌ أكان بخل الكوفيين الصارخ، أم بخل البصريين المُبطّن، أم التمثيليات الدرامية الدقيقة لموسى بن جنة أو الفضل بن العباس، فإن تفاهة الرفض هي ما يُسلّط الضوء عليه دائمًا - لا لإدانته، بل لرؤيته على حقيقته. وفي هذا الصدد، يتجاوز كتاب البخلاء نطاق الأدب ليصبح أداةً لرصد المجتمع، حيث لا يقتصر الأدب على انعكاس العالم فحسب، بل يُقدّم مرآةً دقيقةً لا يُمكن للقارئ أن يُخطئ فيها. ليست الأخلاق هي التي تُنير النص، بل النص هو الذي يُنير الأخلاق، بإظهار كيف تذوب في أساليب التكتم المعتادة.
ولعل هذا هو أعظم دروس الجاحظ، الصامتة ولكن الفاعلة: حقيقة المجتمعات لا تكمن فيما تُعلنه، بل فيما تُسكت عنه - وفي الطريقة الأنيقة والمهذبة، والتي تكاد تكون خفية، في رفض القسمة.