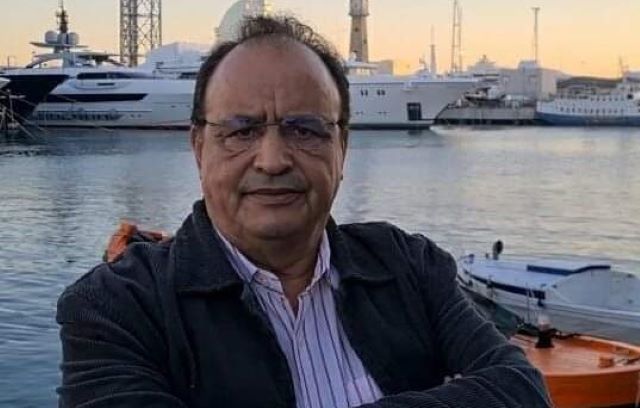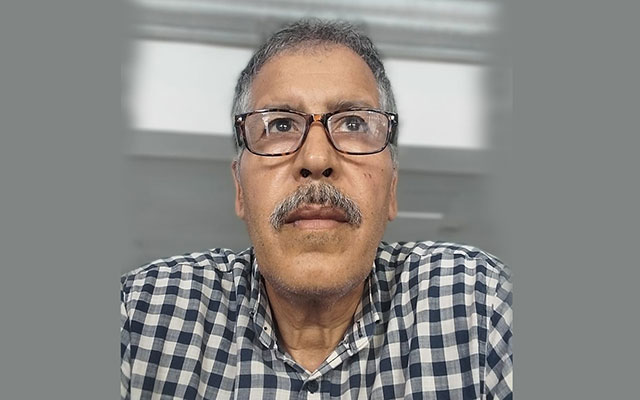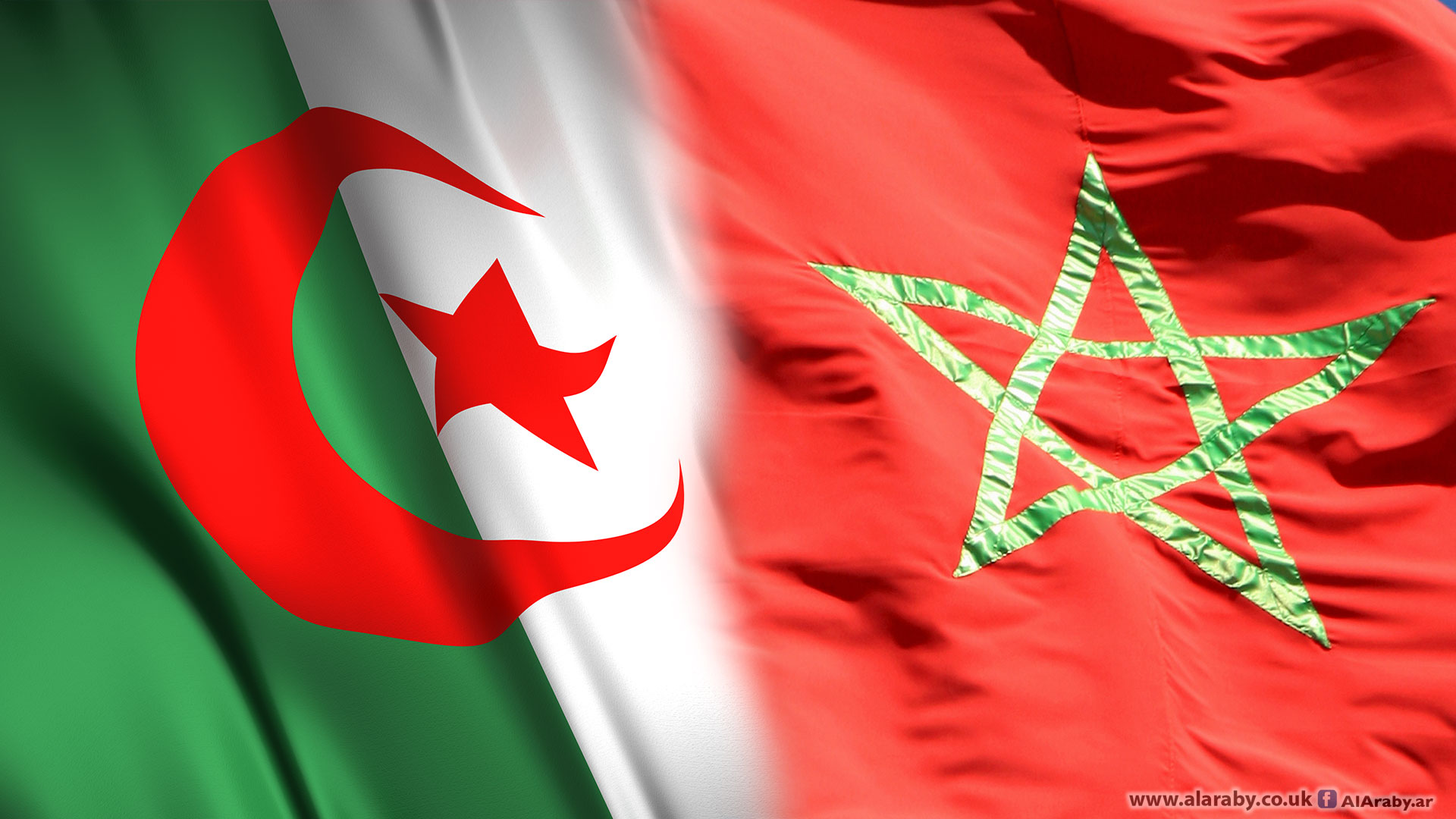في لحظة تاريخية حاسمة، وسط تحولات سياسية واجتماعية إقليمية ودولية، شكّل دستور 2011 بالمغرب لحظة مفصلية في مسار بناء الدولة الحديثة. فقد جاء استجابة لمطالب داخلية وخارجية ملحة، عبّرت عنها أصوات شعبية ونخبوية تطالب بإصلاحات عميقة، وبإعادة ترتيب العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتعزيز مفهوم المواطنة الكاملة. من بين أهم ملامح هذا الدستور، برزت مسألة مغاربة العالم بوصفها رهانًا استراتيجيًا، لا فقط من زاوية الحقوق المدنية والسياسية، بل كذلك باعتبارهم ركيزة تنموية وثقافية تمتد خارج الحدود الجغرافية. لقد نص الدستور بشكل صريح على ضمان حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بما في ذلك الحق في المشاركة السياسية والتمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة، والانخراط الفعلي في الدينامية الوطنية، غير أن هذه المقتضيات ظلت معلقة، تراوح مكانها منذ أكثر من عقد.
لقد تكشف بعد مرور هذه السنوات أن هناك فجوة عميقة بين النص الدستوري والممارسة الفعلية، بين الإرادة المعلنة والتطبيق العملي، بين طموح المؤسسة الملكية في إدماج الجالية في الفعل الوطني، وتردد المؤسسات الأخرى في ترجمة هذا الطموح إلى واقع ملموس. ففي الوقت الذي عبّر فيه الملك محمد السادس، في أكثر من مناسبة، عن التزام صريح بإشراك مغاربة الخارج، وحرص على اعتبارهم امتدادًا طبيعيًا للوطن وخزانًا غنيًا بالكفاءات، ظل الأداء الحكومي والتشريعي حبيس التلكؤ، متعثرًا بين أعذار تقنية وحسابات سياسية ضيقة.
هذا التعثر لا يمكن قراءته بمعزل عن غياب الإرادة السياسية الصادقة. إذ تبدو العديد من الأحزاب السياسية غير معنية فعليًا بإدماج الجالية، بل تخشى من تأثيرها الانتخابي، بالنظر إلى استقلالية رأيها وتنوع مرجعياتها، ما يجعل بعض الفاعلين الحزبيين يفضلون تأجيل هذا الورش أو تقزيمه بصيغ شكلية لا ترقى إلى مستوى النص الدستوري. وفي موازاة هذا التردد السياسي، نجد تعقيدات بيروقراطية وإدارية تشتغل ضد منطق التفعيل، وتُبقي الكثير من القوانين التنظيمية الضرورية في رفوف الانتظار، وكأن هناك من يتعمد إبقاء الدستور في وضع الجمود، خشية أن يُعيد تشكيل موازين القوى داخل الدولة والمجتمع.
إن أخطر ما في هذا التعطيل أنه يخلق مواطنة منقوصة، تميز بين المقيم والمغترب، وتربط الحقوق بمدى القرب الجغرافي، لا بعمق الانتماء. وهذا المنطق لا يمكن أن يصمد في وجه تحولات العصر، ولا ينسجم مع منطق المواطنة الحديثة التي تقوم على المساواة والمشاركة والاعتراف. فكيف يمكن لدولة تحتفي بتحويلات الجالية، وتُثني على ولائها، أن تحرمها في الوقت نفسه من التمثيل السياسي والمشاركة في صياغة القرار الوطني؟ وكيف يمكن لنص دستوري أن يستمر فاقدًا لأدوات التفعيل دون أن يهتز جوهر التعاقد الدستوري نفسه؟
ليس هناك شك في أن المؤسسة الملكية عبّرت، وبوضوح، عن رؤيتها المستقبلية لمكانة مغاربة العالم، رؤية تعتبرهم مكونًا استراتيجيًا في التنمية والانفتاح، وتُعوّل عليهم في الدفاع عن صورة المغرب خارجيًا. غير أن هذه الرؤية لا تجد صداها في مؤسسات تمثيلية وتشريعية وتنفيذية تُعاني من التردد، وتُفضل حسابات المدى القصير على المصلحة الوطنية الطويلة الأمد. والمفارقة أن كل ذلك يتم في ظل دستور واضح، لكن يُتعامل معه وكأنه وثيقة اقتراحات وليست مرجعية إلزامية.
إن اللحظة تقتضي، أكثر من أي وقت مضى، إعادة الاعتبار إلى قوة الدستور بوصفه المرجعية العليا، لا مجرد إطار شكلي للخطاب السياسي. فالمسألة لم تعد تقنية ولا إجرائية، بل أصبحت سياسية بامتياز، وتتعلق بجوهر العلاقة بين الدولة ومواطنيها، أينما كانوا. وبدون تفعيل هذه العلاقة، ستظل الثقة منقوصة، والعدالة معطلة، والانتماء هشًا. إن إصلاح هذا المسار لا يقتصر على إصدار قوانين أو قرارات، بل يتطلب أولاً تغييرًا في الذهنية السياسية، وفي طريقة فهم الدولة للمواطنة، وفي قدرة المؤسسات على الارتقاء إلى مستوى الانتظارات الكبرى.
إن مغاربة العالم ليسوا عبئًا ولا ملفًا ثانويًا يمكن تأجيله، بل هم ركيزة من ركائز القوة الوطنية، ومكون أساسي في صياغة مغرب الغد. وكل تأخير في إنصافهم، هو إضعاف لمنطق الدولة الحديثة، وتراجع عن التزامات دستورية واضحة. ومن هنا، يصبح من الملح أن يتم تجاوز التردد والمماطلة، والانكباب بجدية ومسؤولية على تنزيل مقتضيات الدستور وتفعيل التوجيهات الملكية، حتى لا يتحول هذا الورش الوطني الكبير إلى مجرد ذكرى جميلة في أرشيف الإصلاح المؤجل.