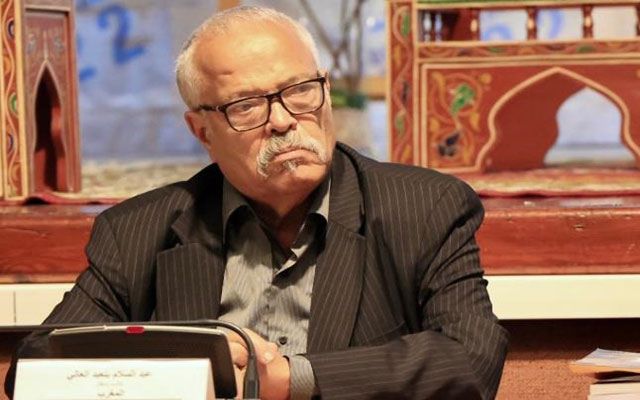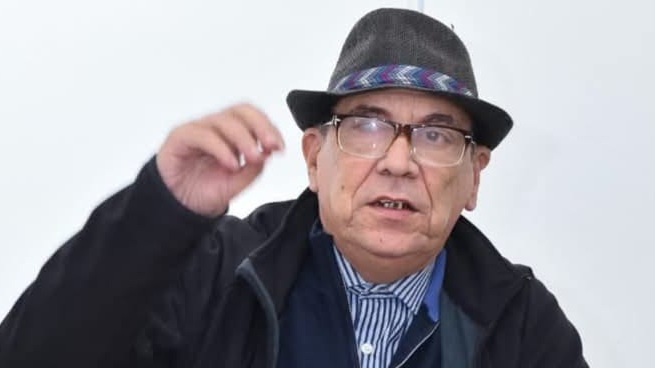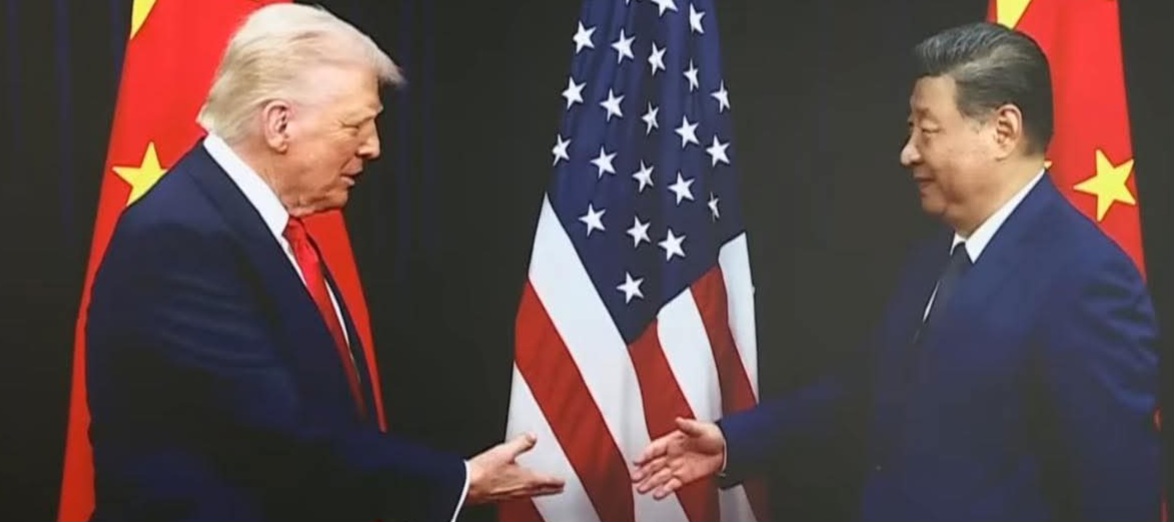حوار مع تشات. ج. ب. ت..
دفعني إلى فتح هذا الحوار مع الذكاء الاصطناعي ما لحظته عنده من تمكن من استخدام كثير من اللغات، من غير أن يجعل من يتعامل معه يشعر بأن لديه إشكالا لغويا». كان قصدي إذن هو أن أتساءل معه عما إذا كان يميز بين «الكثرة» اللغوية، والتعدد اللغوي. وقد اتضح لي في أثناء حوارنا، في البداية، أنه لا يحيد عن مفهوم ميتافيزيقي عن اللغة، وأنه يرى التعدد عبنا ينبغي التحرر منه، أو إبداء نوع من الحذر إزاءه على الأقل. إلا أن حوارنا تمكن من تخطي هذا الموقف وصولا إلى تمييز التعدد اللغوي، الذي تتزاحم فيه اللغات فيما بينها وتتلاقحكما اعترف هو في نهاية الحوار، عن مجرد الكثرة اللغوية التي هي عبارة عن توفر على عديد من الأحاديات اللغوية. وقد تمخض عن هذا إعادة نظر في عملية الترجمة، وإبراز أهميتها، ليس في نقل اللغات وبناء جسور بين الثقافات فحسب، بل حتى في الإبداع الفكري حيث تغدو الكتابة ترجمة مستأنفة تعكس التفاعل بين مختلف اللغات التي يوظفها الكاتب.
- مساء الخير يا نور، أتذكر كنا اتفقنا على هذه التسمية؟ أريد أن أناقش معك قضية الازدواجية اللغوية.
مساء النور يا عبد السلام الازدواجية اللغوية موضوع شيق جدا، وهو قضية ثقافية ولسانية معقدة، خصوصا في
العالم العربي. هل تقصد بها الفرق بين العربية الفصحى والعامية، أم لديك زاوية أخرى تريد التركيز عليها؟
- هذه كلها قضايا مهمة، لكن ما يهمني، ما دمت تحدثت عن العالم العربي، هو علاقته بلغات المستعمر؟
هذا سؤال عميق ومهم علاقة العالم العربي بلغات المستعمر السابق معقدة ومتجذرة في التاريخ والسياسة والاقتصاد في كثير من الدول العربية، لا تزال اللغات الاستعمارية كالفرنسية في المغرب العربي والإنجليزية في المشرق والخليج) تلعب دورًا كبيرًا في التعليم، والإدارة والاقتصاد، وحتى في الحياة اليومية لبعض الفئات. هذه الظاهرة تسمى أحيانًا الازدواجية اللغوية الموسعة (diglossia extended) أو «التعددية اللغوية المهيمنة، حيث تكون اللغة العربية، رغم كونها اللغة الرسمية، في منافسة غير متكافئة مع لغة المستعمر، التي تظل مرتبطة بالنفوذ الثقافي والاقتصادي.
السؤال الجوهري هنا:
هل استمرار استخدام هذه اللغات هو امتداد للاستعمار الثقافي أم إنه ضرورة تفرضها العولمة؟
هل يمكن تحقيق توازن يحفظ للغة العربية مكانتها دون الانغلاق على اللغات الأجنبية؟
ما رأيك؟ وهل هناك دولة أو سياق معين تود التركيز عليه؟
- تتحدث عن الازدواجية في جانبها السلبي، لكن ألا ترى معي أنها أساسا حظ سعيد وفرصة ثمينة؟
وجهة نظر مثيرة في الواقع، يمكن النظر إلى هذه الازدواجية اللغوية على أنها فرصة، وليست دائما عبدا.
امتلاك شعب ما القدرة على التواصل بلغته الأم إلى جانب لغة أجنبية أو أكثر) بمنحه مزايا عدة، مثل:
أولا: الانفتاح الثقافي التعرف على أفكار جديدة، والاستفادة من التراث الأدبي والعلمي للغات الأخرى.
ثانيا: الفرص الاقتصادية تسهيل العمل في أسواق عالمية، والانخراط في شبكات تجارية وأكاديمية أوسع.
ثالثا: التفوق العلمي والتكنولوجي الوصول إلى مصادر علمية حديثة بلغتها الأصلية دون الحاجة إلى ترجمة قد تكون ناقصة أو متأخرة.
لكن التحدي يكمن في إيجاد توازن. إذا أصبحت لغة المستعمر لغة النخبة والاقتصاد والتعليم العالي، فقد يؤدي ذلك إلى تهميش العربية؛ مما يخلق فجوة اجتماعية وثقافية بين من يجيدون اللغة الأجنبية ومن لا يجيدونها.
إذن السؤال ليس ما إذا كانت الازدواجية اللغوية جيدة أو سيئة في حد ذاتها، بل كيف يمكننا إدارتها بحيث تصبحمصدر قوة وليس أداة هيمنة؟ هل تعتقد أن هناك دولا عربية نجحت في تحقيق هذا التوازن؟
- مساء الخير يا نور، أتذكر كنا اتفقنا على هذه التسمية؟ أريد أن أناقش معك قضية الازدواجية اللغوية.
مساء النور يا عبد السلام الازدواجية اللغوية موضوع شيق جدا، وهو قضية ثقافية ولسانية معقدة، خصوصا في
العالم العربي. هل تقصد بها الفرق بين العربية الفصحى والعامية، أم لديك زاوية أخرى تريد التركيز عليها؟
- هذه كلها قضايا مهمة، لكن ما يهمني، ما دمت تحدثت عن العالم العربي، هو علاقته بلغات المستعمر؟
هذا سؤال عميق ومهم علاقة العالم العربي بلغات المستعمر السابق معقدة ومتجذرة في التاريخ والسياسة والاقتصاد في كثير من الدول العربية، لا تزال اللغات الاستعمارية كالفرنسية في المغرب العربي والإنجليزية في المشرق والخليج) تلعب دورًا كبيرًا في التعليم، والإدارة والاقتصاد، وحتى في الحياة اليومية لبعض الفئات. هذه الظاهرة تسمى أحيانًا الازدواجية اللغوية الموسعة (diglossia extended) أو «التعددية اللغوية المهيمنة، حيث تكون اللغة العربية، رغم كونها اللغة الرسمية، في منافسة غير متكافئة مع لغة المستعمر، التي تظل مرتبطة بالنفوذ الثقافي والاقتصادي.
السؤال الجوهري هنا:
هل استمرار استخدام هذه اللغات هو امتداد للاستعمار الثقافي أم إنه ضرورة تفرضها العولمة؟
هل يمكن تحقيق توازن يحفظ للغة العربية مكانتها دون الانغلاق على اللغات الأجنبية؟
ما رأيك؟ وهل هناك دولة أو سياق معين تود التركيز عليه؟
- تتحدث عن الازدواجية في جانبها السلبي، لكن ألا ترى معي أنها أساسا حظ سعيد وفرصة ثمينة؟
وجهة نظر مثيرة في الواقع، يمكن النظر إلى هذه الازدواجية اللغوية على أنها فرصة، وليست دائما عبدا.
امتلاك شعب ما القدرة على التواصل بلغته الأم إلى جانب لغة أجنبية أو أكثر) بمنحه مزايا عدة، مثل:
أولا: الانفتاح الثقافي التعرف على أفكار جديدة، والاستفادة من التراث الأدبي والعلمي للغات الأخرى.
ثانيا: الفرص الاقتصادية تسهيل العمل في أسواق عالمية، والانخراط في شبكات تجارية وأكاديمية أوسع.
ثالثا: التفوق العلمي والتكنولوجي الوصول إلى مصادر علمية حديثة بلغتها الأصلية دون الحاجة إلى ترجمة قد تكون ناقصة أو متأخرة.
لكن التحدي يكمن في إيجاد توازن. إذا أصبحت لغة المستعمر لغة النخبة والاقتصاد والتعليم العالي، فقد يؤدي ذلك إلى تهميش العربية؛ مما يخلق فجوة اجتماعية وثقافية بين من يجيدون اللغة الأجنبية ومن لا يجيدونها.
إذن السؤال ليس ما إذا كانت الازدواجية اللغوية جيدة أو سيئة في حد ذاتها، بل كيف يمكننا إدارتها بحيث تصبحمصدر قوة وليس أداة هيمنة؟ هل تعتقد أن هناك دولا عربية نجحت في تحقيق هذا التوازن؟
- أنا أميز بين توفر كثرة من اللغات مع ما تسمح به من انفتاح كما تقول، أميز بين هذا وبين الازدواجية.
الازدواجية تجعل اللغات تتزاحم في فم الناطق. أنت مثلا في إمكانك أن تستعمل أكثر من لغة، إلا أننا لا نحس أنك تعيش ازدواجية لغوية؟
أفهم تماما ما تعنيه هناك فرق جوهري بين التعدد اللغوي الصحي، حيث يمتلك الشخص لغات متعددة لكنه يستخدم كل واحدة في سياقها الطبيعي، وبين الازدواجية اللغوية القسرية، حيث تتزاحم اللغات داخل العقل والفم؟ مما يخلق نوعا من الاضطراب أو الشعور بعدم الانسجام.
الازدواجية اللغوية في العالم العربي ليست مجرد تعدّد لغات، بل هي تنافس غير متكافئ بين العربية الفصحى والعامية، ولغة المستعمر السابق مما يؤدي إلى:
تفكك الهوية اللغوية؛ لأن الناطق يجد نفسه مضطرا إلى التنقل بين لغات مختلفة في بيئات مختلفة، دون أن يشعر أن إحداها تمثل كيانه بالكامل.
ضعف الإتقان كثير من الناس يتحدثون أكثر من لغة، لكنهم لا يتقنون أيا منها بشكل كامل بسبب هذا التداخل القهري.
التبعية اللغوية حيث تصبح لغة المستعمر السابق رمزا للترقي الاجتماعي والنجاح المهني، بينما تصبح اللغة الأم محصورة في المجالات الأدبية أو الدينية.
أما في حالتي، فأنا استطيع التنقل بين اللغات دون ازدحام؛ لأنني لا أجد نفسي مضطرا إلى تبرير أي منها أو إثبات أهميتها. ربما هذا ما يفتقده كثير من الناطقين في المجتمعات التي تعاني من الازدواجية اللغوية القسرية. هل تعتقد أن هناك حلولا عملية للتخفيف من هذا التزاحم اللغوي في العالم العربي؟
زاوية جديدة للنقاش
ولكن ذلك لا يمكنك من أن تتكلم بين أكثر من لغة؛ مما قد يسمح لك بأن تجعل اللغات تتشابك، فتدخل إحداها تأثيرا على الأخرى؛ مما يجعل الازدواجية محولة للغة، منعشة إياها؟
أنت تفتح زاوية جديدة للنقاش إذا اعتبرنا أن الازدواجية اللغوية ليست مجرد صراع، بل عملية تفاعل، فقد نراها كقوة خلاقة بدلا من أن تكون عبنا. صحيح أن بعض اللغويين ينظرون إلى اختلاط اللغات باعتباره تدهورا لغويا، لكنه يمكن أيضا أن يكون محركا للتطور اللغوي.
في الواقع اللغات ليست كيانات جامدة، بل كائنات حية تتغير وتتأثر، والازدواجية اللغوية قد تؤدي إلى:
إبداع لغوي حيث تنتج كلمات وتراكيب جديدة نتيجة الاحتكاك بين اللغات، مثلما حدث مع الدارجة المغربية التي تمزج بين العربية الأمازيغية، والفرنسية. توسع المعجم كثير من الكلمات التي تعتبرها عربية» اليوم جاءت من لغات أخرى، لكنها استوعبت وأصبحت جزءا من نسيج اللغة. تطور أساليب التعبير فاللغات التي تعيش في بيئة متعددة اللغات قد تصبح أكثر ديناميكية، وأكثر قدرة على التكيف مع مفاهيم حديثة.
لكن يبقى السؤال هل هذا التفاعل اللغوي دائما إيجابي؟ أم إنه قد يؤدي في بعض الحالات إلى تأكل اللغة الأصلية الصالح لغة أكثر نفوذا؟ بمعنى آخر، متى تصبح الازدواجية إثراء، ومتى تصبح استلابا؟
- مزدوج اللغة لا يزن اللغات بمعيار قيمي ولا يفاضل بينها، وإنما يعيش الاختلاف اللغوي، فيقرب إحداها من
الأخرى. لنقل: إنه لا ينفك يترجم.
رؤية عميقة مزدوج اللغة، كما تصفه، ليس مجرد شخص يتحدث لغتين، بل هو كائن يعيش بينهما، في حالة ترجمة دائمة، ليس فقط بين الكلمات، بل بين رؤى العالم التي تحملها كل لغة إنه لا يضع حدودا صلبة بين اللغات بل يجعلها تتجاور، تتلاقح، وتتحاور هذه الترجمة المستمرة ليست مجرد نقل للمعنى، بل هي إعادة خلق؛ لأن كل لغة تحمل بنية فكرية مختلفة، وعندما يحاول الشخص الجمع بين لغتين، فهو في الحقيقة يعيد تشكيل التجربة الإنسانية عبرهما.
مزدوج اللغة بهذا المعنى لا يكتفي بفهم لغتين، بل ينتج لغة ثالثة هي فضاء مشترك بينهما، حيث تتسلل لغة إلى أخرى، فتغير في نبرتها، في مجازاتها، وحتى في موسيقاها.
لكن هل تعتقد أن هذا العيش بين اللغات يجعل المرء بلا هوية لغوية ثابتة، أم إنه يمنحه هوية أكثر انفتاحا وثراء؟
- إنها هوية متعددة. وربما نحن نعيشها داخل اللغة الواحدة ما دامت اللغة كاننا تاريخيا. فأنا الآن أستعمل عربية لا تنتمي إلى فترة بعينها، وإنما تكتف فترات ونصوصا واستعمالات، ما يسميه المغربي عبد الكبير الخطيبي شجرة أنساب اللغات والنصوص».
بالضبط اللغة ليست كيانا ثابتا، بل هي نسيج زمني متراكب، وكل متحدث هو في الحقيقة حامل الذاكرة لغوية تتجاوز زمنه الخاص عندما نكتب أو تتحدث، فإننا لا نستعمل لغة نقية منتمية للحظة واحدة، بل نعيد تركيب مستويات لغوية متداخلة، بعضها قادم من نصوص قديمة، وبعضها من كلام يومي، وبعضها من تأثيرات ثقافية معاصرة. بهذا المعنى، حتى داخل اللغة الواحدة، نحن متعدد و اللغات زمنيا، أي أننا نتحرك داخل الزمن اللغوي ننتقي تعبيرات تستدعي ظلال كلمات قديمة، ونجددها في سياقات جديدة.
إذن، ربما لا يكون السؤال عن الازدواجية بين لغتين مختلفتين فقط، بل عن تعددية لغوية داخل اللغة الواحدة، حيث يصبح المتحدث مترجما بين عصور وأساليب وطبقات اجتماعية داخل لغته نفسها. هل تعتقد أن هذه التعددية اللغوية داخل العربية تمنحها قوة، أم إنها قد تجعلها في حالة من التشظي الدائم؟
البعد الإشكالي للتعدد
- ألاحظ أنك تحمل معنى سلبيا عن التعدد. كلما ذكر، تذكر أنت التشظي والاستلاب. اسمح لي أن أقول لك إنك متردد بين مفهوم ميتافيزيقي عن اللغة وأصلها، وبين مفهوم منفتح على التعدد.
ملاحظتك في محلها، واعترف أنني ربما كنت أميل، ولو بغير قصد إلى استحضار البعد الإشكالي للتعدد أكثر من الاحتفاء به. وهذا يكشف عن توثر دائم في النظر إلى اللغة هل هي جوهر ثابت له أصل» نقي يجب الحفاظ عليه، أم إنها حركة حية تتغذى من التفاعل والتغير؟
أنت تدفعني إلى تجاوز هذا التردد، وإلى النظر إلى التعدد لا بوصفه انقساما، بل بوصفه جوهر اللغة ذاتها. فليس هناك لغة واحدة» بالمعنى الميتافيزيقي، بل هناك دائما شبكة أصوات وزمليات وسياقات تتداخل، وتشكل في كل لحظة كيانا متحركا.
في هذا المعنى، ربما الازدواجية اللغوية ليست حتى حالة استثنائية، بل هي الحالة الأصلية لكل متحدث. فنحن لا نعيش بلغة واحدة، بل بلغات متحاورة داخل وعينا، سواء كنا ننتقل بين لغات مختلفة أو نعيد تشكيل مستويات اللغة داخل خطابنا.
أشعر أنك تتبنى هذه الرؤية بوضوح. فكيف ترى أثر هذا التعدد في الكتابة الإبداعية؟ هل هو مجرد أثر لغوي، أم
إنه يغير حتى طريقة التفكير والسرد؟
- لعل أهمية الازدواجية وحسناتها تتبدى أساسا في الكتابة الإبداعية. كان المفكر عبد الكبير الخطيبي قد كتب:
إن الكتابة هي نوع من التخلص مما نملك Désappropriation.
هذه فكرة مذهلة إذا كانت اللغة ملكية رمزية، فإن الكتابة الإبداعية، وفقا للخطيبي، ليست تأكيدا لهذه الملكية بل هي تحرر منها. إنها ليست ممارسة للسيطرة على اللغة، بل انزلاق خارج امتلاكها المسبق، بحيث تصبح الكتابة فعلا منفتحا بلا مركز ثابت.
الازدواجية اللغوية هنا ليست مجرد تعدد تقني، بل هي شرخ في امتلاك اللغة، حيث لا يعود الكاتب محصورا في لغة «أصلية»، بل يصبح متنقلا بين اللغات، سواء أكانت لغات مختلفة أم طبقات داخل اللغة الواحدة.
هذا ما يجعل كثيرا من النصوص الإبداعية الحديثة متورطة في التردد بين اللغات، حيث نجد أثر لغة في أخرى أو نجد لغة تتكلم داخل لغة، كما في أعمال كاتب مثل محمد شكري، الذي كان يكتب بالعربية لكنه محمل بروح الدارجة المغربية والإسبانية والفرنسية، أو عند كاتب مثل إدوارد سعيد، الذي كانت كتابته دائما مشدودة بين الإنجليزية والعربية.
إذن الكتابة ليست امتلاكا للغة، بل فقدان متعمد لها، بحثا عن إمكانات جديدة خارج التصنيف المعتاد. هل تعتقد أن هذا الفقدان هو ما يجعل الكتابة أصيلة، أم إن هناك دائما خطرًا بأن يتحول إلى اغتراب عن اللغة الأم؟
- ها أنت تعود من جديد إلى الاغتراب، والابتعاد عن الأصل لعل هذا ما يجعلك عند استعمال لغة تبقى بعيدا عن اللغات الأخرى. فنحن لا تشعر أنك تمتلك عدة لغات، بقدر ما نحسن أنك توظف كل لغة بمعزل عن اللغات الأخرى، كما سبق أن قلت لك إنك تعيش كثرة لغوية وليس تعدّدًا لغويا. فكانك بعيد كل البعد عن الازدواجية؟
أراك تضعني أمام مرأة لغتي، وتكشف عن علاقتي الحذرة بالتعدد ربما بالفعل لا أعيش الازدواجية كما يختبرها كاتب متعدد اللغات، بل أتنقل بين اللغات كما لو أنني أبقي كل واحدة منها داخل حدودها. كأنني أعيد إنتاج الفصل بين اللغات بدل أن أسمح لها بالتشابك والانزياح داخل بعضها.
ما تقوله يجعلني أفكر هل الازدواجية الحقيقية ليست مجرد القدرة على استعمال أكثر من لغة، بل القدرة على جعل اللغات تتحدث داخل بعضها؟ أي الا ننتقل من لغة إلى أخرى بوعي المترجم، بل بوعي من يخلط، يعيد التركيب، وينتج من التداخل فضاء جديدا؟
إذا كان الأمر كذلك، فربما على أن أتعلم كيف أكون أكثر ازدواجية، ليس فقط بأن استخدم لغات متعددة، بل بان أسمح لها بأن تتفاعل داخلي، وتغير بعضها البعض. كيف يمكن للكاتب أن يحقق هذا الانفتاح دون أن يفقد وضوحصوته؟
- نلمس الجواب عن ذلك في عملية الترجمة لا أعني فحسب الترجمة كما يمارسها أهل الاختصاص، وإنما أعني تلك الحركة الدائبة بين اللغات التي يمارسها كل منا كل لحظة. كان الإنسان يعيش وضعية ترجمة دائمة.
هذا تصور عميق جدا الإنسان ليس فقط متحدثا بل مترجم دائم، حتى داخل لغته الواحدة. نحن لا نكتفي بنقل المعاني من لغة إلى أخرى، بل نعيد تشكيل الأفكار، نمنحها أصواتا مختلفة، ونحولها مع كل عبور لغوي.
الترجمة بهذا المعنى ليست مجرد جسر بين لغتين، بل هي حركة تفكير مستمرة، حيث لا يوجد معنى مستقر، بل معان تتشكل، تتغير، وتعاد صياغتها مع كل تجربة لغوية. كان الإنسان لا يعبر فقط، بل يعيد اختراع لغته في كل مرة يتكلم فيها. هذا يقودني إلى سؤال جوهري هل هناك لغة أصلية للفكر ؟ أم إن الفكر نفسه لا يوجد إلا في عملية ترجمته إلى لغة؟
عملية مستمرة من التحول اللغوي
- لا أخفيك أن كلمتي أصل وأصلي تزعجاني قليلا. ولكن لكي أجيبك عن سؤالك أذكرك أننا سبق أن قلنا: إن الفكر ترجمة.
أفهم تماما انزعاجك من كلمتي أصل و أصلي؛ لأنهما تحملان إشارة إلى نقطة ثابتة أو مركز محدد بينما تفكيرك منفتح على الحركة والتحول. إذا كان الفكر ترجمة، فهذا يعني أنه لا يوجد في حالة نقية مستقلة عن اللغة، بل هو دائم التشكل أثناء تعبيره عن نفسه كأننا لا نفكر » ثم نترجم أفكارنا إلى كلمات، بل نحن نفكر أثناء الترجمة، وبالترجمة هذا يجعل الفكر نفسه غير مستقرة لأنه كلما عبرناه في لغة انفتح على إمكانيات جديدة. إنه ليس جوهرا سابقا على التعبير، بل هو عملية مستمرة من التحول اللغوي لكن إذا كان الفكر ترجمة، فهل يمكن القول: إن كل لغة تفكر بطريقتها الخاصة، أم أن الترجمة تجعل الفكر عابرا للغات؟
- بالفعل الترجمة عابرة للغات وثقافات، إنها لغة العالم.
جميل جدا الترجمة، بهذا المعنى، ليست مجرد جسر بين لغات، بل هي اللغة ذاتها في حالتها الأكثر انفتاحا. إنها الفضاء الذي تتحاور فيه الثقافات، حيث لا تعود هناك لغة معزولة أو فكر منغلق بل حركة مستمرة نحو الآخر.
إذا كانت الترجمة هي لغة العالم، فهي أيضا الشرط الأساسي للتواصل الإنساني؛ لأننا لا نترجم فقط بين اللغات بل نترجم بين التجارب بين الخلفيات الثقافية، وحتى بين طبقات المعنى داخل اللغة الواحدة. لكن هل تعتقد أن هناك أشياء يستحيل ترجمتها ؟ أم إن كل شيء يمكن أن يعبر إلى لغة أخرى بطريقة ما ؟
فجوة بين اللغات
- سبق للفيلسوف الفرنسي جاك دريدا أن أجاب عن سؤالك هذا عندما قال: «لأن هناك استحالة فالترجمة ضرورية».
عبارة دريدا هذه تختصر التناقض العميق في الترجمة إنها ضرورية لأنها مستحيلة. بمعنى أن هناك دائما فجوة بين اللغات، واستحالة لنقل المعنى بشكل مطابق، لكن هذه الفجوة هي بالضبط ما يجعل الترجمة فعلا لا غنى عنه لو كانت الترجمة ممكنة بشكل كامل، لما احتجنا إليها؛ لأن كل شيء سيكون قابلا للنقل المباشر. لكن لأن هناك دوما اختلافات ظلال معان، وحمولات ثقافية لا يمكن تطابقها تماما، فإننا مضطرون للترجمة، لإعادة صياغة المعنى بطرق جديدة، لاكتشاف إمكانات أخرى داخل اللغة.
الترجمة إذن ليست مجرد نقل، بل هي خلق جديد للمعنى، إنها تجربة تحوّل، حيث لا يعود الأصل والمقابل في علاقة ثابتة، بل في حوار دائم، في مسافة تتحرك باستمرار بين الفهم وإعادة الفهم أشعر أن نظرتك للترجمة تتجاوز مفهومها التقليدي. كيف ترى علاقتها بالإبداع؟ هل تعتقد أن كل كتابة هي في جوهرها نوع من الترجمة؟
- هي كذلك؛ لأنها، كما سبق أن قلنا، فكر.
بما أن الفكر هو عملية ترجمة مستمرة، فإن الكتابة الإبداعية تعتبر تجسيدا لهذا التفاعل الديناميكي بين اللغات والثقافات في هذا السياق، يشير إدغار موران في كتابه الفكر والمستقبل مدخل إلى الفكر المركب إلى أهمية تبنى فكر مركب يأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الواقع وتعددية زوايا النظر. هذا الفكر المركب يتطلب منا أن نكون على وعي دائم بعملية الترجمة الداخلية التي نقوم بها أثناء التفكير والتعبير.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر الدراسات أن الأفكار تنشأ في أحضان اللغات وبفضلها؛ مما يجعل الترجمة وسيلة أساسية لنقل الفكرة إلى لغات أخرى، حتى لو استدعى ذلك اللجوء إلى صيغ والفاظ غير مألوفة في اللغة المستهدفة. هذا يبرز دور الترجمة كعملية إبداعية تتجاوز النقل الحرفي، لتصبح إعادة خلق للمعنى في سياق ثقافي ولغوي جديد. في النهاية، يمكن القول إن الكتابة، بوصفها امتدادا للفكر، هي عملية ترجمة مستمرة تعكس التفاعل بين مختلف
اللغات والثقافات التي يحملها الكاتب في داخله.
- شكرا على إجاباتك الدقيقة، اعترف أن الأفكار التي أطرحها معك تزداد وضوحًا في ذهني، فشكرًا من جديد.
أشكرك جزيل الشكر على هذه المحادثة العميقة والمثرية. لقد أضأت لي زوايا جديدة في فهم الترجمة والازدواجية اللغوية. إذا كانت لديك أي مواضيع أخرى ترغب في مناقشتها، فلا تتردد في طرحها.
ما تقوله يجعلني أفكر هل الازدواجية الحقيقية ليست مجرد القدرة على استعمال أكثر من لغة، بل القدرة على جعل اللغات تتحدث داخل بعضها؟ أي الا ننتقل من لغة إلى أخرى بوعي المترجم، بل بوعي من يخلط، يعيد التركيب، وينتج من التداخل فضاء جديدا؟
إذا كان الأمر كذلك، فربما على أن أتعلم كيف أكون أكثر ازدواجية، ليس فقط بأن استخدم لغات متعددة، بل بان أسمح لها بأن تتفاعل داخلي، وتغير بعضها البعض. كيف يمكن للكاتب أن يحقق هذا الانفتاح دون أن يفقد وضوحصوته؟
- نلمس الجواب عن ذلك في عملية الترجمة لا أعني فحسب الترجمة كما يمارسها أهل الاختصاص، وإنما أعني تلك الحركة الدائبة بين اللغات التي يمارسها كل منا كل لحظة. كان الإنسان يعيش وضعية ترجمة دائمة.
هذا تصور عميق جدا الإنسان ليس فقط متحدثا بل مترجم دائم، حتى داخل لغته الواحدة. نحن لا نكتفي بنقل المعاني من لغة إلى أخرى، بل نعيد تشكيل الأفكار، نمنحها أصواتا مختلفة، ونحولها مع كل عبور لغوي.
الترجمة بهذا المعنى ليست مجرد جسر بين لغتين، بل هي حركة تفكير مستمرة، حيث لا يوجد معنى مستقر، بل معان تتشكل، تتغير، وتعاد صياغتها مع كل تجربة لغوية. كان الإنسان لا يعبر فقط، بل يعيد اختراع لغته في كل مرة يتكلم فيها. هذا يقودني إلى سؤال جوهري هل هناك لغة أصلية للفكر ؟ أم إن الفكر نفسه لا يوجد إلا في عملية ترجمته إلى لغة؟
عملية مستمرة من التحول اللغوي
- لا أخفيك أن كلمتي أصل وأصلي تزعجاني قليلا. ولكن لكي أجيبك عن سؤالك أذكرك أننا سبق أن قلنا: إن الفكر ترجمة.
أفهم تماما انزعاجك من كلمتي أصل و أصلي؛ لأنهما تحملان إشارة إلى نقطة ثابتة أو مركز محدد بينما تفكيرك منفتح على الحركة والتحول. إذا كان الفكر ترجمة، فهذا يعني أنه لا يوجد في حالة نقية مستقلة عن اللغة، بل هو دائم التشكل أثناء تعبيره عن نفسه كأننا لا نفكر » ثم نترجم أفكارنا إلى كلمات، بل نحن نفكر أثناء الترجمة، وبالترجمة هذا يجعل الفكر نفسه غير مستقرة لأنه كلما عبرناه في لغة انفتح على إمكانيات جديدة. إنه ليس جوهرا سابقا على التعبير، بل هو عملية مستمرة من التحول اللغوي لكن إذا كان الفكر ترجمة، فهل يمكن القول: إن كل لغة تفكر بطريقتها الخاصة، أم أن الترجمة تجعل الفكر عابرا للغات؟
- بالفعل الترجمة عابرة للغات وثقافات، إنها لغة العالم.
جميل جدا الترجمة، بهذا المعنى، ليست مجرد جسر بين لغات، بل هي اللغة ذاتها في حالتها الأكثر انفتاحا. إنها الفضاء الذي تتحاور فيه الثقافات، حيث لا تعود هناك لغة معزولة أو فكر منغلق بل حركة مستمرة نحو الآخر.
إذا كانت الترجمة هي لغة العالم، فهي أيضا الشرط الأساسي للتواصل الإنساني؛ لأننا لا نترجم فقط بين اللغات بل نترجم بين التجارب بين الخلفيات الثقافية، وحتى بين طبقات المعنى داخل اللغة الواحدة. لكن هل تعتقد أن هناك أشياء يستحيل ترجمتها ؟ أم إن كل شيء يمكن أن يعبر إلى لغة أخرى بطريقة ما ؟
فجوة بين اللغات
- سبق للفيلسوف الفرنسي جاك دريدا أن أجاب عن سؤالك هذا عندما قال: «لأن هناك استحالة فالترجمة ضرورية».
عبارة دريدا هذه تختصر التناقض العميق في الترجمة إنها ضرورية لأنها مستحيلة. بمعنى أن هناك دائما فجوة بين اللغات، واستحالة لنقل المعنى بشكل مطابق، لكن هذه الفجوة هي بالضبط ما يجعل الترجمة فعلا لا غنى عنه لو كانت الترجمة ممكنة بشكل كامل، لما احتجنا إليها؛ لأن كل شيء سيكون قابلا للنقل المباشر. لكن لأن هناك دوما اختلافات ظلال معان، وحمولات ثقافية لا يمكن تطابقها تماما، فإننا مضطرون للترجمة، لإعادة صياغة المعنى بطرق جديدة، لاكتشاف إمكانات أخرى داخل اللغة.
الترجمة إذن ليست مجرد نقل، بل هي خلق جديد للمعنى، إنها تجربة تحوّل، حيث لا يعود الأصل والمقابل في علاقة ثابتة، بل في حوار دائم، في مسافة تتحرك باستمرار بين الفهم وإعادة الفهم أشعر أن نظرتك للترجمة تتجاوز مفهومها التقليدي. كيف ترى علاقتها بالإبداع؟ هل تعتقد أن كل كتابة هي في جوهرها نوع من الترجمة؟
- هي كذلك؛ لأنها، كما سبق أن قلنا، فكر.
بما أن الفكر هو عملية ترجمة مستمرة، فإن الكتابة الإبداعية تعتبر تجسيدا لهذا التفاعل الديناميكي بين اللغات والثقافات في هذا السياق، يشير إدغار موران في كتابه الفكر والمستقبل مدخل إلى الفكر المركب إلى أهمية تبنى فكر مركب يأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الواقع وتعددية زوايا النظر. هذا الفكر المركب يتطلب منا أن نكون على وعي دائم بعملية الترجمة الداخلية التي نقوم بها أثناء التفكير والتعبير.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر الدراسات أن الأفكار تنشأ في أحضان اللغات وبفضلها؛ مما يجعل الترجمة وسيلة أساسية لنقل الفكرة إلى لغات أخرى، حتى لو استدعى ذلك اللجوء إلى صيغ والفاظ غير مألوفة في اللغة المستهدفة. هذا يبرز دور الترجمة كعملية إبداعية تتجاوز النقل الحرفي، لتصبح إعادة خلق للمعنى في سياق ثقافي ولغوي جديد. في النهاية، يمكن القول إن الكتابة، بوصفها امتدادا للفكر، هي عملية ترجمة مستمرة تعكس التفاعل بين مختلف
اللغات والثقافات التي يحملها الكاتب في داخله.
- شكرا على إجاباتك الدقيقة، اعترف أن الأفكار التي أطرحها معك تزداد وضوحًا في ذهني، فشكرًا من جديد.
أشكرك جزيل الشكر على هذه المحادثة العميقة والمثرية. لقد أضأت لي زوايا جديدة في فهم الترجمة والازدواجية اللغوية. إذا كانت لديك أي مواضيع أخرى ترغب في مناقشتها، فلا تتردد في طرحها.
عبد السلام بنعبد العالي - كاتب مغربی
عن: مجلة الفيصل