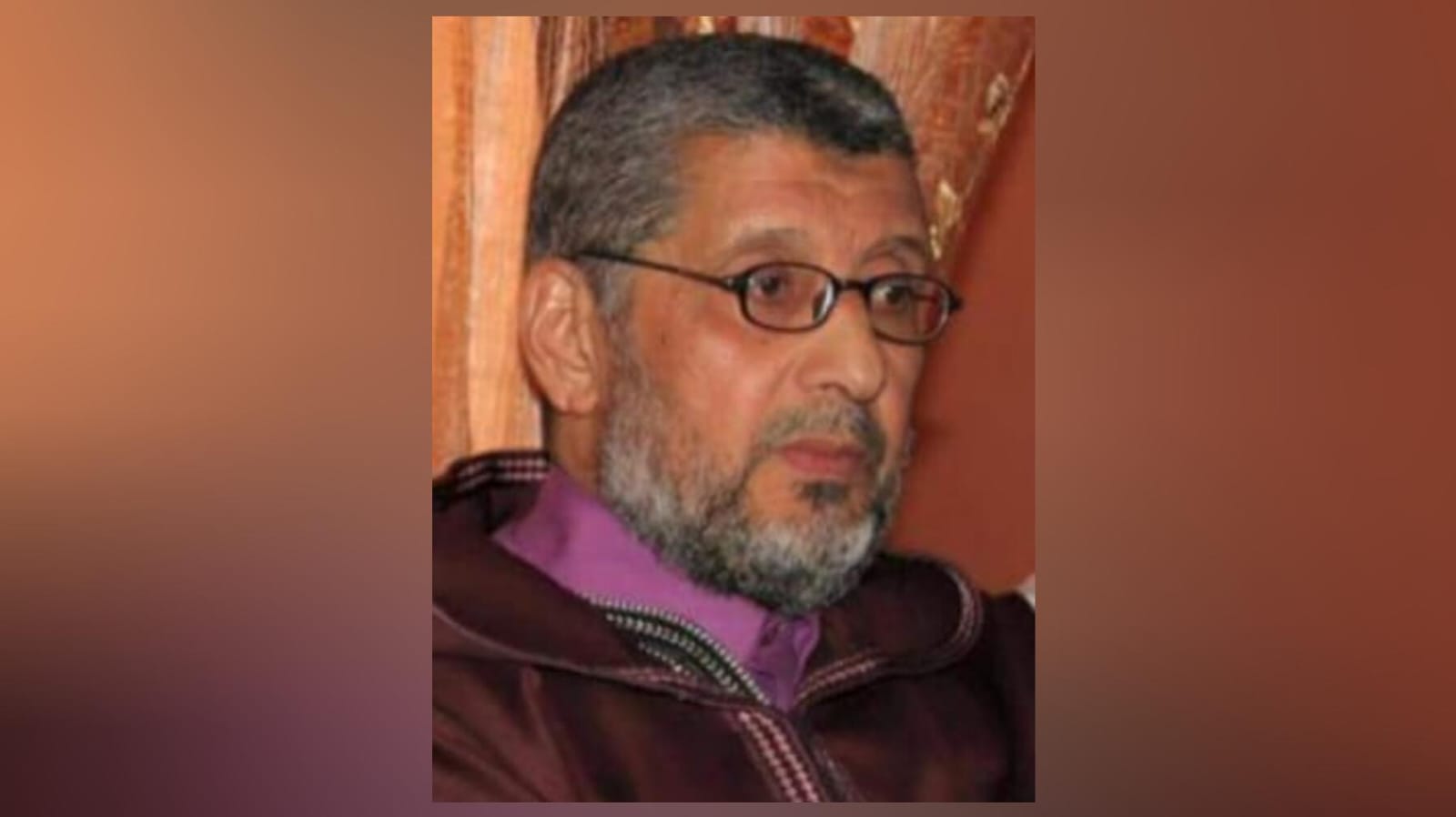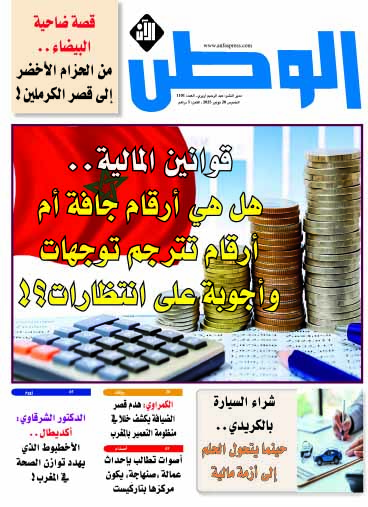**تحولات الخطاب في الصحراء المغربية:
**الأسئلة العميقة خلف السجال، والحاجة إلى رؤية هادئة لهندسة الحكم الذاتي
تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة منذ أسابيع نقاشات محتدمة، تتوزع بين بيانات، تصريحات، تحليلات، ردود وهواجس معلنة وأخرى مضمرَة. ورغم ما يبدو من حدّة في الخطاب، فإن القراءة الهادئة تكشف أن ما يجري ليس صراعاً ولا أزمة، بل هو عودة مؤجّلة لأسئلة بنيوية كانت قد طُرحت منذ بداية مسار الحكم الذاتي، وظلّت تنتظر اللحظة المناسبة للظهور من جديد.
هذه الأسئلة ليست طارئة، ولا هي نتاج ظرف سياسي عابر، بل تعبّر عن انتقال طبيعي من مرحلة «إعلان المبادئ» إلى مرحلة «هندسة النموذج». وكلما اقترب المغرب من لحظة تنزيل الحكم الذاتي، بصيغته الموسعة والواقعية، يصبح بديهياً أن تتجدد النقاشات حول قضاياه الجوهرية: من يمثل من؟ ما هو الامتداد الترابي؟ كيف تُبنى التمثيلية؟ وكيف تُصاغ العلاقة بين الوحدة الوطنية والتعدد الاجتماعي؟
وهذا كلّه، مهما بدا متوتراً، هو علامة صحة لا علامة أزمة، لأنه يعكس يقظة مجتمع يعيش منعطفاً تاريخياً.
أولاً: لماذا تعود الأسئلة الآن؟
لأن المغرب يوجد في لحظة انتقالية دقيقة، بين:
• مرحلة المقترح (2007)،
• ومرحلة الهندسة (2025).
وكل انتقال من صيغة سياسية عامة إلى نموذج مؤسساتي تفصيلي يعيد ترتيب الأسئلة المؤجلة. فمن الطبيعي، بل من اللازم، أن تتفجّر اليوم النقاشات التي طُرحت سنة 2005 و2006 خلال مشاورات الكوركاس، ثم هدأت تحت وقع السياق الدولي والسياسي.
هذه الأسئلة تعود اليوم لأن البلد مقبل على صياغة تفاصيل الحكم الذاتي: صلاحياته، تمثيليته، هندسته الترابية، آليات تدبيره، وضماناته.
ثانياً: ما طبيعة الأسئلة التي تطفو على السطح؟
تدور أغلب النقاشات حول ثلاث دوائر مترابطة:
1. الهندسة السكانية
ويتعلق الأمر بتساؤلات مشروعة حول:
• حدود الفئة المعنية بالحكم الذاتي،
• موقع الذين لا ينتمون تاريخياً إلى البنية القبلية،
• مصير الأجيال الجديدة من أبناء المدن،
• موقع العائدين من تندوف،
• وكيفية استيعاب جميع الساكنة دون تمييز.
هذه أسئلة تخصّ تدبير التنوع، لا «تحديد الهوية».
2. الهندسة التمثيلية
السؤال هنا ليس: «من يملك الشرعية؟»
بل: كيف نضمن تمثيلية عادلة ومتوازنة؟
أي تمثيلية:
• تحترم الشرعية العرفية،
• وتدمج الشرعية الانتخابية،
• وتستوعب الفئات غير الممثلة قبلياً،
• دون أن تتحول أي شرعية إلى احتكار.
3. الهندسة الترابية
ويتعلق النقاش بمدى انتماء طرفاية والطنطان وواد نون إلى نموذج الحكم الذاتي، من حيث:
• الامتداد الاجتماعي والثقافي،
• الانسجام الجهوي،
• والحدود الإدارية الموروثة عن مرحلة الاستعمار.
ثالثاً: السؤال الترابي… بين «حدود الاستعمار» و«حدود الانتماء»
الاختلاف حول وضعية طرفاية والطنطان وواد نون لا يرتبط بمصالح أشخاص أو موقع جهات أو وزن قبائل، بل يرتبط بثنائية أعمق:
• الحدود التي تعتمدها الأمم المتحدة في توصيف الإقليم،
• والامتداد الحسّاني–البيضاني الذي يتجاوز تلك الحدود تاريخياً ومجتمعياً.
ومن هنا يظهر القلق المشروع لدى بعض الفاعلين:
هل يؤدي التقيد الحرفي بالإطار الأممي إلى تقليص المجال الثقافي والتاريخي؟
هذا سؤال مشروع، لكنه لا يعني تعديل الإطار الأممي، بل تفكيرًا أوسع في الهندسة الترابية.
رابعاً: «الحل المركّب» كخيار عقلاني للهندسة الترابية
الحل المركّب يقوم على الجمع بين مستويين:
1. مستوى أممي واضح
يُعرض فيه الحكم الذاتي داخل الإقليم كما هو معرّف في القرارات الدولية، دون تعديل أو توسّع.
2. مستوى وطني سيادي
تتمكن فيه الدولة من منح الأقاليم المجاورة (طرفاية، الطنطان، وادي نون) صلاحيات موازية ضمن الجهوية المتقدمة، بما يضمن انسجام المجال الحساني دون إدراج تلك المناطق في التفاوض الأممي.
بهذا الأسلوب:
• لا يُمسّ الإطار الأممي،
• ولا يُقصى الامتداد الحسّاني،
• ولا يقع المغرب في فخ «توسيع تراب النزاع»،
• مع الحفاظ على حرية المملكة في تدبير ترابها الوطني.
خامساً: كيف نفهم الهواجس المتداولة؟
الهواجس اليوم ليست رفضاً للحكم الذاتي، ولا تشكيكاً في المسار الوطني، بل هي تعبيرات عن أربعة مخاوف رئيسية:
1. الخوف من اختزال الامتداد الحسّاني في الإقليم الأممي.
2. الخوف من تغييب فئات واسعة غير ممثلة قبلياً.
3. الخوف من أن تتحول التمثيلية العرفية إلى صيغة مغلقة.
4. الخوف من صياغة نموذج نهائي دون إشراك محلي.
سادساً:ما الذي تحتاجه هذه المرحلة؟!
لم يعد النقاش الوطني اليوم في مرحلة “تحديد النوايا”، بل هو في قلب مرحلة تفصيل النموذج الموسّع للحكم الذاتي الذي تستعد المملكة لاقتراحه بصيغته المتقدمة. غير أن الانتقال من الفكرة العامة إلى البناء المؤسساتي التفصيلي يتطلب توضيح المرجعيات الكبرى التي تؤطر هذا التفصيل، وتقديمها للرأي العام المحلي والوطني بما يطمئن الساكنة، ويزيل الهواجس، ويحوّل النقاش من سجال متوتر إلى حوار هادئ حول الأسئلة الحقيقية.
فالمرحلة ليست مرحلة «إخفاء التفاصيل»، بل مرحلة شرح الأسس التي سيُبنى عليها التفصيل، وفي مقدمتها:
• مبدأ السيادة الوطنية الكاملة،
• مبدأ التعدد داخل الوحدة،
• مبدأ الإنصاف في التمثيلية،
• مبدأ احترام الامتداد الثقافي الحساني–البيضاني،
• مبدأ الانسجام بين الإطار الأممي والسيادة الوطنية،
• ومبدأ التوازن بين الشرعية العرفية والشرعية الانتخابية،
مع التأكيد أن التمثيلية الانتخابية الديمقراطية تظل الإطار المؤسسي الأساسي والوحيد القادر على تمثيل مجموع الساكنة دون تمييز، بينما تأتي باقي مصادر الشرعية — العرفية، التاريخية، الاجتماعية — كرافد مكمّل يعزز الاستقرار ولا يحلّ مكان صوت المواطنين.
سابعاً: نحو نقاش أكثر هدوءاً… وأكثر نضجاً
إن النقاش الدائر اليوم لم يعد متعلقاً بـ«النزاع»، بل بـ«شكل الدولة المغربية في المستقبل».
الحكم الذاتي، بصيغته الموسعة، لا يعيد تشكيل مجال جغرافي فحسب، بل يعيد تشكيل مفهوم الدولة المغربية الحديثة:
دولة السيادة الموحدة، والتدبير المتقاسم، والهوية المركّبة، والوحدة في التنوع.
ولهذا، فإن النقاش الحالي – مهما بدا محتدّاً – هو علامة على الاستعداد لهذا التحول التاريخي.
خاتمة
الصحراء اليوم ليست ملفاً تفاوضياً فقط، بل هي مختبر وطني لإعادة التفكير في:
• المجال،
• التمثيلية،
• الهوية،
• التنمية،
• ووظائف الدولة.
وكل النقاشات الجارية — مهما تضاربت — ليست أزمة، بل مخاض ولادة نموذج جديد.
ومن مصلحة الجميع تحويل هذا النقاش من توتر إلى حوار، ومن سجال إلى تفكير، ومن ردود أفعال إلى بلورة رؤية مشتركة…
رؤية تجعل الحكم الذاتي مشروعاً جامعاً لا لفئة أو قبيلة، بل لمستقبل دولة مغربية قوية، موحّدة.