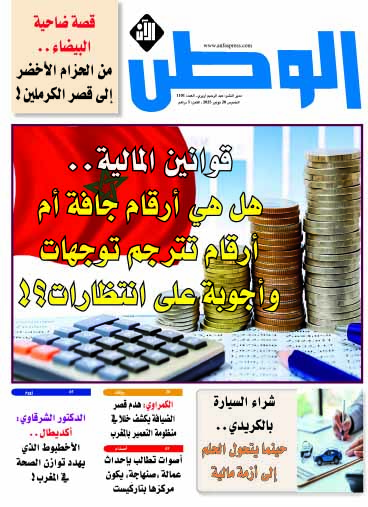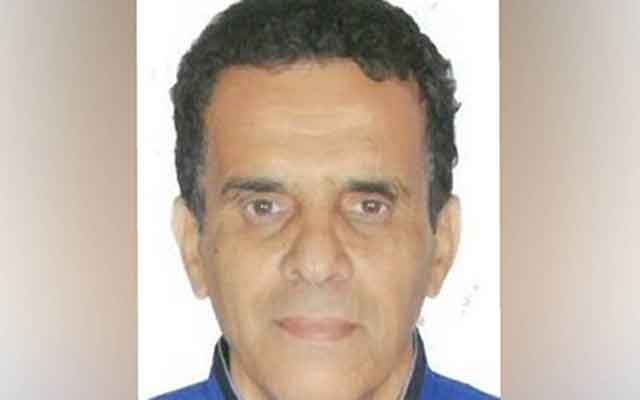من الهلال الخصيب إلى ضفاف النيل، يبدو أن هناك عملية تاريخية تتجه في الاتجاه المعاكس: ففي المكان الذي نشأت فيه أولى الدول والقوانين المكتوبة والإمبراطوريات المؤسسة، نشهد اليوم تجزئة غير مسبوقة. يستكشف هذا المقال كيف أن العراق وسوريا ومصر - الوريثة المباشرة للحضارات الأم - تمر بأزمة وجودية تثير تساؤلات حول مستقبلها والآليات التي أدت إلى إضعافها. بين الإرث التاريخي والتدخلات المعاصرة، ربما تكون هذه هي الفرصة الأخيرة لانبعاث هذه المهود للبشرية.
مقدمة: غروب الحضارات الأم
يمثل التفتت التدريجي للمراكز الكبرى للحضارة العربية الإسلامية المعاصرة إحدى المآسي الجيوسياسية الكبرى في القرن الحادي والعشرين. العراق وسوريا وربما مصر - الوريثة المباشرة لأقدم مراكز الحضارة الإنسانية - تمر بأزمة وجودية لا تطرح تساؤلات حول مستقبلها فحسب، بل أيضاً حول الآليات التاريخية التي أدت إلى إضعافها. يهدف هذا التحليل إلى تتبع العملية المعقدة لتفكك هذه الكيانات الحضارية، من خلال دراسة التفاعل بين العوامل الداخلية والديناميات الخارجية، وبين الإرث التاريخي والتدخلات المعاصرة.
العراق: مسار قوة تاريخية هشة
كيف أمكن لأرض ابتكرت الكتابة والقانون المكتوب وإدارة الدولة أن تغرق في فوضى طائفية؟ يبدو مصير العراق الحديث بمثابة مفارقة تاريخية قاسية، حيث يبدو أن كل مرحلة - من الانتداب البريطاني إلى الغزو الأمريكي في عام 2003 - قد قوضت بشكل منهجي أسس دولة عمرها آلاف السنين. نلقي نظرة على انهيار كان متوقعاً.
1.1 من بلاد ما بين النهرين إلى الدولة الحديثة
يجسد العراق المعاصر بمرارة ساخرة المصير المأساوي للحضارات الأم. مهد الكتابة والقانون المكتوب (قانون حمورابي) وأول أشكال التنظيم الحكومي، تمثل بلاد ما بين النهرين الأساس نفسه للحضارة المدنية. أصبحت بغداد، التي تأسست عام 762 في عهد الخليفة المنصور، تحت حكم العباسيين (من القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر) المركز الفكري والسياسي للعالم الإسلامي، حيث استضافت بيت الحكمة الذي كان يلتقي فيه العلماء المسلمون والمسيحيون واليهود.
بدأ الانحدار مع عدة صدمات متتالية: نهب بغداد على يد المغول في عام 1258، مما أدى إلى تدمير نظام الري في بلاد ما بين النهرين الذي يعود إلى آلاف السنين؛ الانضمام إلى الإمبراطورية العثمانية التي همشت المنطقة؛ وأخيراً الانتداب البريطاني الذي أنشأ في عام 1920 دولة مصطنعة تضم ثلاث ولايات عثمانية ذات سكان متنوعين.
1.2 عهد صدام حسين
سعى نظام صدام حسين البعثي (1979-2003) إلى بناء الوحدة الوطنية من خلال أساليب شمولية صارمة. معتمدًا بشكل أساسي على الأقلية السنية، رسّخ نظام عبادة الشخصية، وقمع المعارضة بعنف. استُهدف الأكراد بشكل خاص، كما رأينا في هجوم حلبجة بالغاز عام 1988، بينما عانى الشيعة من قمع شديد بعد انتفاضة عام 1991. هدفت سياسة السيطرة المطلقة هذه إلى الحفاظ على وحدة البلاد، لكنها رافقتها استقطاب عميق بين الطوائف ومناخ واسع النطاق من الخوف.
في الوقت نفسه، أدت طموحات صدام حسين العسكرية والصراعات الإقليمية إلى تفاقم هشاشة الدولة العراقية. استنزفت الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) ثم غزو الكويت عام 1990 الموارد الاقتصادية والبشرية للبلاد، بينما أدت العقوبات الدولية التي تلت ذلك إلى كارثة إنسانية حقيقية. وقد أدت كل هذه العوامل إلى إضعاف البنية الاجتماعية والسياسية في العراق بشكل دائم، مما مهد الطريق للأزمات وعدم الاستقرار الذي سيميز البلاد بعد عام 2003.
1.3 التدخل في عام 2003 وعواقبه
شكل الغزو الذي قاده تحالف دولي بقيادة أمريكية في عام 2003، تحت ذرائع زائفة بحيازة أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها أبدًا، نقطة تحول حاسمة في إضعاف الدولة العراقية وسقوط نظام صدام حسين. أدت سياسة السلطة المؤقتة للتحالف، بقيادة الحاكم بول بريمر، ولا سيما حل الجيش و” إزالة البعثية “، إلى خلق فراغ أمني وإداري كان له عواقب طويلة الأمد. فقد أصبح حوالي 400 ألف جندي وضابط عاطلين عن العمل، مما شكل خزانًا للتمرد المستقبلي.
أضفى الدستور الجديد لعام 2005 الطابع المؤسسي على النزعة الطائفية من خلال تنظيم السلطة وفقاً لنظام الحصص العرقية والدينية، مما قضى على أي إمكانية لظهور قومية عراقية متجاوزة للطائفية. وانزلق البلد إلى حرب أهلية (2006-2008) أسفرت عن مئات الآلاف من الضحايا ورسخت الانقسام الطائفي.
1.4 حقبة داعش
يمكن اعتبار تنظيم الدولة الإسلامية (2014-2017) ذروة مأساوية لزعزعة استقرار العراق. مستغلًا استياء السكان السنة المهمشين والضعف الهيكلي للدولة، نجح داعش في إقامة خلافة على ما يقرب من ثلث الأراضي العراقية. لم تقتصر استراتيجيته على الغزو العسكري، بل شملت أيضًا التدمير المنهجي للتراث التاريخي، مثل موقع نمرود ومتحف الموصل، في محاولة لمحو الماضي الجاهلي وفرض أيديولوجية متطرفة.
في حين هُزم التنظيم عسكريًا في نهاية المطاف بفضل الهجمات المشتركة للقوات العراقية والتحالف الدولي، إلا أن جذور صعوده لا تزال قائمة. إن الانقسامات الطائفية، والإقصاء السياسي للأقليات، وعدم الاستقرار المزمن للدولة، كلها عوامل مستمرة لا تزال تهدد استقرار البلاد، وتُذكرنا بأن الهزيمة العسكرية وحدها لا تكفي لحل المشاكل المتجذرة.
1.5 العراق اليوم : دولة شبح تحت الوصاية الأجنبية
يُصوّر العراق المعاصر اليوم كدولة ضعيفة ومختلة وظيفيًا إلى حد كبير. يُقوّض الفساد المستشري المؤسسات، بينما يُمارَس النفوذ الأجنبي، لا سيما النفوذ الإيراني، من خلال شبكة من الميليشيات الشيعية التي تؤثر بشدة على القرارات السياسية والأمنية. تحدّ هذه التبعية من السيادة الحقيقية للبلاد وتضعف قدرتها على ضمان حكم مستقر وفعال لجميع سكانها.
في الوقت نفسه، يُكافح النفط، أهمّ موارد البلاد الاقتصادية، لخدمة السكان. ولا تُوزّع عائدات هذا المورد الاستراتيجي بشكل كافٍ، مما يُفاقم التفاوتات الاجتماعية. علاوة على ذلك، لا تزال الانقسامات العرقية والدينية المحرك الرئيسي للحياة السياسية، مما يُشلّ أي محاولة لإعادة بناء وطني متماسك وتحقيق المصالحة بين الطوائف. يُظهر هذا الوضع صعوبة تعافي العراق من ماضٍ اتسم بالصراعات والديكتاتوريات والتدخل الأجنبي.
سوريا: من ملتقى الحضارات إلى دولة ممزقة
سوريا، التي كانت ملتقى الحضارات منذ العصور القديمة، تدفع اليوم ثمناً باهظاً لموقعها الجيوستراتيجي. ما كان في الماضي بوتقة للحضارات الفينيقية والهلنستية والأموية لم يعد سوى ساحة معركة تتصارع فيها القوى الإقليمية والدولية. يكشف تحليل انهيارها كيف أن استقرار الأسد الاستبدادي مهد الطريق لأكثر الصراعات بالوكالة دموية.
2.1 تراث يمتد لآلاف السنين
تتطابق سوريا الحالية تقريباً مع بلاد الشام التاريخية، وهي منطقة مفترق طرق استضافت على التوالي الحضارات الفينيقية والهلنستية والرومانية والبيزنطية والأموية (كانت دمشق عاصمة أول خلافة إسلامية). لطالما جعل موقعها الجغرافي منها مكاناً للتبادل والتمازج الثقافي.
مثل العراق، ولدت سوريا الحديثة من تقسيم استعماري فرنسي (1920) سعى إلى التقسيم من أجل الحكم بشكل أفضل من خلال إنشاء دول منفصلة (لبنان، دولة العلويين، الجزيرة) قبل توحيدها تحت الانتداب السوري. وقد كرر النظام البعثي، الذي وصل إلى السلطة في عام 1963، النموذج العراقي بالاعتماد على الأقلية العلوية (حوالي 12٪ من السكان) للسيطرة على الأغلبية السنية.
2.2 نظام الأسد وإدارة الاستقرار
عزز حافظ الأسد (1970-2000) سلطته من خلال إرساء استقرار استبدادي في سياق إقليمي اتسم بالحرب الباردة، وصعود القومية العربية، والصراعات مع إسرائيل. هذا الاستقرار، الذي اعتبره البعض عاملاً من عوامل تماسك الدولة واستمراريتها، اعتمد مع ذلك على جهاز أمني شديد المركزية وقمع شديد للمعارضة. لا تزال انتفاضة حماة عام 1982 واحدة من أكثر الأحداث إثارة للجدل في التاريخ السوري المعاصر، حيث تتفاوت تقديرات عدد الضحايا بشكل كبير تبعًا للمصدر.
عند توليه السلطة عام 2000، رفع بشار الأسد (2000-2024) سقف التوقعات للإصلاح، لا سيما خلال الفترة المعروفة باسم "ربيع دمشق"، والتي اتسمت بمناقشات سياسية مفتوحة وبدايات التحرير الاقتصادي. ومع ذلك، سرعان ما أُعيقت هذه الديناميكيات، وعزز الانتقال إلى اقتصاد السوق المُتحكم فيه ظهور شبكات أعمال مرتبطة بالنخب السياسية والأمنية. بالنسبة لبعض المحللين، عكس هذا التطور محاولة للتحديث التدريجي ضمن إطار مؤسسي صارم. وبالنسبة للآخرين، فقد أدى ذلك إلى تعزيز التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية وزيادة اعتماد السلطة على الأوليغارشية القريبة من النظام، مما ساهم في إضعاف النسيج الاجتماعي بشكل صامت.
2.3 من الاحتجاجات في عام 2011 إلى الحرب بالوكالة
اندلعت احتجاجات عام 2011 في سوريا في أعقاب الحراك الشعبي الذي شهده "الربيع العربي"، والذي بدأ سلميًا في معظمه، وتمحور حول مطالب الإصلاحات السياسية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الحريات المدنية. إلا أن الرد القاسي من جانب الأجهزة الأمنية، والذي شمل اعتقالات جماعية، واستخدام القوة، وأساليب الترهيب، حوّل الاحتجاج الاجتماعي تدريجيًا إلى تمرد مسلح، وهي عملية يُحللها العديد من الباحثين على أنها نتيجة مشتركة لقمع الدولة، والتنافسات الداخلية بين فصائل المعارضة، وتفتت الوساطة السياسية.
سرعان ما اكتسبت ديناميكيات الصراع طابعًا إقليميًا ثم دوليًا، ضمن إطار جيوسياسي أصبحت فيه سوريا ساحة مواجهة غير مباشرة بين القوى المتنافسة:
- قدمت إيران، وحزب الله، ولاحقًا الميليشيات الشيعية العراقية، دعمًا عسكريًا ولوجستيًا للنظام، بهدف الحفاظ على "محور المقاومة" طهران-بغداد-دمشق-بيروت؛
- قدمت العديد من دول الخليج، بالإضافة إلى تركيا، الدعم لمختلف الفصائل المتمردة، ذات الأجندات المتباينة في كثير من الأحيان، مدفوعةً بمبررات سياسية وأيديولوجية واستراتيجية متباينة؛
- تدخلت روسيا عسكريًا ابتداءً من عام 2015، مُغيرةً ميزان القوى، وسعيًا منها للحفاظ على حليفها السوري ووجودها الاستراتيجي في شرق البحر الأبيض المتوسط؛
- بالتوازي مع ذلك، أعاد انتشار الجماعات الجهادية، مثل جبهة النصرة، ثم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، تشكيل مشهد الصراع بشكل جذري، وساهم في تهميش ما يُسمى بالمعارضة "المعتدلة"، مما أدى إلى تعقيد شديد في خطوط المواجهة.
في هذا السياق، اعتمدت القوى الغربية، وخاصة إدارة أوباما، استراتيجية حذرة، تجمع بين الإدانات الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية وجهود مكافحة الإرهاب، ولكن دون تدخل عسكري مباشر يهدف إلى تغيير ميزان القوى. اعتبر بعض المحللين الإعلان عن "الخطوط الحمراء" المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، دون أن يتبعه تدخل عقابي واضح، شكلاً من أشكال الاستسلام، وإشارةً إلى تراجع استراتيجي وفك ارتباط طوعي، بينما اعتبره آخرون محاولةً لتجنب سيناريو مشابه للعراق أو ليبيا ذي عواقب لا يمكن التنبؤ بها. وقد ساهم هذا الغموض الاستراتيجي الغربي، وفقًا لعدد من المتخصصين، في العزلة التدريجية للمعارضة المعتدلة، وتطرف الصراع، وترسيخ تحالفات النظام الخارجية.
2.4 استراتيجية الأرض المحروقة
نفّذ النظام السوري، بدعم من حلفائه، استراتيجية عسكرية لاستعادة السيطرة، قائمة على تكتيكات الحصار والقصف المكثف والسيطرة على الأراضي من خلال الاستنزاف، بهدف تحييد الجماعات المسلحة وقطع الدعم المدني المحلي. وقد وثّقت العديد من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الاستخدام المتكرر لتكتيكات الإكراه، بما في ذلك القصف العشوائي للمناطق الحضرية المكتظة بالسكان، والقيود الإنسانية، والهجمات الكيميائية المنسوبة إلى القوات الحكومية من قِبل تحقيقات مختلفة تابعة للأمم المتحدة ومستقلة. وتُجسّد أحداث شرق حلب والغوطة منطق "الموت جوعًا أو الركوع"، الذي يجمع بين الحصار المطول وقطع الإمدادات والضغط العسكري المستمر.
إنّ التكلفة البشرية والاجتماعية للصراع باهظة: إذ تشير التقديرات الأكثر شيوعًا إلى أكثر من 500,000 حالة وفاة وحوالي 12 مليون نازح، بمن فيهم حوالي 6.6 مليون لاجئ فروا من البلاد، مما أدى إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية وأزمات الهجرة في القرن الحادي والعشرين. يُضاف إلى ذلك انهيارٌ غير مسبوق للتراث الثقافي: فقد تعرّضت مواقع أثرية رئيسية، مثل تدمر، والأحياء التاريخية في حلب وحمص، بالإضافة إلى المتاحف والمكتبات والأسواق ودور العبادة، لأضرارٍ بالغة أو دُمرت أو نُهبت، مما أسفر عن خسارةٍ لا تُعوّض للتراث الثقافي السوري والعالمي. ويرى بعض المراقبين أن هذا الدمار ليس نتيجةً للحرب فحسب، بل هو أيضًا أداةٌ للهيمنة الرمزية، تهدف إلى تفكيك الهوية والأسس الاقتصادية والمجتمعية للأراضي المُستعادة.
2.5 سوريا اليوم : بلد مقسم
بعد أكثر من عقد من الحرب، تبدو سوريا دولةً مُنهكة بشدة، سيادتها نظريةٌ في معظمها، ومُشتركة بين عدة كتل سياسية وعسكرية. تُقسّم الأراضي إلى مناطق نفوذ متعددة الأطراف، مما يُظهر شكلاً من أشكال البلقنة الفعلية:
- تُسيطر حكومة دمشق، بدعم من روسيا وإيران، على معظم المدن الرئيسية والمناطق الاستراتيجية في الغرب (دمشق، حمص، حماة، اللاذقية، غرب حلب)، لكنها تعتمد اعتمادًا كبيرًا على حلفائها في الأمن والاقتصاد والدبلوماسية.
- تُدير القوات الكردية في الشمال الشرقي، المُشكّلة حول قوات سوريا الديمقراطية (SDF)، منطقة حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع تحت المظلة الأمنية الأمريكية، بنموذج سياسي وإداري مُتميز قائم على الكونفدرالية الديمقراطية.
- لا تزال منطقة إدلب في الشمال الغربي خاضعةً لسيطرة جماعات مُختلفة من المُتمردين والإسلاميين، بما في ذلك هيئة تحرير الشام (HTS)، مع وجود عسكري وسياسي تركي كبير يُرسي دعائم "منطقة عازلة أمنية" هناك.
- تسيطر تركيا بشكل مباشر على عدة مناطق حدودية (عفرين، جرابلس، تل أبيض)، حيث تدعم جماعات سورية تابعة لها، مما يُعيد تشكيل التوازن الديموغرافي والإداري.
في ظل هذه الظروف، تُجسد سوريا سمات الدولة الفاشلة أو المُستولى عليها، حيث تُتفاوض القرارات الرئيسية المتعلقة بمستقبلها السياسي والاقتصادي والعسكري خارج حدودها الوطنية، بين موسكو وطهران وأنقرة وواشنطن، وبدرجة أقل، عواصم الخليج. تواجه إعادة الإعمار عدة عقبات رئيسية: استمرار العقوبات الدولية، وغياب التسوية السياسية، وانهيار المؤسسات، وهروب رؤوس الأموال، وغياب الضمانات القانونية للمستثمرين. تُلزم القوى الغربية إعادة الهيكلة الاقتصادية ورفع العقوبات بانتقال سياسي ذي مصداقية، بينما يُفضل النظام استراتيجية المرونة الاستبدادية، رافضًا أي تنازلات من شأنها أن تُهدد هياكل سلطته.
نتيجةً لذلك، لا تزال سوريا عالقة في وضع راهن متضارب، لا في سلام ولا في حرب كاملة، ومستقبل يعتمد على إعادة ترتيبات التحالفات الإقليمية بقدر اعتماده على ديناميكيات داخلية لا تزال غامضة.
مع سقوط نظام بشار الأسد على يد زعيم سابق لجماعة تحرير الشام المتمردة في ديسمبر/كانون الأول 2024، لا تزال عملية استقرار البلاد هشة. ويعتمد ذلك على قدرة هذه الحكومة المؤقتة الجديدة على إدارة الانقسامات السياسية والعرقية والعسكرية، وإعادة بناء دولة ذات مصداقية، مع تلبية توقعات الشعب والمجتمع الدولي.
يبدو إعادة الإعمار مستحيلاً دون رفع العقوبات الدولية، التي تشترطها القوى الغربية.
مصر : قطب تاريخي تحت الضغط
بفضل تاريخها المستمر الذي يمتد لسبعة آلاف عام، تمثل مصر آخر قوة عربية كبرى معرضة للخطر. إن وحدتها الجغرافية التي شكلها نهر النيل، ووزنها الديموغرافي ونفوذها الثقافي يجعلونها معقلاً تستند إليه استقرار المنطقة بأسرها. لكن تحت مظهر الدولة القوية، تتراكم نقاط الضعف: هل يمكن أن تقضي الانفجار السكاني والأزمة الاقتصادية والاعتماد على المياه على مرونة هبة النيل؟
3.1 مصر : هبة النيل وقلب العالم العربي
بفضل تاريخها المستمر الذي يمتد على 7000 عام، تمثل مصر أقدم دولة قومية في العالم. لطالما جعلتها وحدتها الجغرافية التي شكلها نهر النيل وموقعها المركزي في العالم العربي وقوتها الثقافية الناعمة قطباً حضارياً رئيسياً.
في عهد عبد الناصر (1956-1970)، جسدت مصر القومية العربية ومناهضة الإمبريالية، متحدية القوى الغربية خلال أزمة السويس ومروجة للوحدة العربية. لكن الهزيمة النكراء التي منيت بها أمام إسرائيل في عام 1967 كانت بداية تراجع هذا النفوذ.
3.2 عهد مبارك : الانحطاط البطيء
شهدت فترة حكم حسني مبارك (1981-2011) تآكلًا بطيئًا لدور مصر. أدى الفساد المستشري، والانفجار السكاني (الذي ارتفع من 45 إلى 83 مليون نسمة خلال فترة حكمه)، وبطالة الخريجين الشباب، وتآكل السلطة إلى تمهيد الطريق لانفجار عام 2011.
3.3 الربيع المصري : ثورة فاشلة
بدت ثورة عام 2011 وكأنها أعادت مؤقتًا إلى مصر دورها كمنارة للعالم العربي. لكن الانتقال الديمقراطي لم يدم طويلًا مع انقلاب عام 2013 الذي أوصل المارشال السيسي إلى السلطة. وكان القمع الذي أعقب ذلك وحشياً: آلاف القتلى، وعشرات الآلاف من السجناء، وسحق جماعة الإخوان المسلمين وجميع أشكال المعارضة.
3.4 نقاط الضعف الهيكلية لمصر المعاصرة
تواجه مصر في عهد السيسي تحديات وجودية:
الديموغرافيا والاقتصاد:
- تجاوز عدد السكان 105 ملايين نسمة، يتركزون في 5٪ من الأراضي
- بطالة متفشية بين الشباب (ما يقرب من 25٪)
- ديون هائلة (90٪ من الناتج المحلي الإجمالي)
- اعتماد غذائي حرج (مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم)
- نقص مياه متوقع مع سد النهضة الإثيوبي
الأمن:
- تمرد مستمر في سيناء
- تهديدات إرهابية متكررة
الجيوسياسية:
- زيادة الاعتماد على دول الخليج وصندوق النقد الدولي
- فقدان النفوذ الإقليمي لصالح السعودية والإمارات
3.5 سيناريوهات المستقبل
انهيار مصر ليس أمراً مؤكداً، ولكنه خطر حقيقي. هناك عدة سيناريوهات محتملة:
- استمرار الوضع الراهن الاستبدادي مع تدهور تدريجي في الأوضاع المعيشية
- انهيار اقتصادي يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية لا يمكن السيطرة عليها
- انتقال ديمقراطي يتم التفاوض عليه تحت ضغط شعبي
- تفكك الأراضي (سيناء، الصحاري)
وإدراكاً منها للعواقب الكارثية لانهيار مصر (إغلاق قناة السويس، موجة هجرة جماعية)، تدعم المجتمع الدولي النظام الحالي على الرغم من سجله الكارثي في مجال حقوق الإنسان.
ومع ذلك، فإن هذا السيناريو الكارثي ليس حتمياً. فمرونة المجتمع المصري التاريخية، وجهازه الحكومي القديم، والدعم المالي من دول الخليج، تشكل حواجز ضد انهيار متشائم للغاية.
IV. تحليل شامل : آليات انهيار متوقع
بغض النظر عن الخصائص الوطنية، هناك ديناميات مشتركة تربط بين هذه المسارات الثلاثة للانحدار. إن الإرث السام للاستعمار، ولعنة الموارد، وفشل الأيديولوجيات الحداثية، وتدخل القوى الأجنبية يشكلون مزيجاً متفجراً يفسر لماذا تعاني هذه المراكز الحضارية القديمة من صعوبة في إيجاد مكان لها في العالم المعاصر.
4.1 إرث الاستعمار المسموم
تثقل متلازمة سايكس-بيكو (1916) كاهل المنطقة. فالحدود المصطنعة التي رسمتها فرنسا وبريطانيا تجاهلت عمداً الحقائق العرقية والدينية والقبلية، مما أدى إلى إنشاء دول غير مستقرة من الناحية الهيكلية. وقد فضلت الانتدابات عمداً الأقليات (العلويون في سوريا، والسنة في العراق) من أجل تقسيمها وحكمها بشكل أفضل، مما زرع بذور الصراعات المستقبلية.
4.2 لعنة الموارد
غالباً ما أصبح النفط لعنةً بدلاً من أن يكون نعمة (مفارقة الوفرة). فقد سمح للأنظمة الاستبدادية بالبقاء دون موافقة الشعوب (عائدات النفط)، وشجع الفساد، وجعل هذه البلدان رهانات استراتيجية للقوى الأجنبية.
4.3 فشل الأيديولوجيات الحداثية
فشل القومية العربية (الناصرية والبعثية) في إقامة دول قومية قابلة للحياة، وتحولت إلى أنظمة استبدادية وفاسدة. كما فشل الإسلام السياسي، الذي يجسده الإخوان المسلمون، في تقديم إجابات مقنعة للتحديات الحديثة.
4.4 الدور المزعزع للاستقرار الذي تلعبه القوى الإقليمية
تخوض السعودية (السنية) وإيران (الشيعية) حرباً بالوكالة في جميع أنحاء المنطقة، مستغلتين الانقسامات الطائفية. وتسعى تركيا بقيادة أردوغان إلى تحقيق طموحات عثمانية جديدة. وتؤثر إسرائيل، على الرغم من تورطها المباشر الأقل، على الديناميات الإقليمية من خلال علاقتها الخاصة بواشنطن وصراعها مع الفلسطينيين.
4.5 تأثير التدخلات الغربية
تتحمل التدخلات الغربية الأخيرة، التي قامت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها، مسؤولية كبيرة في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وهي موضوع تحليل نقدي فيما يتعلق بتأثيرها على المنطقة. وقد تمت الإشارة إلى عدة عوامل: الدعم التاريخي للأنظمة الاستبدادية خلال الحرب الباردة، والسياسات التي يُنظر إليها على أنها غير متسقة ومتناقضة (دعم العراق ضد إيران، ثم تدمير العراق نفسه)، و” حرب على الإرهاب “أدت إلى مزيد من الإرهاب بدلاً من القضاء عليه، وترويج متهور للديمقراطية، دون فهم عميق للسياقات المحلية، أدى في بعض الأحيان إلى نتائج عكسية للأهداف المعلنة.
الخلاصة: نحو شرق أوسط جديد؟
من المحتمل أن يكون التفكك الجاري هو الفصل الأخير من النظام ما بعد العثماني وما بعد الاستعماري. إذا كانت مأساة العراق وسوريا تذكرنا بأن الحضارات ليست أبدية، فإن مصر ربما تمثل الفرصة الأخيرة للعالم العربي لإثبات قدرته على إعادة اختراع نفسه دون تدمير نفسه. ما هو التوازن الإقليمي الجديد الذي سيظهر من بين هذه الأنقاض؟
نحن نشهد إعادة تشكيل عميقة للمنطقة وفقًا لمنطق جديد:
- الاختفاء التدريجي لحدود سايكس-بيكو لصالح كيانات عرقية-طائفية (كردستان، الكيان العلوي، السني والشيعة في العراق)
- ظهور” فوضى خلاقة “يمكن أن تؤدي إلى توازنات جديدة
- تحول مركز الثقل في العالم العربي نحو ممالك الخليج
- تزايد نفوذ القوى غير الغربية (روسيا والصين)
سيكون التحدي الذي يواجه الأجيال القادمة هو إعادة بناء الشرعية السياسية التي تتجاوز الانقسامات الطائفية مع احترام التنوع الثقافي، وإيجاد طريق للتنمية الاقتصادية لا يعتمد حصرياً على عائدات النفط. وإذا ما حدثت نهضة لهذه المراكز الحضارية، فسيتعين أن تستند إلى إعادة الاستحواذ النقدي على تراثها التاريخي الغني، الذي غالباً ما استغله الطغاة والمتطرفون.
وتذكرنا مأساة العراق وسوريا بشكل قاسٍ بأن الحضارات، حتى ألمعها، ليست أبدية. فبقائها يعتمد على قدرتها على التكيف مع تحديات عصرها مع الحفاظ على روحها. وربما تمثل مصر، آخر قوة عربية كبرى مهددة بالخطر، الفرصة الأخيرة للعالم العربي لإثبات قدرته على إعادة اختراع نفسه دون تدمير نفسه.