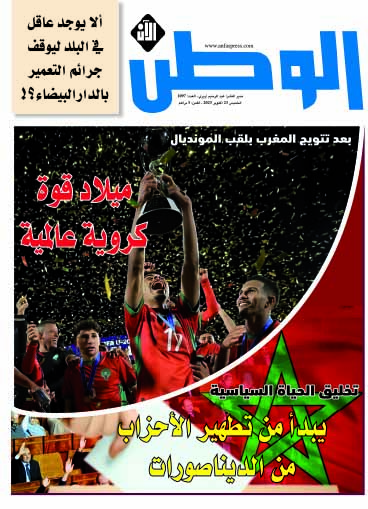يتداول عددٌ من المواقع والصفحات وجهةَ نظر بعض المشتغلين بالفلسفة حول فكر الأستاذ الجابري والأستاذ طه عبد الرحمن. وعلى الرغم من أن هذه الوجهة المتداولة من النظر معروفة ويبدو على صاحبها قدر من الإنصاف والتوازن، على الرغم من ذلك فإنها لا تخلو من نزعة استئصالية لائحة تُخرج المفكرين المغربيين من دائرة القول الفلسفي، وتدرج كلا منهما على حدة في خانة هي أقرب إلى "المثقف المستنير" بالنسبة إلى الأستاذ الجابري، وإلى "متكلم جديد" يرافع عن عقيدة فكرية بالنسبة إلى الأستاذ طه...
لست هنا في مقام الدفاع عن أي منهما، فكتبُهما واجتهاداتُهما جديرة بأن تشهد على مدى الإضافة التي أسهم بها هذا أو ذاك من موقع اشتغاله، وعلى مدى الجهد الأصيل الذي شاركا به من داخل أفقيهما المتفاوتين في دفع الفكر العربي المعاصر نحو الانخراط في مغامرة التفلسف بجرأة وجِدة وتميز...
لا يتسع السياق هنا للتفصيل، أود فقط التوقف بإيجاز شديد عند طه عبد الرحمن في تلك الوجهة من النظر. ربما كان من الأولى القول بأن الأستاذ طه يدافع عن الحق في التفلسف من داخل تقليد حضاري هو التقليد العربي الإسلامي الذي يختلف في جملة من أبعاده ومقاصده عن تقاليد أخرى، وبخاصة منها التقليد الإغريقي والتقليد اليهودي المسيحي في القرون الوسطى.
ميزة الأستاذ طه، سواء اتفق معه بعض المشتغلين بالفلسفة أو اعترضوا عليه، أنه قارئ جيد للتقاليد الفلسفية القديمة وملمٌّ إلماما واسعا بالتوجهات الفلسفية الكبرى في كل من الفلسفة القارية والفلسفة التحليلية. فتكوينه الأساس هو في المنطق والفلسفة التحليلية المعاصرة. بل هناك فرق شاسع بين هاتين الفلسفتين إن على صعيد موضوعات البحث والتفكير، أو على صعيد المقاربة والتحليل. الفلسفة القارية فلسفة نظرية يطغى عليها التأمل في بناء الصروح والأنساق الفلسفية الكبرى، في حين تقدم الفلسفة التحليلية نفسَها على أنها فلسفةٌ عملية ومِراسية تُعنى بتحليل إشكالات فلسفية محددة مرتبطة في الغالب إما بفلسفة اللغة أو بفلسفة الذهن أو بفلسفة العلم. وهو ما يجعلنا أمام أسلوبين متمايزين في نمط التفكير الفلسفي على الرغم من المساعي المتعددة التي ما انفكت تجتهد في التقريب بين الأسلوبين واعتبارهما متكاملين مثلما أكد ذلك هابرماس (1999)، أو مثلما دافع عن ذلك آخرون أيضا وبصيغ أخرى كهيلاري بوتنم (1981)، ورورتي في أبرز أعماله.
المثير في هذه الاجتهادات التقريبية أن أصحابها يصدرون عن خلفية تقضي بأن الفلسفة القارية بما هي فلسفة تأويلية (هيرمينوطيقية) لا تتعارض في الصميم مع الفلسفة التحليلية بما هي فلسفة تقعيدية تعلي من أهمية العلم والمنطق في تحليل الإشكالات الفلسفية التي تدرسها. فكلاهما واقعان اليوم، من منظور التقريبيين، تحت تأثير مقتضيات المنعرج اللساني linguistic turn الذي تبوأت معه اللغة صدراة الاهتمام، وباتت تشغل الموقع الإيبستيمولوجي ذاته الذي ظلت تشغله نظرية المعرفة في الفلسفة طوال قرون (داميت 1994).
على هذا الأساس يغدو الاختلاف بين الفلسفتين، أو حتى التقريب بينهما، يغدو بالنسبة إلى من يعتقد أن للفلسفة روحا geist كونية يتعين على كل مشتغل بالفلسفة أن يمتثل لها وأن يذعن لمبادئها كما لو أنه دعوة إلى التماهي مع هذه الروح والتطابقِ المعياري معها. وهذا ما لا يظهر من الحوار الذي ما زال مسترسلا بين الفلسفتين إلى حد الخصام والتنازع. ذلك أن تجذر الفلسفة التحليلية في العالم الأنجلو أمريكي هي بهذا المنحى تعبير عن خصوصية في مشاغل التفكير لدى جماعة فلسفية معينة تختلف بها عن خصوصية مشاغل الجماعات الفلسفية الأخرى؛ لأنها وجدت في تلك الفلسفة ما يستجيب لمتطلبات أشكال الفكر والحياة التي تخصُّها في الزمن الذي تنتمي إليه.
من هنا تصبح الدعوة إلى الكونية كما لو أنها دعوة تفترض أن للقول الفلسفي سمتا واحدا في التفكير وخطا تاريخيا مستقيما هما اللذان ترسخا في كتب تاريخ الفلسفة على المنوال الأوروبي، تلك الكتب التي لا نجد فيها على الأغلب أثرا يُذكر لإسهامات حضارات فكرية أخرى ما عدا الحضارة الغربية.
هذه النزعة المركزية بالضبط هي ما يستشكله الأستاذ طه وغيره بطرق ربما مختلفة. بل هي النزعة التي يقوضها حتى من لا يندرجون من قريب أو من بعيد في الأفق ذاته لصاحب (الحق العربي في الاختلاف الفلسفي).
يرى فيلسوف مغربي بارز أنه لن يتأتى إخراجُ الفلسفة من دائرة الانغلاق الأكاديمي، وفتحُها على فضاءات فكرية أوسع وموضوعات حياتية أرحب إلا "بزحزحتها عن مواقعها المعهودة وموضوعاتها المستهلكة". إذ ليس في هذه الزحزحة ما ينبئ بنهاية ما للفلسفة، أو ما يجعلها تتجاوز ذاتَها وتنقلب إلى نقيضها؛ بل فيه ما يبعث على تخليصها من وطأة النماذج التقليدية التي ظلت سجينة لها عبر تعاقب أزمنتها، بحيث أمست الفلسفة "أسيرةً لتاريخها ورهينةً لأكاديميتها وكلِّيانيتها" باسم كونية هي كونية الحضارة الغربية...
قلما ننتبه إلى أن الأستاذ طه، وهو يدافع بأسلوبه الخاص، عن الحق في الاختلاف الفلسفي لا يتوقف عن التفاعل مع كل من التقليد الفلسفي القاري والأنجلو أمريكي، ولا يكف عن محاورتهما والاستفادة منهما. فهو لا يجابههما بمسوغات هوية جوهرانية أو بمسوغات "اختلاف متوحش" كما يزعم البعض، وإنما بمسوغاتِ "نسبيةٍ تداوليَّةٍ" تقضي بأن الخوض في القول الفلسفي ليس خوضا في قول مجرد مفصولٍ عن جريان التاريخ وعن شؤون الناس ومجريات حياتهم.
إنه قول نسبي ينهض على التنوع والاختلاف، ويستمد ثراءه وانفتاحه من تعدد الثقافات والحضارات الإنسانية التي يفكر على نحو مخصوص في أسئلتها وفي مدارات وجودها وحياتها.
لهذا الاعتبار ربما لم يفلح البعضُ في إدراج مشاغل فيلسوف مختلف ضمن حدود تاريخ "أرثوذوكسي" للفلسفة له خط بداية وخط وصول هما اللذان رسَّختهما عنه الميتافيزيقا الغربية ولا تزال...