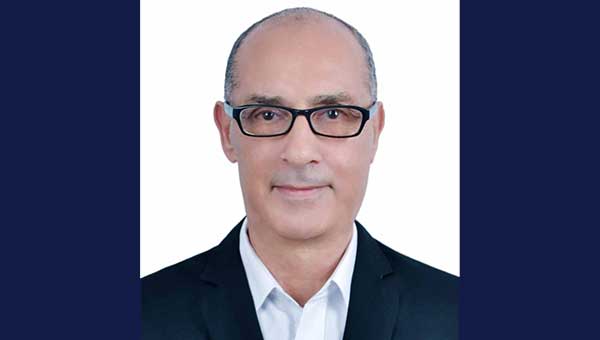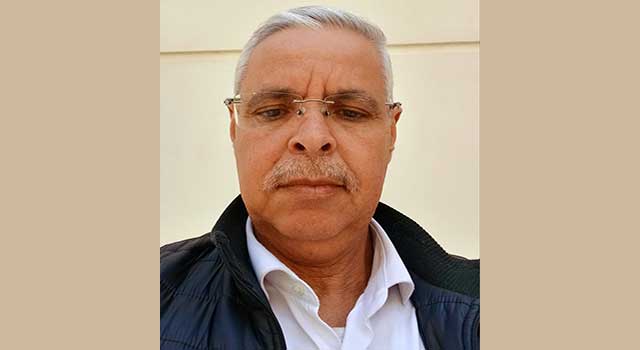كان الاستشراق الألماني منذ البداية استشراقا أكاديميًا، أو على الأقل كلاسيكيًا، وبشكل شبه حصري: كانت للدراسات الإسلامية، للشعر، وحتى للروايات الحيز الأوفر، لكنه لم يكن واقعيًا، ما قامت به الدراسات الاستشراقية الألمانية هو صقل وتطوير تقنيات تُطبّق على النصوص، الأساطير، الأفكار واللغات التي جُمعت حرفيًا من الشرق من قِبل بريطانيا وفرنسا.
ومع ذلك، فإن ما يشترك فيه الإستشراق الألماني مع الإستشراق الأنجلو- فرنسي، ثم الأمريكي لاحقًا، هو نوع من السلطة الفكرية على الشرق، الإستشراق الألماني لا زال ليومنا هذا سجين "البرج العاجي" وحتى الغموض في بعض الأحيان، بخلاف الإستشراق البريطاني أو الفرنسي الذي كان في خدمة "الحاكم" حتى يتمكن على أحسن وجه في ترويض وتركيع "الرعية"، فضل الإستشراقيون الناطقون باللغة الألمانية الإنكباب على دراسات أكاديمية، بالأخص على علم اللغة والتراث الإسلامي الكلاسيكي، كما قاموا بجمع المخطوطات، تحقيقها وتأليف قواميس وموسوعات، وهم كثر من درسوا القرآن والتاريخ الإسلامي، لأنهم كانوا يدركون أن التراث الشرقي يستحق الدراسة، البحث والنبش فيه، فلطالما ربطوا الدراسات الاستشراقية ب "الدراسات الإسلامية"، والذي هو الحال ليومنا هذا.
ومن النواقص التي يمكن لنا أن نبديها هي أنهم درسوا الدول الإسلامية أو الإسلام من زاوية تاريخية محضة، إسلام منفصل عن الناس ومجتمعاتهم، ليس كمادة خصبة تنبض بالحياة والحيوية، حتى جعلوا من اختصاصهم متحفا في بعض الأحيان، ومرد هذا هو الثقل التاريخي الذي لا يستهان، لما أجبر العديد من الإستشراقيين الناطقين باللغة الألمانية من ذوي التوجهات التقدمية أو الحرة مغادرة ألمانيا والنسما بعد صعود النازيين إلى الحكم سنة 1933، حيث تم فصل العديد من البحاث المرموقين من مناصبهم الأكاديمية، وفي بعض الحالات تم حتى قتلهم على يد النظام النازي الألماني. هكذا، فقد الاستشراق الألماني والنمساوي بريقه، حيث أجبر أكثر من ستين باحثًا بارزًا أن يهاجر أو يختار المنفى كملاذ ووطن أكثر اتسعا لروحه وأعماله، ويمكن لنا ذكر البعض منهم مثل "جوزيف شاخت" (1902-1969)، و "فرانز روزنثال"(1914ـ2003)، و "كارل فيتفوجل" (1896-1988)، و "غوستاف فون غرونباوم" (1909-1972)، لهم يرجع الفضل في تطوير الإستشراق في الغرب، حيث ساهموا بشكل متميز في النهضة الإستشراقية في أوطانهم الجديدة، وخاصة بريطانيا، والولايات المتحدة.
كانت هذه خسارة كبيرة لم يتمكن الإستشراق الألماني من تعويضها، حتى ولو تمكن الإستشراق الألماني من إنجاب بحاث مرموقين من قبيل "أنا مارية شيمل" (1922ـ2003) التي تعتبر سفيرة الثقافة الإسلامية والصوفية في الغرب، حيث ألفت أكثر من 100 كتاب ومقالات خاصة بالإستشراق، ومع ذألك، فظلت كجميع الإستشراقيين الألمان أو النمساويين أن تبقى سجينة المنهج الإستشراقي الألماني الذي يركز على فقه اللغة مع إغفال تام للسياق السياسي والمجتمعي، وتجميل الماضي بدل النبش في الحاضر الذي يعد وسيلة غير مباشرة لنفي حاضر ينبض بالحياة والحوية، وهو ما يغذي الطرح أن الإستشراق الألماني لا زال يجر وراءه إرث وثقل التاريخ و"البرج العاجي"، لأن العالم تغير، وهجرة عدد كبير من المسلمين إلى الدول الغربية، والعولمة وتحديات اندماج هذه الفئات المسلمة تفرض أسئلة ومقاربة جديدة، لا يمكن للإجابة عنها بأجوبة البارحة أو بتحقيق المخطوطات، حيث من الازم أن تكون هذه المقاربة الجديدة متعددة التخصصات والمهارات والتي تسعى في العمق إلى ربط النص بالسياق، والتاريخ بهموم الناس اليومية، والماضي بالحاضر، لأن الإعجاب الفكري للقرون الفارطة لا يتناقد مع التمحيص في الواقع والمعايش اليومي.
في سياق الأزمات وما ينتج عنها من حاجة إلى التفسير وتنوير الرأي العام الغربي، يميل بعض الإستشراقيين الألمان أو النمساويين الذين يواجهون تحديات وضغوطات علنية إلى العودة إلى مواقف استشراقية كلاسيكية، وتفسير جميع الأحداث المحتملة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة بـ "الإسلام": "الإسلام هو"، "المسلمون هم"، "قال النبي"، "هذا وارد في القرآن"، غالبًا ما تكون هذه الأقوال والمبررات لمحاولات تفسير لا تفسر شيئًا فحسب، بل غالبًا ما تقود مرة أخرى إلى فخ الكليشيهات الاستشراقية المضللة.
والصورة النمطية للمسلمين والإسلام بصفة عامة لا زالت تسود وتجول، حيث تعتبر شريحة مهمة من مجتمعات الدول الناطقة بالألمانية أن دين المسلمين دين بدائي، أبوي، كاره للنساء، وغامض للغاية، والذي لا يزال تفسيره خاضعًا لسيطرة دراسات شرقية عتيقة، ليست لها أي ارتباط بالواقع أو الحقيقة، ودغدغة العقول والمشاعر هي ميزة هذا العصر، حيث يتحول الشخص إلى مستهلك للمشاعر الافتراضية أكثر من عاشق للحياة وجمالها، أين أصبحت الرسائل النصية المليئة بصور القلوب بديلا عن اللقاءات الشخصية والعميقة، ناهيك عن الرسالات الصوتية.
في ظل هذه الظروف، ليس من المستغرب أن هذا النوع من الإستشراق لا يزال يُعطي انطباعًا باتباع نموذج استشراقي تليد، أي تفسير كل حدث في بلدان دول الشرق أو شمال أفريقيا ب "الإسلام"، وكم من مرة هاجم "كارل هاينريش بيكر" هذا الموقف، حيث قال: "من يجد في القرآن وحياة محمد كافيين لتفسير واقع الدول الإسلامية، فهو مخطئ"، وهذا ما يحدث بالضبط في الدول الناطقة باللغة الألمانية حيث لا الإستشراق الأكاديمي أو غير الأكاديمي كنظيره الانجلو- فرنسي أو الإستشراق الأمريكي، لطالما حاول ممارسة نوع من "السلطة الفكرية" على الشرق كما جاء على لسان إدوارد سعيد.
وهو بالفعل ما نلاحظ اليوم، مع كل الاحترام للمستشرقين المتنورين، لكن مع الأسف أنتج الاستشراق بصفة عامة نظاما خطابيا ومفاهيم لا زالت ترخي بظلالها السامة على الفضاء العام الغربي، حيث أثرت المعجم السياسي لليمين المتطرف وزودته بالوقود المناسب بغية نشر الاسلاموفوبيا التي تشكل في الأساس نوع من الاستمرارية الاستعمارية، حيث يمكن اعتبارها الإبن الشرعي للاستشراق المتحيز، لما ورثت جيناته الفكرية والأيدولوجية وحولتها إلى رأس مال سياسي فعـّـال في عصر ما بعد الاستعمار، والاستشراق بصفة عامة لم يكن بريئا في بعض الأحيان، حيث أنتج مجموعة من الإستشراقيين والمفكرين من قبيل "أرنست رينان" (1823ـ1892) في فرنسا التي كانت أفكارهم ليس مجرد أفكار عابرة، بل اللبنة الأولى للبناء الأيديولوجي للاستعمار، ولو تعرضت اليوم لانتقادات واسعة النطاق بسبب عـنـصريتها أو "أدولف كرومان" (1887ـ1977) في الدول الناطقة بالألمانية، لما سخر أبحاثه الإستشراقية لصالح الأيديلوجية النازية.
الجدل لا زال قائما، حيث يعتبر الإسلام في الدول الناطقة بالألمانية أنه لا يتوافق مع القيم الغربية وأن المسلمين يشكلون تهديدا وجوديا للهوية والثقافة المحلية، كما يستعمل كذلك هذا الخطاب العابر للقارات في الصراع القائم في الشرق الأوسط، والثنائية القاتلة لا زالت صاحبة كلمة الفصل: عقلاني ـ غرائزي، متحرر ـ خنوع، ومع ذلك، ليس لنا أي بديل، التكامل الفكري والثقافي هو الأنجع والأكثر فعالية، هذه الفسيفساء الإنسانية، حيث تحتفظ كل قطعة ببريقها، لونها، حجمها وشكلها المميز، والكل يشكل لوحة واحدة فريدة ومتناغمة، ليس تضاد ولكن تبادل ناجح ومثمر، حيث تقدم كل حضارة، ثقافة ما عندها من كنوز مما يثري الحوار ويساهم في تعزيز تبادل المعرفة والمهارات، كما كان الحال في الأندلس، لما التقت حضارات إسلامية منفتحة على وسطها بحضارات محلية أخرى، فأنتجت عصرا ذهبيا مرموقا في الفلسفة، العلوم، الطب والفن المعماري، كما يقال في بعض الأحيان: جميع الرحلات تبدأ بالخطوة الأولى، لكنها لا تكتمل إلا برفقة الأهل والأحباب.