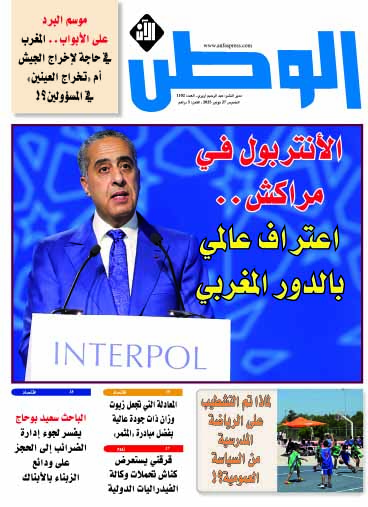تُعدّ التربية واحدة من الوسائل المهمة لإعداد الأفراد للحياة في مجتمعهم، بطريقة تُمكّنهم من التكيّف مع هذا المجتمع والاستفادة منه وإفادته(1). ويُنظَر إليها باعتبارها وسيلة ناجعة للتحكم في كمّ المعرفة والثورة المعلوماتية المتزايدة، وحُسن توجيهها بما يتواءم مع متطلبات المجتمع وأهدافه. كما أنها تُعدّ الأداة الأهم لصناعة التغيير نحو الأفضل في المجتمعات التي تتطلع إلى مواكبة التجديدات المتنوعة في العصر الحديث، من خلال الاهتمام برأس المال البشري وتنمية موارده بإعداد وتأهيل كوادر مستقبلية تتسم بجودة البحث والفكر المُبدع، في زمنٍ أضحى فيه التعليم من أنجح أشكال الاستثمارات المتعددة المجالات.
إضافةً إلى ذلك، أصبح نوع التربية ومخرجاتها من المقاييس التي يُعتمَد عليها في الحكم على مقدار تقدم الأمم أو تأخرها، وبالتالي فهي تُشكّل أحد العوامل الحاسمة التي تسهم في تحديد مكانة المجتمعات وتميّزها في هذا العصر، الذي يعتمد بالضرورة على التطور التعليمي، والذي يرتكز على معطيات في مقدمتها مدى مواءمته لفلسفة المجتمع، والأسس التي بُنيت عليها هذه الفلسفة أو انبثقت عنها، خاصة ما يتعلق بفلسفة التربية وأهدافها المركزية.
وفي عالمٍ تحكمه التناقضات، وتتنافس فيه النماذج الاقتصادية والسياسية، تبرز التجربة "الصينية" كنموذج حضاري غير مسبوق، وقد تجلّى ذلك بشكل واضح من خلال الاستعراض العسكري والبشري والتكنولوجي والدبلوماسي الأخير الذي قامت به الصين، احتفالًا بالذكرى الـ80 لاستقلالها. وبهذا الاستعراض غير المسبوق، تُعلن "المعجزة الصينية" عن ثقة كبيرة في النفس، قائمة عمليًا على ندّية تنافسية غير مسبوقة اجتماعيًا، اقتصاديًا، تقنيًا، سياسيًا وعسكريًا. كما أنها لا تُخفي تمسكها بفلسفة قائمة على نبذ الحروب، والاستعمار، ونهب ثروات الشعوب.
وعليه، لم تعد الصين قادمة فحسب، بل وصلت بالفعل، وأصبحت لاعبًا رئيسيًا في مسرح العالم، ترفع شعار: "التعاون والمنفعة المتبادلة."
فكيف لبلد، والحال هذه، كان يعاني الفقر المدقع، والعزلة السياسية، والتأخر الصناعي، أن يتحوّل في غضون عقود قليلة، من أرضٍ كانت تحت وطأة الاستعمار، إلى قمة العالم في التقدم والابتكار؟
وكيف استطاعت الصين أن تصبح المنافس الأول للولايات المتحدة الأمريكية، كأكبر اقتصاد عالمي وقوة تكنولوجية مهيمنة؟
في إطار محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة، يمكن القول إن هذا التحول المنقطع النظير على جميع الأصعدة لم يكن وليد الصدفة، بل كان نتاج رؤية استراتيجية طويلة الأمد، تبنّاها الحزب الشيوعي الصيني، الذي استطاع، رغم طبيعته المركزية الصارمة وسماته القمعية، أن يمزج بين الانضباط السياسي والانفتاح الاقتصادي، ليُحقق بعد ذلك معادلة نادرة تجمع بين السيطرة المطلقة والإبداع التكنولوجي(2).
وقد تطلب ذلك إرادة سياسية ورؤية استراتيجية تقودها قيادة مركزية قادرة على اتخاذ قرارات طويلة المدى، وتفادي التقلبات السياسية التي تواجه الأنظمة الديمقراطية. كما اعتمدت الصين على تعليم مركزي بهدف تحسين نظامها، خاصة في مجالات العلوم والهندسة، مما ساهم في تكوين قاعدة بشرية مؤهلة لدعم التطور الصناعي والتكنولوجي. كما وفّرت الحكومة الصينية دعمًا ماليًا ولوجستيًا كبيرًا للشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الصناعي، الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، مركزة على تطوير تقنياتها الخاصة وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية(3).
فما طبيعة "السرّ التربوي والتعليمي" الكامن وراء المعجزة الصينية البادية للعيان؟
الواقع أن هناك العديد من الوثائق والمراجع التي تتناول بالدراسة والتحليل موضوع التربية وخصوصية النظام التعليمي الصيني، غير أن الصدفة والضرورة كانتا سببًا في اكتشاف كتاب مفيد في هذا الموضوع، هو "التعليم الجديد في الصين" لمؤلفه تشو يونغ تشي(4). ومن خلال هذا الكتاب، حاولنا إبراز بعض العناصر الأساسية التي قد تساعدنا في إعداد النفس وتمرينها على فهم واستيعاب بعض عناصر هذه التجربة الرائدة تربويًا وتعليميًا، آملين الخروج مما سمّاه كل من الدكتورين محمد عابد الجابري وعبد الله العروي: "أزمة التعليم في المغرب"(5).
أهمية المرجع الأخلاقي في تجربة التعليم الجديد بالصين
في الوقت الذي طوّر فيه الغرب نظريات تربوية مختلفة تبعًا للخلفيات الفلسفية، لوحظ أن أغلبها يُرجّح الجانب المادي الاقتصادي في عملية التعليم، فلا تلتفت هذه النظريات إلى ما يُنمّي المعارف والخبرات. وهو الأمر الذي نبّه إليه فرانسوا رابليه منذ بدايات الاكتشافات العلمية الحديثة في القرن السادس عشر بقوله الشهير:
"علمٌ من دون وازعٍ دمارٌ للروح."
وعليه، فإن تجربة التعليم الجديد في الصين، رغم استفادتها من النظريات الغربية، تتميز بخصوصياتها الثقافية، والتاريخية، والحضارية العريقة، وقد حملت تعاليم فيلسوفها كونفوشيوس الذي قال:
"الإنسان الفاضل الحقيقي هو من يفضّل الأخلاق على المال، وتحقيق المساواة أهم من الاهتمام بنقص المؤن، والقلق من عدم الاستقرار أهم من القلق من الفقر، والميل إلى الحياة الآمنة المسالمة أهم من الميل إلى الكسب المادي."
بهذا يكون التعليم الجديد في الصين، حسب تشو يونغ تشي، هو: "مشروع لنشر المثل."
التمسك بالمثل في العملية التربوية
حتى إذا كان الأمر بمثابة السير عكس التيار الجارف نحو ربط التعليم بما هو مادي اقتصادي، فإن قطب رحى التعليم الجديد في الصين يحرض على المثابرة في العمل والإيمان بالمستقبل كأسس أخلاقية تدخل في بناء مكونات فلسفة تجربة التعليم الجديد، والتي لا تقوم على المعلم فقط، بل على التلميذ نفسه وأولياء أموره، ودائمًا باتجاه نشر المثل. إنه مشروع بناء الإنسان قبل أي شيء آخر، ولكن عبر المثل دائمًا، لئلا تكون حياته حائرة وغير فعالة، وحياة جهل وغباء(5).
إدراج الطبيعة والفنون مع تحصيل التعلمات الأساسية
لا يقتصر التعليم الجديد في الصين، بحسب تشو يونغ تشي، على تعلم القراءة والحساب فقط، بل يشمل أيضًا الطبيعة والفنون والكتابة، خصوصًا كتابة اليوميات، وغيرها من الأمور التي تغني الحياة الروحية للتلاميذ. إن مدارس تجربة التعليم الجديد تفوح منها الروح الفنية في كل تلميذ؛ فبعضهم يعزف على آلة موسيقية، ويبرع آخرون في فن الخط أو الرقص أو الرسم. يوجد بينهم من يقترب مستواهم من كبار الرسامين أو الفنانين الصينيين الكبار، ومنهم من ينتشي بالألحان الصينية، ومن يمكنه كذلك الاستمتاع بالأوبرات الصينية التقليدية.
لا من أجل أن يصبح كل تلميذ فنانًا حسب المؤلف، بل ليصبح شخصًا يعرف كيف يتمتع بالفن، ويحب الفن، ويحترم الفن. فمتى ما استطاع الشخص أن يجعل الفن يرافقه طوال حياته، غدا بالتأكيد إنسانًا يتمتع بالثراء الروحي. إنها تجربة تقوم على أن تاريخ النمو الروحي للإنسان هو تاريخ قراءته للكتب، وغايتها هي جعل: كل تلميذ يمتلك قلبًا حساسًا، ويحب الآخرين بواسطة قراءة الشعر صباحًا، ومطالعة الكتب ظهرًا، ومراجعة الذات مساءً بهدف رسم خريطة روحه من جديد(6).
ربط التعليم الجديد بالعمل العلمي العملي
تدعو تجربة التعليم الجديد في الصين إلى البحث العلمي العملي، أي إلى البحث بالعمل في طبيعة المدرسة. وهذا أسلوب جديد للبحث العلمي، وأسلوبي جديد لإدارة المدرسة، على اعتبار أن تجربة التعليم الجديد هي مسيرة تطور المدرسة، انطلاقًا من الصف كمسرح التعليم الأساسي، حيث يُراد أن تصبح تجربة التعليم الجديد بحثًا علميًا يغير حياة المعلمين وحياة التلاميذ والمدرسة. ويُطلب من المعلمين والتلاميذ جميعًا أن يشتركوا في هذا البحث(7). وثمار هذه التجربة ليست كثرة الرسائل البحثية، بل التنمية الحقيقية لكل تلميذ ولكل معلم. وابتكار أسلوب البحوث العلمية يمكنه أن يغير حياة المدرسة ونمط تطورها، لعل الخبراء الباحثين في نظريات التعليم يخرجون بذلك من مكاتبهم ليدخلوا الحياة، بسبب ما يتمنى صاحب دعوة إصلاح التعليم الجديد.
أهمية الوازع الأخلاقي في التحريض على فعل القراءة
في هذه التجربة يُعزّز كل من المعلم والتلميذ الثقة بالنفس، ويُعزّز الجميع، المعلم والتلميذ والأهل، بالوعي والعزيمة والحب. وتصبح القراءة مرادفة للتربية نفسها، وتقوم الكتب بإضفاء المعنى على المدرسة، حتى إذا ما خلت مدرسة من الكتب، بطل معناها كمدرسة. إذا كانت المثل هي التي تحفظ الحضارة الروحية البشرية بقدر ما تحفظ استمرارها، فإن قراءة الكتب طريق لابد منه لتحقيق هذا الهدف، لكونها جسرًا لتوارث الحضارة، إلى جانب كونها وسيطًا يعي حياة ويغنيها.
أما الحب فهو وسيط تربوي أساسي لا يقل أهمية عن القراءة، لذا روى لنا تشو يونغ تشي كيف يحقق الحب المعجزات في العملية التربوية، من خلال قصة مائتي طفل فقير، ليبين أهمية أن يكون قلب المعلم مفعمًا بالحب حيال عمله وتلاميذه.
الاستجابة للحاجيات الحيوية للمتعلمين
لا أحد ينكر اليوم في عالم التربية المعاصر أن طرائق التعليم وأساليبه تتجدد مع تطور احتياجات المتعلمين في مختلف المجتمعات، ومع تجدد حاجاتهم الفكرية واحتياجات مجتمعاتهم الاقتصادية والعلمية. فإن الإنسان، ومنذ الأزل، يفكر ويخترع ويطوّر، وهذه القدرة على الإبداع خاصية تميّزه عن سائر المخلوقات، كما تميّز الإنسان عن أترابه، بجعله فريدًا ومختلفًا بتفكيره.
وبهذه القدرة العجيبة على التفكر والرغبة في فهم كل شيء، فإن أروع ما أنتجته الإنسانية: العلم وأساليب نقله، أي التعليم، وهو فن الفهم والتطوير الذي أتاح إنجازات البشر عبر حضارات، ما تكاد تنطفئ شعلة إحداها حتى تلهب شعلة أخرى بوهج المعرفة العلمية التي تضيء مزيدًا من اكتشاف العالم المجهول المحيط بنا. لكن ما يمسك بجماح الإنسان المعرفي هو وازع الضمير، جوهر الإنسان، فيزن ذلك العلم ليعرف ما له وما عليه(8)، ويضبط مساره ليقيه شر الشطط الذي حذر منه فلاسفة غربيون أمثال جورج أورويل والدوس هكسلي وغيرهما كثيرون.
خلاصة القول
إن كتاب "التعليم الجديد في الصين" من جهة، يحتاج إلى قراءة مؤسساتية تتجاوز إرادات الأفراد، لتنتقل إلى الإعداد النفسي الفردي والجماعي القادرين على فهم محتواه كرسالة تربوية، في منهج قائم على التوازن الدقيق بين العلم والأخلاق، موجّه إلى العالم في الشرق والغرب من أجل الإلتفات إلى أن التعليم لا يخاطب عقل المتعلم وحده، بل يخاطب أيضًا قلبه وضميره وروحه، ويخاطبه في جملته الإنسانية العقلية، النفسية والأخلاقية.
من جهة أخرى، يمكننا أن نضيف أن التجربة الصينية ليست قصة نجاح اقتصادي فحسب، بل هي درس عميق حول كيفية توظيف الموارد البشرية والإرادة السياسية لتحقيق التحول الشامل، من خلال قيادة حازمة ورؤية استراتيجية في أفق تحقيق أهداف تنموية عظمى في ظل قيود سياسية صارمة. وهي تجربة على الأقل تذكرنا بأن مسارات التنمية متعددة، وأن لكل أمة الحق في صياغة نموذجها الخاص الذي يتوافق مع ظروفها وتاريخها وطموحاتها. ومن هنا تبقى الصين مثالًا حيًا على الإرادة والإدارة القوية القادرة على تحقيق المستحيل، مهما كانت القيود والتحديات.
المراجع
(1) التعليم في الصين واليابان: ملامح ودروس. محمد بن شحات. 2016
(2) د. حمدي سيد محمد محمود. (النهضة الصينية: كيف استطاعت دولة مقيدة الحريات أن تقود العالم تكنولوجيا؟) المركز الديمقراطي العربي – القاهرة – مصر. 28 يناير 2025.
(3) نفس المرجع
(4) التعليم الجديد في الصين: تشو يونغ شين، ترجمة وانغ فو، مؤسسة الفكر العربي. الطبعة الأولى 2013.
(5) د. عبد الله العروي: استبانة، الطبعة الثالثة 2016، المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء / المغرب.
(6) التعليم الجديد في الصين: تشو يونغ شين، ترجمة وانغ فو، مؤسسة الفكر العربي. الطبعة الأولى 2013.
(7) نفس المرجع
(8) المصدر نفسه