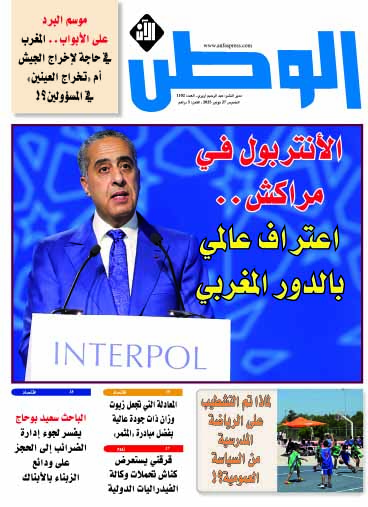كيف يمكن الحديث، اليوم، عن الاحتجاج وأسبابه وغاياته، وعمَّا يمكن أن يُحركه من حس النقدي أو روح النقدية في علاقتها بالمجال العام؟ وهل يسعف هذا الحديث في صياغة مفرداته من دون الإحساس بنوع من الصعوبة في إيجاد عناصر تمنحه ما يلزم من الصدقية؟ أليست الظرفية التاريخية والسياسية والتواصلية التي نعيش تضع المرء في موقف أقرب إلى الإرباك منه إلى الاطمئنان والوضوح؟
ثمة اقتناع انتشر منذ أكثر من عقد، في الكثير من الساحات كما في المغرب، بأن النخب تعيش حالة حيرة مُعمَّمة، بل وتواجه حالة عجز إزاء القوة الجارفة للحس المشترك (وهو ما يتعارض مع الحس النقدي)، ولِما أصبح يُنعت بالتفاهة، في الكلام، وفي السياسة، وفي الفن، وفي غيرها من المجالات التي ازدهرت فيها على نطاق واسع، حيث تلقفتها جماهير غفيرة، تلوكُها وتنشر مضامينها بكل الطرق التي أصبحت تتيحها وسائط التواصل اليوم.
هل بوسعنا تقديم تشخيص وتحليل لهذه الظرفية، وبناء خطاب مناسب يمكنه توجيه إمكانيات النقد ويسعف في توجيه نمط مغاير من الحضور في المجال العام، وإذا تمت عملية البناء فما هي الوساطات التي يمكن الاستناد إليها قصد توصيل لغة هذا النمط وتعميمه؟
أغامر بطرح هذا السؤال لأن مؤشرات عدة تدعو إلى نوع من الحذر باعتبار أن المرحلة الحالية لا تساعد، بشكل معقول ومُناسب وبنَّاء، على الانخراط في التزامات واضحة، وإن كانت الحاجة إليها تستدعيها بلا شك. فأغلبنا يرى أن وضعنا يقتضي تجريب طرق ما للمشاركة بالرأي النقدي، والتدخل في المجال العام، والجهر بما نفكر فيه من أجل خلخلة مظاهر التسطيح، والتكلُّس الخطابي، والتفقير السياسي، والتبرير الفج، والدعاية المُمِلة. غير أن من يُعبر عن الرغبة في تغيير هذه الوضعية يجد نفسه أمام غلبة مختلف تمظهرات تدوير الكلام، والتكلس، والتبرير، والدعاية التي ترفع من منسوب الصعوبات التواصلية، وتضاعف من شروط تغيير هذه التمظهرات.
من جهة أخرى يستدعي المقام الحاجة إلى التمييز المطلوب بين ما يندرج ضمن ما تستلزمه الروح النقدية، سواء انطلقت مما هو ذاتي أو ما ينصبُّ على ما هو عمومي، وهي روح تجمع بين الاجتهاد الفكري والفعالية الثقافية والهدف السياسي؛ وبين ما تقوم به ما تبقى من قوى المعارضة من تدخلات، وإجراءات، وما تتخذه من مواقف مُتبرمة أو معارضة للاختيارات الحكومية، في وقت حصلت على لغة المعارضة تحولات قاموسية ودلالية وتداولية جعلتها، هي ذاتها، معرضة للتسطيح، والإفقار، والتكرار، مهما بلغت حدة اللهجة الاعتراضية على السياسات والقرارات موضوع الاعتراض.
كما أنه لا مناص، ونحن نواجه موضوع الروح النقدية، من استدعاء مختلف تعبيرات الاحتجاج الذي يحصل هنا وهناك في المدن والبوادي المغربية؛ حيث تُنظَّم وقفات، ومسيرات تطالب بتلبية مطالب حيوية من قبيل بناء طرق ومستشفيات ومدارس، وتوفير وسائل نقل، ومحاربة الفساد المُعمَّم. وهي مطالب يرفعها سكان قرى وأحياء في مدن بطريقة جماعية، بما فيها تنظيم اعتصامات أمام مقار عمومية لتبليغ احتجاجاتهم ورسائلهم؛ قد تصل هذه التحركات إلى مستوى تنظيم مظاهرات واسعة، كما حصل في 20 فبراير 2011 وما تمخض عنها من مستجدات قانونية وسياسية في المغرب؛ وحراك الريف، واحتجاجات آيت بوكماز، وظاهرة جيل Z 212.
الحاجة إلى التمييز الضروري بين ممارسة النقد، والمعارضة، والاحتجاج، تفترض العودة إلى تاريخ الاحتجاجات والإضرابات الوطنية في ثمانينيات القرن الماضي ومآلاتها؛ غير أن حركية اجتماعية واسعة ذات طبيعة احتجاجية انطلقت في المغرب، منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي، تزعمها الشباب الذين تخرجوا من الجامعات حاملين دبلومات عليا ومطالبين بالحق في التشغيل ومنتقدين، في شعاراتهم ورسائلهم، السياسات العمومية في مجال التعليم والشغل؛ كما أن حركة 20 فبراير خرجت من أحشائها نخبة من الشابات والشباب برهنوا على اقتدار كبير في تشخيص ونقد ما يشهده المجتمع السياسي من وقائع وتناقضات، وانخرطوا في النقاش العمومي في مختلف وسائل الاتصال بطرق ارتقت بلغة الحوار والحِجاج إلى مستوى أثار انتباه المراقبين لتحولات الخطاب السياسي في المغرب وتطوراته.
أما على صعيد الأشكال التعبيرية الفنية في الفضاء العمومي، فلا شك أن فنون الغرافيتي، وموسيقى الراب، ومسرح الشارع، والسينما وغيرها من الحقول الإبداعية شكَّلت، منذ بداية الألفية، وسائل تعبير عن أفكار وآراء ومواقف الشباب مما يشهده المغرب من تفاوتات، وتضارب مصالح، وتعسف، وانسداد الآفاق أمامهم.
ومن الملاحظ أن احتجاجات الشباب تتساوق دوما مع إحساس دفين باستخفاف الفاعل السياسي بوضعيته وبوجوده، وبتنامي وتوسُّع روح نقدية تستلهم "قيم حقوق الإنسان"، حيث إن جل الفاعلين من مثقفين، وأحزاب، ونقابات، وجمعيات، وتنسيقيات وتجمعات شبابية لا تخضع لصيغ التنظيم التقليدية، جعلوا من هذه القيم مرجعيتهم الرئيسية في المناقشات العمومية وفي مطالبهم المعلنة. وعلى الرغم من المقومات التي ترتكز عليها هذه المرجعية بكل أجيالها، من حرية، وعدالة، وكرامة، ومساواة، وغيرها من القيم، فإن استثمارها من جهات انْتَهَكتْها وحاربتها، جعلت الاستعمال العمومي لهذه المرجعية تعبر، في الكثير من الحالات، عن خلط في المواقف والتموقعات، وعن نوع من "الإجماع الرخْو" حول مبادئ نبيلة وظفتها جهات تمارس سياسات لا تستجيب لروحها ولمقتضياتها.
لذلك أحسب أن الحديث عن الحرية، أو الروح النقدية في المجال العام، اليوم، يفترض استحضار التاريخ الطويل من سياسات الخلط، ومن الحرب التي تعرض لها الذكاء المغربي من طرف جهات ومؤسسات تشهر، حسب ظرفيات وسياقات بعينها، كل ما تملك من قوة لمحاصرة الحرية، سواء أتعلق الأمر بحرية القول والتعبير أو بحرية الإبداع والثقافة النقدية، بدعوى أن من يحملها يشكل مصدر إزعاج يتعين محاصرته أو الحد من مساحات التعبير لديه. والمؤكد أن هذا الاختيار السياسي نؤدي بسببه أثمانا ظاهرة في سياستنا وثقافتنا، وفي طرق حضور الذاتية المغربية أمام ذاتها وأمام العالم.
ولعل ما عبر عنه جيل زيد 212 وما برهن عليه من ملامح وعي سياسي ومدني يمكن أن يشكل مناسبة للفاعلين السياسيين لتغيير الأساليب المتعالية التي ينهجونها في تعاملهم مع التعبيرات الاحتجاجية للشباب المغربي؛ وأن يجعلوا منها فرصة لمحاسبة الالتزامات التي أطلقهوها طيلة سنوات من دون نتائج اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية عادلة، وأن يغتنموا هذه المناسبة لمواجهة صُورهم كما تبدو لهم حقَّا في المرآة.