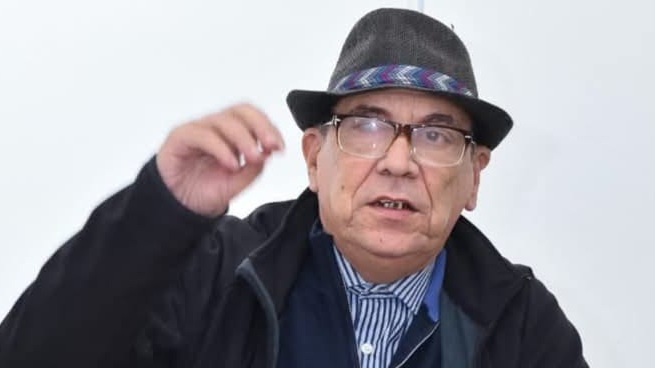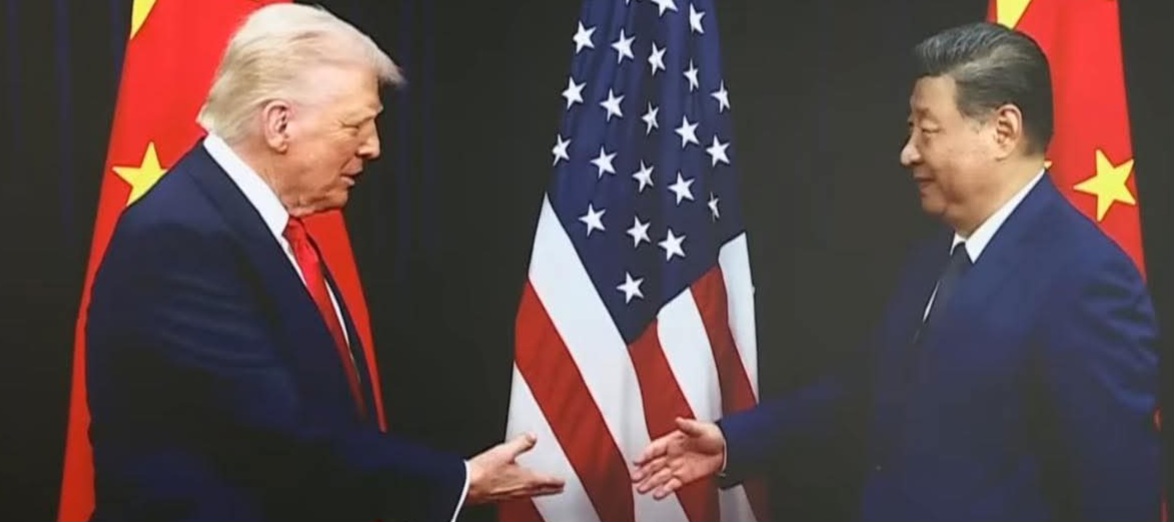الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، أي أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش إلا في وسط اجتماعي، ولا يستطيع تحقيق أغراضه، دون تواصل وتفاعل مع غيره من البشر.
ومن المعروف أن المجتمع وتنظيمه هو ضرورة إنسانية، كما بين ذلك ابن خلدون عندما قال: " أن الاجتماع الإنساني ضروري، ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم: الإنسان مدني بالطبع". ومن الأسئلة المتكررة في هذا الصدد: هل المجتمع أهم من الدولة؟ وهل قوة المجتمع أهم من قوة الدولة؟ وما الذي يجعل المجتمع قويا؟ وأين نحن من المجتمع الذي نريد؟
من أبرز المفكرين الذين تطرقوا بإسهاب لموضوع العلاقة بين المجتمع والدولة نذكر عالم السياسة الأمريكي، جويل مجدال Joel Migdal ، في كتابه "مجتمعات قوية ودول ضعيفة: علاقات الدولة والمجتمع وقدرات الدولة في العالم الثالث". والذي صنف الدول والمجتمعات في التاريخ الى أربعة نماذج هي: دولة قوية ومجتمع قوي، ودولة ضعيفة ومجتمع ضعيف، ودولة قوية ومجتمع ضعيف، ودولة ضعيفة ومجتمع قوي.
وبالتأكيد الحالة المثالية هي دولة قوية ومجتمع قوي، والتي تليها هي دولة ضعيفة ومجتمع قوي، أما حالات ضعف المجتمع فهي مقدمات لانهيار كل من المجتمع والدولة.
ويضيف الأستاذ جويل في دراسته، أن قوة المجتمع هي الأساس سواء أكانت الدولة قوية أم ضعيفة، لأنه بدون قوة المجتمع لن تستطيع الدولة الاستمرار. والدولة القوية هي التي تعمل على جعل مواطنيها أقوياء، لأن قوة الدولة من قوة مواطنيها. وعلى العكس من الدولة القوية، فإن الدولة الضعيفة هي التي تجعل من سكان الدولة ضعفاء، وتسلبهم روح المواطنة، لأن الدولة الضعيفة هي التي تخشى المواطنين الأقوياء، ولهذا فهي تلغي المواطنة.
والمجتمع دائما أهم من الدولة وقبلها، لذلك لم يكن قديما اهتمام الأنبياء والرسل ببناء المجتمع وتربيتها من قبيل المصادفة، بل كانت استراتيجية فعالة لبناء المجتمع القوي الذي يسبق النهوض ويقوده، فكانوا يبدؤون بتصحيح الأفكار التي تشكل تصورات الناس وأسس التفكير لديهم، مع الجهد في إصلاح أخلاق المجتمع وتربيته على القيم المشتركة، ومحاربة مظاهر فساده.
وثمة عوامل مختلفة تجعل المجتمع قويا أو ضعيفا منها: مكانة العلم والمعرفة، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، والمشاركة المدنية، والمسؤولية الاجتماعية، واحترام المرأة وتمكينها، ومنها أيضا الابتكار والتكنولوجيا في الوقت الحاضر.
وسأكتفي هنا بالتطرق للعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، واحترام وتمكين المرأة كأهم الركائز الاجتماعية التي لابد من توافرها لتحقيق قوة المجتمع.
أولا-تحقيق العدالة الاجتماعية: للعدالة الاجتماعية عدة تعاريف ومن أكثرها شيوعا واتفاقا تعريف للفيلسوف الليبرالي الأمريكي جون رولز، الذي عرفها بأنها” تمتع كل فرد في مجتمع بالمساواة في نيل فرص العمل المتاحة للفئات المميزة“. ويضيف جون رولز، أن الوثيقة الدستورية التي تعد العقد السياسي والاجتماعي بين الشعوب والسلطات، يجب أن تتأسس على أمرين:” الأول تداول السلطة والثروة كعنصرين لا ينفصلان“.
وعموما يقصد بالعدالة الاجتماعية تلك الحالة التي ينتفي فيها الظلم والقهر والحرمان من الثروة أو السلطة أو من كلتيهما، والتي يغيب فيها الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي وتنعدم فيها الفوارق الطبقية غير المقبولة بين الأفراد والجماعات والأقاليم.
ويعد الفقر من بين أهم التحديات التي تواجه تحقيق العدالة الاجتماعية بالمغرب، لأنه يتسبب في حرمان عديد من المواطنين من فرص التعليم الذي تحول إلى سلعة مكلفة تستنزف الأسر وترهق ميزانيتها، مما عمق التفاوت الاجتماعي أكثر فأكثر.
يستنتج مما تقدم، أن العدالة الاجتماعية لا تحقق على أرض الواقع، إلا في الدولة الدستورية التي تطبق الدستور والقانون على أساس حقوق المواطنة، ويستحيل تحققها في مجتمع يتآكل وينخره فيروس الفساد المتعدد الأشكال، مجتمع تستغله طبقات برجوازية طفيلية نهابة منها طبقة عقارية ومالية وبيروقراطية إدارية، جنت بسرعة فائقة ثروات مالية ضخمة، بمقابل ذلك تشهد الطبقات الوسطى والفقيرة تدهورا في الأحوال المعيشية.
ظل هذا الواقع المرير يطرح التساؤل؟ كيف تتحقق العدالة الاجتماعية والمواطن يضحي بنفسه، وبالتالي يفقد حياته لأنه لا يستطيع أن يدفع ثمن العلاج ببلده.
ثانيا- تحقيق تكافؤ الفرص بين أطياف المجتمع: إذا كانت العدالة الاجتماعية تعني أن حقوق جميع الناس في المجتمع تؤخذ بعين الاعتبار بطريقة عادلة. فإن مبدأ تكافؤ الفرص بمعناه البسيط التساوي بين جميع أفراد المجتمع في المجالات المختلفة، لاسيما في مجالات التعليم والصحة والشغل والترقية الاجتماعية.
ومبدأ تكافؤ الفرص يقتضي عدم التمييز بين المواطنين لأي سبب كان وإتاحة نفس الفرص لجميع الأفراد الذين يملكون نفس المؤهلات التي تؤهلهم من تحقيق أهدافهم وحقهم في الانتفاع من الخدمات بنفس المستوى التي توفرها الدولة.
جاء في الفقرة الثانية من الفصل 35 من دستور 2011، أن” تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا".
لكن رغم ما تحقق من تطورات على صعيدين الدستوري والقانوني، إلا أن هناك تحديات ما زالت تعرقل تحقيق الأهداف المرجوة، ومن أبرزها الواسطة والمحسوبية المتجذرة بالمغرب، والتي تلغي مبدأ تكافؤ الفرص، وتضعف ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، فضلا عن ضعف الثقافة القانونية، إذ لا يدرك الكثير من المغاربة حقوقهم وواجباتهم، مما يؤدي إلى ضعف قيم المشاركة والتماسك والتضامن.
ثالثا-احترام المرأة وتمكينها: المرأة نصف المجتمع، والمرأة هي الأم والأخت والزوجة وهي من يصنع المجتمع وهي من يصنع الحياة. واحترام المرأة والاعتراف بدورها وتمكينها في المجتمع هو من مفاتيح القوة والتقدم.
واحترام المرأة يعنى أن تتمتع بكافة حقوق المواطنة دون تفرقة أو تمييز وأن تمارس واجباتها، تشمل قدرتها على الإسهام في اتخاذ القرارات الخاصة والعامة، وعلى دفع التنمية الاقتصادية والبشرية والثقافية.
وتمكينها يعنى أن نمكنها من ممارسة مسؤولياتها بقدرة وكفاءة. والكفاءة والعمل الجاد والانضباط في العمل وحسن التعامل مع المواطنين هي المعيار بغض النظر عن أي اعتبارات اخرى.
وتمكين المرأة اليوم ليس خيارا، بل أمر ضروري لبلوغ التنمية المنشودة. فعندما تتمتع المرأة بفرص متساوية في الحصول على التعليم والفرص الاقتصادية، يمكنها المساهمة في خلق مجتمع أقوى وأكثر عدلا.
ختاما، المطلوب دولة قوية ومجتمع قوي ومستدام، وفي المغرب نحن بحاجة أشد إلى مجتمع أقوى. وهذه من الضرورات لمن يطمح للالتحاق بركب الدول القوية في هذا القرن.