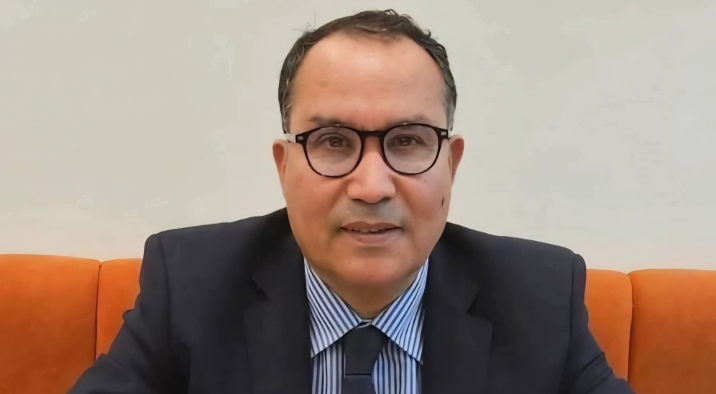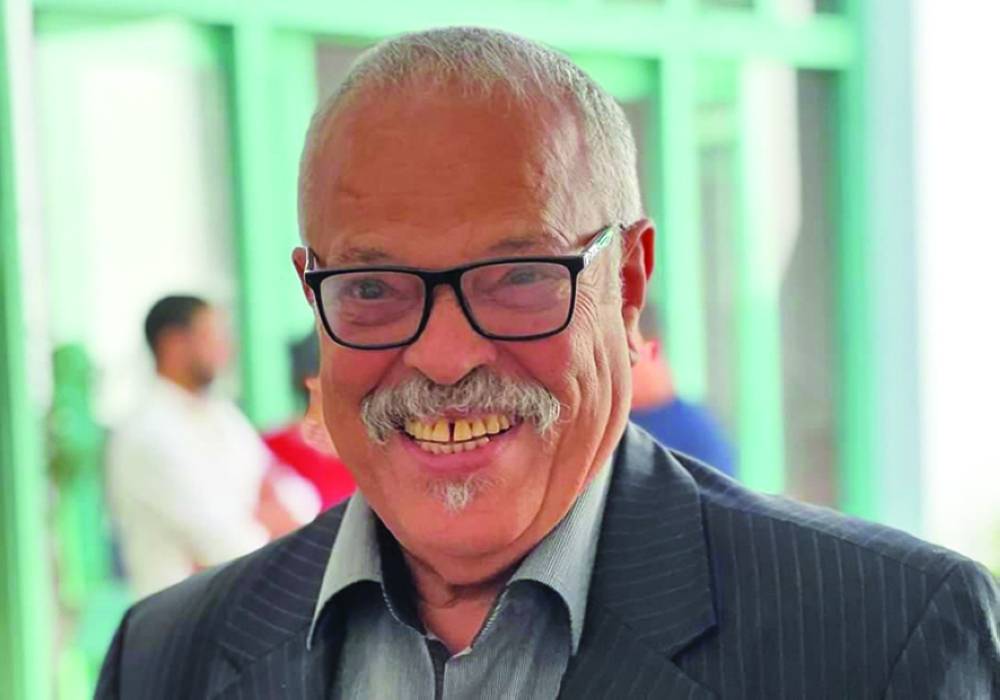ما حدث في إحدى المؤسسات الجامعية بالقنيطرة، حين أُدرجت "فرقة الشيخات" ضمن برنامج حفل التخرج، وما شهدته مؤسسة تعليمية بالدار البيضاء باستدعاء شيخة لتنشيط حفل التميز بحضور آباء وأولياء التلاميذ، لا يمكن اعتباره مجرد سهو تنظيمي أو اجتهاد خاطئ في البرمجة، بل هو مؤشر مقلق على غياب الحس التربوي والثقافي العميق، وعلى منحدر خطير في إدارة مؤسساتنا التعليمية، وعلى التباس خطير في فهم رمزية الفضاء الجامعي والتربوي ودوره في المجتمع.
الذي جرى مؤخرا من استقدام مجموعة من الشيخات إلى جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وأيضًا إلى مؤسسة تعليمية بمناسبة حفل تميز، أثار موجة من الانتقادات والاستغراب.
والحقّ أنني لست مع العديد من الانتقادات السطحية، التي تمزج بين الفن والانحراف، وتختزل "الشيخة" في صورة مشوهة وذكورية، باعتبارها أداة لـ"هزّ البطن" و"التحريض على الفجور"، وهي مقاربات لا تعي البعد الرمزي والتاريخي لهذا الفن الشعبي. وتتناسى أن الشيخات هن من يزينن أبهى حفلاتنا الحميمية بلا عقد، لكن، في المقابل، لا يمكننا أيضا أن نغفل عن إشكال اختلاط الفضاءات الرمزية، وعن سؤال السياق.
ليست الجامعات والمدارس مجرّد بنايات، إنها رموز، أماكن لها قداسة مدنية، مثلها مثل المساجد والمحاكم والمكتبات. إنها الفضاء الذي نؤمن فيه، ولو بشكل رمزي، أنّ العقل له السيادة، وأن المعرفة لها الهيبة. لهذا يُطلق على الجامعات أسماء مثل "المنارات"، و"الحرم الجامعي" و"المعاهد" و"المدارس العليا"، دلالة على علوّ القيمة لا على ارتفاع الطوابق.
حين نستقدم فنًّا مثل فن الشيخات إلى هذا الفضاء، نُهين الفن الشعبي ذاته، ونرتكب خطأ في العنوان وخلطًا في المعاني. الشيخة تُكرّم في المهرجانات، في الساحات، في حفلات الزفاف، في أمسيات الاحتفالات الخاصة... هذا لا يسيء لا للشيخات ولا لهذه الفضاءات.
السياق القانوني والاعتباري للمؤسسات التعليمية
إن ما جرى في جامعة ابن طفيل، أو غيرها من المؤسسات التعليمية التي استقدمت عروضًا غنائية ل"الشيخات" في مناسبات تربوية، يطرح أيضًا سؤال الضوابط القانونية والتربوية المؤطرة لاستخدام فضاءات التعليم.
إن ما جرى في جامعة ابن طفيل، أو غيرها من المؤسسات التعليمية التي استقدمت عروضًا غنائية ل"الشيخات" في مناسبات تربوية، يطرح أيضًا سؤال الضوابط القانونية والتربوية المؤطرة لاستخدام فضاءات التعليم.
فالمؤسسات التعليمية، حسب الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والقانون الإطار رقم 51.17، ليست فقط أماكن لتلقين المعرفة، بل هي فضاءات لصناعة المواطن المسؤول، وترسيخ قيم الانضباط، الاحترام والاجتهاد. وكل نشاط يتم تنظيمه داخلها، يجب أن يكون منسجمًا مع مبدأ التناسق البيداغوجي، والقيم الكونية والوطنية التي تدعو لها المنظومة التربوية، ومنها: الحرية، الكرامة، والاحترام.
لكن الحرية التربوية لا تعني العبث بالمقامات الرمزية، ولا استغلال المناسبة لتسويق الفرجة المجانية. بل إن الدليل التنظيمي للأنشطة الموازية، الصادر عن وزارة التربية الوطنية، يوصي بأن تكون الأنشطة داخل المؤسسات التعليمية داعمة للمنهاج، وأن تراعي الخصوصية الثقافية والسياقية للفضاء التربوي وتخضع لموافقة لجان مختصة.
إضافة إلى ذلك، فإن الفصل 7 من القانون الداخلي النموذجي للمؤسسات الجامعية، يشدد على ضرورة احترام الطابع العلمي والثقافي والجامعي للمؤسسة، والحفاظ على هيبتها.
وبالتالي، فإن تنظيم حفلات رقص شعبي داخل مؤسسة للتعليم العالي، دون بُعد فني مدروس أو سياق ثقافي واضح، يدخل في باب الإخلال بالوظيفة الاعتبارية للجامعة.
من الناحية التربوية، أيضًا، يُعلّمنا علم بيداغوجيا الفضاء أن الأماكن ليست حيادية، بل تشكّل وتوجّه السلوك. ففضاء القسم مختلف عن فضاء المسرح، وفضاء المسجد مختلف عن فضاء الملعب. وعليه، فإن تحويل فضاء جامعي إلى منصة رقص، يُربك التمثلات التي يجب أن يحملها المتعلم عن مؤسسته، ويُساهم في تفكيك الرمزية التربوية التي بُنيت عبر سنوات. نحن لا نرفض "الشيخة"، بل نرفض سوء تموضعها. ولا نذمّ الفرح، بل نطالب بتمييز الفرح التعليمي عن الفرجوي.
لذلك، فإن من مسؤولية الإدارات التربوية، والمجالس الجامعية، أن تتدخل ليس لمنع الفنون، ولكن للتفريق بين السياقات، وحماية الهيبة الرمزية للمؤسسات، باعتبارها مؤسسات للدولة والعقل والمعرفة، لا مسارح مؤقتة للفرجة.
المؤسسات التعليمية هي معمل رمزي يُنتج المعنى
لا يتعلق الأمر إطلاقًا بالحكم على فنّ الشيخات في حد ذاته، ولا بإصدار موقف أخلاقي أو ثقافي إقصائي، كما قد يُفهم خطأً. فنحن لا ندين "الشيخات" كفن شعبي له جذوره وشرعيته الاجتماعية والتاريخية، بل ننتقد فقط "سياق استدعائه" و"المنصة التي يُقام عليها". هناك فرق بين فضاء الأعراس أو الساحات العمومية، حيث يتجذر هذا الفن في طقوس الفرح الجماعي، وبين الفضاء الجامعي والتربوي، الذي يُفترض فيه أن ينتج رمزية مغايرة، ويؤسس لذاكرة معرفية لا لذاكرة الفرجة.
لا يتعلق الأمر إطلاقًا بالحكم على فنّ الشيخات في حد ذاته، ولا بإصدار موقف أخلاقي أو ثقافي إقصائي، كما قد يُفهم خطأً. فنحن لا ندين "الشيخات" كفن شعبي له جذوره وشرعيته الاجتماعية والتاريخية، بل ننتقد فقط "سياق استدعائه" و"المنصة التي يُقام عليها". هناك فرق بين فضاء الأعراس أو الساحات العمومية، حيث يتجذر هذا الفن في طقوس الفرح الجماعي، وبين الفضاء الجامعي والتربوي، الذي يُفترض فيه أن ينتج رمزية مغايرة، ويؤسس لذاكرة معرفية لا لذاكرة الفرجة.
حين نختار أن نُحيي حفل تخرج جامعي بفن احتفائي شعبي ذي طابع جسدي، فإننا نربك المعنى التربوي، ونبعث برسائل ملتبسة للطلبة وللرأي العام. هل نحن هنا لنتوّج سنوات من المثابرة الفكرية والمعاناة العلمية، أم لنكافئ الطلبة على صبرهم بالرقص والغناء؟ هل نغرس فيهم صورة الجامعة كفضاء للتحوّل المعرفي والنقدي، أم نغريهم بثقافة الترفيه السطحي؟
الأمر أعمق من مجرد اختيار فني، إنه سؤال في الرمزية التربوية، فالجامعة ليست مجرد مكان لتلقين المعرفة، بل هي معمل رمزي يُنتج المعنى ويعيد تشكيل المخيال الجماعي. وكل لحظة فيها – بما فيها حفلات التخرج – يجب أن تترجم هذا البُعد الرمزي، لا أن تُقوضه.
من السهل أن نقول إننا نريد "تقريب الجامعة من الناس"، لكن أليس من واجبنا أيضًا "تقريب الناس من المعنى"؟ الجامعة ليست نادٍ ثقافي ولا مسرحًا عشوائيًا للفرجة، بل هي فضاء يُفترض فيه أن يرتقي بالذوق وبالرمزية وبالأسئلة. لذلك، كان الأولى أن يُحتفى بالتميز بمحاضرة نوعية، أو بلقاء مع شخصية فكرية ملهمة، أو بعرض فيلم وثائقي يستعرض رحلة الطلبة، أو حتى بلحظة تأمل جماعية تُستعاد فيها المسيرة الأكاديمية بكامل رهاناتها.
ثم إن هناك مفارقة خطيرة في هذا التناقض التربوي الصارخ تعكس خلطًا في الخطاب وتضاربًا في الرؤية: هل نريد جامعة تنتج الوعي أم جامعة ترقص على شفير الفراغ الرمزي؟
لسنا ضد الفنون بل ضد الابتذال الرمزي حين يحلّ محلّ الاعتراف المعرفي. لسنا ضد الفرح بل ضد أن يُصاغ الفرح بأدوات لا تحترم السياق ولا المقام. لسنا ضد الثقافة الشعبية، بل ضد توظيفها خارج مواضعها، حين تصبح وسيلة لتجميل هشاشة رمزية لا لبناء وعي.
لا يختلف اثنان على أنّ "الشيخة" ليست رمزًا للانحطاط بل هي وريثة تقاليد فنية شفهية وشعبية لها جذورها في الوجدان الجماعي المغربي. هي امتداد لصوت الأرض، وذاكرة الأفراح، وشاهدة على تاريخ اجتماعي عميق امتزج فيه الغناء بالحكي، والرقص بالوجدان.
لكن السؤال الأهم ليس: هل "الشيخة" فن هابط أم لا؟ بل ما موقع هذا الفن؟ وأين يجب أن يُحتفى به؟ وهل يجوز استدعاؤه داخل أسوار المؤسسات التعليمية والجامعية؟
أعتبر أن المشرفين على تنظيم حفل مؤسسة جامعية بالقنيطرة أو مؤسسة تعليمية في حفل التميز، أخطأوا العنوان وافتقدوا للحس الثقافي والأخلاقي، ليس مكان فرق الشيخات هو الجامعات والمؤسسات التربوية، لأننا حين نضع الشيخات أو غيرها من الفنون ذات الطابع الحميمي والاحتفائي في منصة تخرج جامعي، فإننا نربك المعنى، ونبعث برسائل ملتبسة:
هل نمنح الطلبة ذاكرة معرفية أم نغريهم بثقافة الفرجة؟
فلكل مقام مقال، ولكل سياق دلالته. وحين نحاول تزيين الحفل الأكاديمي بفنّ شعبي، فإننا في الحقيقة نُسطّح وظيفة الجامعة نفسها، ونختزلها في مجرّد منصة ترفيه، بدل أن تظل منارة فكر ونقاش وحوار عميق.
إن استحضار التراث الشعبي، بما فيه فن الشيخات، في المناهج والبرامج والمقاربات البيداغوجية، واجب وضروري، لكن في إطاره المعرفي والنقدي. أما أن يُحوّل إلى عرض احتفالي في قلب المؤسسة التعليمية، فذاك نزول بالمدرسة إلى لغة الفرجة، بدل ارتقاء بالمجتمع إلى لغة الفكر.
إن الجامعة – في كل دول العالم التي تحترم نفسها – تحتفي بتميزها بإعلاء المعرفة، تنصت لصوت المفكر، تُعلّي من مقام الفكر... ولكل رمزية سياق، ولكل فضاء لغته الخاصة. فأعيدوا للجامعة هيبتها الرمزية، فهي ليست مجرد بناية بل معمارٌ للمعنى.
عن جريدة "العلم"/ العدد 26070