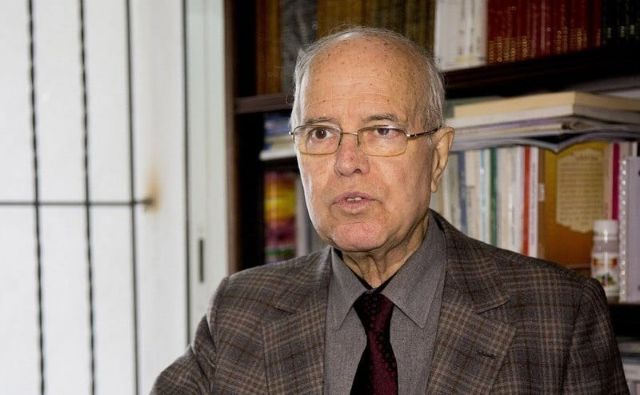منذ الزمن الأول ارتبط الغذاء بالإنسان؛ واستطاع الغذاء والطعام والمطبخ عبر التاريخ الطويل للإنسانية أن يعكسوا في الآن نفسه حياة بيولوجية وثقافية وتصورات تخص المجموعات البشرية المتعاقبة على الأرض.
ولهذا اعتبر الغذاء، وما يرتبط به من عمليات متداخلة ومترابطة من إنتاج وتخزين وإعداد وطهي وتقديم وتدوير، أرضية لقراءاة توازنات المجتمع وعلاقاته وامتداداته وتوتراته عبر الراهن والزمن المنصرم والمستقبل المنتظر.
ولعل هذا الطرح هو ما تعكسه مسارات البناء الثقافي لمجتمع ما في علاقته بالغذاء؛ ذلك أن المثن الغذائي يتجاوز في معناه وحدود دلالاته ليشمل المثن الاجتماعي والديني والاقتصادي والسياسي والنفسي، كما يؤكد ذلك عالم الاجتماع المغربي عبد الرحيم العطري.
إن الحديث عن الطعام والغذاء، هو حديث بالأساس عن أرشيف ممتد ومفتوح من التصورات والممارسات والعلاقات والتوازنات والرغبات المكبوثة والمعلنة؛ كما أن المطبخ يعد بصريح القول مختبرا لصناعة المعنى؛ فالتعامل مع الطعام لا يكون في مبعد عن النسق الثقافي الذي ينتمي إليه الشخص الذي يحقق فعل الإطعام، وينتج الطعام ويعده ويقدمه ويعيد انتاجه وتدويره باعتباره فاعلا غذائيا.
وإذا كان الفاعل الغذائي استطاع عبر حقب أن ينتقل من الحالة الطبيعية إلى الحالة الثقافية المؤطرة في التعامل مع الطريدة والغذاء؛ فإنه تحت هذه الزاوية يحقق بذاك صيغا متعددة للعبور، من التزود بالطعام والأكل من وضع النهش والتسابق عليهما والتصارع من أجلهما، إلى وضع الالتزام بالقواعد وآداب الطبخ والمائدة والإطعام.
إن ما يعكس أيضا حجم التفكير الاجتماعي المرتبط بالغذاء والمطبخ والطعام، هو كم الإنتاج الشعبي المتعلق بهذا المكون الحياتي؛ ذلك أن الطعام والأكل يعاد انتاجهما في الأمثلة الشعبية وفي الحكي مقترنين بالنعمة والرزق والعطاء، وبغير قليل من مفاهيم الرجاء والتمني والتقدير.
وارتباطا بتيمة الغذاء ذاتها، فإن الإنسان عبر تطوره واستمراره عبر الفضاءات والأزمنة، كان دائما يعطي للطعام مكانته وفضله لدرجة أننا نقوم بتقبيله عندما نجده في غير مكانه فيما يشبه الاعتذار منه وطلب الصفح عن التقليل من شأنه. وكان هذا الأخير يصاحب عددا وافرا من طقوس العبور وأزمنة المقدس من زواج وولادة وموت ونعي واستبراك وامتلاك.
ومن بين الأوقات التي يكون للطعام فيها مكانا ذا دلالة اجتماعية، تبرز المناسبات المرتبطة بالفرح والقرح؛ إذ تصبح العادات الغذائية والاختيارات بمدلولات وظيفية وبمحددات موازية للفعل المحتفى به أو للحزن المعبر عنه؛ فيغلف الإحساس المعني بأمر المناسبة بطعم الطعام المواكب له والحامل لدلالات توازيه؛ لأن الطعام رغم شكله الجامد والثابث في أحايين كثيرة، يكتسي معنى اجتماعيا ودلالات نفسية فقط لأنه بكل بساطة ليس هناك طعام صامت.
وبالعودة للقول الشعبي؛ فإن التداول اللساني المغربي يزخر بعدد من الجمل والتعابير ذات ارتباط بالغذاء والطعام، تسهم في موقعة هذا المكون بالمقارنة مع الذات والآخر والزمن نفسه؛ هذا ونجد من ضمن هذه التعابير ما يحفظه اللسان الدارج من تلفظ وألفاظ حول الموضوع وذلك من قبيل :
- "الجوع ما يكرو فيه الكريصات" : ما يعني أن القطع الصغيرة من الخبز لا تكفي لسد الجوع.
- " الى كليتي دجاج الناس سمن دجاجك" : ما يعني إذا استضافك الناس على مائدة غذائهم، فحضر نفسك لاستضافتهم وإطعامهم .
- " حولي عيد الاضحى كيبان في آخر زلافة ديال حريرة رمضان" أي أن التفكير في عيد الأضحى باعتباره مناسبة أكل وشرب وغذاء وذبيحة، يبدأ من نهاية رمضان، وهنا نستشف علاقة الأكل والغذاء والتحضير له والتفكير فيه بدورة العام وبالزمن الاجتماعي والغذائي على وجه العموم.
وبالعودة لغذاء ومائدة المناسبات؛ فيمكن القول بالاستناد لملاحظة فاحصة لعادات الأسر المغربية بالحواضر والبوادي أن الغذاء يتسم بتنوعه وبغناه وبارتباطه بدورة الانتاج الفلاحي والحيواني. فعلى سببل المثال ارتبط الاحتفاء بحفظ القرآن الكريم بتوظيف موائد غذائية ذات صلة وطيدة بالأرض؛ إذ تقدم أسر حفاظ القرآن أنواعا من الحساء والعصيدة والذرة والحليب والثمر، وهي أطعمة منها ما له صلة بأرض المجال حيث تقدم.
أما مناسبات الحزن والفقد؛ فتتميز بتوظيف طعام ذي خصوصية ترتبط بالوضع العاطفي الخاص بالمناسبة؛ كما هو الحال للموت باعتباره حالة تحول، وطقسا من طقوس العبور نحو عالم البقاء والحقيقة، وجسرا نحو " دار الحق" وخروجا من " دار الباطل". وبملاحظة التفاعلات الاجتماعية في علاقتها بالغذاء بمجال عبدة في السياق المذكور، يمكن أن نسجل المنطلقات التالية :
- لا يخلو الاحتضار، باعتباره حالة سابقة عن الموت والعبور نحو العالم الآخر من توظيف للغذاء؛ إذ يتم توظيف الماء على سبيل المثال لا الحصر بأشكاله المتاحة كتقطير ليشربه المحتضر. ويتم أيضا تقطير ماء زمزمز في فم المقبل على الموت، وذلك لارتباط هذا الماء المقدس بركن الحج وبالتمني وتحقيق الرغبات، وبطهارة الجسد والروح التي يجسدها التواجد بالبيت المعمور.
- يحرص أهل المحتضر وزواره على الاستجابة لطلباته فيما يتعلق بالغذاء؛ فقد يطلب المحتضر كأس لبن مثلا أو كأس حليب أو بعضا من طعام الكسكس أو أكلة تقليدية محددة. ويتسم التعاطي مع طلب المحتضر بالضرورة، تحت طائلة قراءات نفسية وتطهيرية ترتبط بالاستجابة لرغبة الجسد المقبل على الموت، في ظل بروز خطابات من قبيل " خاطرو بغات" " منردوهاش في وجهو أو وجهها" " بغات تبرد حرارة الموت"، في إشارة صريحة لعدم معاكسة رغبة المحتضر فيما يريد وتلبية طلباته بدون تلكؤ، خاصة وأن زمنه بالدنيا أصبحت ساعاته معدودة على رؤرس الأصابع.
- إذا كان من عادات ساكنة عبدة الاحتفال بالمناسبات السعيدة الدينية منها وغيرها، بتوظيف مأكولات بتمايز ملحوظ وحلويات متنوعة ك"الكعك" و"كعب الغزال" وحلوة "ريشبوند" و"الكاطو" و"الماصابان" و"الغريبة" و"البهلة" و " القريشلات " باعتبارها من بين حلويات معروفة بعبدة صنعا واستهلاكا وتسويقا؛ فإن الطعام المرتبط بالمآثم يتسم عموما بطابع التواضع والبساطة مع بعض الاستثناءات تخص أسرا وشرائح اجتماعية تختار الاجتهاد في تقديم الطعام الجنائزي، وذلك اعتبارا للقيمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيش على إيقاعها هذه الأسر.
- تعرف مجالات واسعة من قبيلة عبدة توظيف الكسكس مباشرة بعد وفاة الميت؛ حيث يعد الجيران أطباقا منه لتوفيره كطعام لمقدمي واجب العزاء ولأهل الميت أنفسهم، لأنه من الصعب على أسرة الميت أن توفر الطعام بالشكل المطلوب في فترة حزن على الفقد، وانتقال روح وجسد الهالك من حالة الدنيا والزوال إلى حالة الأزلية والخلود.
- تعكس المقولة الشعبية " ميمكنش تاكل طعام مطبوخ بالدموع" المتداولة بمجال عبدة، فهم الناس للعسر المسجل لدى عائلة الميت في الجمع بين حالة الحزن وحالة إعداد الطعام، وتحضير الموائد للزوار و" أصحاب (العزو) العزاء"، وبالتالي فالناس يساهون في سد الخصاص الحاصل لدى أهل المتوفي بتوفير الطعام المرجو والمنتظر.
- يطلق على الطعام المخصص لعائلة الميت بدائرة جزولة وبمناطق أخرى من عبدة " لقمة زكوم " أي لقمة العزاء والوفاة. وفي تصغير الطبق وتوصيفه باللقمة تصغير للأكل والتمتع به في حضرة الموت هادم اللذات، وتكبير لحجم الحدث وقيمته.
- خلال اليوم الأول الذي يصادف الوفاة، يتكلف الجيران والأقارب بتحضير الطعام، وقد لا تتجاوز الأكلات الكسكس والخبز وأطباق الفطور من شاي وحساء، وهي تجتمع في غالبيتها حول المطهو من الطعام.
- بالنسبة ليوم عشاء الميت الذي يكون في معظم الحالات خلال اليوم الثاني من رحلة العبور إلى دار الحق؛ يمكن أن نميز في مجال عبدة وعدد من دواويره ومراكزه، بين عادات مهمة تتمثل في تكلف أفراد بعينهم بتحضير خيمة العشاء بمعداتها وبكراسيها وبفراشها وبتحضير الشاي للمشاركين في العزاء والمواساة؛ وهؤلاء الأفراد يكونون من الجيران أو هم فعاليات عن المجتمع المدني المحلي المعروف في حالات التطوع والتضامن. أما الطعام الغالب فيكون الكسكس أيضا؛ بحيث تستقبل الخيمة "قصعات" و"قصريات" يتم ترقيمها من أجل سهولة إرجاعها لأصحابها، وتقدم حسب الحضور من الرجال والنساء والأطفال ضمن موائد تضم من الأشخاص ما لا يتم بالضرورة التركيز على تعداده، ويكون في ذلك مرونة ملحوظة بالنظر لطبيعة الحدث على عكس حفلات الزواج.
- تستقبل خيمة العزاء والعشاء فقهاء يتكلفون بقراءة القرآن وبالدعاء للميت، ويتم التكلف بطعامهم حسب حالاتهم الصحية واختياراتهم العذائية ضمن نسق الغذاء العام طبعا.
- من عادات الطبقات الشعبية بمجال عبدة، عادة "التفراق" أو "التفاريق"؛ وهي عادة ما تزال حاضرة في المخيال الشعبي العبدي وفي الممارسة المرتبطة بزيارة المقابر عموما بمدن المملكة كما بالبوادي؛ وهي تمارس خلال عاشوراء وبدرجة أخف خلال أيام أخرى من الأسبوع كما هو حال الجمعة.
- فيما يخص شكل التفراق في حالة الوفاة الحديثة؛ فيتم تحضير الخبز الذي يعتبر أساس طعام التفريق باعتماد مقلاة طينية "الفراح" أو أخرى عصرية. تتكلف امرأة بوضع الخبز بعد طهيه فوق رأسها بعد ترتيبه في الطبق الذي يحتويه، وتسير به انطلاقا من منزل الميت إلى المقبرة التي دفن بها، وتتم هذه العملية صباح اليوم الذي يلي ليلة العشاء مباشرة.
- تمضي المرأة التي تحمل فوق رأسها الطبق لغايتها، دون أن تكلم أحدا، ودون أن تلتفت، بما يوحي في طياته الرغبة في أن يقضى الغرض وتتحقق النية من عملية التفراق نفسها؛ خاصة وأن الذهنية الاجتماعية والروحية تحتفظ بأهمية ودور الصمت في تحقيق الغايات والمراد؛ فالصمت علامة للقبول والصمت إشارة لتحقق الرغبة والطلب، كما ورد في تجربة نبي الله زكرياء و مريم ابنة عمران، باعتبارها من قصص التراث الديني التي تحكم وتؤطر الاعتقاد في ماهية الصمت.
- إذا كان التفراق والتصدق على الموتى بكبريات الحواضر يكون بقنينات المياه المعدنية وبعلب الحليب، وبقطع الفواكه الجافة كالثمر والجوز واللوز والتين المجفف والقطع النقدية؛ فإن التفراق ببادية عبدة يكون الخبز أساسه وتضاف إليه حلويات عصرية" الفنيد" وفواكه جافة وحليب الأبقار أو آخر معلب.
- يتم تحضير هذا الطبق فوق توب يوضع مباشرة على الأرض على مقربة من قبر الراحل/ة؛ وتشرع المرأة المكلفة بتأطير الطقس في توزيع حصص من الطبق للحاضرين من النساء، مع التركيز على البدء بالأطفال والأيتام. هذا ويمكن أن تكون المرأة الموزعة للحصص و" الحقوق" إبنة المتوفي أو المتوفية.
- بالعودة لمنزل المتوفي، يتكلف أهله بعد العودة من المقبرة بإعداد الغذاء للمشاركين في طقس التفراق، والذين قد يتقلص عددهم بعد تفرف عدد منهم نحو منازلهم، وقد تكون وجبة الغذاء هذه أول وجبة تعدها أسرة الميت، بعد دفنه وتقديم العشاء من أجله وتفريق الطعام على قبره؛ مما يمكن من القول باستعادة عائلة الميت لعافيتها النفسية والروحية، واستعدادها بهذا الشكل لتقبل الوضع الجديد، واستئناف حياتها الاعتيادية، وهي تعيد إشعال نيران مطبخها لتستقبل المتأخرين من مقدمي العزاء، بطهي ما تبقى وتوفر من طعام.
- بدراسة لطبق التفراق، يتضح جليا أنه يجمع بين الخبز التقليدي باعتباره منتوجا لمحاصيل الأرض العبدية كالقمح والشعير والذرة. كما أنه يحضر مطهوا في آنية تقليدية أو أخرى عصرية غير متكلفة تماشيا مع طرح البساطة وعدم التكلف الذي تفرضه المناسبة.
- باعتبار وجود الحليب ضمن الطعام المشار إليه، فإن طبق التفريق يجمع بين النيء والمطهو، ويرتبطان بنفسية تعيش فترة حرارة حسية قد يبردها كأس حليب بارد، أو يزيد من ريق صباحها المر حلوى صغيرة. ويبقى الغرض من هذه الأخيرة تحبيب مستهلك الطبق من الأطفال وغيرهم في الطبق نفسه، لالتهامه كاملا وعدم تركه ليدخل نسق المتعفن من الطعام. هذا ويمني المشاركون النفس بأن يصير الأجر كاملا والتواب صريحا، لفائدة الميت، الذي توزع الحصص والأطعمة على مقربة من جسده المسجى تحت تربة قبر باردة.
إن انطلاقنا في هذه المقالة كان من أجل العرض للطعام الذي يتم إعداده وتقديمه خلال فترة الموت، باعتباره حالة انتقال من حال إلى حال ومن مقام الى مقام، وهو بالأساس انتقال روحي ونفسي تصاحبه أفعال وهواجس ورغبات معلنة وأخرى مضمرة وتمثلات حول الموت وعبور الروح من الأرض إلى السماء وانمحاء الجسد الزائل تحت التراب؛ عملية يحضر من خلالها الطعام بشكل يجعل منه مادة وغاية مرجوة لتنقية روح الميت ومباركة عمله بأجر جديد محتمل؛ وتطهير مسيره نحو السماء بإطعام لا يخلو من معان نفسية تعويضية، وبموائد يسكنها تواضع وعدم إسراف وتقبل لحال الموت والانتقال، كحقيقة ونهاية ومطلب لا شك فيه ولا زيادة فيه ولا غلو.
ويفهم كذلك من مجمل التصورات المبسوطة سابقا، أنه كلما اتجهنا نحو الفئات الشعبية العريضة من المجتمع، إلا ولمسنا حجم تآزر مهم وتضامن ملحوظ إبان فترة الفقد، وفي مواجهة الموت وفي طريقة تلقيه والتعاطي معه. هذا التضامن يشمل أيضا شكل الأطعمة المقدمة والمصاحبة لهذه الفترة من حيث البساطة والترشيد والغاية. وعند تغييرنا للطبقات الاجتماعية في مقاربة ثنائية الموت والطعام، نستنبين التمايزات في تلقي الوفاة وفي صيغ إعداد الطعام، وتوفيرة وأشكاله وفي طريقة تدبيره والمحافظة عليه.
وعليه، فباستعراضنا لمختلف الأطعمة والممارسات الغذائية الموازية للموت، بطريقة تجمع بين العرض والتحليل والوصف والتأويل؛ نستكشف أن مختلف الأطعمة التي ذكرناها آنفا ليست أطعمة صامته في حد ذاتها، بقدر ما عكست وتعكس في إعدادها وطهيها وتقديمها وتدوريها لكي لا تتعفن وتتلاشى، آدابا اجتماعية وتصورات وذهنية، تتمثل الموت كمرحلة صادقة من مراحل الوجود البشري وتتماهى معه، وتفسر وفرة الطعام الموازي له وجودته وحسن طهيه وتوافر الذين يستهلكونه وعدم تضييعه بجودة خصال الفقيد وطيبة سريرته وفعله، وحسن مآله ورضى السماء عليه.