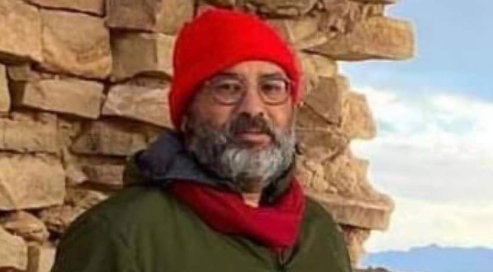منذ أواخر شتنبر 2025، يعيش المغرب مرحلة غير مسبوقة، تجاوزت تداعياتها مجرد إطار التظاهرات. ففي عدة مدن، من الدار البيضاء إلى طنجة، ومن الرباط إلى مراكش، خرج آلاف الشباب إلى الشوارع، بدايةً في حراك سلمي، للمطالبة بالحق في الصحة والتعليم والكرامة. لا شيء أكثر أساسية ولا أكثر عالمية من هذه المطالب التي تمس جوهر العقد الاجتماعي. هذا الحراك، الذي وُلد من عفوية شبكات التواصل الاجتماعي، جسّد قلقاً كان يختمر منذ زمن بعيد، لكنه سرعان ما انقلب إلى مواجهات شوّهت صورته ومنحت السلطات ذريعة لقمع شديد. قتيلان، مئات الجرحى، سيارات ومبانٍ محروقة، ومئات الاعتقالات: الحصيلة ثقيلة، تكشف حجم الغضب مثلما تكشف حدود نظام حكم يواصل تفضيل القوة والصمت على الإصغاء والكلام.
ما يثير الانتباه أولاً هو الفراغ في التواصل. ففي الساعات التي كانت فيها الشوارع تغلي، لم يتحدث أي مسؤول حكومي رفيع المستوى لتهدئة الوضع أو الاعتراف به أو اقتراح حلول. هذا الفراغ لم يكن مجرد سهو، بل كان ذا دلالة رمزية. ففي بلد يشكل فيه الشباب الأغلبية السوسيولوجية، فإن عدم التوجه إليهم مباشرة يعني عملياً إنكار وجودهم السياسي. الأمر لا يتعلق فقط بغياب الكلمات، بل بترسيخ شعور بالاحتقار: أن تُتجاهل آلامهم، ويُستهان بتضحياتهم، وتُختزل غضباتهم في تهديد للأمن العام. وهذا الاحتقار أخطر بكثير من الاحتجاج نفسه، لأنه يزرع في العقول قناعة بأن السلطة لا تسمع، ولا تريد أن تسمع، وأن أي محاولة سلمية محكوم عليها بالفشل.
في الشوارع، انطلقت دينامية التصعيد بشكل شبه آلي. مسيرات كان يمكن أن تبقى سلمية تحولت إلى بؤر توتر بسبب تفريقات عنيفة، وتطويقات أمنية، وهجمات سريعة أشعلت أحياء هشة أصلاً. وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، كانت كل إشاعة، وكل اعتقال، وكل فيديو لعصا مرفوعة ينتشر فوراً، مغذياً شعوراً فورياً بالظلم ومعززاً الغضب. في هذا المناخ، لعبت العوامل المحلية دور الشرارة: ففي أكادير مثلاً، أدت وفيات متكررة في مصلحة الولادة بمستشفى الحسن الثاني إلى تركيز سنوات من الإحباط ضد نظام صحي منهك. في ساعات قليلة، تحوّل مطلب وطني إلى آلام محلية، وصارت المأساة المعاشة في مدينة واحدة صدى في مدن أخرى.
ومع ذلك، فإن القول إن السلطات دفعت عمداً الشباب إلى التدمير هو قراءة مبسّطة أكثر من اللازم. ما جرى لا يندرج في خانة المؤامرة بقدر ما يعكس عجزاً مزمناً عن إدارة الاحتجاج سياسياً. فمنذ عقود، ظلّت العقيدة نفسها: الاحتواء بالقوة، والمماطلة بإعلانات تقنية، وتجنّب أي التزام علني بحوار صريح. هذا الاختيار البنيوي ينتج تلقائياً تأثيراً للتعفين: حين لا يتكلم الدولة، تصرخ الشوارع بصوت أعلى؛ وحين تتطرف الشوارع، تُقابل بالقمع؛ وحين يسقط القمع، يختفي المعتدلون تاركين المجال للأكثر عنفاً. إنها دائرة مفرغة معروفة، ولا يمكن أن تقود سوى إلى إضعاف الثقة الجماعية.
في العمق، ما هو مطروح ليس مجرد غضب ظرفي، بل تناقض بنيوي يعيشه الشباب المغربي. لم يكن قط أكثر تمدرسًا، ولا أكثر اتصالاً بالعالم، ولا أكثر وصولاً إلى المعلومة والمقارنات الدولية. لكنه أيضاً لم يشعر يوماً بهذا القدر من التفاوت بين طموحاته وواقعه اليومي. يرى مدارسه مكتظة، ومدرّسيه منهكين، ومستشفياته مشبعة، وأطباؤه محبطين أو مهاجرين. يلاحظ، كل يوم تقريباً، أن بلده قادر على بناء ملاعب جديدة في وقت قياسي لاستضافة كأس إفريقيا للأمم، وقريباً كأس العالم 2030، لكنه عاجز عن توظيف ما يكفي من القابلات لتفادي مآسٍ يمكن تلافيها في مستشفى إقليمي. يرى الميزانيات تُصرف على مشاريع استعراضية، لكنها لا تُصرف على أقسام دراسية لائقة أو أقسام طوارئ فعالة. هذا التفاوت لم يعد محتملاً، وهو الذي يغذي الانتفاضة.
البعد الرمزي أساسي. فالشباب لا يطالبون فقط بمستشفيات مجهزة بشكل أفضل ومدارس مموّلة بشكل كافٍ، بل يطالبون بأن يُنظر إليهم كمواطنين كاملين. يريدون أن يُدرجوا في السردية الوطنية، في تحديد الأولويات، في رسم المستقبل. لكن، حتى الآن، تبدو مكانتهم محصورة في الهامش: يُطلب منهم أن يصبروا، أن يثقوا، أن ينتظروا. غير أن للصبر حدوداً، وعندما ينقلب إلى غضب، يجرف كل شيء معه.
السؤال المطروح الآن بسيط: ماذا بعد؟ كيف نخرج من هذه الدائرة التي كلّفت بالفعل غالياً على مستوى الأرواح والتماسك الاجتماعي والصورة الدولية؟ أولى الأولويات سياسية: كلمة واضحة ورسمية. يجب على رئيس الحكومة، أو أي سلطة سياسية كبرى عند الضرورة، أن يتوجه مباشرة إلى الشعب، معترفاً بالأخطاء، مبدياً تعاطفاً، معلناً وجهةً. بدون ذلك، لن تكفي أي إجراءات تقنية، أو خطط مالية، أو تدابير أمنية لإعادة بناء الثقة. ما ينتظره الشباب ليس قائمة أرقام، بل الاعتراف بكرامتهم ومكانتهم في الوطن.
الأولوية الثانية قضائية وأخلاقية. يجب التعامل مع العنف بصرامة، لكن أيضاً بتمييز. ينبغي متابعة مثيري الشغب ومحاكمتهم بسرعة، لكن ينبغي إطلاق سراح المتظاهرين السلميين واحترام حقوقهم. يجب أن تُظهر العدالة أنها تميز، وأنها لا تضع الجميع في خانة واحدة، وأنها قادرة على الرد بشكل متناسب. لأن إحساس الظلم إذا ترسّخ، فسوف يغذي الموجة القادمة من الغضب.
الأولوية الثالثة مؤسساتية. يجب أن يُكفل الحق في التظاهر، مع تنظيمه، لكن باحترامه. يجب أن تتمكن المسيرات من الوجود من دون أن تُفرّق بشكل منهجي. ينبغي وضع آليات للوساطة، وتحديد مسارات مسبقة، وتعميم الكاميرات المحمولة على الصدور لتفادي التجاوزات والاتهامات الباطلة. بلد حديث لا يمكن أن يعتبر كل تعبئة تهديداً وجودياً، بل يجب أن يتعلم كيف يجعل منها لحظة ديمقراطية حيّة.
لكن ما هو أبعد من الطوارئ هو الأساس: الإصلاح البنيوي. لم يعد ممكناً أن تظل الصحة والتعليم آخر اهتمامات السياسات العمومية. لا بد من خطة استعجالية للمستشفيات: توظيف واسع، تعزيز مصالح الولادة، إعادة توزيع الموارد نحو المناطق المحرومة، نشر مؤشرات أسبوعية لإظهار التقدم. لا بد من خطة للمدرسة: تخفيض أعداد التلاميذ في الأقسام، إعادة الاعتبار للمدرسين، إصلاح التكوين، وتوفير وسائل ملموسة للأكاديميات الجهوية. يجب تحصين صندوق للصحة والتعليم، يخضع لتدقيق مستقل، مع تقارير علنية منتظمة. ويجب وضع مبدأ واضح: لا درهم واحد لمشاريع استعراضية إذا لم تُحقق في الجهة نفسها الحدود الدنيا في مجالي العلاج والتعليم.
وأخيراً، يجب ابتكار علاقة جديدة بين الدولة والشباب. هذا يفترض مجالس جهوية للشباب تملك حق الإنذار، وميزانيات تشاركية في المدن الجامعية، وخدمة مدنية اختيارية تتيح إشراك الشباب مباشرة في مهام ذات منفعة عامة. كما يفترض الاعتراف بأن السياسة لم تعد تُمارس فقط في الأحزاب أو المؤسسات الكلاسيكية، بل يجب أن تشمل أيضاً الفضاءات الرقمية الجديدة حيث يناقش الشباب وينظمون أنفسهم ويتطلعون للمستقبل.
إن ثمن الصمت اليوم يُقاس بأرواح مفقودة، وغضب متراكم، وثقة مهدورة. لكن غداً قد يُقاس بشروخ دائمة، وتطرفات غير متوقعة، وأزمات متكررة. والتجارب الحديثة في المغرب كما في دول الجوار تُظهر أن تجاهل الشباب خطأ استراتيجي دائماً. فجيل يشعر بالاحتقار سينتهي بالبحث في مكان آخر عمّا لم يجده في وطنه: في الهجرة، أو في العنف، أو في العزوف واللامبالاة.
ومع ذلك، يمكن أن تتحول هذه الأزمة إلى فرصة. قد تجبر السلطة على مواجهة ما لم يُعالج قط: التراتبية الحقيقية للأولويات، ظلم توزيع الميزانيات، إنهاك الخدمات العمومية. قد تفرض إعادة توجيه، لا تجميلية بل بنيوية. وقد تفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من الحداثة السياسية المغربية، تلك التي يتوقف فيها الشباب عن أن يكونوا مجرد شعار ليصبحوا فاعلاً معترفاً به.
كل شيء سيتوقف على قدرة السلطة على تحمل مسؤولية الكلمة، والانخراط في الأفعال، والوفاء بالوعود. ففي هذه الأزمة، القضية ليست فقط تهدئة الشوارع، بل إعادة تأسيس ميثاق الثقة. إذا استمر الصمت، سيكون الثمن باهظاً. وإذا فُتح باب الكلام وترافق مع إصلاحات ملموسة، يمكن للمغرب أن يحول أزمة اليوم إلى فرصة تاريخية.