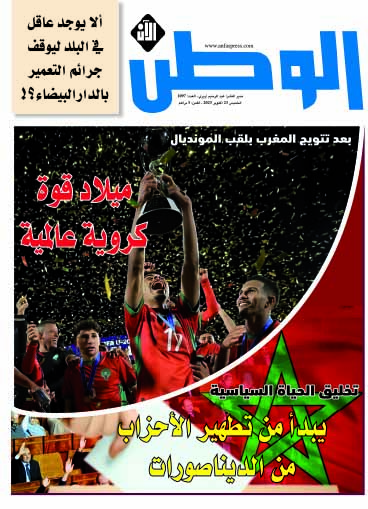في عالم يتجه بسرعة نحو مزيد من التعقيد واللايقين، تتسارع التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لتفرض على الدول ضرورة مراجعة نماذجها التنموية، والتفكير في تعاقدات جديدة تُعزز التماسك والاستقرار.
والمغرب، الذي اختار منذ عقود طريق الإصلاح والتحديث، يواجه اليوم تحديات تتقاطع فيها آثار ما بعد الجائحة، والتقلبات الجيوسياسية، وتغير المناخ، إلى جانب ضغوطات اجتماعية واقتصادية متزايدة تمس بشكل مباشر الفئات الهشة والمتوسطة.
على الصعيد الدولي، ما زالت تداعيات جائحة كورونا تلقي بظلالها على بنية الأسواق العالمية، فيما ساهمت الحرب الروسية الأوكرانية في رفع أسعار الطاقة والغذاء، وزادت من هشاشة سلاسل الإمداد، وتدهور القدرة الشرائية عبر العالم.
وعلى المستوى الوطني ، يعيش المغرب تحت ضغط متنامٍ بفعل تصاعد الفوارق الاجتماعية واتساع التفاوتات المجالية، وارتفاع كلفة المعيشة، وتعمق أزمة الموارد الطبيعية وعلى رأسها الماء، وهي كلها مؤشرات تفرض إعادة التفكير في أسس التعاقد الاجتماعي الراهن، وضرورة تجديده بما يضمن الإنصاف والاستقرار.
وعلى المستوى الوطني ، يعيش المغرب تحت ضغط متنامٍ بفعل تصاعد الفوارق الاجتماعية واتساع التفاوتات المجالية، وارتفاع كلفة المعيشة، وتعمق أزمة الموارد الطبيعية وعلى رأسها الماء، وهي كلها مؤشرات تفرض إعادة التفكير في أسس التعاقد الاجتماعي الراهن، وضرورة تجديده بما يضمن الإنصاف والاستقرار.
وفي هذا السياق الدقيق، جاء خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2025 كرسالة قوية تُجدد الالتزام الملكي بقضايا العدالة الاجتماعية والمجالية، وتُعيد توجيه البوصلة نحو جوهر المشروع التنموي الوطني الجديد.
شكّل الخطاب الملكي لحظة تأسيسية حقيقية لتعاقد اجتماعي جديد يقوم على استحضار مسؤوليات الجميع، ويستدعي تعبئة وطنية شاملة تتجاوز الإصلاحات التقنية أو الإجراءات القطاعية.
لكن الانخراط في هذا الورش الوطني لا يمكن أن يتم دون تشخيص دقيق وموضوعي لواقع التفاوتات الطبقية و الفوارق المجالية و معدلات الفقر و الهشاشة الغدائية.
لابد ايضا من استحضار واقع النساء اللواتي يواجهن واقعًا أكثر هشاشة، إذ تشير معطيات اليونيسف إلى أن نسبة الانقطاع المدرسي لدى الفتيات في العالم القروي بلغت 27%، فيما لا يتجاوز معدل النشاط الاقتصادي للنساء 21.5% حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2024. هذه المعطيات لا تُظهر فقط فجوة في التكافؤ، بل تُشير إلى فشل السياسات السابقة في ضمان إشراك فعلي للنساء في دورة التنمية.
ورغم الإصلاحات والبرامج التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين، من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2005)، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية (2016–2023)، وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية (2021–2025)، فإن أثر هذه السياسات ظل دون المستوى المطلوب. ويعود ذلك إلى غياب التنسيق بين الفاعلين، وضعف آليات التقييم والتتبع، ومحدودية التمكين المالي والمؤسساتي للجماعات الترابية، إلى جانب مشاكل في الاستهداف العادل للفئات والمناطق.
أضف إلى ذلك أن الإطار المؤسساتي الحاضن لهذه البرامج لا يزال يواجه اختلالات عميقة، فمشروع الجهوية المتقدمة، الذي أقره دستور 2011، لا يزال يراوح مكانه بسبب بطء نقل الاختصاصات، وتضارب الصلاحيات بين المركز والجهات، وغياب الموارد المالية والبشرية الكافية.
كما أن تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري لم يرق إلى مستوى الطموحات، في ظل استمرار مركزية القرار، وتأخر تفويض الصلاحيات للإدارات الجهوية.
كما أن تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري لم يرق إلى مستوى الطموحات، في ظل استمرار مركزية القرار، وتأخر تفويض الصلاحيات للإدارات الجهوية.
و لازالت لعلاقة بين الجماعات الترابية والسلطات المحلية بدورها تعاني من نوع من التوتر المؤسسي، حيث يشتكي العديد من المنتخبين من تقييد صلاحياتهم، ووجود "بلوكاج" غير معلن يعطل المشاريع، ويُفرغ التجربة المحلية من فعاليتها. ويُضاف إلى ذلك تأثير الزمن السياسي والانتخابي القصير، الذي لا ينسجم مع الزمن التنموي الطويل، مما يؤدي إلى تعطيل الاستمرارية والنجاعة.
أمام هذا الواقع، تبرز الحاجة إلى تعبئة وطنية جماعية تنخرط فيها كل القوى الحية في البلاد. فالدولة تظل الضامن الأكبر للتوازن الاجتماعي والمجالي من خلال التخطيط الاستراتيجي وتوفير الموارد. والحكومة مطالبة بتوحيد الرؤية، وضمان انسجام السياسات العمومية وربطها بالمحاسبة. أما الأحزاب السياسية، فقد آن الأوان لتسترجع ثقة المواطن، وتخرج من منطق الظرفية الانتخابية نحو منطق التأطير والمواكبة والاقتراح.
القطاع الخاص أيضًا مطالب بأن يتحمل مسؤوليته الاجتماعية والبيئية، عبر الاستثمار في المناطق المهمشة، وخلق مناصب الشغل، ونقل المعرفة.
ولا يمكن في هذا السياق الحديث عن أي تعاقد اجتماعي جديد أو تنمية مجالية ناجعة دون تمكين الجماعات الترابية من أداء دورها بصفتها الفاعل الأقرب للمواطن، والأكثر قدرة على ترجمة الحاجيات المحلية إلى برامج فعلية. فالجماعات ليست مجرد إدارة ترابية، بل فاعل سياسي وتنموي مركزي في الهندسة الدستورية للمملكة. غير أن واقع الحال يُظهر أن هذه الجماعات لا تزال مكبلة من نواحٍ عديدة، بدءًا من ضبابية الاختصاصات الفعلية الممنوحة لها، مرورًا بضعف الإمكانات المالية والبشرية، وانتهاءً بالاختلال في العلاقة مع السلطات العمومية ممثلة في الولاة والعمال. فالتداخل بين السلطات المنتخبة والإدارية يؤدي إلى إرباك حقيقي في مسارات اتخاذ القرار وتنفيذ البرامج، ويخلق حالة من "البلوكاج غير المعلن" تُعطل مشاريع حيوية وتمس بشرعية الفعل الانتخابي نفسه.
إن تفعيل أدوار الجماعات الترابية يمر أولًا عبر مراجعة جذرية لمنظومة الاختصاصات، بشكل يُحدد بوضوح من يفعل ماذا، ثم عبر إعادة النظر في نظام التمويل، فالأعباء المفروضة على الجماعات تتسع عامًا بعد عام، في حين أن الموارد الذاتية تظل محدودة، والتحويلات المركزية مشروطة وبطيئة. كما أن الجماعات في حاجة ماسة إلى إعادة تأهيل رأسمالها البشري، وضمان الاستقرار الإداري، والتمكين من أدوات التخطيط والمواكبة والتقييم، بدل اختزال أدوارها في التسيير اليومي. ولكي تسترجع الجماعات المحلية دورها كمختبر حقيقي لديمقراطية القرب والتنمية المجالية، يجب كذلك تصحيح العلاقة المؤسسية بينها وبين السلطات الترابية، عبر آليات واضحة للتنسيق، تضمن التوازن بين المراقبة والمواكبة، وتحترم إرادة الناخبين ومخرجات الاقتراع. إن الاستثمار في الجماعات الترابية ليس فقط ضرورة ديمقراطية، بل رهان تنموي محوري لا يمكن كسبه دون إرادة سياسية واضحة لرفع الحصار المؤسساتي والمالي عن الجماعات، وتمكينها من أداء وظائفها في إطار رؤية تشاركية، مندمجة، ومنصفة.
ولا تكتمل شروط بناء هذا التعاقد الاجتماعي الجديد دون إعطاء أولوية لمسألة تخليق الحياة العامة، باعتبارها ضرورة سياسية وأخلاقية لضمان الشفافية واستعادة الثقة. لكن سياسية التخليق لا يجب اختزلها في معاقبة المتورطين في نهب المال العام أو تحويلهم إلى المحاكم فقط، لأن الاقتصار على العقاب غالبًا ما يُغذي الشعور العام بأن الفساد ظاهرة مستعصية على المعالجة، ويُعمق فقدان الثقة في المؤسسات والفاعلين السياسيين. إن التحدي الحقيقي يكمن في وضع منظومة متكاملة للوقاية والمراقبة والمساءلة، تضمن عدم تكرار حالات التلاعب بالمال العام، وتُرسخ ثقافة النزاهة كقيمة مؤسساتية وليست فقط مطلبًا أخلاقيًا. ويقتضي ذلك إرساء آليات إلزامية للتصريح بالممتلكات، والربط بين المسؤولية والمحاسبة، واعتماد آليات صارمة للصفقات العمومية والتدبير المالي، بالإضافة إلى دعم هيئات الرقابة الوطنية والجهوية ومنحها الاستقلالية والفعالية. كما يجب تعزيز ثقافة الإبلاغ والحماية القانونية للمبلغين، وتوسيع فضاءات التقييم المجتمعي لمشاريع الدولة، وتعميم تقارير النجاعة والنتائج على العموم. فالمواطن لا يطلب فقط معاقبة الفاسدين، بل يُطالب بمنظومة تمنع الفساد قبل وقوعه، وتُرسخ مبدأ الخدمة العامة بدل الريع، والشفافية بدل المحاباة، والتنافسية بدل الزبونية.
كما ينبغي تعزيز دور الجامعة والبحث العلمي، باعتبارها خزانا معرفيًا واستراتيجيًا، قادرًا على تحليل التحولات واقتراح البدائل المبنية على الأدلة.
ولا يقلّ دور المجتمع المدني أهمية، خاصة في تعبئة الساكنة، وبلورة حلول مبتكرة، وتمثيل صوت الفئات الهشة.
ولا يمكن إغفال دور المواطن ذاته، الذي عليه أن يكون شريكًا حقيقيًا لا مجرد متلقٍ للقرارات، عبر الانخراط الواعي في الحياة العامة، والمساءلة والمشاركة.
ولا يمكن إغفال دور المواطن ذاته، الذي عليه أن يكون شريكًا حقيقيًا لا مجرد متلقٍ للقرارات، عبر الانخراط الواعي في الحياة العامة، والمساءلة والمشاركة.
وفي هذا الإطار، يحضر ايضا دور مغاربة العالم كرافعة استراتيجية في هذا التحول. فإلى جانب التحويلات المالية التي بلغت سنة 2023 ما يفوق 114 مليار درهم (حسب مكتب الصرف)، يملك المغاربة المقيمون بالخارج رأسمالًا بشريًا وعلميًا هائلًا في مجالات متعددة كالطب، والهندسة، والتدبير، وريادة الأعمال. ولابد من إدماجهم في السياسات العمومية الترابية، وتعبئتهم كمواطنين كاملي الحقوق والواجبات، من أجل المساهمة في تطوير مناطقهم الأصلية، وضخ دينامية جديدة في مشروع التنمية.
إن خطاب العرش لسنة 2025 هو أكثر من لحظة خطابية، إنه إعلان عن مرحلة تأسيسية جديدة، قوامها عقد اجتماعي يقوم على العدالة، والكرامة، والمشاركة، والمسؤولية المشتركة.
ان تحقيق هذا الرهان يقتضي إرادة سياسية صلبة، وتفكيرًا استراتيجيًا بعيد المدى، وتعبئة جماعية شاملة، تضع المواطن في قلب المشروع الوطني، وتجعل من كل فاعل، مهما كان موقعه، جزءًا من الحل لا عنصرا من المشكلة.
دة. خديجة الكور، باحثة في علم الاجتماع