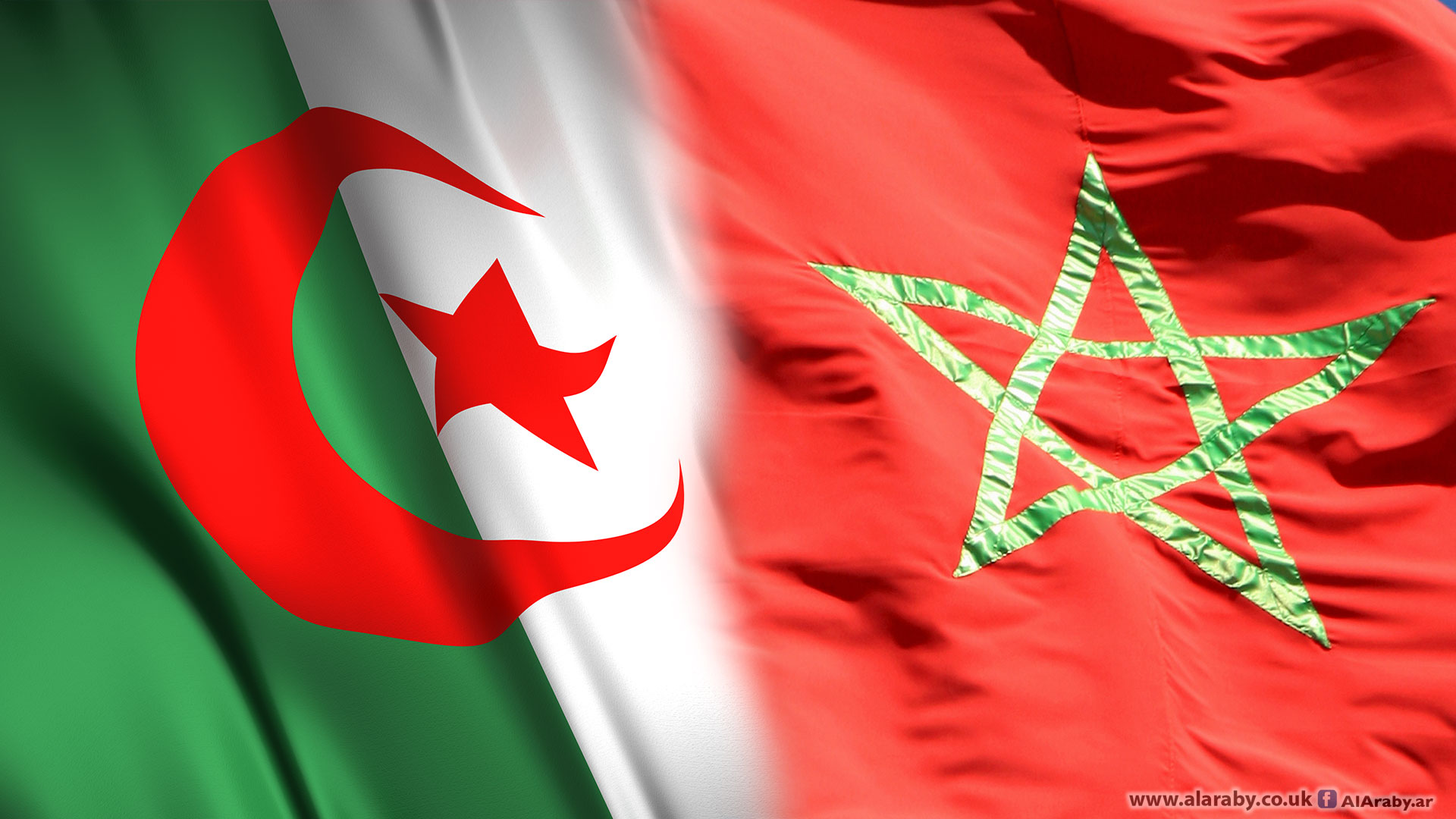في عالمٍ فكريٍّ اعتاد تقديم العلم كمرجعية مطلقة و"مقدسة"، جاء مشهد قناة ميدي 1 تيفي ليقلب الصورة رأسًا على عقب. مناظرة جديدة بين الدكتور طلال لحلو والأستاذ أحمد عصيد… لكنها لم تكن مواجهة متكافئة بقدر ما كانت عرضًا حيًّا لانكشاف أسطورة فكرية اعتدناها على الشاشات والصالونات الثقافية.
الدكتور لحلو دخل الحلبة بثقة لغوية صارمة ومنهجية تحليلية تُذكّر بمناضلي "الفكر الجاد"، بينما بدا الأستاذ عصيد وكأنه نُقل على عجل من استوديوهات "اليوتيوب المبسّطة"، حيث يكفي أن تبتسم للكاميرا أكثر مما تُجهد العقل. توتره كان واضحًا، لا لضعف تحضيره فحسب، بل لأنه وجد نفسه هذه المرة في مواجهة حقيقية، لا أمام جمهور يصفق للشعارات المعلّبة.
الأستاذ عصيد، الذي طالما رفع العلم إلى مرتبة التأليه وادّعى الدفاع عن "العقلانية الكونية"، لم يقدّم طرحًا واحدًا يرقى إلى الحد الأدنى من العمق الفلسفي. كل ما جاء به كان تكرارًا لشعارات مُستهلكة، وكأنه يبيع "ثقافة بلا مفاهيم": كلام محفوظ يُردّد بلا فهم، كخطيب يقرأ خطبته المملة أمام رأي عام انتظر منه مقارعة الحجة بالحجة لا بالتسول العاطفي.
والأدهى أن هذا الارتباك الواضح، الذي بدا عليه منذ الدقائق الأولى، لم يكن مجرد توتر عابر، بل كان انعكاسًا لأزمة أعمق: انهيار المرجعية الفكرية التي ظل الأستاذ عصيد يدافع عنها بشراسة لسنوات. المناظرة لم تكشف عجزًا تكتيكيًا أمام الدكتور لحلو، بقدر ما كشفت خواء المنظومة الفكرية التي يمثلها. لقد بدا الأستاذ عصيد وكأنه يقاتل دفاعًا عن أطلال فكرة ماتت، بل وتعفنت.
فالثالوث المقدّس الذي بنت عليه الحضارة الغربية هيمنتها–الزعامة الفكرية والثراء المادي والعلو الأخلاقي – يبدو اليوم في طور الانهيار بوتيرة لم يكن يتوقعها حتى أكثر المتشائمين غرورًا. هذه ملاحظات عبّر عنها فلاسفة كـأوزفالد شبنجلر، الذي قال إن الغرب بلغ "مساءه" التاريخي، يشابه بذلك نهاية الإمبراطوريات التي بدت قوية وعظيمة، رغم زوالها المحتوم.
وبهذا المعنى، فالمقولة القائلة : الثالوث المقدس الغربي يتهاوى، ليست مجرد تشاؤم تراجيدي، بل قراءة دقيقة لتفكّك مشروع بني على التراكم المادي فقط، دون احتضان مرجعيته الأخلاقية أو الفكرية. إن الانهيار لا يأتي من الخارج فقط، بل من تفكك داخل المنظومة التي ظلت تعتقد أن الإنسان الغربي قتل الخالق وحل محله.
الانهيار الفكري: المحاكمات الجديدة للعلم وحرب الجوقة الواحدة
إنه ليس مجرد انهيار، بل ثورة مقلوبة على العلم نفسه، حيث تحوّل البحث العلمي إلى قفص مسقوف بأجندات ضيقة ومحاكم تفتيش عصرية تنقب عن أعداء للخط السائد. العلماء الذين يجرؤون على طرح رؤًى خلاّقة أو إخضاع الأيديولوجيا للتمحيص، يجدون أنفسهم مُحاصرين بحملات تسمية، مقاضاة معنوية، وسجن لصوتهم في فضاءات جامعية كانت تُفترض أن تكون منارات للحرية الفكرية.
في المملكة المتحدة، كشف تقرير حديث أن أكاديميين شاركوا في بحوث منتقدة للنظريات الجندرية واجهوا مضايقات وعزلًا مهنيا. واحدة منهن، كاثلين ستوك، تعرضت لضغوط من مؤسستها الجامعية بتهديدات قانونية وتشهير. وكلما تصاعد صوت الباحث المنادي بحرية الفكر، ازدادت آليات الرقابة الناعمة وإلغاء الثقافة وسياسة الاعتراض المسبق التي تمنع حتى طرح الأسئلة الجدية.
وفي هذا المحفل الساخر من حرية الفكر، تعرّض الباحث الأمريكي ريشار ستيرنبرغ، الذي عبّر بجدّية عن شكوك علمية حول "التطوّر الدارويني"، لضغوط مهنية وجّهت ضده اتهامات جعلته عرضة لـ"حملة تنكيل" داخل مؤسسة سميثسونيان. تحقيق برلماني أميركي أكد أن ما تعرّض له كان مدفوعًا بدوافع أيديولوجية وسياسية لا علمية .ثم جاء نصير حركة "التصميم الذكي"، غويليرمو غونزاليس، الذي واجه رفضًا جامعيًا لمنحه الاستقرار المهني في جامعة آيوا، على هامش دعمه لمواقف نقدية تجاه نظرية التطور، ما أدى إلى إنهاء مساره الأكاديمي.
استنزاف ببدلات أنيقة: من قهر السلاح إلى عبودية المنظومة
يُقال إن الغرب صار "عجوزًا و مرعوبًا "فقط لأن أعداد المتقاعدين تتسارع وأعداد الوفيات صارت تتجاوز أعداد الولادات في سباق انهيار سكاني عجيب. لكن الواقع أدهى: الغرب لم يعد ينتج ثروة تليق بطموحاته المتضخمة، بل أصبح يتغذى على الإمكانيات المغتصبة من دول الجنوب، أموالًا وموارد وأراضٍ رخيصة، عبر آليات "التبادل غير المتكافئ "الذي وصفه المفكرون بـنظرية التبعية، حيث أن ثراء الشمال مستحيل دون استنزاف الجنوب عبر استغلال نظامي واتفاقيات تفاوضية ظالمة.
الآن، لم تعد القرصنة الاستعمارية مجرد مظالم قديمة، بل أصبحت جزءًا من المنظومة العالمية: شركات عملاقة تسند الإنتاج لبلدان نامية، تستثمر في العمال الرخيص والبيئات التنظيمية الهشة، وتُصدر فوق ذلك تصريحًا بأنها تساهم في "التنمية والرخاء".
في ظل هذا السيناريو، تحول الغرب إلى بطل استهلاكٍ بائس، يعيش فوق إمكانياته، بينما يستنزف مدخرات وثروات الآخرين، دون أن يبذل جهدًا حقيقيًا لإنتاج جديد أو تحقيق نمو مستدام. النظام الدولي كله يمثّل شبكة تسمح لهذا الغرب العجوز أن يبقى أقوى ظاهريًا، رغم أنه عاجز عن تلبية احتياجاته الحقيقية أو تمويل رفاهية حقيقية لشعوبه.
في هذا السياق، تصبح "النهضة" التي تبيعها للناس في البلدان النامية رغبة سائغة في محاكاة الغرب، بينما الواقع هو أننا ندور في حلقة من التبعية: مواردنا تُجرف لمصالحه، عقولنا تُستنزف من الكفاءات، ونظامه الدولي يُثبت إرادته بمزيد من الديون والسياسات المالية الذليلة.
باختصار: الغرب لم يُنهِ مرحلة الاستعمار، بل قلبها إلى استعمار اقتصادي يائِس يعيش على أنقاضنا. واليوم، هو يعيش كرجل على قشرة بيضة، لا ينتج ولا يُنتج إلا وهم السيادة والتكنولوجيا الفائقة، بينما يبقى فقراء العالم، بما فيهم بلدنا، يعانون ثقل التاريخ وميراث السياسات غير العادلة.
وفي مشهد يدعو للسخرية بدل التداعي، يقف الغرب اليوم كمحب اللامساواة، يُسوّق "حرية السوق" فقط حين تخدم مصالحه، ويسحبها كقُماش بالي بمجرد أن تتعارض مع أجنداته الاقتصادية والسياسية. فعندما يبيع للجنوب مبادئ الانفتاح والتنافس، فإنه يستثني نفسه من هذه القواعد عندما حان وقت إنتاج المعرفة أو حماية مصالحه الصناعية. هذه النفاق المزدوج، الذي يكشفه المؤرخين والاقتصاديين النقديين، يوضح أن السوق الحر في الغرب لا يُطبق إلا لمن لا يُشكّل تهديداً، بينما يبحث الغرب دائماً عن قوانين تُعلي مصالحه حتى لو على حساب سيادة الدول الفقيرة.
خذ على سبيل المثال منظمة التجارة العالمية؛ فهي تدعو إلى تحرير التجارة، لكنها في الواقع تمنح الدول الكبرى الامتيازات وتحمى زراعتها وصناعتها بينما تُفرض على البلدان النامية إلغاء دعمها وتشريع حقوق الملكية الفكرية لصالح شركات دوائية أوروبية وأمريكية، مما يحرم المحتاجين من الأدوية ويستنزف اقتصادات الدول المحرومة. إن هذا النظام العالمي ليس عادلاً، بل مصمم للحفاظ على تفوّق صناعات الشمال على حساب الجنوب.
وبالذات حين تتحدث الدعوات إلى حرية المبادرة والمنافسة العادلة، فإن الغرب يلغيها كلياً إن لم تفد شركاته العملاقة. ففي الواقع، الدعم والضخ المالي يصب فقط في جيوب كبار المستثمرين، بينما تُحرم الشعوب من المواهب المؤهلة لقيادة اقتصادها نحو التقدّم.
تقول الأدبيات البنيوية إن الهوية الوطنية ليست فقط ما تملك الدولة، بل ما تمثّله أيضاً. إن الغرب، رغم شعاراته، لا يمثل سوى مصالحه، ويستخدم الشرعية المؤسسية لتثبيت هيمنته. أما النظريات النقدية، فتفضح كيف أن دعم الدول النامية لقضايا الجنوب – مثل فلسطين – ليس مجرد تضامن إنساني بل ضرب من المقاومة الرمزية تجاه نظام عالمي يحتكر قيمة الإنسان والأرض والكرامة.
الخلاصة؟ لا تدعوا الغرب يتحدث عن حرية السوق والعدالة الدولية. فقد بنى نظامه على إبادة شعوب بأكملها، واستحدث معاهدات تحمي مصالحه من تأثير الآخرين. هو السوق، ولكن فقط عندما يخدمه.
الإنسانية على الطريقة الغربية: دماء الاطفال في غزة وتجارة الاطفال في قصور الصفوة
في الغرب، دماء الأطفال في غزة مجرد "أضرار جانبية"، أما أجساد الأطفال في قصور الصفوة فهي تسلية شرعية تُدار بعناية وحراسة هندسية. هذا هو درس الإنسانية على الطريقة الغربية: تبرير الإبادة في العلن، وممارسة أبشع أشكال العبودية الأخلاقية في الخفاء، من حفلات إبستين السرية إلى صفقات السلاح التي تُغذي آلة الموت في فلسطين.
لقد جاءت أحداث غزة، وما رافقها من إبادة جماعية وحشية بحق شعب أعزل، كصفعة مدوية أسقطت ورقة التوت الأخيرة التي كان الغرب يستر بها عورته الأخلاقية. لسنوات طويلة، ظل يقدّم نفسه – بوجه متأنّق وابتسامة إنسانية مصطنعة – باعتباره حامي حقوق الإنسان، ونصير العدالة، وضمير العالم الحي. كان يُلقي علينا الدروس في الأخلاق كما يلقي القاضي خطبته على المتهمين، ويستعمل هذه "الهيبة الأخلاقية" سلاحاً ناعماً يمارس به علوه الرمزي على شعوب تُوصف بالدروشة الفكرية، ومنهم أولئك الذين رددوا خطابه كالببغاوات.
لكن غزة جاءت ففضحت كل شيء. سقط القناع فجأة، وظهر وجه الغرب الشيطاني القبيح: متواطئ، مدافع عن المجازر، بل داعم لها بالمال والسلاح، ثم يتحدث ببرود عن "حق الدفاع عن النفس". الغرب الذي كان يوبّخ الآخرين على أبسط انتهاك لكلب بلدي في جماعة قروية، صار اليوم يبرر قتل الأطفال ونسف المستشفيات بحجج واهية. لم تعد هناك مبادئ كونية، ولا ضمير عالمي، بل مجرد حسابات سياسية ومصالح مادية لا تعرف للإنسانية معنى.
وما أحداث غزة إلا حلقة جديدة في مسلسل طويل من الانهيار الأخلاقي الغربي. فالغرب الذي صدّع رؤوسنا لعقود بخطابه عن "القيم" و"التحضر"، هو نفسه الذي تستّرت نُخبه السياسية والمالية لعقود على فضائح جنسية مهينة، كما في قضية جيفري إبستين، الذي حوّل قصره إلى ماخور نخبة سياسية واقتصادية عالمية، شارك فيه رموز من الصف الأول تحت حماية شبكة نفوذ معقدة. وهو نفسه الغرب الذي صنع أسطورة السينما الأمريكية على أكتاف متحرشين كبار مثل هارفي واينستين، الذي استعبد عشرات النساء في أروقة هوليوود لسنوات قبل أن تنكشف جرائمه. هذه القضايا لم تكن مجرد انحرافات فردية، بل فضحت بنية أخلاقية مريضة تُدار فيها المصالح بالابتزاز والفضائح، لا بالقيم والمبادئ التي يدّعونها.
هكذا انهار العلو الأخلاقي الغربي، وانهارت معه تلك "الهالة المقدسة" التي خدع بها النخب التابعة في بلداننا، والتي كانت ترى في الغرب مثالاً أعلى للعدالة والحرية. اليوم، صار من الصعب على هؤلاء الدفاع عن تلك الصورة الزائفة، لأن الدم الفلسطيني كتب الحقيقة بحروف لا يمكن إنكارها: الغرب لم يكن يوماً رمزاً للعدالة، بل كان يستعمل الأخلاق كأداة استعمارية ناعمة… حتى سقطت، في غزة، سقوطاً مريعاً.
في الختام، لا يمكن القول إن الأستاذ أحمد عصيد هو من خسر المناظرة، فالأمر أبعد من شخص يجلس على كرسي مواجهة فكرية. الحقيقة أن المنظومة الفكرية التي حملها على كتفيه لعقود هي من انهارت وتركته وحيدًا في منتصف الحلبة. لم يهزمه الدكتور طلال لحلو بقدر ما خانه الخطاب الذي ظل يقدسه: شعارات براقة بلا عمق، ومرجعية غربية لم تعد قادرة على تبرير نفسها أمام واقع ينهار أخلاقيًا وفكريًا. الأستاذ عصيد لم يُهزم كمحاور، بل كممثل لفكرة لفظت أنفاسها الأخيرة على الهواء مباشرة.
د. نبيل عادل/ أستاذ باحث في الاقتصاد والعلاقات الدولية، عضو المجلس الوطني للحركة الشعبية