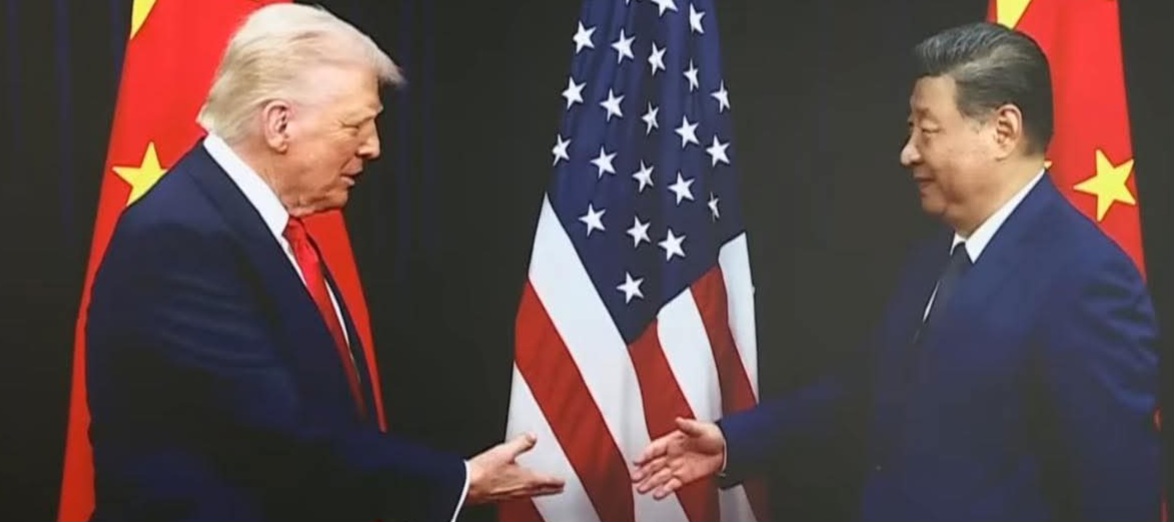تعود مسألة الهوية المغربية لتفرض نفسها من جديد على الساحة الفكرية والسياسية، بين من يقرؤها من زاوية تراكمية ثقافية جامعة، ومن يختزلها في بُعد عرقي ضيق يقفز على حقائق الجغرافيا وعمق التاريخ. وفي خضم هذا النقاش، جاءت رسالة الأستاذ محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، كرد صريح ومسؤول على المقاربات الإقصائية، لتعيد تموقع النقاش في سكته الأصلية: الدفاع عن التنوع في إطار وحدة وطنية لا تتجزأ، والاعتراف بجميع مكونات الهوية المغربية بوصفها روافد لا متنافية، بل متكاملة.
في هذا المقال، نقف أولًا عند سياق الرسالة وتفاعلاتها الفكرية، ثم ننتقل إلى قراءة تحليلية في مرتكزاتها وتداعياتها، على ضوء الرهانات الوطنية الكبرى المرتبطة بوحدة المجتمع وتماسك الدولة.
السياق
في رسالته المفتوحة إلى المؤرخ عبد الخالق كلاب، قدم السيد محمد أوزين رؤية فكرية متماسكة لقضية الهوية المغربية، تنطلق من إيمان عميق بأن المغرب ليس نتاج عنصر واحد، بل هو حصيلة تراكمات حضارية وثقافية متعددة، شكلت عبر القرون نسيجه الوطني الغني والمعقد في آن واحد.
ينتقد أوزين، بوضوح ودون مواربة، كل مقاربة تقصي أحد مكونات الهوية المغربية أو تختزلها في بعد لغوي أو عرقي وحيد، ويرد على ما اعتبره تأويلاً مجتزأً لمداخلته في مؤتمر حزبي، بكونه مجرد إشادة بتوازن الخطاب الحزبي في استحضار الانتماء العربي الإسلامي، دون إغفال البعد المحلي والوطني، لكنه لم يكن إقصاءً للأمازيغية، بل تعبيرًا عن رؤية تقوم على التعدد والاحتواء، لا على الإلغاء والتنافي.
ويؤسس محمد أوزين مواقفه على قراءة أنثروبولوجية وتاريخية تعتبر المغرب أرض التلاقي لا التصادم، وفضاء للتلاحم لا للتفكك. فالمغرب، كما يذكر، كان دائمًا نقطة التقاء للفينيقيين والرومان والوندال والأمازيغ والعرب، ضمن إطار وحدوي صاغته قيم الإسلام السمحة وروح الوطن الجامعة. لذلك، فهو يرفض ما يسميه بـ"القراءة الأحادية للتاريخ" التي تنسف التراكم المشترك، وتتناقض مع فلسفة دستور 2011، الذي نص صراحة على تعددية الهوية المغربية، واعتبر الأمازيغية والعربية والحسانية والعبرية والأندلسية روافد متكاملة في إطار وحدة وطنية غير قابلة للتجزئة.
كما يؤكد أوزين أن الدفاع عن الأمازيغية لا ينبغي أن ينقلب إلى تعصب عرقي، ولا أن يقع في فخ نفس الإقصاء الذي طالها تاريخيًا. فالنضال من أجل الأمازيغية، كما يراه، هو نضال من أجل شمول المواطنة، لا من أجل التفوق الهوياتي. وهو ما يجعله ينتقد بقوة أي خطاب يسعى إلى استبدال هيمنة بهيمنة أخرى، أو إلى تصفية حسابات سياسية بلغة التاريخ والهوية.
وفي رده على الباحث الذي اتهمه بإغفال الأمازيغية، يلفت أوزين الانتباه إلى مفارقة لافتة: كيف لمن يطالب باستحضار الأمازيغية أن لا يستعملها حتى في خطابه النقدي؟ وكيف لمن يتحدث عن الإقصاء أن يمارس نوعًا منه باسم الدفاع عن المكون الثقافي الأمازيغي؟ إنها، بحسب أوزين، مفارقة تكشف عن نزعة انتقائية في التعاطي مع قضية الهوية، تتغافل عن أن "الوطن للجميع أو لا يكون".
ولا يفوت محمد أوزين، في رسالته، أن يضع الموقف الحركي من الهوية في سياقه التاريخي والسياسي. فالحركة الشعبية، كما يشدد، لم تكن يومًا حزبًا ذا لون لغوي أو عرقي، بل كانت ولا تزال حركة وطنية انبثقت من رحم المغرب العميق، وضحى مناضلوها بالنفس والنفيس انتصاراً لقضايا المغاربة في السهل والجبل والساحل، بالأمازيغية والعربية، دون تمييز. وهي، بحسب تعبيره، "لا شرقية ولا غربية"، بل مغربية خالصة، تجسد الوحدة في التنوع وترفض مزايدات الإقصاء أو المتاجرة بالهويات.
لقد قدّم السيد محمد أوزين، من خلال هذه الرسالة، درسًا في الفهم الوحدوي للهوية، يقوم على الإيمان بأن مغرب المستقبل لا يُبنى على تصنيفات عرقية أو لغوية، بل على أساس المواطنة الجامعة، والاعتزاز بكل الروافد في إطار وطني موحد. هويته ليست نقيضًا لهويتي، بل امتداد طبيعي لها، ومغربيته ليست قابلة للتجزئة أو للتأويل السياسي الضيق.
وبهذا المعنى، فإن دعوته لعقد ندوة فكرية ضمن أكاديمية لحسن اليوسي حول سؤال الهوية المغربية، ليست مجرد دعوة للحوار، بل دعوة لتأسيس نقاش وطني مسؤول، ينطلق من واقع التنوع المغربي، لكنه يتجه نحو مشروع وحدوي جامع، لا يُقصي أحدًا ولا يُفضل أحدًا، بل يعترف بالجميع في إطار مغرب موحد، متجذر في تاريخه، ومفتوح على مستقبله.
القراءة
ما يجب التأكيد عليه، في سياق هذه الرسالة وفي جوهرها، هو أن مقاربة السيد محمد أوزين لقضية الهوية ليست مقاربة عرقية أو إثنية، بل هي مقاربة ثقافية عاقلة وواعية تنأى بنفسها عن الانزلاقات الخطيرة التي قد تؤدي إلى تفتيت النسيج الوطني. فحين تختزل الهوية في عرق أو لون أو لغة، نكون بصدد زحف خطير نحو نزعات انفصالية، سبق أن عرفها التاريخ الأوروبي في القرن التاسع عشر، حين تحوّل خطاب "القومية العرقية" إلى مقدمة دامية للحرب العالمية الأولى. كما لا يخفى أن انهيار يوغوسلافيا، والحرب الأهلية في رواندا، وبعض أزمات دول الساحل الإفريقي، كلها أمثلة تؤكد أن اللعب بورقة العرق هو لعب بالنار. المغرب، بحكم تاريخه وتركيبته المتعددة، لا يحتمل هذا النوع من التوتر الهوياتي، لأنه ببساطة أمةٌ لم تُبْنَ على الدم، بل على التراكم الحضاري والتعدد الثقافي والانصهار التدريجي في بوتقة وطنية جامعة ومانعة.
إن ما يقترحه السيد محمد أوزين ليس دفاعًا عن عنصر ضد آخر، بل قراءة وطنية للهوية تعتبر أن العربية ليست لغة عرق، بل لسان حضارةٍ دينيةٍ وثقافية بَنَت مجدًا عابرًا للقبائل والجغرافيا، تمامًا كما أن الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية ما كانت لتنتشر في القارات الخمس لو ارتبطت بنزعة قبلية أو عرقية ضيقة. وعلى نفس المنوال، فإن الثقافة الأمازيغية ليست حكرًا على الأمازيغ، بل هي تراث مشترك لكل المغاربة، ننهل منها ونفخر بها جميعًا، كما نفخر بمكتسبات حضارية من مشارب مختلفة، ما دامت تصب في وعاء المواطنة والكرامة الإنسانية.
ثم كيف يُطلب من السيد محمد أوزين، وهو رجل سياسة وزعيم حزب وطني كبير مارس المسؤولية الحكومية ويطمح مجددًا إلى المساهمة في تدبير الشأن العام، أن يوحّد المغاربة حول "بديل حركي" جامع، إذا أقصى مكوناً للأمة انتصاراً لمكون آخر؟ وكيف يستقيم هذا التناقض، وهو الذي لم يتردد في التأكيد على أن الوطن للجميع، وأن التعدد قوة، وأن مغرب اليوم والغد ليس بحاجة إلى مزيد من الشروخ في الجدار الوطني، بل إلى جسور توصل بين المكونات لا جدران تُقام بينها؟
ومن المهم، في هذا السياق، ألا نغفل أن واحدة من أبرز أدوات الاستعمار، ثم الهيمنة النيو-استعمارية لاحقًا، كانت دائمًا اللعب على وتر الهويات الفرعية والإثنية والطائفية. فقد استُخدم هذا السلاح بفعالية مدمّرة في تفكيك المجتمعات العريقة، كما حدث في العراق وسوريا ولبنان، وفي السودان وليبيا وأفغانستان، بل حتى في مصر أيام الحماية البريطانية، حين حاولت سلطات الاحتلال تغذية الصراع بين المسلمين والأقباط. لم يكن الهدف حماية أي مكون من مكونات المجتمع، بل تفجير نسيجه من الداخل، ليُصبح هشًّا وقابلاً للاختراق، وتُصبح الأمة كلها عاجزة عن مقاومة السيطرة الخارجية، فيسهل استنزاف ثرواتها وتمييع سيادتها.
إن أخطر ما يمكن أن نواجهه اليوم هو إعادة تدوير هذه الأدوات، تحت عناوين جديدة، ظاهرها الدفاع عن الحقوق، وباطنها تفخيخ الوحدة الوطنية، وتحويل التعدد إلى تمزق، والاختلاف إلى تناحر. المغرب، بتاريخه الموحد رغم تنوعه، يشكل استثناءً إيجابيًا يجب حمايته، لا تفكيكه. واليقظة الفكرية والسياسية في مواجهة هذا المخطط يجب أن تكون واجبًا وطنيًا مشتركًا، لا مجرد موقف سياسي ظرفي.
وهنا، لا بد من التذكير بأن دور المثقف الحقيقي ليس تأجيج الانقسامات، ولا النفخ في رماد الهويات الفرعية من أجل مجد شخصي زائف أو وهج إعلامي مؤقت. بل إن الوظيفة النبيلة للمثقف العضوي هي حماية المجتمع من الانزلاق نحو الفتنة، والتنبيه إلى مخاطر خطاب التقسيم والتموقع الهوياتي الضيق. فالمثقف ليس زعيم قبيلة، ولا وصيًا على فصيل دون آخر، بل هو حامل لواء الوعي الجمعي، المدافع عن التوازن، والرافض للانجرار وراء استقطابات عرقية أو طائفية تُهدد وحدة الوطن واستقراره.
إن من يُفترض فيهم أن ينيروا الرأي العام بالمعرفة، لا يليق بهم أن يصبوا الزيت على النار، فقط لأنهم وجدوا في خطاب الاستفزاز سوقًا رائجة. فالغنيمة الرمزية لا تُبرر تقويض السلم الاجتماعي، ولا تُغتفر إذا ما كانت نتيجتها تمزيق عقد المواطنة. والمغرب، بتاريخه ومكانته، أكبر من أن يكون مادة لرهانات شخصية ضيقة، وأغلى من أن يُضحى بوحدته على مذبح نرجسيات فكرية عابرة.
لكن المشكلة الأكبر ليست فقط في التأويل المغلوط، بل في صعود بعض "المثقفين المستجدين" الذين جعلوا من المزايدة العرقية تجارة رمزية يبيعون بها أوراق "النضال الهوياتي" في سوق الولاءات الضيقة. هؤلاء، وهم يرفعون شعار الدفاع عن الثقافة الأمازيغية – أو غيرها – ينزلقون إلى خطاب إقصائي يضرب إحدى أهم مقومات المغرب الحديث: وحدة الانتماء والمصير. يوقدون شمعة لأنفسهم ويحرقون وطناً بأكمله، ومن أجل لحظة من البروز الإعلامي أو الأكاديمي، يزرعون بذور الفتنة في وطن لم يكن يومًا قابلاً للانشطار.
لحسن الحظ، ما زال في المغرب زعماء وطنيون مستنيرون ممن يمتلكون قراءة متوازنة للتاريخ ومشروعًا وطنيًا جامعًا للمستقبل، ويؤمنون أن المغرب ليس رقمًا صغيرًا على هامش الحضارة، بل أمةٌ مدعوة من جديد إلى أداء دورها في مسرح التاريخ الإنساني، عبر نموذجها الفريد في التعدد، والاعتدال، والارتكاز على إرث حضاري مشترك يؤمن بالاختلاف تحت سقف الوحدة.
د. نبيل عادل، أستاذ باحث في الاقتصاد والعلاقات الدولية