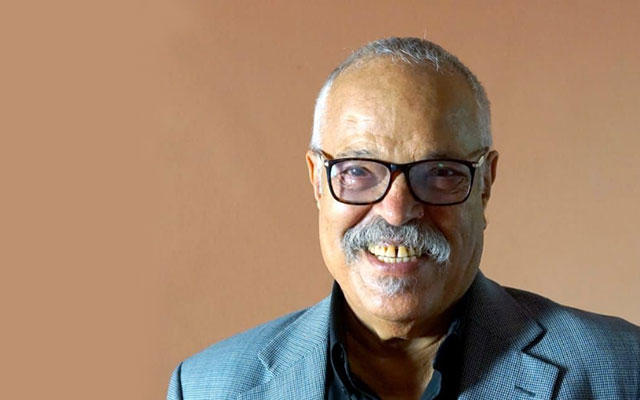لوحظ خلال 23 سنة الأخيرة من الإنتاج التّشريعي للقوانين التي لها علاقة بالتجريم والعقاب أن هناك تضخما، وأحيانا توسيع دائرة العقاب، لا في قانون الشكل ولا في قانون الموضوع، من حيث أن المشرّع أنحى منحى تشديديّا في تجريم عدد من الظواهر. وأخص بالذكر قانون الإرهاب، الغش في الامتحانات، شغب الملاعب، إهانة رموز المملكة، وغيرها من الأعمال والظواهر التي طالها التجريم والعقاب.
إلاّ أنه في المحافل الدولية، دائما يصطدم المغرب بما يسمى بـ "قواعد طوكيو ،"بمعنى آخر أن المغرب مطالب بتقديم بعض التوضيحات حول وقائع محينة، والمشكل يعود للتشريع. وما فتئت الأمم المتحد تطالب بإضفاء الطابع الإنساني على السياسة الجنائية، بخصوص الشكل والموضوع.
والمغرب قد تراجع، تدريجيا، عن مجموعة من القواعد التشريعية التي تجرم مجموعة من الظواهر أبرزها قانون النشر والصحافة، الذي كانت الحكومة السابقة تسوق له، وأنه منتوج تشريعي جيّد وممتاز، خاليا من النّصوص التي تنص على عقوبات سالبة للحرية، إلا أنه من بعد هذا القانون، مجموعة من الصّحافيين في السّجن. كيف سنفسّر هاته الظاهرة؟.
العقوبات السالبة للحرية الذي جعل الغرب يتأخر في إصدار هاته القوانين التي أُثير بشأنها نقاش مجتمعي بين القانونيين والحقوقيين وغيرهم، إلا أنه ليس هناك سبب وحيد أخّر مشروع قانون العقوبات البديلة، متداخلة ومتعددة ومعقّدة.
فحينما نرى مشروع قانون تنفيذ العقوبات للمؤسسات السجينة والجهة القانونية الرّسمية التي تسهر على تنفيذ العقوبة، إلا أن المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج دقت ناقوس الخطر بشأن الإعتقال الإحتياطي. وهذا مؤشر وإنذار للخطر حول الطاقة الاستيعابية للسجون، وحول الجدوى من سن عقوبات سالبة للحرية في جميع الجرائم، إن لم نقل أغلبها. والجهة التي أوكل لها تنفيذ العقوبة السجنية، والطاقة الاستيعابية تفوق نزلاء السّجون.
والإشكال في قانون العقوبات البديلة يصعب أن يتم تطبيقه من قبل جهة واحدة، لأن سياسة التجريم والعقاب شأن مجتمعي يجب أن يكلف به ويتدخل فيه جميع المتدخلين، بدءا من الضابطة القضائية والجهاز القضائي ككل، وانتهاء بالمؤسسات السّجينة، والمؤسسات التّعليمية.
ما نلاحظه حاليا، أن العقوبات السّالبة للحرّية قد تكون دافعا لحالة العود، وقد تكون دافعا لإخراج مجرمين آخرين أشد خطورة على الأمن العامّ ممّا كانوا عليه قبل أن يكونوا عليه في أحكام وعقوبات سالبة للحرية.
وفي مشروع العقوبات البديلة هناك تغييب للضّحية، والضحية هو القريب من الجريمة، هو الذي يعاني من أثر الجريمة المباشر، قبل أن يكون المجتمع، فتغييب حقوقه في سن مثل هاته القوانين فيه نوع من الإجحاف، ونوع من الاقصاء من الجريمة التشريعية ككل.
وبخصوص التأهيل الطبي واستعمال السّوار الإلكتروني وغيره، فلكل سياسة تجريمية ثمن، ضروري أن تكون هناك تعثرات، وضروري أن ترصد اعتمادات مالية ومبالغ وأغلفة مالية وأطقم طبية ولوجستيكية، علينا أن نهيء لها، فعلينا أن نعدّ لها.
مسألة شراء العقوبة سيؤدي إلى اختلال في منظومة وفلسفة التّجريم والعقاب. فمن يملك المال يستطيع أن "يشتري"العقوبة السّجنية والغرامة، ومن لا يملكه سيؤدي به إلى، ممّا سيؤدي إلى تكريس نوع من الطّبقية على حالتها.
والمغرب قد تراجع، تدريجيا، عن مجموعة من القواعد التشريعية التي تجرم مجموعة من الظواهر أبرزها قانون النشر والصحافة، الذي كانت الحكومة السابقة تسوق له، وأنه منتوج تشريعي جيّد وممتاز، خاليا من النّصوص التي تنص على عقوبات سالبة للحرية، إلا أنه من بعد هذا القانون، مجموعة من الصّحافيين في السّجن. كيف سنفسّر هاته الظاهرة؟.
العقوبات السالبة للحرية الذي جعل الغرب يتأخر في إصدار هاته القوانين التي أُثير بشأنها نقاش مجتمعي بين القانونيين والحقوقيين وغيرهم، إلا أنه ليس هناك سبب وحيد أخّر مشروع قانون العقوبات البديلة، متداخلة ومتعددة ومعقّدة.
فحينما نرى مشروع قانون تنفيذ العقوبات للمؤسسات السجينة والجهة القانونية الرّسمية التي تسهر على تنفيذ العقوبة، إلا أن المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج دقت ناقوس الخطر بشأن الإعتقال الإحتياطي. وهذا مؤشر وإنذار للخطر حول الطاقة الاستيعابية للسجون، وحول الجدوى من سن عقوبات سالبة للحرية في جميع الجرائم، إن لم نقل أغلبها. والجهة التي أوكل لها تنفيذ العقوبة السجنية، والطاقة الاستيعابية تفوق نزلاء السّجون.
والإشكال في قانون العقوبات البديلة يصعب أن يتم تطبيقه من قبل جهة واحدة، لأن سياسة التجريم والعقاب شأن مجتمعي يجب أن يكلف به ويتدخل فيه جميع المتدخلين، بدءا من الضابطة القضائية والجهاز القضائي ككل، وانتهاء بالمؤسسات السّجينة، والمؤسسات التّعليمية.
ما نلاحظه حاليا، أن العقوبات السّالبة للحرّية قد تكون دافعا لحالة العود، وقد تكون دافعا لإخراج مجرمين آخرين أشد خطورة على الأمن العامّ ممّا كانوا عليه قبل أن يكونوا عليه في أحكام وعقوبات سالبة للحرية.
وفي مشروع العقوبات البديلة هناك تغييب للضّحية، والضحية هو القريب من الجريمة، هو الذي يعاني من أثر الجريمة المباشر، قبل أن يكون المجتمع، فتغييب حقوقه في سن مثل هاته القوانين فيه نوع من الإجحاف، ونوع من الاقصاء من الجريمة التشريعية ككل.
وبخصوص التأهيل الطبي واستعمال السّوار الإلكتروني وغيره، فلكل سياسة تجريمية ثمن، ضروري أن تكون هناك تعثرات، وضروري أن ترصد اعتمادات مالية ومبالغ وأغلفة مالية وأطقم طبية ولوجستيكية، علينا أن نهيء لها، فعلينا أن نعدّ لها.
مسألة شراء العقوبة سيؤدي إلى اختلال في منظومة وفلسفة التّجريم والعقاب. فمن يملك المال يستطيع أن "يشتري"العقوبة السّجنية والغرامة، ومن لا يملكه سيؤدي به إلى، ممّا سيؤدي إلى تكريس نوع من الطّبقية على حالتها.
عمر الدّاودي، الحقوقي والمحامي لدى هيئة المحامين بالرباط