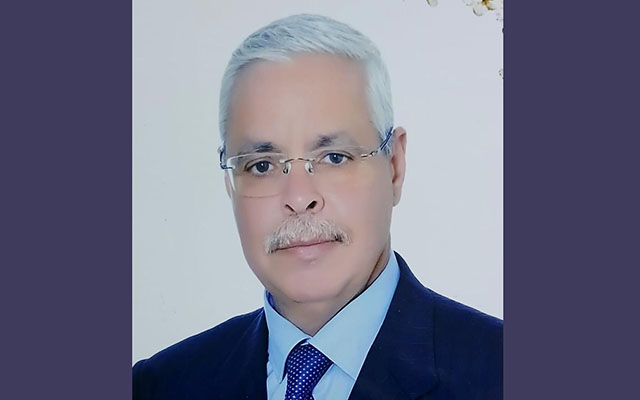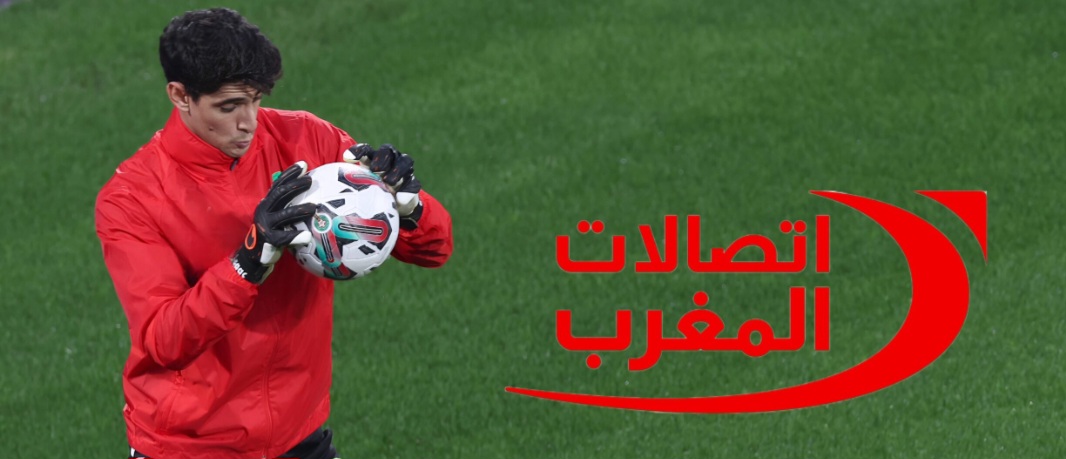في مثل هذا اليوم منذ 21 سنة نشرت لي جريدة "الصحيفة" التي تعتبر جريدة "الأيام" استمرارا لها، مقالة نظرية تحت عنوان "المجتمع المدني وإشكالياته النظرية"، الجريدة تصرفت في العنوان لكن ذلك لم يؤثر على المقالة/ الدراسة المصغرة التي كنت قد هيئتها قبل سنة من تاريخ نشرها..
ولأن المقالة ما زالت تحتفظ بكامل راهنيتها، أعيد نشرها، خاصة وأن النقاش الذي مر بالجمعية المغربية لحقوق الانسان بشأن الفصل بين السياسي والمدني أظهر لي أننا ما زلنا بحاجة لهذه الأدبيات..
الجزء الأول:
المجتمع المدني اصطلاح لاتيني قديم استعمله أرسطو. ويعتبر تاريخ هذا المفهوم هو تاريخ تحولات دلالاته منذ تشكله الاول مارا بتشكيلات المعرفة التي تعبر عن ظرفيات تاريخية متميزة، و في كل تكون للمعرفة يأخذ مفهوم المجتمع المدني بدوره معنى جديدا متميزا عن المعنى القديم ومواكبا للتطورات التي تعرفها كل من البنيتين التحتية والفوقية، فهو في معناه اللاتيني القديم يعني مجموعة سياسية أعضاؤها هم المواطنون الذين يعترفون بقوانين الدولة ويتصرفون وفقها، وفي مرحلة ما بعد القرون الوسطى أصبح المجتمع المدني يعني كل تجمع بشري خرج من حالته الفطرية إلى الحالة المدنية التي تتمثل بوجود هيئة سياسية تضبط نظام المجتمع، أي أن المجتمع المدني هو المجتمع المنظم سياسيا. ولا مجال في هذه المرحلة للتمييز بين الدولة والمجتمع، وفي سنة 1767 ألف الفيلسوف الاسكتلندي آدم فرجسون كتابا بعنوان: "مقال في تاريخ المجتمع المدني" طرح فيه أسئلة حول تمركز السلطة السياسية واعتبر الحركة الجمعياتية هي النسق الاحسن للدفاع ضد مخاطر الاستبداد السياسي وسجل ان تطور المبادلات التجارية وتقسيم العمل وازدهار الصناعات اليدوية وكذا التخصص العسكري يعتبر بمثابة انتقال من الحياة البربرية نحو مجتمع متحضر، غير أن هذه الحركة تحمل في ذاتها خطر ذوبان الفكر المدني الذي يعتبر حياة المواطنين في اليونان القديمة والجمهورية الرومانية، هاتان الدولتان تمثلان بالنسبة لفرجسون نموذج المجتمع المدني المحكوم بالقوانين مع المشاركة الدؤوبة للمواطنين، إلا ان سؤالا ظل مطروحا بالنسبة له وهو كيف يتم السير في طريق تحضير المجتمع في حصانة عن خطر سقوطه في الطغيان وفي عسكرة النظام السياسي للمجتمع المدني، فرجسون أجاب عن سؤاله بأن رأى أن الحل هو مضاعفة تجمعات المواطنين في كل مجالات الحياة الاجتماعية التي من بينها العدالة والجيش، لكنه لم يشر إلى الكيفية التي يتم بها ذلك وسبب عجزه ذاك يعود إلى أزمة النمط الفكري التقليدي الذي سبق الثورة الفرنسية.
أما توماس هوبز فهو أول من فرق بين الدولة والمجتمع في كتابه حقوق الانسان عام 1791 بحيث أنه دعا إلى حكومة محددة الوظائف ومجتمع مدني حر وسام، إلا أن دعوته تلك لم تجد صداها في فترة نمو المجتمع الرأسمالي.
وإذا جاز لنا أن نصنف المقاربات السياسية ضمن إشكاليات المجتمع المدني يمكن محورتها كما صاغها كل من هوبز وجون لوك وكارل ماركس وغرامشي.
مقاربة هوبز:
في المرحلة الاولى من التاريخ الحديث هيمن النموذج الذي نظر له هوبز الذي يعتبر أن المجتمع المدني هو خروج من حالة الطبيعة بما تعنيه من فوضى وبربرية واقتتال للدخول الى حياة مدنية منظمة تتأسس فيها على انقاض الطبيعة دولة تعتبر بمثابة ساعة تضبط سلوك الافراد وتحميهم وتضمن لهم النظام والسلام.
مقاربة جون لوك:
يعتبر جون لوك من مهندسي نظرية التعاقد الاجتماعي وفي مقاربته حول المجتمع المدني تبنى فلسفة هوبز واعتبر المجتمع المدني هو مجتمع المدنية والتحضر ومجتمع خروج من البربرية ليلتف أعضاؤه حول اتفاق تعاقدي يصبح في إطاره القانون هو الذي يسمو ليكون مرجعية لتنظيم العلاقات الاجتماعية بين الناس، أي أنه هو المنظم وضامن الحرية، وفي كتابه "في المجتمع المدني" يقول جون لوك... وهكذا فحيث يؤلف عدد من الناس جماعة واحدة، ويتخلى كل منهم عن سلطة تنفيذ السلطة الطبيعية التي تخصه ويتنازل عنها للمجتمع، ينشأ عندنا حين ذاك فقط مجتمع سياسي أو مدني. وإضافة إلى الادوار التي يعطيها هوبز للمجتمع المدني فإن جون لوك يضيف إليه مهمة المحافظة على الأملاك.
مقاربة هيغل:
في كتابة الصادر سنة 1821 "نقد فلسفة الحق" هزأ هيغل من دولة العقد الاجتماعي التي تعتبر الدولة شيئا مصطنعا تواضعت على تأسيسه جماعة سياسية لتخرج من حالة الطبيعة الى حالة المدنية و اعتبر المجتمع المدني في ظل دولة التعاقد مجتمعا غير قادر على ضمان العقل والأمن، ونظر إلى الدولة على أنها هي الاصل والجوهر وليست فقط صنيعة العقد الاجتماعي، لذلك اعتبر أن المجتمع المدني هو فقط مظهر من مظاهر الدولة أرقى نسبيا من الاسرة، ومجاله هو تقسيم العمل وإنتاج وتبادل الخيرات المادية أي مجال لتنافس المصالح المتعارضة في سياق سعي الأفراد لإشباع حاجاتهم، في حين أن الدولة هي الممثلة للمصلحة العامة أي ضامنة مصالح المجتمع المدني.
مقاربة كارل ماركس:
استعمل ماركس الشاب في مؤلفاته مفهوم المجتمع المدني بمعاني قريبة من الدلالات التي نجدها للمفهوم في نصوص هيغل، أن المجتمع المدني هو مجال تضارب وتصارع المصالح الاقتصادية حسب القيم البرجوازية، وقد تخلى ماركس فيما بعد عن المفهوم وتحدث عن المجتمع البرجوازي، وفي سياق نقده للمثالية الهيغلية في مختلف مستوياتها نظر ماركس الى المجتمع المدني باعتباره الاساس الواقعي للدولة و قد شخصه في مجتمع العلاقات المادية للأفراد في مرحلة محددة من مراحل تطور قوى الانتاج. و عند دراسة ماركس لبنية المجتمعات الرأسمالية كان يقيم تمييزا تاما بين الدولة باعتبارها الاداة الطبقية لسلطة الطبقة السائدة اقتصاديا وإديولوجيا وبين المجتمع، وهو الأمر الذي جعله يتجاوز المنظور الليبرالي للدولة. وقد ساهمت مفاهيم الصراع الطبقي والبنية الفوقية والتحتية واستراتيجية الثورة البروليتارية في صياغة رؤية فلسفية وسياسية دينامية ومتطورة بالمقارنة مع التحليلات السياسية التي بلورتها نظرية التعاقد. وفي مؤلفات ماركس الناضج حسب التعبير الالتوسيري، نجد مفهوم المجتمع المدني الذي يتطابق مع مفهوم البنية التحتية، بل إن ماركس لم يعد يستعمل المفهوم وحاول بواسطة الزوج المفهومي بنية تحتية و بنية فوقية الإمساك بالأسس المادية و الإديولوجية المؤطرة للوجود المجتمعي.
مقاربة غرامشي:
بعد غياب لبضعة عقود من الزمن عاد مصطلح المجتمع المدني الى الظهور، لكن هذه المرة مع أنطونيو غرامشي الذي استعمله استعمالا مغايرا ووسع دلالاته، و يشتمل مفهوم المجتمع المدني عند غرامشي في سياق تجديداته للفكر الماركسي ومحاولة إيجاد أجوبة علمية على الاسئلة التي يطرحها الواقع الايطالي في النصف الاول من القرن العشرين الذي يختلف عن الظروف الروسية التي تمت فيه ثورة 1917، ذلك الواقع الذي يحتاج الى هيمنة إديولوجية لنجاح الثورة الاشتراكية، من هنا فالمجتمع المدني عند غرامشي مجاله هو البنية الفوقية في إطار ممارسة الصراع الإديولوجي من أجل تحقيق هيمنة فكرية للثقافة التحررية التي يحمل لواءها المثقف العضوي الفرد -أي المناضل الشيوعي- والمثقف الجمعي موجه الثوريين و قائد الطبقة العاملة و هو الحزب الشيوعي، و انطلاقا من كون غرامشي يعتبر المجتمع المدني مجموع التنظيمات المرتبطة بوظيفة الهيمنة الإديولوجية، فهو يدخل بذلك المدرسة والكنيسة والنقابات والجمعيات كمكونات للمجتمع المدني.
خلاصة القول فالمجتمع المدني كمفهوم وآلية عمل تبلور مع مطلع القرن 17 وجاء معبرا عن الفلسفة الليبرالية مهدما لنظرية الحق الالهي للملوك في الحكم، وعلى أنقاضها أسس ذاته كناسخ لسلطة دنيوية، وكان معبرا فعليا على المجتمع الرأسمالي الناشئ، غير أن غرامشي حور المفهوم ليستعمله في معركته الإديولوجية ضد الفكر الرأسمالي.
فإلى أي حد كانت هناك استمرارية لهاتين المقاربتين في النصف الثاني من القرن 20، وخصوصا في الوطن العربي؟
الجزء الثاني:
خلال سنوات السبعينات عاد مفهوم المجتمع المدني إلى الرواج من جديد بواسطة مثقفين ليبراليين في أروبا الشرقية، وكذلك مثقفين محافظين جدد في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، أما في العالم العربي فإن الاهتمام بمفهوم المجتمع المدني سيطرح لأول مرة في نفس الفترة تقريبا في إطار الرجوع الى المنظومة السياسية الليبرالية بعد فشل الثورات العربية بمختلف تلاوينها (قومية، اشتراكية، اسلامية)، وبعد أن فقد مصطلح النهضة العربية والثورة العربية بريقهما، لكن استعمال المصطلح على المستوى العربي كان استعمالا عشوائيا، ودون إرادة في التأصيل أو أية عودة للجذور الفلسفية للمفهوم. وتعتبر تونس والجزائر هما السباقتان زمنيا للتفاعل مع المفهوم.
بمصر و لبنان استعملت كلمة شارع لمدة طويلة قبل استعمال المجتمع المدني لترمز الى العامة ورأيها، وفي الجزائر يعني المجتمع المدني الشعب في تنوعه، أما في تونس فبدأ استعمال مصطلحات الجمهورية المدنية والمجتمع المدني بعد التدخل الثالث للجيش لإعادة النظام وهنا تم تحميله شحنة نضالية، فهو يعني تعدد التنظيمات التلقائية المستقلة عن الدولة التي يعبر من خلالها الشعب عن آرائه ورغبته في التخلص من قمع الدولة وهيمنة الحزب الوحيد، والفكرة الكامنة وراء الشحنة النضالية التي أعطيت له هي أن أية جمهورية مدنية معرضة في أي وقت للانقلاب العسكري إذا لم ترتكز على شبكة من المؤسسات المستقلة للمجتمع المدني لتحصينها، وهذا الفهم دفعت به نخبة ذات توجهات ليبرالية جرى إقصاؤها من الحزب الدستوري مع بداية السبعينات ليخلو الجو فيه للعناصر الأكثر انتهازية والأكثر خمولا وخضوعا، أما قوى اليسار والإسلاميين بتونس فلم يكونوا مهيئين لاستخدام الاصطلاح الى حدود 7 نونبر 1987، بعد ذلك التاريخ أصبح المفهوم يدل على استقلال الأحزاب السياسية والتنظيمات الاجتماعية والمهنية عن الدولة التي كانت تهدد استقلالية المجتمع المدني، لكن بعد سنة 1990 أصبحت فئات واسعة تنظر الى حركة النهضة على أنها مصدر تهديد للمجتمع.
إلى جانب مفهوم المجتمع المدني هناك مفهوم المجتمع الأهلي الواسع الانتشار في الكتابة السياسية العربية في المشرق، ويعتمده بعص الكتاب العرب في صياغة طروحاتهم معتبرين المجتمع الاهلي وليد الخصوصية العربية، وهو فعلا متمايز نوعيا عن المجتمع المدني لكون مكوناته هي المؤسسات التضامنية التقليدية التي تحتفظ للمجتمع بحدود معينة من استقلاله، وتلعب دورا دفاعيا اتجاه التدخل السياسي والاجتماعي للسلطة المركزية. وهذه التنظيمات تشمل القبيلة والعشيرة والعائلة والطائفة والزاوية، وتقوم على رابطة علاقة الدم والولاء القبلي والديني والعرقي، وهذا التضامن العصبوي يحتوي تراتبية في السلطة وفوارق على مستوى الكسب المادي، فهو بالتالي يعيد إنتاج علاقاته السلطوية، والمجتمع الأهلي هذا يضرب بعروقه في جذور التاريخ والمجتمع.
المجتمع المدني بالمغرب:
دلالة المجتمع المدني بالمغرب:
بالمغرب كباقي الدول العربية بدا تداول مفهوم المجتمع المدني في عقد السبعينات، وبنهاية الثمانينات وبداية التسعينات اصبح المصطلح الاعجوبة، مصطلح زئبقي يتكلم به الجميع و يعني جميع الاشياء، فهو يعني الشعب المتحضر، ويعني الديموقراطية وحقوق الانسان ودولة التعددية، ويعني مجموع المؤسسات الحديثة المستقلة عن الدولة، وتدخل ضمنه أحيانا مؤسسات "المجتمع الاهلي"، ويشير كذلك الى مجتمع مزدهر اقتصاديا، ويصبح أحيانا المشروع المجتمعي المنشود. وانطلاقا من كل هذه الحمولات التي يحملها مفهوم المجتمع المدني يمكن محورة هذه الطروحات في خمس تعريفات رئيسة وهي :
- أن المجتمع المدني هو اداة عمل وبالتالي فهو يعني الحزب والنقابة والجمعية وغيرها من المؤسسات التي تأطر العمل السياسي والثقافي.
-أن المجتمع المدني هو مقياس لتطور المجتمع ويكون عبارة عن شعار تحته يتم إحراز مستوى معين من التطور الحضاري.
- أن المجتمع المدني هو جوهر يجب تحقيقه، وهنا هو بذاته يعني حقوق الانسان والديموقراطية.
-المجتمع المدني هو فضاء لممارسة الصراع بما يعني أنه ساحة يجب استعمال أدواتها لتهديم الوضع السائد وبناء البديل المنشود على أنقاظ ذلك.
-أن المجتمع المدني هو أداة و جوهر، أي انه أداة لتحقيق التطور والغاية هو مجتمع متحضر ليبرالي.
وكل الطروحات أعلاه تتفق بشكل أو بآخر على إسناد مهمة حماية المجتمع من الاستبداد للمجتمع المدني مما يفتح لها -أي المؤسسات المستقلة للمجتمع المدني- آفاقا ويتيح لها لعب دور أساس في إعادة صياغة المجتمع السياسي في ضوء الصراع الاجتماعي .
هل يوجد مجتمع مدني بالمغرب؟
مقومات المجتمع المدني :
- وجود دستور مكتوب كان أو عرفيا.
- فصل بين الدين و الدولة.
- فصل بين السلط الثلاث.
- وجود مؤسسات منتخبة بشكل حر ولها صلاحيات.
- وجود تعددية حزبية.
- وجود أحزاب ونقابات وجمعيات في مختلف المجالات قوية ومستقلة حقا عن الدولة.
- سيادة القانون والديموقراطية وحقوق الانسان.
- بنى اقتصادية واجتماعية متطورة.
فهل يا ثرى تتوفر لدينا بالمغرب هذه المقومات حتى نقول بوجود مجتمع مدني لدينا؟
بالمغرب يوجد دستور مكتوب لكنه ليس دستورا يؤسس لدولة ديموقراطية حديثة، وتوجد لدينا أحزاب عديدة ولها فعل في الساحة إلا أن بعضها تابع وأداؤها لا يزال بعيدا عن ان يستطيع تحقيق المجتمع المدني، و ببلادنا أيضا هناك مؤسسات منتخبة، لكنها مزيفة ولا صلاحيات لها. وببلادنا لازالت البنى الاقتصادية ضعيفة والبنى الاجتماعية تقليدية، ومازلنا نعاني من خرق القانون وانتهاك حقوق الإنسان.
خلاصة:
خلاصة القول لا يوجد بالمغرب مجتمع مدني متبلور بمؤسساته الحديثة ومستلزمات حركيته وفعله على شاكلة الغرب، ولكن هناك نواة إذا توفرت الارادة يمكن رعايتها حتى يشتد عودها وتكون بوابتنا على المستقبل، وهذا طبعا مع الوعي التام بأن مفهوم المجتمع المدني كما هو متداول حاليا مفهوم غير علمي يخلط بين طبقات المجتمع، وبين الاهداف والوسائل، فهو يحمل كثيرا من التشويش، وأحيانا التغليط، ورواجه من جديد كاصطلاح جاء في إطار الرواج الذي تعرفه في السنوات الاخيرة منظومة القيم الليبرالية، ناهيك عن دوره الديماغوجي في أطروحة التنابذ بين السياسي من جهة والثقافي الجمعوي المدني من جهة، وهي معادلة تخدم تأبيد الوضع السائد بدل جعل الحقلين يتكاملان من أجل هدف موحد هو التغيير المجتمعي.
إذن بالرغم من الدور الإديولوجي -بالمعنى القدحي للكلمة- الذي يعطيه منظور النظام العالمي الجديد لمفهوم المجتمع المدني يمكن شحنه نظريا وعمليا وفي إطار ممارسة الصراع الثقافي والطبقي من أجل إعطائه بعدا ثوريا كما فعل انطونيو غرامشي مما يتيح إمكانية الانخراط في عملية بناء المجتمع المدني لكن حسب الفهم اليساري.
ملحوظة :
-هذه المقالة أنجزت منذ 22 سنة ونشرت منذ 21 سنة في جريدة الصحيفة بعد التصرف في عنوانها وذلك بتاريخ 24 فبراير 1999.