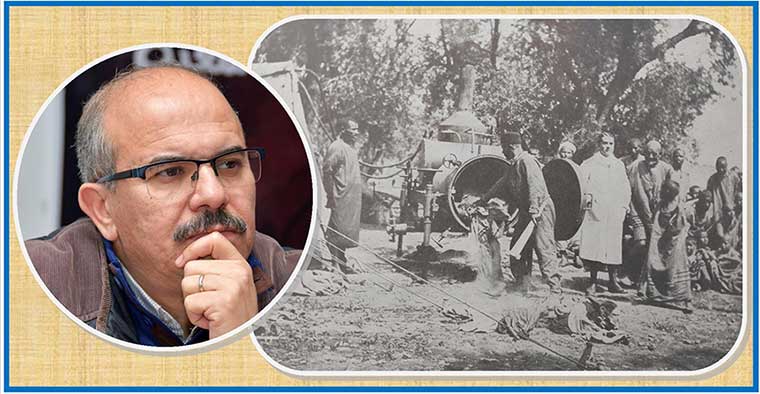لننطلق، اليوم، من هذا السؤال المركزي:
ما هي الأمراض الفتاكة التي كانت متفشية بالمغرب في العقود الثلاثة الأولى للقرن 20؟
كل المصادر التي اشتغلت عليها، والتي سبقت الإشارة إليها من قبل، تتضمن تفصيلا مبوبا لما يمكن وصفه بـ "شجرة الأمراض المتفشية بالمغرب وفروعها"، مع نهاية القرن 19 وبداية القرن 20. لكن أكثرها دقة، هي التقارير المنجزة من قبل مصالح حفظ الصحة التابعة للإقامة العامة الفرنسية بالرباط (بعضها يوجد في مكتبات وأرشيفات غرف الصناعة والتجارة خاصة بالرباط والدار البيضاء. وهي كنز وثائقي قليلا ما ينتبه إليه وبعضه طاله التلف للأسف). ومن ضمن تلك التقارير تقرير مطول صادر سنة 1937 من قبل "إدارة الصحة العمومية بالمغرب" التابعة للإقامة العامة الفرنسية بالرباط، الذي أصدرته مؤسسة "إفريقيا الشمالية" بالدار البيضاء، في مجلد ضخم من 270 صفحة. فهو تقرير تفصيلي، تقني، بخلفية سياسية أكيد، تتغيى تمجيد الدور الفرنسي في تطوير البنية التحتية للمغرب وتحسين ظروف حياة المغاربة، لكنه غني جدا على مستوى ما يتضمنه من معلومات وبيانات ورسوم توضيحية.
كانت الخطة التوسعية للاحتلال الفرنسي لوسط المغرب، ابتداء من قصف الدار البيضاء واحتلالها سنة 1907، ثم قصف مدينة وجدة واحتلالها سنة 1908، قبل فرض الحماية على كامل التراب المغربي بعد توقيع اتفاقية الحماية يوم 30 مارس 1912 بفاس بين السفير الفرنسي رينو والسلطان المغربي مولاي حفيظ (باختلاف كبير عن الخطة الإسبانية في شمال المغرب وجنوبه)، تستند إلى استراتيجية مزدوجة فعالة، تعتمد الاشتغال بذراعين كبيرين، واحد عسكري عنيف ومباشر وآني، والآخر تنموي سلمي بناء ويشتغل على المدى المتوسط والبعيد (يتضمن الشق الاقتصادي والصحي والتعليمي). أي أن تطويع المغاربة كان يستهدف كسر شوكتهم المقاومة الشعبية المسلحة، وفي الآن نفسه تقديم خدمات عمومية مدينية جديدة غايتها ترسيم الحاجة إلى المساعدة الفرنسية في تحقيق أسباب التنمية. وكان في القلب من ذلك تطوير مجال الصحة العمومية. أليس يقول الماريشال هوبير ليوطي، أول مقيم عام فرنسي بالمغرب (وأكثر المقيمين العامين الذي قضى فترة طويلة بالمغرب بلغت 14 سنة)، في إحدى خطبه العمومية أمام "الأيام الطبية ببروكسيل" ببلجيكا سنة 1926، ما يلي:
"لقد أرسلت تلغرافا سريعا إلى الجنرال غالييني (وهو يتحدث عن مرحلة إشرافه على تنفيذ احتلال جزيرة مدغشقر في أول القرن 20)، أقول له فيه: إذا ما أرسلتم لي أربعة أطباء إضافيين، فإنني سأعيد إليكم أربع وحدات عسكرية" (أي ما مجموعه 800 عسكري). هذا معناه أن الصحة والطب سلاح أشد فعالية من الرشاش والدبابة.
بالعودة، إذن، إلى السؤال أعلاه، فإن شجرة الأمراض التي كانت متفشية في المغرب في العقود الثلاثة الأولى للقرن العشرين، خارج دورات الجوائح والأوبئة، التي ظلت تتوزع بين الكوليرا والتيفوس والطاعون، تتحدد في أربعة فروع كبرى: الأمراض الصدرية (خاصة السل)، الأمراض الجنسية (خاصة الزهري)، الأمراض المناعية (خاصة الملاريا)، ثم الأمراض المعدية (خاصة الجدري).
1 - الملاريا:
يعتبر هذا المرض واحدا من أكثر الأمراض الفتاكة التي كانت منتشرة ليس فقط بالمغرب، بل بكامل شمال إفريقيا. وكل المصادر الطبية تجمع على أن هناك "ملاريا مغاربية"، ظلت تسجل بكل من المغرب والجزائر وتونس، كلما كانت المواسم ماطرة فيها بغزارة. وهي مختلفة عن الملاريا الاستوائية أو ملاريا خط نهر النيل. ووسيلة تفشيها الكبرى في البلدان المغاربية هي حشرة الناموس والبعوض الناقلة لها على نطاق واسع، بسبب ما يتشكل في الأودية والبحيرات الصغيرة بالمغرب من نباتات طحلبية تولد بغزارة الناموس، الذي يصبح العدو الأول ضد الصحة العامة بشمال إفريقيا. ولعل من المفارقات في هذا الباب، أن الناموس في سنوات الجفاف ببلداننا المغاربية لا يكون معديا، كما في السنوات المطيرة، وأن منحنى العدوى في سنوات الجفاف ينزل كثيرا في شهري يناير وفبراير، بينما يرتفع في شهور الصيف، لكن بدرجات عدوى لا تقارن خطورتها أبدا بالسنوات المطيرة، التي ترتفع فيها العدوى في شهور دجنبر ويناير وفبراير، وكذا في شهور ماي ويونيو ويوليوز. وحسب الإحصائيات الرسمية لإدارة الصحة العامة الفرنسية بالمغرب، لسنة 1936، فإن أصعب سنوات انتشار الملاريا بالمغرب كانت هي مواسم 1921/ 1922، ثم 1927/ 1928. وهي السنوات التي سجلت فيها نسبة مرتفعة للوفيات ببلادنا بسبب درجة انتشار عدوى الملاريا، خاصة بالمناطق الشمالية، بلغت في المعدل 38 بالمئة من مجموع حالات الإصابة.
وتبعا للخريطة الوبائية التي رسمتها مصالح حفظ الصحة التابعة للإقامة العامة بالرباط، فإن الرسم البياني لانتشار العدوى خلال عقد العشرينات، قد أظهر ارتفاعا كبيرا لحالات الإصابة بمرض الملاريا في منطقة سهل الغرب (خاصة بسيدي سليمان وسوق الأربعاء الغرب ومدينة بوتي جون/ سيدي قاسم اليوم، ثم بمدينة بور ليوطي/ القنيطرة حاليا، وكذا بتخوم وزان). مثلما سجلت إصابات كبيرة بسهل سايس وبمحيط مدينتي فاس ومكناس، وبكل المسار الذي يقطعه نهر سبو، وبهضاب ورغة. فيما تتضاءل الإصابات كلما اتجهنا جنوبا، حيث سجلت إصابات مهمة بسهل الشاوية وسهل دكالة، بينما كانت شبه منعدمة في المناطق الجبلية للأطلسين الكبير والمتوسط وفي سهل الحوز وسهل عبدة. ما جعل إدارة الحماية تركز جهودها على تلك المناطق الشمالية، التي خصصت لها 3 أطنان من الأدوية المقاومة لطفيل الملاريا. وأن تلك المقاومة قد توازت مع عمليات تنظيف دورية لمجاري المياه بالمدن، والبحيرات المطرية بالبوادي، وكذا كل الشعاب والأودية المحيطة بالقرى، وهي العملية التي بفضلها سيتم إنشاء مصلحة حفظ الصحة بالمغرب، لأول مرة في بداية العشرينات وصدر قانونها التنظيمي سنة 1926.
2 - مرض الجدري
كان الجدري، دوما، واحدا من أخطر الأمراض الفتاكة بالمغرب قبل الحماية سنة 1912، وفي العشر سنوات بعدها حتى سنوات 1922 و1924. وهو مرض فيروسي يؤدي إلى الوفاة، وفي حالات كثيرة إلى تشوهات جلدية وإلى نسب عالية من العمى (المثال الأشهر في تاريخ الأدب العربي هو الأديب الفيلسوف أبو العلاء المعري، الذي أصيب به وهو في الرابعة من عمره وتسبب له في العمى طيلة حياته).
كانت القارة الأوروبية، بسبب طبيعة مناخها البارد، من بين أكثر مناطق العالم التي تفشى فيها الجدري، بسبب نسبة التلوث العالية في كبريات مدنها، خاصة لندن وباريس وبرلين وروما وجنوة وفيينا. وهناك العديد من الكتابات الأدبية والمسرحيات والكتب التاريخية التي كان موضوعها هو الجدري. ولن تبدأ المجتمعات الأوروبية في التخلص منه، سوى في نهاية القرن 18 وبداية القرن 19، بعد اكتشاف الطبيب الإنجليزي إدوارد غينر للقاح ضد الجدري، انطلاقا من فيروس آخر هو "جدري البقر". وبالعودة إلى العديد من الكتب التاريخية المغربية، مثل كتاب البيدق وكتاب الضعيف وكتاب الاستقصا، نجد إشارات لهذا المرض الذي كان يصنف ضمن الأمراض الخطيرة (الملعونة)، وأن شكل مواجهته في كبيرات المدن المغربية مثل فاس ومراكش، هو في عزل المصاب في حي خاص معزول على أطراف المدينة عليه حراسة مشددة، ويترك المصاب هناك حتى ينتصر لوحده على الفيروس بما يحمله معه من عاهات جلدية أو بصرية (لكنها لم تعد معدية)، أو يتوفى.
لكن، لم يبدأ فعليا القضاء على مرض الجدري في المغرب، سوى في أواسط العشرينات حتى أواسط الثلاثينات من القرن 20، حين خصصت مصالح "حفظ الصحة الفرنسية" ميزانية خاصة ضمن الميزانية السنوية لـ "إدارة الصحة العمومية بالمغرب" لمحاربته. مما كانت نتيجته تراجع كبير لهذا المرض الخطير في الغالبية الكبرى من المناطق المغربية الواقعة تحت الاحتلال الفرنسي (عكس المناطق التي كانت تحت الاحتلال الإسباني التي تأخر فيها النجاح في القضاء عليه حتى بداية الخمسينات من القرن الماضي).
وكانت طرق المواجهة مزدوجة، تنبني على تعميم التلقيح بالنسبة للساكنة (خاصة بالمدن الكبرى في البداية)، وعلى الرعاية الطبية للمصابين من خلال برنامج أدوية ذات فعالية. مما كانت نتيجته صدى إيجابيا لدى المغاربة، الذين أصبحوا هم من يطالبون السلطات الطبية والإدارية الفرنسية بتطعيمهم من خلال بروز عبارة "بغينا ليبرة" (أي الشوكة)، والمقصود بها هو اللقاح ضد الجدري، وأيضا ضد مرض الزهري الجنسي كما سنرى لاحقا.
وبالأرقام، فإنه ما بين 1925 و1935، انتقل عدد الملقحين بالمغرب ضد الجدري من 480 ألف ملقح، إلى 854 ألق ملقح. وكانت بلدان شمال إفريقيا ومن ضمنها المغرب، من أول البلاد الإفريقية (إلى جانب مصر) التي اختفى فيها الجدري في نهاية الأربعينات، بينما لم يختفي نهائيا من العالم سوى سنة 1977، وكانت آخر الحالات بالصومال.
3 - مرض السل
كان الاعتقاد السائد، لدى الأوربيين، وضمنهم الفرنسيون، أن مرض السل هو مرض شمالي أوروبي بامتياز، بسبب برودة الطقس الشديدة. إلى أن احتلت فرنسا الشواطئ الشمالية للجزائر سنة 1830 ميلادية، ثم احتلت تونس سنة 1882 ميلادية، فبدأت تكتشف أن مرض السل واحد من أكثر الأمراض الصدرية التي تنتشر في شمال إفريقيا، فغيرت من قناعاتها الطبية السابقة بخصوص هذا الداء الفتاك. وحين فرضت الحماية على المغرب، ستجد أنه من أكثر البلدان المغاربية التي تسجل فيها نسب عالية جدا من مرض السل بمختلف أنواعه، بل ستكتشف على أن هناك نوعا منه تكاد تختص به مدينة مراكش لوحدها في كل الشمال الإفريقي.
أكثر من ذلك، لم تستطع فرنسا أصلا القضاء نهائيا على مرض السل، سوى بعد الحرب العالمية الأولى، حيث إنها لم تقرر تلقيح مواطنيها ضد داء السل حتى سنة 1921، وهو التلقيح الشهير الذي لا يزال معمولا به إلى اليوم (الشهير بـ "البيسيجي"). والذي لم يكتشف سوى سنة 1906 من قبل العالمين ألبير كالميت وكاميل غيران. ولم يصبح لقاحا عالميا سوى بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945، بعد أن تبنت ذلك اللقاح باقي الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي وألمانيا.
بالتالي، فإن الفضاء المغربي، في ما يرتبط بمواجهة داء السل، كان مختبرا مثاليا لتجريب ذلك اللقاح وتجريب مختلف الأدوية المنتجة بأروبا لمواجهته، بالنسبة لباريس. فكانت الخريطة الطبية للحماية الفرنسية الخاصة بداء السل، من أكثر الخرائط الطبية تدقيقا وفعالية. كونها تتضمن بتفصيل مختلف أنواع السل المتفشية ببلادنا، ومجالات بروزه حسب المناطق والجغرافيات، وأيضا حسب شرائح الساكنة بالمغرب، بين المسلمين واليهود والأوروبيين. بدليل أنه في 10 سنوات فقط (أي عند حدود سنة 1922)، أصبحت بالمغرب خمس مستوصفات متخصصة في محاربة داء السل، مثلما تم إنشاء مستوصفات متنقلة في المناطق القروية المحيطة بالمدن الكبرى.
مما تسجله ذاكرة المغاربة إلى اليوم، خاصة من الجيل البالغ الآن ما فوق السبعين سنة، أن عدد قتلى مرض السل بمختلف مناطق المغرب كان كبيرا إلى حدود الستينات من القرن الماضي. وهو الواقع الذي تؤكده أيضا الإحصائيات الرسمية لمصالح إدارة الصحة العمومية بالمغرب في العشرينات والثلاثينات، التي تعترف أن النسب الحقيقية لمدى انتشار المرض أكبر من ما تمكنت من الوصول إليه من تحديد للحالات المصابة والمعالجة. مثلا، في سنوات 1928 و1929 و1930 و1931 و1932، تم تسجيل حالات إصابة جديدة بالتوالي كالآتي، في مجموع المنطقة التي بلغها الإحتلال العسكري الفرنسي (لأن هناك مناطق أخرى من المغرب لم يصلها التواجد الفرنسي حتى سنوات 1934 و1936): 998/ 1002/ 1226/ 1524/ 1705). وأن نسبة المتوفين بسبب داء السل ضمن مجموع الوفيات لأسباب مرضية مختلفة بالمغرب، وصلت في المعدل ما بين 1925 و 1932، نسبة 7.67 بالمئة.
فيما تؤكد ذات الإحصائيات المسجلة، أن نسبة الوفيات ضمن مجموع المصابين بداء السل بالمغرب، كانت تتراوح حسب المدن والمناطق بين 69 بالمئة و35 بالمئة. مما يعني أنه مرض كان يجرف الكثيرين من المغاربة، خاصة من الشريحة العمرية ما بين 18 و35 سنة، التي هي الشريحة الشابة المؤهلة للعمل والعطاء. مثلا في مراكش سجلت سنة 1930، وفيات تصل إلى 33 وفاة من مجموع 59 إصابة. وفي فاس 100 حالة وفاة من مجموع 189 إصابة. وفي مكناس 32 حالة وفاة من مجموع 55 إصابة. وأن مجموع الوفيات في المدن التي يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة، قد بلغ 1042 حالة وفاة، يشكل المغاربة المسلمون من مجموع عدد الوفيات بكل الأمراض، نسبة 8.81 بالمئة، ثم الأوروبيون بنسبة 5.5 بالمئة، ثم المغاربة اليهود بنسبة 3.81 بالمئة.
دائما بلغة الأرقام، نجد أنه من مجموع 15 ألف استشارة طبية، سجلت 7 آلاف حالة إصابة بمرض السل، مما يترجم الدرجة العالية لتفشي هذا المرض بالمغرب حينها. وأن أنواع الإصابات تتوزع بين الإصابة بالسل الرئوي بنسبة 79 بالمئة، ثم سل العظام بنسبة 6 بالمئة، ثم سل العقد اللمفاوية بنسبة 14 بالمئة، ثم سل الدماغ بنسبة 1 بالمئة. لتبقى مدينة مراكش وحدها في كامل المغرب التي تتميز بضعف واضح في الإصابة بالسل الرئوي في مقابل ارتفاع كبير جدا لسل العظام وسل العقد اللمفاوية.
أخيرا، لا بد من تسجيل معطى طبي جديد بالمغرب في العشرينات، هو دخول التقنيات الصناعية الطبية إلى المغرب، حيث تم إدخال تقنية الفحص بالصدى وبالأشعة، مما مكن من إنجاز 4109 فحص بالصدى بمدن الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس ومكناس في سنة 1930، وتم إنجاز 5075 فحص بالأشعة في ذات السنة. وهو تطور تقني جديد آنذاك بالمغرب، غير من رؤية المغربي للطب وأيضا من رؤيته للمحتل الأجنبي وللعالم ولمفاهيمه الطبية الكلاسيكية والقديمة، سواء بالمدن أو بالمناطق القروية التي بلغها الطب الحديث.
4 - مرض الزهري (الجنسي)
كان هذا المرض الجنسي، بمراحله الثلاثة، حسب التقارير الرسمية لمصالح حفظ الصحة الفرنسية، من أكثر الأمراض تفشيا بين المغاربة (ما بين 20 و60 سنة). حيث تذهب أرقامها إلى التأكيد على أن ما بين 75 و85 بالمئة من المغاربة البالغين مصابون على الأقل بنوع من أنواع مرض الزهري الجنسي. حيث سجلت مصالح الحماية منذ 1912 انتشار الطفح الجلدي والتقرحات بكثرة بسبب ارتفاع نسب الإصابة عند المغاربة الذكور بالمدن. ومما تؤكد عليه تلك التقارير الطبية، أن من أكبر المعارك الصحية التي دخلتها مصالح الحماية هي محاصرة تفشي هذا المرض، حيث بادرت أولا إلى محاولة تنظيم حملة فحص شاملة، مكنت من تحديد خريطة انتشار المرض في مدن فاس والرباط والدار البيضاء ومكناس في ما بين 1913 و1915، ثم في مدينة مراكش سنة 1916. وباشرت إجراءات التطبيب ضد تفشي هذا المرض المعدي، من خلال برنامج أدوية صارم ومدقق، يتوزع بين تعميم الأدوية بالإبر عبر مستوصفات متنقلة، وعبر أمصال خاصة بمحاربة الجرثومة المتسببة في ذلك المرض. حيث شرعت في إعطاء الأدوية المتوفرة حينها، المتمثلة في دواء "السالفرسان" (المتضمن للزرنيخ)، المكتشف في سنة 1908.
كان مرض الزهري واحدا من أهم الأسباب التي جعلت المغاربة بالمدن الكبرى، يثقون في الطب الحديث عبر بوابة الاحتلال الفرنسي، وأصبح المطلب الشعبي العمومي هو "بغينا ليبرة"، أي طلب الشوكة التي أظهرت فعالية في التقليص من المرض ومقاومته والشفاء منه. وهذا تحول غير مسبوق في الذهنية المغربية حينذاك. خاصة وأن سلطات الحماية، قد بادرت ضمن خطتها الصحية إلى إنشاء سبعة مراكز للعلاج بخمسة مدن كبرى، وكذا تنظيم دوري لزيارات ميدانية متنقلة لعدد من المناطق القروية، مكنت إحصائيا، في سنة 1929 لوحدها، من تسجيل 200 ألف حالة إصابة. وأنها تمكنت من رسم خريطة للحالات المرضية التي بلغت درجة التوتر الذهني والعصبي، بكل ما كان ينتج عنها من ردود فعل عنيفة ضد الأغيار والأقارب. فباشرت إلى توزيع مكثف للأدوية، خاصة دواء "نوفاغزينبنزول" (وزعت منه 136 كلغراما، وهو حجم طبي كبير)، و121 ألف أنبوب زجاجي صغير من مادة ملح الميركور، وأكثر من طن من البوتاسيوم، و67 ألف أنبوب زجاجي صغير من ملح البيسموت. وغيرها من المواد الطبية المصاحبة للعلاج. مما كانت نتيجته إيجابية وفعالة، لكنها خلقت مشكلا آخر هو عدم مواظبة المصابين على إكمال العلاج، بمجرد بداية تشافيهم، مما كان يضاعف من حالات الإصابة، أسابيع وشهورا بعد ذلك. وكان من القرارات التنظيمية الحاسمة التي نفذتها إدارة الحماية الفرنسية، هي إنشاء أحياء خاصة للدعارة (بوسبير بالدار البيضاء كمثال)، مراقبة طبيا بصرامة بمختلف المدن المغربية، للتحكم في انتشار وتفشي مرض الزهري.