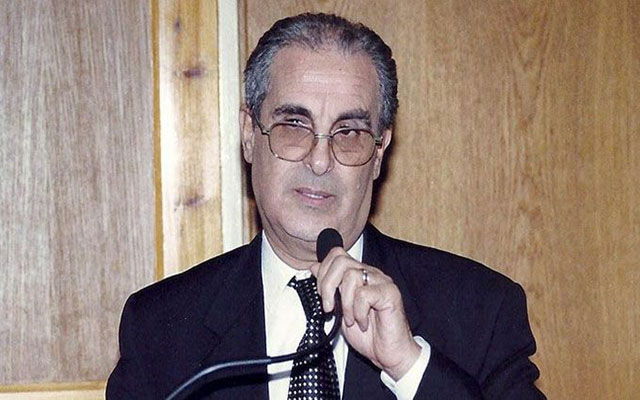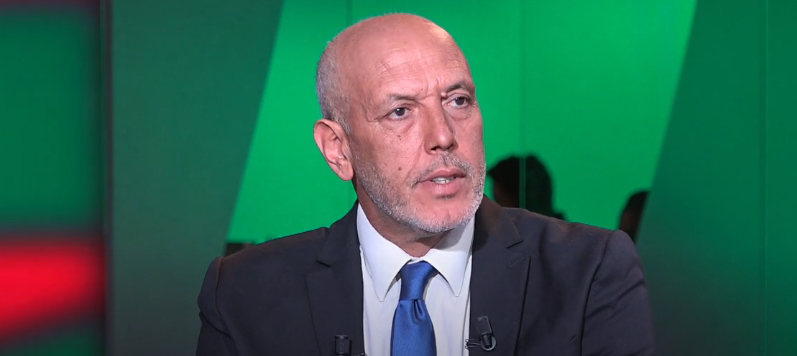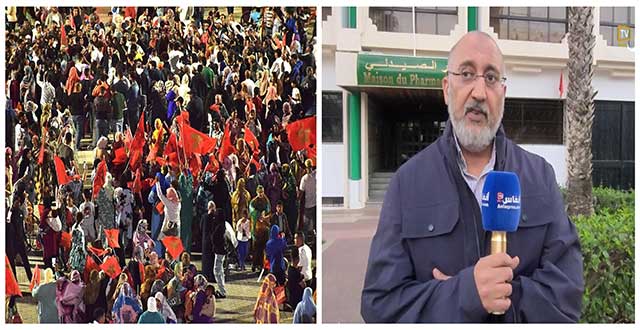مَن يقرأ هذا العنوانَ، سيظن أن المجتمعَ الذي سأتحدَّث عنه كلُّه خوف أو يسري فيه الخوف برمته. والحقيقة أني أتحدَّثُ عن مجتمعٍٍ يكون فيه التَّديُّن، بالتوارث، هو مصدر الخوف. ولمزيدٍ من التَّوضيح، توجد، في هذا المجتمع، شريحة عريضة من الأفراد، إن لم نقل توجد أغلبيةٌ ساحِقة من الأفراد لا يعرفون عن الدين الإسلامي إلا ما ورثوه عن آبائهم وأمهاتهم، أو إلا ما تم تقليدُه من طقوس rites ومُمارسة pratique.
وهذا يعني أن هذه الفئة من الناس أو من المجتمع، مسلمة بالتوارث، أي أن الطقوس والممارسة، المشار إليهما أعلاه، تنتقل من جيل لآخر ،عبرَ الوراثة أو التقليد. وفي الحقيقة، ما هو متوارثٌ، هو التَّدين وليس الدين. التَّديُّن هو انتقال دينٍ من الأديان من وضعِه النظري إلى وضعٍ، يتِم من خلالِه، تطبيق ما هو نظري في هذا الدين، على أرض الواقع.
في هذه الحالة، هذا الانتقال يفرض علينا طرحَ السؤالين التاليين : 1.هل يتساوى التَّديُّن بالتقليد أو بالتوارث مع التَّدين الناتج عن "معرفة مُعمَّقة" للدين؟ 2.كيف يكون التَّديُّن مصدرا للخوف؟
الجواب على السؤال الأول، أي "هل يتساوى التَّديُّن بالتقليد أو بالتوارث مع التَّدين الناتج عن معرفة مُعمَّقة للدين؟"، بديهي ولا يحتاج إلى مزيدٍ من التَّوضيح. المنطق يفرض علينا أن نقولَ إن هناك فرقا شاسعاً بين تديُّن أساسُه التقليد الأعمى، أي التوارث وتديُّن ناتجٍ عن معرفة معمَّقة للدين، كما هو مُتعارفٌ عليه، على المستوى النظري في القرآن الكريم. والتَّقليد الأعمى أو التقليد بدون بصيرة، يكتفي بالتِّكرار المحض لِما يقوله أو يفعله الآخرون دون تشغيل العقل لفهم ما يتم تقليده أو تِكرارُه. وتِكرار الأمور بدون فَهمِها فيه نوعٌ من الاستلاب l'aliénation. والشخص المُستلَبُ يفقد استقلاليتَه son autonomie، إن لم نقل سيادتَه الفكرية داخل المجتمع التي، عادةً، يمارسها بفضل فكره النقدي sa pensée critique. وبما أن الشخصَ المقلِّدَ الأعمى، فاقد للفكر النقدي، فإنه يقبل كل الطقوس وكل المُمارسات ولو كانت مٌخالِفة للعقل والمنطق.
أما الجواب على السؤال الثاني، أي "كيف يكون التَّديُّن مصدرا للخوف؟، أقول إن الشخصَ الذي يقلِّد، بكيفيةٍ عمياءَ، الطقوس والممارسات التَّديُّنية، بدون أن يدركَ أصولَها ومغزاها ولماذا يقوم بها، فإيمانُه مبني على السمع والبصر والحفظ عن ظهر قلب، وخصوصا، إذا كانت الجهات المُقَلَّدَة، أي الآباء والأمهات، هم أنفسُهم، مُتديِّنون بالتَّوارث. ولهذا، فالشخص المتديِّن بالتوارث، نظرا لعدم إلمامِه بحيثيات الدين، كما هو منصوصٌ عليه في القرآن الكريم، يكون هذا المُتديِّنُ بالتوارث دائما عرضةً للخوف. بمعنى أنه يخاف أن يرتكب خطأً، في تقليده للطقوس والمُمارسات وتتمُّ معاتبتُه على هذا الخطأ. فما هي الجهات التي يخاف منها المتديِّن بالتوارث؟
فعوض أن يخاف اللهَ، سبحانه وتعالى، فإنه يخاف لومَ المجتمع، لومَ أنداده، لومَ الأسرة، لومَ الأقارب، وبصفة عامة، يخاف لومَ الناس، وخصوصا، إذا كان هؤلاء الناس من ذوي الاختصاص، أي علماء وفقهاء الدين. غير أن هذا الوضع، أي التَّديّن بالتِّوارث، يفرض عليَّ أن أطرحَ على نفسي وعلى الجميع السؤالَ التالي : "أي تديُّنٍ هذا يتخلَّله الخوف"؟ أو بعبارة أخرى، "أي إيمانٍ هذا، يتخلَّله، من حينٍ لآخر، الخوف من لوم لائمٍ"؟
والإيمانٌ لا يكونُ إيماناً إن لم يكن نابِعاً من القلب، أي من وِجدان الشخص الذي يريد أن يُؤمنَ، وخصوصا، إذا تخلَّلته ولو ذرة واحدة من الشك. والتَّديُّن بالتوارث أو التقليد ، إذا تخلله الخوفُ، فهذا معناه أن المتديِّن بالتوارث يشك في تديُّنه. والإيمانُ، إما أن يكونَ قويا ومترسِّخاً في الوِجدان، وإلا فهو، فقط، تقليد للإيمان. والإيمانُ لا يمكن تقليدُه لأنه أمرٌ شخصي. وحتى يكونَ الإيمانُ إيماناً، من الضروري، أن ينبعَ من وجدان الشخص الذي يريد أن يؤمنَ. فما هو السبب الرئيسي أو الأسباب التي تجعل المتديِّنَ بالتوارث يخاف ويشك في تديُّنِه؟
السبب الرئيسي له علاقة بتربية الأطفال، داخلَ الأسرة وخارِجها وداخل المدرسة. وفي هذا الصدد، أخص بالذكر، التربيةَ، بصفة عامة، والتربية الدينية، بصفة خاصة.
بصفة عامة، كثيرٌ من الأسر، في المجتمع المغربي، تُربِّي بناتِها وأبناءَها ليسَ على الاستقلالية l'autonomie بذاتِهم، أي ليس على التَّعوُّد على الاعتماد على أنفسهم. بل على الاعتماد على الغير. بمعنى أنهم ليسوا قادرين على أخذ المبادرة. وإذا أخذوا المبادرة، يتسلَّط عليهم اللومُ من كل جهة، وبالتالي، مع مرور الوقت، يصبح الأطفال عُرضةً لعدم الثقة في أنفسهم، مخافةَ أن يشملَهم التَّوبيخ كلما حاولوا أخذ المبادرة.
أما التربية الدينية التي يتلقاها الأطفال، سواءّ في البيت وفي المجتمع وفي المدرسة، فهي، أساساً، مبنية على التَّخويف والترهيب. بمعنى "إذا فعلتَ هذا، فستذهب إلى الجنة". "وإذا لم تفعل هذا، ستذهب إلى جهنَّم". فالطِّفل سواءً تواجد في الأسرة أو في المجتمع أو في المدرسة، فهو، على الدوام، مُحاطٌ بالخوف لأنه لا يريد أن تكون إحدى مراحل تديٌّنه خاطئة، وخصوصا، أنه تربَّى على أن الأخطاءَ يتبعها عقابٌ إلهي. ولا شيءَ يُنسيه هذا الخوف إلا اللعب. لكن، سرعان ما يتغلب الواقع على اللعب ويعود الخوف إلى ما كان عليه.
والحقيقة، كل الحقيقة، هو أن مصير البشر، بعد الحساب. يدخل في عالم الغيب، أي في عالمٍ يجهله علماء وفقهاء الدين، بل يجهله حتى الرسول (ص)، مصداقا لقولِه، سبحانه وتعالى : "وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ" (هود، 31). في هذه الآية، الرسول (ص)، هو الذي يتحدًّث قائلا : "...وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ…". فإذا كان الرسول (ص)، الذي اختاره، سبحانه وتعالى، من بين آلاف البشر لتبليغ رسالته للناس، ويعترف بأنه لا يعلم الغيبَ ولا يتباهى بأنه "مَلَكٌ"، فما بالك بعلماء وفقهاء الدين الذين هم بَشَرٌ عاديون والذين قد يُوهيمون الناسَ بأنهم، إذا أطاعهم هؤلاء الناسُ، مصيرهم الجنة، وإذا خالفوهم، مصيرُهم جهنَّم.
وفي الختام، إذا عنونتُ هذه المقالة ب"مجتمع الخوف"، فالمقصود ليس هو التّنكُّر للتَّديُّن بالتوارث. لا أبدا! ليس هذا هو
قصدي. المقصود، هو أن تتغيِّر نظرتنا للدين وللتَّديُّن. وحتى يكون هذا التغيير واقعاً ملموسا، من الضروري، أن يكونَ المجتمع والأسرُ والمدرسة، هم المُحرِّكون الأساسيون لهذا التَّغيير les moteurs essentiels de ce changement. وهذا التغيير يجب أن يكون مُطابقا للإسلام المنصوص عليه في القرآن الكريم. وهذا هو ما سأبيِّنه في مقالةٍ مقبِلة إن شاء الله. بمعنى أن الدين جاء ليُسعِدَ الناسَ وليس ليكون مصدرا للخوف.