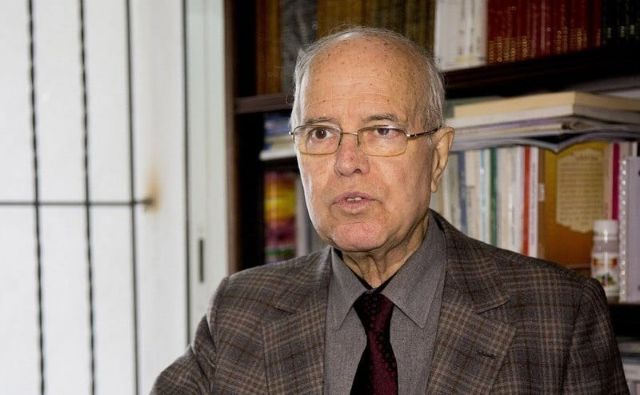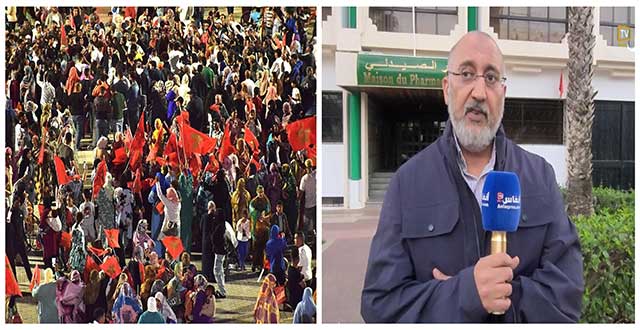عرف مسار التصويت على مشاريع القوانين داخل البرلمان المغربي، في السنوات الأخيرة، مظاهر متكررة لضعف الحضور النيابي، حتى عند مناقشة والتصويت على قوانين جوهرية تمس البنية القانونية والمؤسساتية للدولة، وتنعكس بشكل مباشر على حقوق وحريات المواطنين. وقد أعاد التصويت الأخير على مشروع قانون المسطرة الجنائية داخل مجلس النواب، والذي لم يحضره سوى 33 نائباً من أصل 395، النقاش العمومي والحقوقي حول مفهوم التمثيلية البرلمانية وحدود الالتزام السياسي والقانوني لممثلي الشعب.
هذا السلوك النيابي لا يُمكن اعتباره مجرد حالة عرضية، بل هو مؤشر على أزمة عميقة في تصور بعض النواب لمهامهم، وتراجع واضح في منسوب الوعي بالمسؤولية التي تفرضها التزكية الشعبية، ومن المؤسف أن تتحول الوظيفة النيابية، التي يُفترض أن تُترجم الإرادة العامة وتصون الحقوق وتصوغ التشريعات بحضور ونقاش وتمثيل فعلي، إلى مجرد موقع رمزي يغيب فيه الحضور، وتتراجع فيه المحاسبة.
التمثيل البرلماني، في فلسفته الدستورية، ليس ترفاً سياسياً أو امتيازاً انتخابياً، بل هو واجب وطني يعلق عليه المواطنون آمالهم في تدبير الشأن العام وسن القوانين وضمان التوازن بين السلط. ومن هذا المنطلق، فإن التغيب غير المبرر عن جلسات التصويت على نصوص تشريعية مفصلية، لا يمكن تصنيفه كمسألة شكلية أو إجراء داخلي، بل يُعدّ إخلالا جوهريا بالواجب التمثيلي، يقتضي إعادة النظر في آليات المحاسبة وربط المسؤولية بالمساءلة، بما ينسجم مع مبادئ الديمقراطية.
ورغم أن الفصل 64 من الدستور المغربي يقر الحصانة البرلمانية، ويمنع متابعة النواب أو محاكمتهم بسبب الآراء أو التصويت الذي يصدر عنهم أثناء مزاولتهم لمهامهم، فإن هذه الحصانة لا تمتد إلى حماية النواب من مسؤولية الإخلال بواجبات الحضور والمشاركة النشيطة في الجلسات، وهو ما تؤكده المادة 166 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص بوضوح على إلزامية الحضور وتخول اتخاذ إجراءات تأديبية في حال الغياب غير المبرر. غير أن هذه الإجراءات، في صيغتها الحالية، تبقى محدودة الأثر، ولا ترتقي إلى مستوى المحاسبة المؤسساتية أو القضائية التي تضمن الانضباط الفعلي لنواب الشعب.
في هذا السياق، يطرح سؤال قانوني جوهري: هل يمكن تكييف هذا التغيب المتكرر وغير المبرر في ضوء قواعد المسؤوليةالمدنية؟
إن الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود يُقر صراحة أن "كل فعل يرتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح به القانون، فيحدث ضرراً مادياً أو معنوياً للغير، يلزم مرتكبه بتعويض الضرر".
وبالتالي، فإن الإخلال الجسيم من قبل النواب البرلمانيين بواجباتهم التمثيلية، وما يترتب عنه من تمرير قوانين دون تمثيل حقيقي للناخبين، أو في غياب النقاش العمومي الواجب، يمكن – نظرياً – تكييفه كفعل تقصيري، يضر بالمصلحة العامة، ويُرتب مسؤولية مدنية.
وقد يكون من المشروع التفكير في فتح نقاش قانوني ومجتمعي حول إمكانية رفع دعاوى أمام القضاء الإداري أو حتى المدني، تُحمِّل المؤسسة التشريعية، أو النواب المتغيبين بصفتهم النيابية ، مسؤولية الإضرار بالمصلحة العامة، باعتبار أن الإخلال بواجبات التمثيل لا يُعد فقط خرقاً سياسياً أو أخلاقياً، بل يُلامس أيضاً مقتضيات القانون، خاصة عندما يكون له أثر مباشر على فعالية النصوص القانونية ومضامينها الديمقراطية.
ولأن الإشكال يتجاوز البعد القانوني ليطال البنية الأخلاقية للممارسة البرلمانية، فإن تغيب النواب عن التصويت هو أيضاً إخلال بالثقة التي وضعها فيهم الناخبون، وانتهاك للعقد السياسي الذي يجسده البرنامج الانتخابي للحزب و الذي يقوم على تمثيل مصالح المواطنين والدفاع عنها. وإذا لم تُربط هذه الثقة بالمحاسبة، فإننا سنكون أمام برلمان لا يمثل سوى ذاته، وأمام ديمقراطية للواجهة ديمقراطية شكلية تُمرر فيها القوانين دون تمثيل فعلي.
ولذلك، تقتضي المرحلة التفكير في إصلاحات جوهرية، من بينها:
مراجعة النظام الداخلي للبرلمان لتشديد العقوبات على الغياب، وربطها بالاقتطاعات المالية، وبالإجراءات السياسية مثل سحب الثقة أو توجيه التنبيهات الحزبية.
إرساء آليات مدنية ورقابية لتتبع أداء النواب ونشر معدلات حضورهم ومشاركتهم ليس فقط في نشرة المجلس او موقعه الالكتروني وانما في الجرائد الوطنية والمواقع الرسمية.
تمكين المواطنين أو منظمات المجتمع المدني من الطعن في الإخلالات التمثيلية، أمام القضاء الإداري أو حتى المحكمة الدستورية، في حالات الإضرار الجسيم بالمصلحة العامة.
لا يمكن تصور برلمان يُمرر قوانين تمس العدالة والحريات بحد أدنى من الحضور، ثم يُطلب من المواطن احترام هذه القوانين، وكأنها نابعة من إرادة جامعة.
إن احترام القانون يمر أولاً من احترام المسطرة التي وُضع بها، ومن شرعية التمثيل التي تُنتجه.
لقد آن الأوان لإعادة الاعتبار لمكانة البرلمان كمؤسسة دستورية تُجسد صوت الشعب، ولتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسة التشريعية، بما يضمن احترام المواطن، ويصون شرعية القانون، ويُعيد للممارسة البرلمانية بعدها الأخلاقي والوطني.
لأن التغيب عن أداء الواجبات التمثيلية، حين يصبح قاعدة لا استثناء، لا يُمكن وصفه إلا كخيانة للأمانة، وإضرار مقصود بجوهر الديمقراطية.
هذا السلوك النيابي لا يُمكن اعتباره مجرد حالة عرضية، بل هو مؤشر على أزمة عميقة في تصور بعض النواب لمهامهم، وتراجع واضح في منسوب الوعي بالمسؤولية التي تفرضها التزكية الشعبية، ومن المؤسف أن تتحول الوظيفة النيابية، التي يُفترض أن تُترجم الإرادة العامة وتصون الحقوق وتصوغ التشريعات بحضور ونقاش وتمثيل فعلي، إلى مجرد موقع رمزي يغيب فيه الحضور، وتتراجع فيه المحاسبة.
التمثيل البرلماني، في فلسفته الدستورية، ليس ترفاً سياسياً أو امتيازاً انتخابياً، بل هو واجب وطني يعلق عليه المواطنون آمالهم في تدبير الشأن العام وسن القوانين وضمان التوازن بين السلط. ومن هذا المنطلق، فإن التغيب غير المبرر عن جلسات التصويت على نصوص تشريعية مفصلية، لا يمكن تصنيفه كمسألة شكلية أو إجراء داخلي، بل يُعدّ إخلالا جوهريا بالواجب التمثيلي، يقتضي إعادة النظر في آليات المحاسبة وربط المسؤولية بالمساءلة، بما ينسجم مع مبادئ الديمقراطية.
ورغم أن الفصل 64 من الدستور المغربي يقر الحصانة البرلمانية، ويمنع متابعة النواب أو محاكمتهم بسبب الآراء أو التصويت الذي يصدر عنهم أثناء مزاولتهم لمهامهم، فإن هذه الحصانة لا تمتد إلى حماية النواب من مسؤولية الإخلال بواجبات الحضور والمشاركة النشيطة في الجلسات، وهو ما تؤكده المادة 166 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص بوضوح على إلزامية الحضور وتخول اتخاذ إجراءات تأديبية في حال الغياب غير المبرر. غير أن هذه الإجراءات، في صيغتها الحالية، تبقى محدودة الأثر، ولا ترتقي إلى مستوى المحاسبة المؤسساتية أو القضائية التي تضمن الانضباط الفعلي لنواب الشعب.
في هذا السياق، يطرح سؤال قانوني جوهري: هل يمكن تكييف هذا التغيب المتكرر وغير المبرر في ضوء قواعد المسؤوليةالمدنية؟
إن الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود يُقر صراحة أن "كل فعل يرتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح به القانون، فيحدث ضرراً مادياً أو معنوياً للغير، يلزم مرتكبه بتعويض الضرر".
وبالتالي، فإن الإخلال الجسيم من قبل النواب البرلمانيين بواجباتهم التمثيلية، وما يترتب عنه من تمرير قوانين دون تمثيل حقيقي للناخبين، أو في غياب النقاش العمومي الواجب، يمكن – نظرياً – تكييفه كفعل تقصيري، يضر بالمصلحة العامة، ويُرتب مسؤولية مدنية.
وقد يكون من المشروع التفكير في فتح نقاش قانوني ومجتمعي حول إمكانية رفع دعاوى أمام القضاء الإداري أو حتى المدني، تُحمِّل المؤسسة التشريعية، أو النواب المتغيبين بصفتهم النيابية ، مسؤولية الإضرار بالمصلحة العامة، باعتبار أن الإخلال بواجبات التمثيل لا يُعد فقط خرقاً سياسياً أو أخلاقياً، بل يُلامس أيضاً مقتضيات القانون، خاصة عندما يكون له أثر مباشر على فعالية النصوص القانونية ومضامينها الديمقراطية.
ولأن الإشكال يتجاوز البعد القانوني ليطال البنية الأخلاقية للممارسة البرلمانية، فإن تغيب النواب عن التصويت هو أيضاً إخلال بالثقة التي وضعها فيهم الناخبون، وانتهاك للعقد السياسي الذي يجسده البرنامج الانتخابي للحزب و الذي يقوم على تمثيل مصالح المواطنين والدفاع عنها. وإذا لم تُربط هذه الثقة بالمحاسبة، فإننا سنكون أمام برلمان لا يمثل سوى ذاته، وأمام ديمقراطية للواجهة ديمقراطية شكلية تُمرر فيها القوانين دون تمثيل فعلي.
ولذلك، تقتضي المرحلة التفكير في إصلاحات جوهرية، من بينها:
مراجعة النظام الداخلي للبرلمان لتشديد العقوبات على الغياب، وربطها بالاقتطاعات المالية، وبالإجراءات السياسية مثل سحب الثقة أو توجيه التنبيهات الحزبية.
إرساء آليات مدنية ورقابية لتتبع أداء النواب ونشر معدلات حضورهم ومشاركتهم ليس فقط في نشرة المجلس او موقعه الالكتروني وانما في الجرائد الوطنية والمواقع الرسمية.
تمكين المواطنين أو منظمات المجتمع المدني من الطعن في الإخلالات التمثيلية، أمام القضاء الإداري أو حتى المحكمة الدستورية، في حالات الإضرار الجسيم بالمصلحة العامة.
لا يمكن تصور برلمان يُمرر قوانين تمس العدالة والحريات بحد أدنى من الحضور، ثم يُطلب من المواطن احترام هذه القوانين، وكأنها نابعة من إرادة جامعة.
إن احترام القانون يمر أولاً من احترام المسطرة التي وُضع بها، ومن شرعية التمثيل التي تُنتجه.
لقد آن الأوان لإعادة الاعتبار لمكانة البرلمان كمؤسسة دستورية تُجسد صوت الشعب، ولتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسة التشريعية، بما يضمن احترام المواطن، ويصون شرعية القانون، ويُعيد للممارسة البرلمانية بعدها الأخلاقي والوطني.
لأن التغيب عن أداء الواجبات التمثيلية، حين يصبح قاعدة لا استثناء، لا يُمكن وصفه إلا كخيانة للأمانة، وإضرار مقصود بجوهر الديمقراطية.