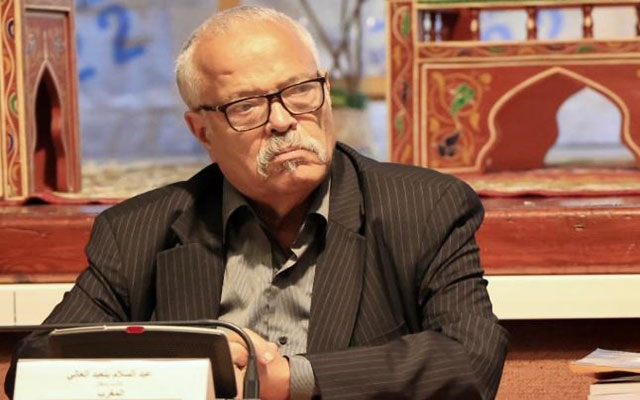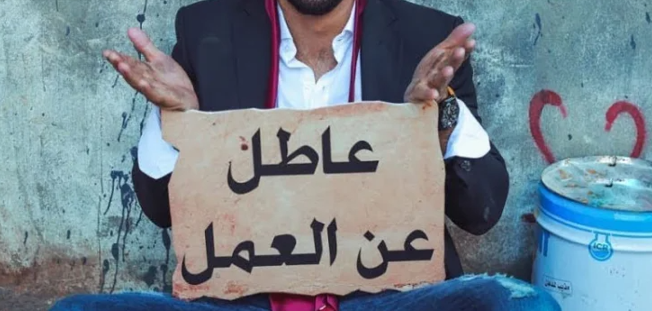في مقال كان م. هار كتبه سنة 1980 تحت عنوان "هايدغر وماهية التقنية"، يشير إلى الظواهر التي تحيل إليها اليوم عبارة "ماهية التقنية"، وهي تشمل في نظره ظواهر عديدة، مع ما قد يبدو من تباين بينها، كظاهرة "توحيد أنماط العيش والتفكير"، وظاهرة "تصنيع النشاط الفني والثقافي والسياحي"، وظاهرة "الازدهار السريع للإعلام الذي لا يستهدف إلا ذاته"، ثم ظاهرة "اجتثاث المكان والزمان، وإضفاء طابع الحياد عليهما"، و "فقدان الشعور بالقرب والبعد (الراجع لتقدم وسائل النقل والإعلام)"، و"فقدان الحساسية إزاء الألم الشديد (كون الحروب والكوارث غدت مشاهد تلفزيونية مكرورة ومألوفة)"، و"تشكيل مدخرات هائلة من الطاقة"، و"الاستهلاك المبالغ فيه"، و"استنفاد الثروات الطبيعية"، و"هوس التخطيط والبرمجة"، و"التنظيم البيروقراطي"، و"الأنظمة الشمولية"، و"الإيمان الدائم بأن الحل الممكن للقضايا البشرية حل "تقني" ، و"تسخير الرأي العام وصناعته وتطويعه عن طريق الدعاية والإعلام".
السؤال الذي تطرحه علينا هذه الظواهر، التي يبدو للوهلة الأولى أن لا رابطة توحدها، هو ما علاقتها بالتقنية؟ أليست التقنية، كما قيل دوما، هي العلم المطبق؟ أليست مجرد تطبيق لمعرفة؟ أليست نقلا واستعمالا لآلات؟
النظرية والتطبيق
هذه على أي حال هي الصورة التي تكرست عن التقنية عند كل من كان يعتبر أن العلم نظر ثم تطبيق، وأن هذا التطبيق لا يتخذ قيمته إلا في ما يجلبه من منافع وما يترتب عليه من نتائج. وهو مكسب إنساني وليس حكرا على من اكتشفوه. لذلك فلا مانع من نقله وتعميمه. فهو لا يحمل معه النظرية التي هو تطبيق لها، ولا ينقل معه "ذهنية" من ابتدعوه. لذلك نرى عندنا أن الذين يعارضون منا "استيراد الأفكار الغربية"، والذين ينددون بالغزو الثقافي، لا يقفون الموقف ذاته في ما يخص التقنية. كل ما في الأمر أنهم قد يشترطون أن يكون نقلها بعدها مجرد "أداة"، أي أن يكون نقلا طاهرا نزيها خاليا مما يعلق بها من "شوائب" نظرية، وما قد يتسرب إليها من أفكار "دخيلة".
يسلم هذا الموقف إذن بأن التقنية لا تنقل معها النظرية المتضمنة فيها، وأنها لا لون لها. هي مجرد أداة ووسيلة. وهي ليست خيرا ولا شرا في ذاته، اعتبارا بأن الوسائل لا تستمد معناها إلا من الغايات التي تستهدفها. فلا خوف إذن على ثقافتنا وهويتنا وأعرافنا وعاداتنا من هاته "الآلات" البكماء الصماء، حتى إن أصبحت تتخذ أشكالا أكثر "التواء"، حتى إن صارت "تتكلم" وتسمع، تتذكر وتخزن، بل حتى لو غدت "ذكاء صناعيا"، فلا خوف علينا منها، وهي لا تحول مفهومنا عن المكان ولا الزمان، وهي لا تغير أنماط عيشنا وأسلوب تفكيرنا، ولا تؤثر على فنوننا وآدابنا، ولا تغير أذواقنا وأهواءنا، ولا تنظم إداراتنا ودواليبنا. مجمل القول إنها لا تتجسد في أي ظاهرة من تلك التي أشار إليها م. هار في مقالته.
ما يبدو سندا لهذا الموقف "التلقائي" من التقنية، حتى لا نقول الساذج، هو أن فلاسفة الغرب أنفسهم ظلوا، حتى وقت غير بعيد، يقفون الموقف ذاته. فهم أيضا ظلوا يفصلون العلم عن التقنية، ويميزون النظر عن التطبيق، والفكر عن الممارسة، متناسين أن اللفظ الإغريقي "تيخنى" كان يعني عند القدماء النظر والعمل في الوقت ذاته، شأنه في ذلك شأن لفظ صناعة في تراثنا حيث كان يطلق على صناعة الحياكة كما يطلق على صناعة الفلسفة. يقول هايدغر: "في ما يتعلق بدلالة كلمة تيخني ينبغي أن نأخذ أمرين اثنين بعين الاعتبار: الأول هو أنها ليست اسما للعمل والمهارة الحرفيين، بل كذلك للفن الرفيع... الثاني هو أنها ترتبط منذ وقت مبكر إلى زمن أفلاطون بكلمة "إيبيستيمي"، أي العلم، والكلمتان تدلان على المعرفة بالمعنى الواسع".
أضرار ومنافع
وعلى رغم ذلك، ظلت التقنية، حتى عند المفكرين الغربيين، تفصل عن الإبيستيمي، وبقيت شيئا محايدا. لذلك اقتصروا، هم كذلك، على التساؤل حول أضرارها ومنافعها، ولم يعملوا على طرح الموقف "التلقائي" منها موضع تساؤل، ولم يجعلوا من التقنية "مسألة فلسفية"، والأهم من ذلك، لم يتساءلوا عن ماهيتها، إلا منذ وقت قريب. والغريب أننا لا نعثر حتى عند مفكر عصر الصناعة كارل ماركس، الذي لقبه كوسطاس أكسيلوس بـ"مفكر التقنية"، لا نعثر عنده على إعادة نظر في المسلمة التي يقوم عليها الموقف "التلقائي"، وفي العلاقة التي تربط النظر بالعمل، والفصل المزعوم بينهما.
في محاضرة أصبحت نصا كلاسيكيا في الموضوع نُشرت في صيغتها النهائية تحت عنوان "السؤال عن التقنية"، يعزو هايدغر سيادة الموقف التلقائي من التقنية إلى أن مساءلته تتطلب مساءلة الميتافيزيقا وأزواجها. فما دمنا نؤول التقنية انطلاقا من علاقة النظر بالعمل، والنظرية بالممارسة، وما دمنا ننطلق من الفصل الأولي بينهما، فلا يمكن الموقف التلقائي أن "يزعجنا" ولا أن يوقظ تفكيرنا.
ولكن لماذا الانطلاق من هذا الفصل؟ بالضبط كي نتبين أن التقنية ليست هي العلم المطبق، وأن ماهيتها لا تكمن في استعمال الآلات، وأنها ليست آلة عظيمة تضم أجهزة وأساليب للتنظيم وأنماطا للعمل، وخلاصة القول كي نتبين أننا نكون "في" التقنية من غير أن نكون أمام آلات. ذلك أن الآلية بمعناها الحديث ليست مجرد تطبيق للعلم. إنها حلول لممارسة معرفية جديدة. فليست ماهية الآلية تحويلا للأداة إلى آلة بقدر ما هي قائمة في الآلة ذاتها، تلك الآلة التي ليست آلة إلا بمقدار ما فيها من رياضيات. الآلة آلة باطنيا وانطلاقا من الجدة النوعية للمعرفة المستخدمة، وليس خارجيا وكتطبيق للمعرفة. الآلة "تنطوي" على نظرية ولا تكتفي بتجسيدها.
امتلاك الطبيعة
إن المعرفة التي بفضلها اتخذت الممارسة شكلا آليا هي الرياضيات. إنها المعرفة التي أصبح فيها الوجود ذا طبيعة رياضية. يتعلق الأمر بمعرفة "تجعلنا سادة على الطبيعة وممتلكين لها"، كما كتب ديكارت. إرادة المعرفة هنا إرادة قوة. والعلم ذاته لم يصبح رياضيا إلا بالارتباط مع هذا الصراع وبغية السيطرة. للعلم إذن صبغة تقنية. العلم كنظرية، وقبل أن يغدو تطبيقا، هو خاضع لماهية التقنية في شكلها الحديث. لهذا غدا الحديث اليوم عن أمر واحد موحد هو "التقنوعلم" الذي يجعل الانكشاف يتعلق بالطبيعة، ليس كانفتاح، أي ليس ككائن ينفتح من تلقاء ذاته، وإنما كشيء نستحثه ونكشف عنه ليمثل أمامنا كمستودع للطاقة.
يقول هايدغر: "الحقل الذي كان الفلاح سابقا يزرعه، عندما كانت الزراعة لا تزال تعني الرعاية والعناية، يظهر الآن بكيفية مغايرة، في ما سبق، لم يكن الفلاح هو الذي يحث الطبيعة على الانفتاح، عندما كان يبذر الحبة، كان يوكل البذرة لقوى النمو ويكتفي هو بأن يرعاها. أما الآن فإن زراعة الحقل قد دخلت في دوامة نوع آخر من الزراعة. الزراعة اليوم هي صناعة آلية للتغذية".
يجد إنسان عصر التقنوعلم نفسه مدعوا إلى هذا الكشف عن الكائن كمستودع للطاقة. وسلوكه هذا يتجلى في ظهور العلم الحديث. إن شكل التمثل الخاص بهذا العلم يطارد الطبيعة ويعتبرها بمثابة مركب من القوى قابل للحساب الرياضي. فليست الفيزياء الحديثة فيزياء تجريبية لأنها تطبق على الطبيعة آلات من أجل فحصها. العكس هو الصحيح. فلأن الفيزياء، مسبقا وكنظرية خالصة، تجبر الطبيعة كي تظهر مركبا من القوى قابلا للحساب الرياضي، أمكن التجريب أن يمحصها. التقنوعلم لا يطبق هنا على طبيعة محايدة ما ارتآه، إنه منذ البداية يكون أمام موضوع من صنع التقنية. فضلا عن هذا، فإن المعرفة العلمية ذاتها يتم التعامل معها بالأسلوب التقني نفسه الذي يتم به التعامل مع الكائن عموما من حيث ينظر إليه كطاقة تختزن رصيدا من المعلومات تكون رهن الإشارة وتحت الإمرة.
ما أبعدنا إذن عن التقنية كمجرد تطبيق، ما دامت التقنية تغدو، بفضل ما تقدم، نمطا لتجلي الموجود. إنها الكيفية التي يختفي فيها الوجود ليظهر كمستودع. والأهم أن الإنسان ذاته، شأنه شأن العلم، يشكل هو كذلك جزءا من هذا المستودع. وبما أن الواقع الفعلي يمثل هنا في وحدة الحسابات التي تنقلها التصاميم والمخططات، فإن الإنسان يحشر في هذه الوحدة والانسجام، ويمتد الموجود في غياب الاختلاف، ذلك الغياب الذي يستجيب لمبدأ الإنتاجية. ورغم أن هذا المبدأ يظهر أنه يِؤدي إلى نظام تراتبي، إلا أنه يقوم، أساسا، على غياب كل تراتب، من حيث إن مرمى الإنتاج ليس إلا الفراغ الموحد.
هذا الفراغ الموحد، هذا الغياب للاختلاف هو الذي يوجد وراء كل تلك الظواهر التي أشار إليها م. هار في بداية هذا المقال، وهو الذي يوحدها ويمكن أن يكون الاسم المشترك بينها، هو الذي يتسرب إلى ثقافاتنا، إن حق لنا بعد أن نستعمل صيغة الجمع في هذا الصدد، وهو الذي يُستورد مع الآلات ونماذج التنمية ومخططات التنظيم فينظم علاقتنا بالمكان والزمان، ويحدد طبيعة انفعالاتنا، ونمط عيشنا، وأسلوب تفكيرنا، ويعين طرق عملنا وأشكال فنوننا وآدابنا، ويطبع أذواقنا وأهواءنا، وينظم إداراتنا ودواليبنا.
عن : مجلة " المجلة"