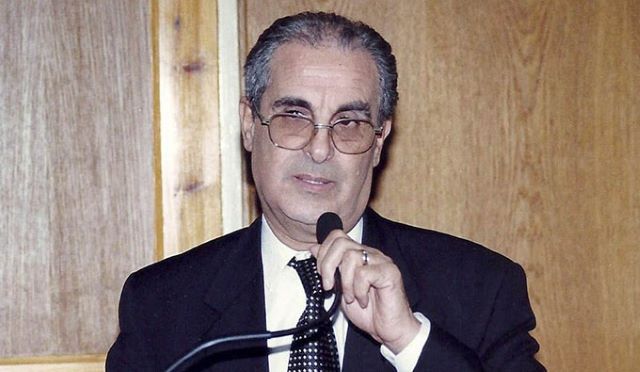الحق في التظاهر السلمي ليس مجرد شعار دستوري، بل مرآة تعكس جوهر التحول الديمقراطي الحقيقي، وأداة راقية تمكن المجتمع من أن يُسمع صوته ويُجدد عهده بالمساءلة والرقابة الشعبية. هو فعل مواطنة يعيد الاعتبار للإنسان كذات فاعلة، قادرة على التعبير عن همومها وتطلعاتها بوسائل حضارية، بعيدا عن منطق العنف والانفلات. ومن هذا المنطلق، يصبح التظاهر معركة مشتركة لا تخص فئة بعينها: إنها قضية المجتمع بأسره، حيث يلتقي المواطنون، والمثقفون، والفاعلون المدنيون، وحتى رجال الأمن أنفسهم، في مواجهة الفساد والمفسدين، دفاعا عن استقرار الوطن وصون كرامته.
في قلب هذا المشهد، برز جيل "Z" كفاعل جديد، يحمل وعيا مختلفا، مسلحا بقدرات رقمية غير مسبوقة، ورؤية نقدية لمآلات السياسات العمومية. لم يخرج هذا الجيل إلى الشارع بحثا عن مغامرة، بل خرج ليقول بوضوح إن الحكومة التي اعتلت سدة المسؤولية عبر صناديق الاقتراع لم ترتق إلى مستوى الانتظارات. لقد رفع هذا الجيل شعاراته السلمية مطالبا بأبسط الحقوق: تعليم يليق بكرامة الإنسان، منظومة صحية عادلة، وعدالة اجتماعية تحمي الفئات الهشة من التهميش والفقر.
إنها ليست مجرد مطالب ظرفية، بل هي جوهر العقد الاجتماعي الذي يشكل أساس الشرعية لأي حكومة منتخبة. فعندما يُفرَّغ هذا العقد من محتواه، ويُترك المواطن في مواجهة واقع من الإقصاء والحرمان، يصبح التظاهر السلمي بمثابة صيحة إنذار، ورسالة حضارية تقول إن الديمقراطية ليست مجرد صناديق انتخابية، بل التزام يومي بكرامة المواطن وحقوقه.
لكن المفارقة المؤلمة أن الحكومة، في لحظة كان يُنتظر منها أن تُظهر نضجها السياسي وحسها بالمسؤولية، آثرت الانزواء خلف جدران الصمت. لم يخرج الناطق الرسمي ليقدم تفسيرا صريحا واضحا ومقنعا، ولم يبادر رئيس الحكومة إلى مخاطبة الناس بلغة تطمئنهم وتعيد بناء الجسور معهم.
إن هذا الفراغ في التواصل السياسي لا يُقرأ فقط كخطأ عابر في التدبير، بل كعرض لأزمة أعمق: أزمة في فهم وظيفة الدولة الحديثة التي لا تقاس فقط بقدرتها على فرض النظام، بل بقدرتها أيضا على إنتاج الثقة وضمان الحد الأدنى من التماسك الاجتماعي. فحينما تغيب الكلمة الصادقة، ويُستبدل الحوار بالتجاهل، يتحول الصمت إلى وقود يزيد من حرارة الاحتقان، ويمنح للشائعات والمتربصين فرصة لتأجيج الوضع.
لقد أثبتت التجارب السياسية الكبرى أن الشعوب لا تحاكم الحكومات فقط على مستوى السياسات العمومية، بل أيضا على قدرتها على الإصغاء والاعتراف والاعتذار إن لزم الأمر. لذلك، فإن عجز الحكومة عن التقدم بخطاب يليق بالمقام، وتهربها من مسؤولية المواجهة المباشرة مع المطالب الشعبية، لم يفقدها فقط رصيدا سياسيا محدودا أصلا، بل فتح الباب واسعا أمام مزيد من فقدان الثقة بين الحكومة والمجتمع.
ومع ذلك، فإن بارقة الأمل لا تزال قائمة، ما دام التظاهر السلمي محتفظا بروحه النبيلة وبوصيته الكبرى: التعبير عن الحق، لا الإنزلاق إلى العبث. فالتاريخ علمنا أن أعظم ما يمكن أن تُنجزه المجتمعات في لحظات الغليان هو قدرتها على حماية نفسها من الاستغلال الرخيص، ومن أولئك الذين يتربصون بالموجة ليركبوا على ظهرها، محرفين مطالب الناس، محولينها إلى أوراق مساومة أو أدوات ضغط تخدم مصالح ضيقة وأجندات شخصية.
إن أخطر ما يمكن أن يُصيب الحركات الاحتجاجية هو أن تقع في شَرَك الانتهازيين، أولئك الذين تطلق عليهم العامة "أشمايت". هؤلاء لا قضية لهم سوى الفوضى، ولا حلم لهم سوى إشاعة الفتنة. يقتاتون على الاضطراب كما يقتات الطفيلي على الجسد الحي، ويتحولون في لحظات الأزمات إلى "أبطال زائفة" يصورون على أنهم قادة بينما هم في الحقيقة لا يعدون سوى تجار أزمات.
هنا تكمن لحظة الاختبار الكبرى: فالتظاهر، ما لم يُحصن بالوعي الجمعي وباليقظة المدنية، قد يتحول إلى سيف ذي حدين. وإذا ما وقع انفلات أمني أو اجتماعي، فإن الخسارة لن تكون محصورة في طرف دون آخر، بل سيذوق مرارتها الجميع: الحكومة التي تتآكل شرعيتها، والمجتمع الذي تتفتت وحدته، والأفراد الذين يفقدون شعورهم بالأمان والثقة. من هنا، يصبح الحفاظ على السلمية مسؤولية مشتركة، لا يتحملها المحتجون وحدهم، بل كل فاعل في المجتمع: من المثقف الذي يضيء الطريق، إلى الإعلامي الذي يكشف التضليل، إلى رجل الأمن الذي يحرس لا ليقمع بل ليصون، إلى المواطن البسيط الذي يدرك أن حماية الوطن تبدأ من حماية المظاهرة نفسها من الانفلات.
هنا، الواقع يرسم صورة واضحة عن نوعين من الاحتجاجات المتزامنة، كل له أبعاده ودلالاته.
الأول: احتجاج سلمي واع، منظم، يقوده جيل مثقف "مربي" ، واع بمسؤولياته، يعرف ما يريد وكيف يبلغه، يختار أسلوب الحوار المدني الممنهج، ويستخدم أدوات العصر الحديث بحكمة. هذا النوع من التظاهر ليس مجرد احتجاج عابر، بل عملية بناء تاريخية، يضع أسس المستقبل، ويشيد جسور الأمل، لأن أسلوبه حضاري، لا يجر البلاد إلى الانحدار، ويحول المطالب المشروعة إلى فعل جماعي مؤثر يكتب التاريخ بأحرف من وعي وإبداع.
الثاني: فهو أشبه بانفجار جماعي غير منظم، يغذيه اليأس، الإحباط، وفقدان الثقة بالواقع السياسي والاجتماعي، إضافة إلى اضطرابات نفسية تراكمت عبر الزمن. أفراده غالبا ما يفتقرون إلى أي مشروع واضح أو رؤية مستقبلية، فيختارون العنف كوسيلة للتعبير، ويخربون الممتلكات العامة والخاصة، متسترين بأقنعة تخفي وجوههم وكأنها تعكس فراغا داخليا عميقا، وفقدانا لأي شعور بالانتماء أو المسؤولية. سلوكهم لا يعكس سوى أزمة اجتماعية ونفسية، ويضاعف من التوتر ويهدد السلم المجتمعي، محولا المطالب الحقيقية إلى فوضى ضارة تعود بالضرر على الجميع.
المسؤولية هنا ليست طارئة ولا عابرة، بل ثمرة سياسات طويلة المدى، سلخت عن المجتمع جلده القيمي والثقافي، وأفرغت التعليم من جوهره، لتترك الساحة عارية أمام مشاهد عبثية تقدم بوقاحة على أنها قدوة.
فها هو الفضاء العام يُغرقه ضجيج من لا يملكون غير لغو ساقط، أو سروال ممزق لا يستر العورة، أو قنينة خمر تُرفع في الهواء بيد، وسيجارة ملفوفة باليد الأخرى امام الجماهير من هذه الفئة. هؤلاء صاروا "نجوما" يُحتفى بهم، تُمنح لهم الجوائز، وتُعلق على صدورهم الألقاب ويأخد الوزير معهم صورا للذكرى مع ابتسامة عريضة، وكأن القدوة صارت تُقاس بجرأة الانحطاط لا برصانة الفكر.
في الجهة الأخرى، يقف المفكرون، والمبدعون الحقيقيون، وأبناء الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن الوطن، مهمشين، مقصيين، كأنهم غرباء في أرض سقوها بدمائهم. إنه مشهد مؤلم، يعيد طرح السؤال الأزلي: بأي معيار تُصنع القدوة؟ وبأي منطق يُقصى من حمل الفكر والكلمة، ويُقدم من باع الوهم والتفاهة؟
إنها ليست مجرد أزمة أخلاقية أو سياسية، بل جريمة رمزية في حق الذاكرة الجماعية، حيث يمحى معنى التضحية والنبل، ويكرس الانحدار كأفق وحيد لجيل يتلمس طريقه وسط عتمة مقصودة.
إن الفراغ الذي خلفه غياب الاستثمار الحقيقي في التربية على المواطنة، وفي العلم والفكر، وفي ترسيخ الهوية الوطنية، هو الذي أنتج هذا الواقع المأزوم. فحين يُهمش التعليم، وتُهمل القيم، ويُترك الشباب يتيه بين الجهل والفقر، يتحول هذا المزيج إلى كارثة حقيقية تهدد نسيج المجتمع واستقراره.
والأدهى من ذلك أن بعض الانتهازيين، سواء من الداخل أو الخارج، يستغلون هذه الكارثة كالفرصة المثالية لإضعاف الوطن، ونشر التوتر، وتقويض مؤسساته، خدمة لمصالحهم الضيقة وأجنداتهم الخفية. وهنا تتضح مسؤولية المجتمع بأسره، من المثقفين والمبدعين إلى الإعلاميين والأجهزة الأمنية، في التصدي لهذه المحاولات، وحماية الشباب، وضمان أن يظل الفضاء العام ميدانا للحقائق، لا ملعبا للفوضى والانتهازية.
في خضم هذه اللحظة الحرجة، يبرز الدور الحيوي للمثقفين، والأطباء، والأكاديميين، والصحافيين، وكل من يمتلك الكلمة والرأي المؤثر، ليكونوا خط الدفاع الأول أمام هذا الانحدار الاجتماعي والسياسي، ويحصنوا المجتمع من الانزلاق نحو النفق المظلم للفوضى والانفلات.
فالوطنية الحقيقية لا تقاس بالشعارات أو العبارات الرنانة، بل بالقدرة على حماية الوطن من التفكك، والحفاظ على السلم الاجتماعي، وضمان أن تظل المطالب المشروعة للأفراد والجماعات مسموعة ومحقة، ضمن إطار حضاري وسلمي. إنها مسؤولية جماعية تتطلب وعيا رصينا، وتصميما على أن تكون القوة العقلية والثقافية والوعي المدني خطوط الدفاع الحقيقية، لتتحول المطالب الاجتماعية إلى فعل بناء يشيد مستقبلا مستقرا ومشرقا، لا إلى ساحة للصراعات والخلافات التي تهدد استقرار الدولة والمجتمع معا.
إن الحق في التظاهر السلمي ليس مجرد مطلب قانوني، بل تعبير عن وعي جمعي يتشكل عبر الأجيال. وإذا كان جيل "Z" اليوم قد اختار أن يرفع صوته بطريقة سلمية وحضارية، فإن ذلك يحمل الحكومة مسؤولية مضاعفة: مسؤولية الإصغاء والتفاعل الإيجابي، لا الهروب إلى الأمام أو تجاهل الأصوات الصادقة. ففي نهاية المطاف، ما يطالب به هؤلاء الشباب هو الحق في مستقبل أفضل، مستقبل يليق ببلد غني بتاريخه وهويته وإمكاناته.
وعليه، يبقى الرهان الأساسي هو أن تتحول هذه الاحتجاجات إلى فرصة لإصلاح عميق، يعيد الاعتبار للمدرسة العمومية، وللخدمات الصحية، ولمنظومة العدالة الاجتماعية، ويحصن القيم الوطنية من الانهيار. أما الانفلات والفوضى، فلا يخدمان إلا أعداء الوطن والانتهازيين الذين يتربصون بالمشهد السياسي والاجتماعي.
عاشت بلادي، وستظل — بإذن الله — أرضا للأمان والاستقرار، مهما تعاقبت الأزمات وتبدلت الحكومات. فالمغرب، حين تتوحد فيه إرادة أبنائه، يصبح أقوى من كل انقسام، وأقدر على تجاوز كل تحد. إن صوت المجتمع، حين يعلو بالمطالب المشروعة، لا يهدد الدولة، بل ينقذها من العطب؛ وحين تصغي المؤسسات لهذا الصوت بصدق، يتحول الاحتجاج إلى طاقة بناء، والغضب إلى وعي، والاختلاف إلى مشروع إصلاح.
فالوطن لا يُبنى بالشعارات ولا بالولاءات العمياء، بل بالتلاقي بين الدولة والمجتمع على قاعدة مشتركة: العدالة، والكرامة، والحرية. هذه هي القيم التي شكلت هوية المغرب العميق عبر التاريخ، وهي التي تضمن له أن يبقى نموذجا في التوازن والاستمرار وسط عالم مضطرب.
وعليه، فإن مغرب الغد الذي نحلم به، لن يولد من رحم الصراعات أو الصمت، بل من الحوار، والمحاسبة، والوعي الجماعي بأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. فحين يعلو صوت العقل، وتحترم إرادة الشعب، يصبح الإصلاح طريقا لا رجعة فيه، وتغدو الأزمات مجرد محطات عبور نحو وطن أكثر عدلا وكرامة وإنسانية.
عاشت بلادي آمنة مستقرة، قوية بأبنائها، عادلة في مؤسساتها، حرة في قرارها.