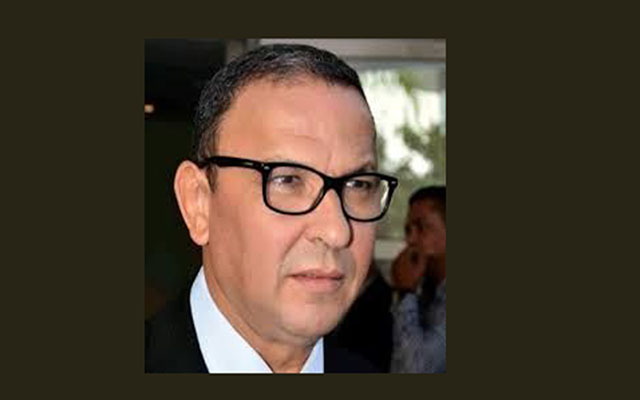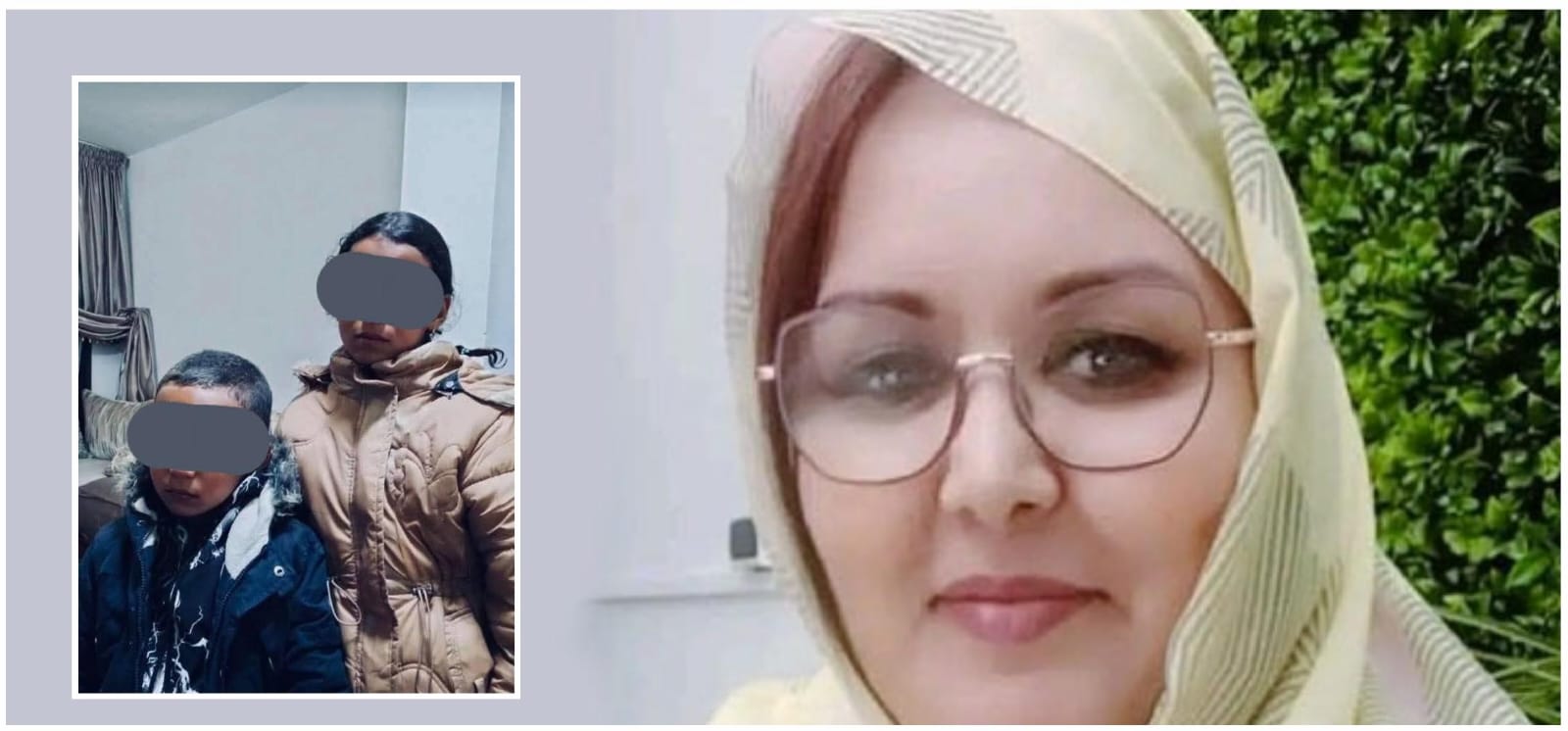ترى الدكتورة وصال المغاري، الأخصائية في علم النفس أن تنامي العنف المدرسي، في السنوات الأخيرة، يعود الى عوامل متعددة ضمنها العوامل الاجتماعية و التي تضم المستوى السوسيو اقتصادي لبعض الأسر الفقيرة، حيث يشعر التلميذ بالنقص، وهو ما يدفعه الى كراهية الآخرين، وبالتالي ممارسة العنف، إضافة إلى عوامل المحيط المدرسي ( ترويج المخدرات وحبوب الهلوسة أمام أبواب المؤسسات التعليمية ):
كيف تنظرين الى تنامي ظاهرة العنف في المؤسسات التعليمية، وإلى ماذا تعزى في نظرك؟ هل يرتبط بالعنف السائد بالشارع ؟
العنف المدرسي هو ظاهرة حديثة العهد في المؤسسات التعليمية، هو سلوكات و تصرفات تكون غالبا عدوانية و شريرة و التي يمكننا تقسيمها إلى نوعين؛ العنف المادي و يتجسد في التخريب داخل الفصول و في الساحات، الكتابة عن الجدران، والعنف الرمزي كالسخرية و الإستهزاء و الشتم.
تتدخل عدة عوامل في تعدد أسباب العنف المدرسي حيث يمكننا عرضها كالتالي؛
ـ عومل سيكولوجية حيث أن المتعلمين يحسون بالإضطراب مما يجعلهم يشعرون بالإرتباك و بالتالي ارتكاب أعمال العنف.
ـ عوامل اجتماعية و التي تضم المستوى السوسيو اقتصادي لبعض الأسر الفقيرة، حيث يشعر التلميذ بالنقص، هذا الإحساس بالنقص يدفعه إلى الإحساس بالكراهية و الحقد تجاه الآخر مما يولد لديه نزعات عنفية.
ـ عوامل أسرية، فالأسر التي لا تتوفر على مستوى تعليمي، لا يمكنها تأطير و تربية أبنائها لأنهم في مرحلة التكوين وهم في أمس الحاجة إلى العناية و المراقبة.
ـ عوامل المحيط المدرسي كالظواهر التي أصبحنا نلاحظها أمام أبواب المؤسسات التعليمية كالمخدرات خصوصا حبوب الهلوسة التي تؤدي إلى الممارسات العدائية الخطيرة.
ـ عوامل تربوية كضعف المحتويات الدراسية المغربية وعجزها عن مسايرة التطورات و الطفرات التي تعرفها وسائل الإعلام و التي لا تعرفها المدرسة المغربية.
وقد أكدت دراسات سابقة على أن ٪97 من حوادث العنف المدرسي راجعة إلى عوامل خارجية عن المؤسسة كالأسرة و الشارع، وأضافت هذه الدراسات أنه لا يمكن الحديث عن عنف في الوسط المدرسي لأنه ظاهرة اجتماعية، فهو سلوك عدواني فردي يمارسه بعض الأشخاص في المدرسة لإختلال السلوك وغياب التنشئة التي قد تكون شاهدة على مواقف مؤلمة كثيرة، كالعنف الممارس داخل الأسرة من طرف الأب، الأم، الأخ، حيث يصبح الطفل أو المراهق معتادا على مثل هذه الممارسات، بل وأكثر من هذا، يقوم بنقلها خارج الأسرة إما في الشارع أو المدرسة، كما أنه العنف الممارس بالشارع يقوم بتطبيع مثل هذه السلوكات، فضعف التمسك بالقيم و الأخلاقيات الإجتماعية أفرز شحنات عنيفة متكاثرة، فأصبحنا نرى مشاهد أليمة لم نكن نعرفها من قبل كما هو الحال مثلا في مدينة فاس التي عرفت طفرة متوحشة في هذا المجال.
وماذا عن تقييمك لواقع الصحة النفسية في ظل الإرتفاع المهول للأمراض النفسية، وضمنها الإكتئاب الذي يعد من أكثر الأمراض النفسية شيوعا في المغرب ؟
لقد كشفت الإحصائيات الأخيرة لوزارة الصحة أن ٪48.9 من المغاربة يعانون من اضطرابات نفسية،٪26.5 منهم يعانون من الإكتئاب و٪14 تجاوزوا الإكتئاب إلى محاولة الإنتحار.
ليس هناك عائلة مغربية ليس لها آبن أو قريب يعاني من مشاكل نفسية، فنسبة كبيرة من المغاربة تعاني في صمت من اضطرابات نفسية متفاوتة، قد تتحول في غياب المراقبة و المتابعة النفسية إلى أمراض أو اضطرابات حادة و أكثر خطورة.
و في هذا الإطار، يلجأ العديد إلى الطب التقليدي أو طقوس الشعوذة و الخرافة دون الوصول إلى الأخصائي النفسي أو الوصول إليه بعد فوات الأوان و تعقد الاضطراب هذا من جهة، من جهة أخرى هناك ضعف في الخدمات و المرافق والموارد البشرية الكافية للإحاطة بمجموع هذه الفئة التي تعاني من الاضطرابات ، فتظل هذه الفئة بين نارين؛ نار وطأة الإضطراب عليها و على محيطها القريب، ونار نظرة المجتمع، فالتمثل السائد اجتماعيا حول هذه الإضطرابات و الذي يتوارد مع مصطلح "الجنون" تمثل سلبي ساهمت في إنتشاره ثم ترسيخه وسائل الإعلام. مع الأسف لا يزال الشخص الذي يعاني من مشاكل نفسية أو عقلية من سوء الفهم و غياب الجدية و المسؤولية سواء من طرف المجتمع أو من طرف الأسرة، بل حتى من قبل بعض المختصين خاصة الأطباء النفسيين، ما داموا في بعض الأحيان لا يقومون بتشخيص إكلينيكي حقيقي، ويكتفون بآقتراح أو وصف العلاج الدوائي فقط.
وفيما يخص ودود اضطراب الإكتئاب بين صفوف المغاربة، فهو ينتشر بوثيرة مقلقة تجعله في صدارة الإضطرابات التي يعاني منها الأشخاص، وتتم غالبا الخطوة الأولى للتشخيص عبر استشارة عادية للطب العام و في غياب أرقام رسمية جديدة، يمكننا القول أن عدد الأشخاص المصابين بالإكتئاب قد ارتفع في السنوات الأخيرة، نظرا لأسبابه المتعددة
و المتداخلة، منها نمط العيش، تزايد الهشاشة النفسية، البيولوجية، الإقتصادية، الإجتماعية، و الثقافية، ومنه فإن الحاجة أصبحت ملحة إلى سياسة صحية نفسية قائمة على التحسيس و التعريف بهذا الإضطراب، سواء عبر وسائل الإعلام أو أيام تحسيسية و قوافل صحية نفسية لكي لا تصاحب هذا الإضطراب تأويلات و تفسيرات غير علمية.
يحتل المغاربة المركز الثاني من حيث الشعوب الأكثر إقبالا على الإنتحار في المنطقة العربية و ذلك بنسبة ٪ 5.3 في كل 100 ألف مواطن، فما هي أسباب ذلك في نظرك، وكيف يمكن الخروج من هذا الوضع المخيف؟
لابد من الإشارة أولا أن الإنتحار ظاهرة علمية تخترق كل البلدان وكل الثقافات ولا يستثنى منها بلد من البلدان، وتبقى الإحصائيات متضاربة نظرا لإعتبار هذه الظاهرة نوعا من الطابوهات..
كما أن الموضوع يعتبر حساسا، نظرة لإقحام الدين في الحكم عليه، فالشخص المنتحر هو شخص ضعيف لا دين له كما هو شائع في الثقافة المغربية خصوصا و العربية عموما
يمكننا أن نصنف عوامل الإنتحار حسب ثلاثة أبعاد؛ اجتماعية، نفسية، وربما جينية أي وجود حالات انتحار سابقة في تاريخ الأسرة، وقد يكون هنا الإنتحار تقليدا لا أكثر.
للأسف لا وجود لدراسات ميدانية علمية تبحث في عوامل انتشار الإنتحار بالمغرب، إلا أن معظم التفسيرات و القراءات تصب في دور الفقر، البطالة، التفاوت الإجتماعي الحاد كعوامل قوية مسببة له.
فانتشار الإنتحار مرتبط بتراكم الإحباط نتيجة للتطلع إلى التغيير، كالتغيير الإجتماعي مثلا، مما يؤدي إلى توجيه العدوانية نحو الذات في حالة للفشل و للإخفاق.
وكما هو معلوم ومرئي لكل المغاربة، هناك استفحال خطير للتفاوت الإجتماعي، شأنه شأن الفقر والبطالة، التي تمس نسبة كبيرة من الشباب، بجانب خدمات الدولة الضعيفة مما يسمح لهذه النقائص الإقتصادية الهيمنة و التحكم في هذه الظاهرة، خاصة وأن ظاهرة الإنتحار تمس أكثر الأشخاص ذوي الدخل المنخفض و المتوسط.
إذا تناولنا موضوع الإنتحار مناولة سيكولوجية، يمكننا القول، نحن الأخصائيين النفسيين أن بعض الإضطرابات النفسية، كالإكتئاب مثلا تؤدي إلى الإنتحار خصوصا إذا لم يخضع الشخص للعلاج.
وهنا أود أن أشير إلى تصنيف الأخصائيين الاجتماعيين لهذه الظاهرة، وذلك بغية الفهم و خصوصا لإدراك الفروقات و خصائص كل نوع من الانتحار، فنتكلم عن الانتحار الاحتجاجي كحرق الذات، الانتحار العقابي الذي يحمل الذات مسؤولية الألم و الفشل، الإنتحار الطوعي والذي يعمد فيه الشخص إلى قتل ذاته من أجل قناعة دينية، نفسية....الإنتحار البطيء المرتبط بإدمان المخدرات، الانتحار الاحتمالي الذي يجازف فيه الشخص بحياته من أجل تحقيق هدف ما، والإنتحار الجبري و الذي تكون مسبباته عصبية أو جنبية.
الخروج من هذا الوضع المخيف يستلزم أولا عتراف الدولة بوجود هذه الظاهرة، ليس فقط بالحديث عنه، وإنما بإرساء استراتيجينيات سواء على مستوى الدعم النفسي للأشخاص الذين يعانون من اضطراب الإكتئاب، وأيضا على المستوى اللوجيستيكي أي بدعم البنيات التحتية اللازمة كمراكز الإستماع ومراكز الدعم النفسي و الإجتماعي و المستشفيات الخاصة بالعلاج النفسي، كما ينبغي محاولة التخلص من الأحكام المسبقة و المرتبطة غالبا بالناحية الدينية لأن الإنتحار أعمق و أخطر من أن ينسب للكفر بالله.