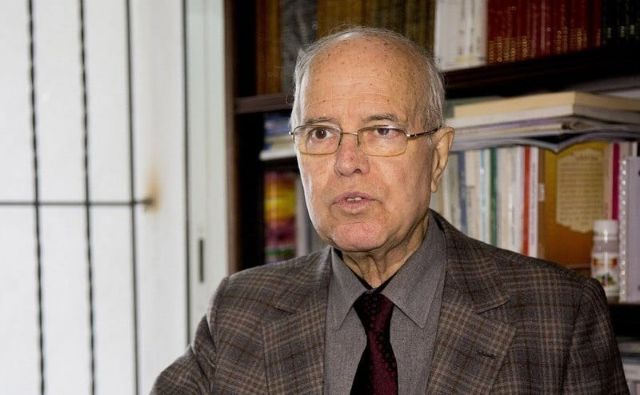يشهد الفضاء الرقمي في السنوات الأخيرة تحوّلًا جذريًا في أنماط التلقي والتفاعل، خاصة مع صعود ما يُعرف بـ"الريلز" (Reels) على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام، فيسبوك، وتيك توك. فهذا الشكل الجديد من المحتوى المرئي المقتضب لا يُمثل مجرد تطور تقني أو صيغة تواصلية مبتكرة، بل يعكس تحوّلات ثقافية أعمق تمس علاقة الإنسان بالزمن، وبالمعرفة، وبالآخر.
وفي مقابل هذه الثقافة السريعة، اللحظية، والمجتزأة، تبرز "ثقافة العمق والممانعة" كمفهوم مضاد، يستدعي التريّث، والتأمل، والانخراط الواعي في فهم الذات والعالم. إنها ثقافة تراهن على الزمن الطويل، وعلى المعنى المتعدد لا اللقطة الواحدة، وعلى الفهم العميق لا الاستجابة السريعة.
لم يعد "الريلز" مجرد وسيلة للترفيه أو تسويق المحتوى، بل أصبح نمطًا ثقافيًا قائمًا بذاته، يُؤطر الزمن في ثوانٍ معدودة، ويختزل التجربة الإنسانية في إيقاع بصري سريع ومثير. هذا الاختزال، الذي تشجّعه خوارزميات المنصات، يعكس نزعة نحو ما يمكن تسميته بـ"ثقافة الفُتات"، حيث يُستهلك المحتوى بسرعة، ويُنسى بسرعة أكبر، في ما يشبه ما وصفه زيغمونت باومان بـ"الحداثة السائلة"؛ حيث لا شيء يدوم، وكل شيء يتبخّر.
الفكرة.
نحن إذًا أمام اختلال عميق في وظيفة التواصل ذاتها؛ فالمنصات الرقمية لم تعد تُيسّر الحوار أو توسّع دائرة التفكير، بل تحوّلت إلى فضاءات للعرض اللحظي، تغذّي ما وصفه بيير بورديو بـ"العنف الرمزي الناعم"، من خلال فرض نماذج معينة للنجاح، والجمال، والجدارة الرمزية – بل وحتى الذوق والسلوك – بما يُعمّق الفوارق الاجتماعية بدل أن يُقلصها.
بهذا المعنى، لا يمكن النظر إلى "الريلز" كمنتوج بريء أو محايد؛ فهو يُعيد تشكيل الوعي بطريقة لا شعورية، حيث يُصبح الإنسان سجينًا لاقتصاد الانتباه، ومرتهنًا لسرعة تقتل التمهّل، وتُعطل النقد، وتفرغ التواصل من مضمونه التأويلي.
ومن هنا، فإن السوسيولوجيا مدعوة، أكثر من
أي وقت مضى، إلى مساءلة هذه الأشكال الجديدة من الاستلاب الرقمي، بدل الاكتفاء بوصفها كظواهر تقنية عابرة.
ثانيًا_ من الفكرة إلى الصورة: هيمنة المرئي وتراجع الكلمة
مع صعود الريلز، يلاحظ تراجعًا في سلطة الكلمة المكتوبة أو المحكية لصالح الصورة المتحركة، بل يمكن القول إن ثقافة الريلز تضعف المسافة الضرورية للتفكير والتأمل. فالصورة لا تُقنع بالحجة، بل تُغري بالسرعة والانفعال. وهنا تبرز مفارقة سوسيولوجية: كلما زادت القدرة على الوصول إلى المعلومات، قلّت القدرة على التفكير فيها. هذا التراجع لا يُعد تحوّلًا عفويًا، بل هو نتاج مسار طويل من "تشييء" المعرفة وتحويلها إلى محتوى قابل للاستهلاك اللحظي، منفصل عن سياقه، وعن
عمقه التاريخي والفلسفي. إن الصورة المتحركة، كما تُستخدم في الريلز، لا تُتيح بناء المعنى، بل تُبدّده عبر التكرار، المونتاج السريع، والمؤثرات البصرية التي تهدف إلى الإثارة أكثر من الإفهام. في هذا السياق، تصبح المعلومة "مشهدًا"، ويُختزل الإدراك في ردّ فعل سريع: إعجاب، مشاركة، تمرير، حذف. وما يُفقد هنا ليس فقط الزمن التأملي، بل أيضًا البعد الحواري للفكر؛ إذ لم تعد المعرفة تُبنى في تفاعل عقلاني أو نقدي، بل تُبتلع ضمن تدفق بصري يجعل التفكير فعلاً مؤجلاً، وربما غير ضروري. إننا نعيش ما يمكن تسميته بـ"أفول الفكرة"، حيث يتم استبدال المعنى بالانطباع، والحجة بالصورة، والموقف بالتفاعل. وهذا الانزياح لا يهدد المعرفة الأكاديمية وحدها، بل يطال الحياة العامة برمتها، حيث يُعاد تشكيل المجال العمومي على أساس الجاذبية البصرية لا العقلانية التداولية، وهو ما يُضعف إمكانيات
النقاش الديمقراطي، ويُعزّز مناخًا من التفاهة المُمنهجة على حد تعبير آلان دونو.
ثالثًا_ ثقافة العمق: مقاومة صامتة
في مقابل ثقافة الريلز، تبرز دعوات وممارسات تُعيد الاعتبار لقيمة العمق في التعاطي مع العالم: القراءة، الاستماع البطيء، التأمل، الحوار النقدي... كلها تشكّل أنماطًا مقاومة لاستهلاك المعنى السريع والزائل. ليست هذه الممارسات حنينًا إلى الماضي بقدر ما هي "ممانعة ثقافية" تُقاوم ما يُفرض اليوم كمعيار للجاذبية الاجتماعية.
إنها ممانعة تتجلّى في الإصرار على البطء في زمن السرعة، وعلى التفكيك في زمن التلقي الفوري، وعلى استعادة الزمن الطويل كشرط أساسي للمعرفة والنضج. فأن تقرأ كتابًا في
عصر الفيديوهات القصيرة هو فعل مقاومة ناعم، وأن تُصغي إلى حوار عميق بدل تقليب المقاطع الساخرة هو تعبير عن رفض ضمني لهيمنة التفاهة كقيمة معيارية.
هذه الأنماط البديلة تُعيد تشكيل هوامش جديدة للفعل الثقافي، حيث يتحوّل العمق من خيار فردي إلى موقف وجودي في مواجهة "التنميط الرقمي" الذي يُجانس الأذواق، ويفرض إيقاعًا ثقافيًا أحاديًا لا يحتمل الانحراف أو التمايز. والمفارقة هنا أن المعنى الحقيقي لا يُبنى في العُجالة، ولا يُقاس بمدى الانتشار الفيروسي، بل يُنتَج في الهامش، في الصمت، في إعادة القراءة، وفي القدرة على الشك.
هذه الثقافة البديلة لا تُنكر الواقع الرقمي، لكنها ترفض الاستسلام له. إنها دعوة لإعادة التفاوض مع شروط هذا الواقع، بما يحفظ للذات شيئًا من سيادتها الرمزية، وللعالم شيئًا من كثافته
الإنسانية. إنها دعوة للوعي في زمن التشويش، وللتفكير البطيء في عصر الحوسبة القصوى للعقل والعاطفة.
.
رابعًا_تحولات الذوق العام ومعايير القيمة
أحد أخطر انعكاسات الريلز هو إعادة تشكيل الذوق العام، حيث أصبح المعيار هو "عدد المشاهدات" بدل القيمة الفكرية أو الجمالية. وهنا يتدخل منطق السوق بوصفه محدّدًا للذوق، مما يُضعف استقلالية الأذواق الثقافية ويحول الفضاء الرقمي إلى سوق تنافسي للفت الانتباه بدل تبادل المعنى.
إن ما نشهده هو انزياح في وظيفة الثقافة ذاتها: من كونها مجالًا للتأمل والتمثّل إلى كونها
"منتجًا" يُقوَّم بمؤشرات كمية، لا بمعايير نقدية. لقد بات الذوق يُصاغ بواسطة الخوارزميات التي تروّج لما هو أكثر قابلية للانتشار، لا لما هو أكثر عمقًا أو تعقيدًا. وبذلك تُستبدل الوظيفة التربوية أو التحررية للثقافة بوظيفة تسويقية، تَختزل الإنسان في "مستهلك بصري"، وتُدخله في سباق لا ينتهي من المقارنة، الإعجاب، والمحاكاة.
وهو ما يتقاطع مع ما أشار إليه بودريار في نقده للواقع المُفرط في التمثيل، حيث تغدو العلامة أهم من المدلول، والانتشار أهم من الحقيقة. وهكذا، بدل أن يكون الذوق تعبيرًا عن تفضيلات ذاتية متفاعلة مع مرجعيات معرفية وجمالية، يتحوّل إلى استجابة لاواعية لإملاءات السوق والمنصة، مما يضعف حرية الاختيار ويُفرغ الثقافة من بعدها التكويني
خامسًا_ نحو سوسيولوجيا نقدية للزمن الرقمي
إن التحدي المطروح اليوم ليس في رفض الريلز أو تمجيد العمق، بل في فهم طبيعة التحولات الثقافية التي تحدث على تخومهما. فالثقافة الرقمية ليست شرًّا محضًا ولا خيرًا مطلقًا، بل هي مجال صراع على المعنى، وعلى طرائق الوجود والإدراك. ما نحتاجه اليوم هو سوسيولوجيا نقدية للزمن الرقمي، لا تكتفي بوصف الظواهر بل تسعى إلى تفكيك بنياتها العميقة، وتسائل ما يبدو بديهيًا أو ترفيهيًا من منظور علاقات السلطة والمعرفة.
إنها سوسيولوجيا تُنصت للصور لا لتنبهر بها، وتفكك إيقاعها لا لتتبنّاه، وتُمعن النظر في أثرها على تشكيل الذوات، وتحوّل العلاقات، وإنتاج
المعنى. فالزمن الرقمي لا يغيّر ما نفعله فقط، بل يغيّر كيف نفكر، وكيف نرى أنفسنا والآخرين. إنه زمن يعيد صياغة الذاكرة، والهوية، والانتباه، ويخلق نمطًا جديدًا من الحياة اليومية تهيمن عليه السرعة، التجزئة، واللااستقرار.
وفي مواجهة هذا الزمن، لا يكفي أن نُدافع عن "العمق" بوصفه قيمة مثالية، بل علينا أن نُعيد بناء شروطه داخل العالم الرقمي نفسه: أن نصنع منصات للفكر لا للتشتيت، أن نستثمر التكنولوجيا لا لمراكمة المشاهدات بل لإعادة تشكيل الفهم، وأن نُربّي على الوعي لا على التفاعل اللحظي. إن استعادة موقع الفكر في عالم تتسارع فيه الصور وتتقادم فيه الأفكار هي مهمة نظرية وثقافية عاجلة، تتطلب حلفًا بين النقد والمعرفة، بين التأمل والمقاومة.
ختاما
بين ثقافة الريلز وثقافة العمق، يقف الفرد الراهن في مفترق طرق: إما أن ينخرط في دوامة الاندفاع البصري، حيث لا مكان للتأمل، أو أن يُعيد ترتيب علاقته بالزمن والمعنى. والسوسيولوجيا، كعلم نقدي، مدعوة اليوم إلى تجاوز التحليل السطحي للظواهر الرقمية، والذهاب نحو مساءلة أشكال الهيمنة الرمزية التي تُمارس باسم الترفيه والتواصل. فالمعركة ليست بين القديم والجديد، بل بين الاستهلاك السطحي والفهم العميق.
إن أخطر ما يُنتج اليوم تحت غطاء الريلز ليس المحتوى في حد ذاته، بل نمط الإدراك الذي يُعاد تشكيله وفق منطق السرعة والانفعال. وكل تأجيل للتفكير في هذا النمط هو تنازل ضمني عن أحد أعمق أشكال الحرية: حرية الفهم. من هنا، تصبح مهمة السوسيولوجيا ليست فقط فهم العالم، بل مقاومة آليات تحويله إلى عرض متواصل من الصور العابرة. ذلك أن الدفاع عن العمق لم يعد ترفًا نخبوياً، بل رهانًا على بقاء المعنى نفسه في زمن التبديد الممنهج.
د.عبد اللطيف رويان باحث في سوسيولوجيا الجريمة والانحراف.