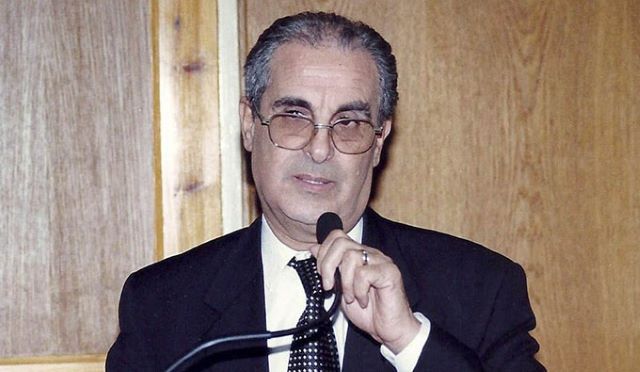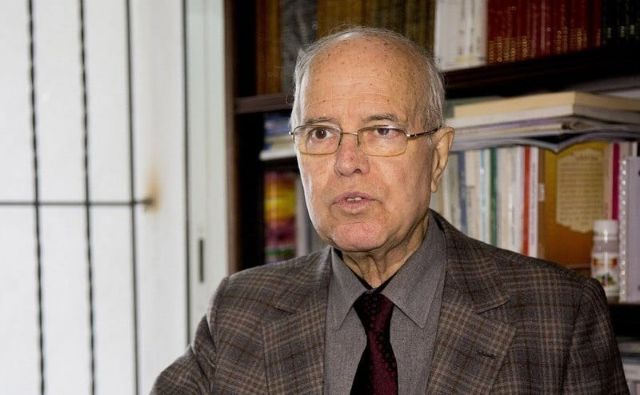ماذا لو لم يكن النقص فشلاً، بل شكلًا من أشكال فهم الحياة؟ في زمن تتشظّى فيه التجارب، وتؤجَّل المشاريع، وتُروى الحكايات على إيقاع الانقطاع، يبدو أن الناقص قد غدا وضعنا المشترك — مقلقًا، خصبًا، غامضًا.
يحاول هذا المقال أن يلامس وجوه هذا النقص المعاصر، عبر عدسة الأدب، والأنثروبولوجيا، وأشكال التعبير الحديثة، لا ليملأ الفراغ، بل لنتعلّم كيف نسكنه.
1- اللانهاية كهيكلٍ للرغبة
اللانهاية ليست ظاهرة جديدة. فهي، قبل أن تصبح تجربة جماعية معاصرة، تُشكّل حالةً إنسانيةً أساسية. منذ العصور القديمة، حاولت الأساطير والفلسفات والروايات أن تصوغ هذا الفراغ الداخلي الذي يدفع الإنسان إلى البحث، إلى الإبداع، إلى الكلام. إنّ النقص ليس شذوذاً، بل دافعًا.
في الفكر اليوناني، تورد أسطورة أريستوفان في حوار أفلاطون في «المأدبة» صورة الإنسان الأولي ككائن كرويٍّ قُسّم إلى نصفين بأمر الآلهة — ومنذ ذلك الحين، يبحث كل واحد عن نصفه الضائع. يُصوّر الإنسان ككائن ناقص جوهرياً، محكوم عليه بالرغبة، وبذلك باللانهاية.
هذا المفهوم يجد صدىً قوياً في التحليل النفسي. لدى جاك لاكان، تنشأ الرغبة من الفقد: "الرغبة هي رغبة في الآخر". نرغب فيما يتهرب منا، وما هو دوماً أبعد عن بلوغنا. نحن لا نتمكن من هدف الرغبة (الشيء المشهور بـ objet a) بصفة كاملة أبداً — دائماً ينقص شيء ما. فاللانهاية مُضمّنةٌ في بنية النفس ذاتها: هي ما يُحرّك الشخص، ما يخرجه من السكون، من الحبس.
على المستوى الوجودي، صاغ ألبير كامو هذه التوترات ببراعة من خلال شخصية سيزيف. إن عودته الأبدية إلى الصخرة ليست مجرد عقاب، بل هي صورة جذرية للوضعية الإنسانية: أن نعيش يعني أن نعيد، دون نهاية. ومع ذلك، يتم كامو قائلاً: «يجب علينا أن نتخيّل سيزيف سعيدًا». هذه السعادة المتناقضة قد تنبع من قبول النقصان كفضاء من الحرية، فضاء للفعل.
في التقاليد الصوفية، المسيحية أو البوذية — يكون مسار الإنسان نحو المطلق دائماً غير مكتمل، تقربيًّا. الكمال خارج نطاق هذا العالم، وهذا النقص في الاكتمال هو بالذات ما يجعل المسيرة الروحية حية، نابضة، حاملةً للمعنى.
هكذا، قبل عصرنا بكثير، ظهر النقصان كتجربة تأسيسية للإنسانية: هو ما يجعلنا كائنات لغوية، ساعية، راوية.
2- اللانهاية المعاصرة: تفاقم أم تحوّل؟
رغم أن اللانهاية كانت دوماً توتّراً حيوياً، فإنّ عصرنا يجعلها تجربة يومية، شبه عادية، لكن أيضاً أكثر إيلاماً. لم تعد مجرد نقص وجودي أو روحي، بل أصبحت نمط حياة، حالة متشرية، أسلوب حياة في عالمٍ يسبح في تقلب مستمر.
زمن متسارع
أحد السمات الكبرى لحداثتنا المتأخرة هو تسارع الزمن. يُحدّث هارتموث روزا، السوسيولوجي الألماني، عن "انضغاط الحاضر": كل شيء يصبح أسرع، أكثر تقلباً، وأكثر تنوعًا للطلبات. تتعاقب المشاريع دون أن تستقر في الزمن. نبدأ ألف مشروع — مهن، صداقات، تعليم، علاقات — ولكن يبدو أن الاستمرارية، والنُضج، والإتمام أمور تتفتت. المستقبل، الذي كان وعداً، صار تهديداً أو عدم يقين.
في هذا السباق الدائم، يصبح الإنجاز التام والمطلق شبه مريب، كما لو أنه يعني نوعًا من الاستسلام أو الجمود. يُطالَب الفرد المعاصر بأن "يبقى في حركة"، أن "يتطوّر بلا توقف" — لكن هذه الحركة المستمرة تخلق تعباً خفياً، إحساسًا بـ عدمية الاكتمال– دائمًا.
الأنا المتفتّتة: بين الأداء والتشتت
الإنسان المعاصر متعدد، متجزّئ، قابل للانعكاس والتقلب. عليه أن يكون في الوقت نفسه أبًا، عاملاً، مواطنًا، منتج محتوى، مدبرًا لذاته. الأنا تصبح مشروعاً دائماً، ورشة عمل من دون نهاية، يجب تحسينها. الهويات متنقلة، مرنة، لكن هذه الحرية الظاهرة تُنتج أيضاً قلقاً بنيوياً: من أنا في هذه الحركة؟ أين الوحدة؟ أين الأثر؟ أين التماسك؟
في مجتمع الفعالية والنجاعة، يُواجه الإنسان باستمرار ما لم يُنجَز، ما لم يُتعلم، ما لم يُصبح. لم تعد اللانهاية في الكينونة هي ما يشغلنا، بل لانهاية في الفعل ذاته - لانهاية قابلة للتقييم، للقياس، للكمّ، في خطر الانزلاق إلى الدوران أو الدوار.
الروايات المتفكّكة: الشبكات، السرد الذاتي، وهم الإغلاق
غيّرت وسائل التواصل علاقاتنا بالسرد. لم نعد نعيش لنروي، بل نروي لنُوثّق وجودنا. السرد الدائم يوفر تحكّماً في رواية الذات، لكنه غالباً ينتج روايات مجزّأة، دائرية، بلا تطوّر حقيقي. إنها خدعة توفر «نهايات» بلا إغلاق، «حكايات» بلا عمق.
الخوارزمية نفسها تتجاهل اللانهاية - لتحل محلها سلسلة من التحديثات، هروب نحو "المحتوى التالي".
هذا المنطق الزمني المُنقّل ينتج فقدان المعنى، تآكل الكثافة: يبدأ كل شيء دون أن يبدأ حقًا، وينتهي دون أن ينتهي فعلاً. يبدو أن المشروع الشخصي أو الجماعي يظل دائماً معلّقًا - مؤجّلاً، مُهّرجاً، مذابًا في اللحظة.
وباختصار، لم يكتشف عصرنا اللانهاية، لكنه غيّر معالمها: ما كان سابقًا دافعاً للرغبة أو طريقًا للحكمة أصبح اليوم شكلًا اجتماعيًا للاضطراب، أسلوبًا ليكون الفرد معرضًا لكثرة الإمكانات، بدون راسخ دائم.
لكن هذه اللانهاية الجديدة - وإن كنا نشعر بها كدوار - يمكن قراءتها أيضًا كفرصة: انفتاح نحو أشكال أخرى من المعنى، من السرد، من الانتماء. وهذا ما سنتقصّاه في الأقسام التالية، بالاقتراب من الجسد، واللغة، والذات.
3- اللغة، الجسد، الذات: مواقع حساسة للانتهاء
اللانهاية ليست مجرد مفهوم أو ظاهرة اجتماعية. إنها تسكن أفعالنا اليومية، لغاتنا الناقصة، علاقاتنا المتمايلة، صمتنا. لها نسيجها وحرارتها. نحسّ بها، ونعيشها.
اللغة الأجنبية وتمتمة الذات
الكثير من ذواتنا المعاصرة تقوم في سياقات متعددة اللغات، مستعمرة، مهاجرة، راحلة. يصبح الكلام آنذاك عبورًا: الكلمة الدقيقة دائمًا في حاجة إلى البحث، إلى الترجمة، إلى الخيانة. نسكن لغات عديدة، لكن لا لغة تؤوينا تمامًا.
الجسد كجزء
يحمل الجسد أيضاً اللاانتهاء: في تحوّله المستمر، وفي جروحه، وفي تحوّلاته. لا يكون "مكتملًا" تمامًا أبدًا. في المجتمعات الحديثة، يُعرض الجسد، يُعاد اختراعه، يُعدّل، لكن أيضًا يواجه المعايير، والمقارنة، وعدم الرضا.
هويات النوع، والانتقالات الجندرية، وتجارب المرض أو الإعاقة، تطرح سؤالًا عميقًا عن فكرة "جسد مكتمل". على العكس، يصبح الجسد مكان المرور، ورواية غير مكتملة، وإعادة تشكيل. يتحدّث بطرق أخرى، من خلال الصور، والإحساسات، والثغرات.
في بعض الأداءات الفنية أو الطقوس (الصوفية، الرقص المعاصر، الوشم، المسرح الجسدي)، يُؤكّد اللاانتهاء الجسدي كقوة: جسدٌ يرتجف ويشك، ينفتح على المجهول.
الارتباط: دائماً أكثر من اللازم أو غير كافٍ
وأخيرًا، المجال الذي نُصدم فيه بـ اللاانتهاء هو مجال العلاقات الإنسانية. يؤلمنا وينقذنا.
الحب يولد من نقص، ويموت غالبًا من فرط. تُبنى الصداقة في تقطع مستمر. العائلة، في تناقل غير كامل.
ليس هناك من علاقة تكتمل أبدًا: إنما تبقى سردًا معلّقًا، مليئًا بالتوقعات والالتباسات.
هنا أيضًا، اللاانتهاء ليس فقط عنفًا، بل قد يكون هو الشكل الذي يأخذه كل رابط حي، كل غربة واختلاف. عندما نبرم كل شيء ونوقفه ونختمه، لا تبقى لا رغبة ولا حوار.
اللغة، الجسد، الصلة: هذه المواقع الثلاثة، التي نسكنها يوميًا، هي أيضًا المختبرات الكبرى لعدم الاكتمال. باستكشافها يُفهم أن اللاانتهاء ليس فقط حالة تُحتمل، بل شكلٌ من الانتباه لما يختلج، لما ينفلت، ما قد يحدث.
4- فنّ عدم الإتمام: جماليّات التّجزئة والأشكال المفتوحة
في تاريخ الفن، هناك افتتان دائم بما لا يكتمل. بعض التحف الفنية بقيت غير منجزة دون أن يقلّل ذلك من قوّتها؛ بل على العكس، يصبح النقص جزءًا من غموضها، من جمالها.
-
الجزء المبتور كلغة
كان فنانو اليونان القديمة ينحتون أجسادًا مثالية — لكن غالبًا ما تكون التماثيل المكسورة، والوجوه المتآكلة، المعروضة في المتاحف، هي التي تهزّنا أكثر من غيرها. ما ينقص يُبرز ما تبقّى.
الجزء المجتزأ يشدّ النظر، ويوقظ الرغبة في التخيّل، في الإتمام ذاتيًا. إنّه يفتح فضاءً للإسقاط، بدلًا من أن يُغلق المعنى.
هذه الجمالية القائمة على الجزء الناقص نجدها في الشّعر الرومانسي الألماني (شذرات نوفاليس أو شليغل)، كما نجدها في الكتابة المعاصرة: رولان بارت (شذرات من خطاب في الحب)، مارغريت دوراس (الحب)، أو حتى آني إرنو (السنوات)، التي تكتب ذاكرةً جماعيةً على شكل مشاهد متفرّقة.
لدى هؤلاء، يصبح اللاإتمام تنفّسًا، طريقةً لاحترام ما لا يُقال، لترك المجال للآخر، لنظرته، لقراءته. -
العمل المفتوح والكتابة غير المكتملة
تحدّث أومبرتو إيكو عن "العمل المفتوح": شكلٌ فني لا يُغلق، يرحّب بالتأويل، بإعادة الاختراع، بالمشاركة.
كافكا سيّد هذا الانفتاح: رواياته غير المنجزة (القلعة، المحاكمة) ليست فشلاً ما، بل متاهات من المعاني، مرايا للعالم الحديث، حيث الانتظار، والغموض، والتعليق، جزء من الحقيقة المعيشة.
أمّا عند صموئيل بيكيت، فالصمت، والتكرار، والإلحاح، هي أشياء تعبّر عن استحالة النهاية.
وعند ف. ج. زيبالد، الاستطراد، والصورة، وغياب الحبكة المتواترة، كلّها تحفر اللاإتمام في نسيج السرد ذاته.
حتى اليوم، يختار الكثير من الفنانين أشكالًا متقطّعة، هشّة، مفكّكة، تعبّر عن عالم لم يعد فيه السرد الموحدّ ممكناً — أو لم يعد صائبًا. هذه الأشكال تحترم الفوضى، والتردّد، والذاكرة المثقوبة. -
أخلاقيّات الثّغرة
في المسرح المعاصر، كما في بعض الممارسات البصرية أو الراقصة، يُعدّ اللاإتمام فعلاً مقصودًا: ألّا يُقال كلّ شيء، ألّا يُعرض كلّ شيء، هو أن يُترك مجالٌ للمُشاهد، للإصغاء، للمفاجأة.
لم يعد الفنّ تسليماً للمعنى، بل تجربة مشتركة للفراغ: لا فراغ عقيم، بل فراغ خصب، قد يولد فيه شيءٌ ما.
كما كتب الشاعر بول فاليري: "العمل لا يُتمم أبداً، بل يُتْرَك."
فماذا لو لم يكن هذا القول تعبيرًا عن كآبة، بل عن ثقة؟
أن تترك العمل، هو أن تهديه، أن تجعله مخترقًا، منفتحًا على الآخر، على المستقبل.
في المحصّلة، اللاإتمام في الفن ليس ما ينقصه، بل ما يظلّ ممكنًا.
إنه لا يدعونا إلى الختام، بل إلى الاستمرار بشكل مختلف، إلى التفكّر، إلى الإحساس، إلى الخيال.
السكن في اللّااِكتمال
ماذا لو، بدل أن نخشاه، تعلّمنا أن نسكن اللّاإتمام؟ لا باعتباره قدراً أو نقصاً، بل شكلاً من الحضور في العالم، وطريقةً في أن نكون في تحول مستمر، قيد التشكّل، على حافة كينونتنا.
اللّااِكتمال المعاصر، الذي تفاقم بفعل السّرعة، والتشتّت، وهشاشة العلاقات، قد يبدو مربكًا، مهّدًا للدوار. وقد يولّد شعورًا بالتبعثر، بل بالعجز. لكنّه أيضًا علامة على عصر يبحث عن الانفتاح، عن إعادة الابتكار، عن سرديّات متعدّدة. إنّه يُجبرنا على التخلّي عن وهم السيطرة الكاملة، عن الوضوح التّام، عن الاكتمال المطلق.
وربّما تكمن هنا فرصتنا: أن نعيد تعريف علاقتنا بالزمن، بالآخر، بأنفسنا.
اللّاإتمام يفتح باب الحوار. يتيح إمكانيّة الفن. يمنح المجال للأخلاق. فحيث يُغلق كل شيء، لا يمكن أن يحدث شيء. وحيث يكتمل كل شيء، لا مجال للتحوّل.
أن نسكن اللّااِكتمال يعني أن نغيّر نظرتنا.
ألا نبحث عن نهايةٍ مريحة كأفق، بل أن نتجذّر في الحركة، في "ما يكاد أن يكون"، في الانفتاح. أن نصغي إلى صمت اللغة. أن نحسّ بما يقوله الجسد وهو يلامس حدوده الخاصة. أن نعيش العلاقات كتركيبات جارية، لا كأشياء جامدة. أن نبتكر أشكالًا فنية لا تُهيمن على الواقع، بل ترافقه في ارتجافاته.
وربما تكون هذه هي مهمّتنا الجديدة:
أن نتعلّم كيف نجعل من النقص موضعًا للانتباه، ومن الفراغ فضاءً للخلق، ومن اللّااِكتمال أسلوبًا في الوجود.