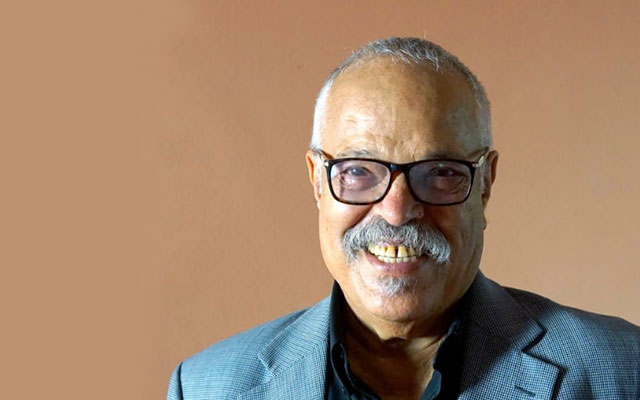كان للتحليل النفسي الفضل في التنبيه بأن كل ما يصدر عن الفرد من حركات وكلمات وتصرفات لا يتم اعتباطا، فهو، حتى إن بدا أنه من الأفعال "التافهة" التي لا معنى لها، فإنه ينطوي على دلالات، ويصدر عن دوافع، ويهدف إلى غايات.
تلك حال فلتات اللسان وزلات القلم وأفعال النسيان، وكل ما كشف عنه أصحاب التحليل النفسي ابتداء من المؤسس فرويد، وخصوصا في كتابه "علم النفس المرضي للحياة اليومية"، إلى دانيال سيبوني في كتاباته حول اليومي. سنجد امتدادا لهذا الانشغال باليومي فيما بعد عند بعض الفلاسفة وعند أصحاب السيميولوجيا وعلماء الاجتماع، نذكر من بينهم فالتر بنيامين في "طريق وحيد الاتجاه"، وميشيل دوسيرتو في "ابتداع اليومي"، وأمبرتو إيكو في "حرب الزيف"، وكذا في كتابات الفيلسوف المعاصر سلوتردايك.
هذا الاهتمام باليومي استلزم نقل فعل التفلسف من المنابر الأكاديمية، وزحزحته من مواقعه المعهودة، وموضوعاته المستهلكة. ذلك أن ما حصل بالفعل هو أن الفلسفة ذاتها وقعت في مصائد نصبتها لنفسها، فغدت سجينة تاريخها وأكاديميتها. ولعل الفيلسوف الذي أبرز هذه المسألة بكل وضوح هو جيل دولوز الذي كتب: إن "تاريخ الفلسفة أخذ يعمل كسلطة في الفلسفة، بل وحتى في الفكر. فهو قد لعب على الدوام دورا قمعيا: كيف يمكنكم أن تفكروا من غير أن تكونوا قرأتم أفلاطون وديكارت وكانط وهايدغر، وكذا كتاب فلان أو فلان عنهم؟ إنها مدرسة جبارة للتخويف تنتج أخصائيين في الفكر، لكنها تعمل أيضا على أن يمتثل من يظلون خارجها أقوى امتثال لهذا التخصص الذي يسخرون منه. لقد تشكلت تاريخيا صورة عن الفكر تدعى فلسفة، تحول بين الناس والتفكير".
في نهايات أربعينات القرن الماضي، شهدت فرنسا على وجه الخصوص، نوعا من اليأس من تاريخ الفلسفة حيث وعى الفلاسفة، كما كتب دولوز، أنهم كانوا سجيني تاريخ الفلسفة، وأنهم كانوا، على حد تعبيره، "ككلاب صغيرة، تتهافت وراء نزعة مدرسية سكولائية أدهى من تلك التي عرفتها القرون الوسطى".
هذه الإشارة إلى دوغمائية القرون الوسطى ووثوقيتها، وإلى تحويل الفكر إلى معرفة وتحصيل، هي التي كانت ربما وراء اليأس من "جدية الفلسفة"، أو، على الأقل، اليأس من سجن تاريخ الفلسفة، والخروج منه بحثا عن لغة أخرى، وطرقا لموضوعات أخرى، على منابر أخرى.
تبينت الفلسفة أنها بدل أن تقوم "ضد..."، صارت تعمل "وفق متطلبات الوضع القائم"، وسرعان ما تحولت إلى "معرفة" فلسفية، و"لغة رسمية لدولة خالصة" تعمل على تقديس أصنام الفكر، و"أسطرة" المعاني، وجرها نحو الثبات والإطلاق، وإسنادها إلى سلطات معرفية، وأوثان جديدة، كي تنسى اعتباطيتها، وتزعم الضرورة والكلية، وسرعان ما كانت تسكن السلوكات اليومية والتصرفات "العادية"، فتسعى نحو الترسخ والمحافظة والتقليد.
ضد هذا التكريس، قام اتجاه مضاد يرى أن مهمة الفلسفة هي التصدي لهذه "الأسطرة"، والأسطرة الذاتية قبل كل شيء، لفضح لعبة توليد المعاني وسعيها نحو الترسخ، مقاومة للبلاهة، وانفصالا عن الدوكسا، وفضحا للأوثان الفكرية.
لا يعني ذلك مطلقا إهمالا للفلسفة وتاريخها. ذلك أن طبيعة الموضوعات التي سيعرض لها هذا النوع المستحدث من الأبحاث فرضت التمسك بطرق قضايا الفلسفة الشائكة ولكن من غير حاجة إلى اقتحام أبواب تاريخ الفلسفة التقليدي واستعراض تأويلاته، والضياع بين نصوصه، والغرق في بحر المفهومات المجردة والمصطلحات التقنية، وإنما بالاكتفاء بالنهل من معين اليومي ومتابعة مخاضه. ما يعني أن هذا الهروب من التاريخ التقليدي للفلسفة، وهذا التعقب لليومي في شتى مظاهره، لم يكن هروبا من التاريخ ذاته، ولا نفيا للزمان التاريخي.
لعل أشهر من دشن هذه الردة في فرنسا هو السيميولوجي رولان بارت الذي جمع مقالات كان نشرها في الصحف، في كتيب يحمل عنوانا دالا هو "ميثولوجيات" أو "أسطوريات".
لا ينبغي أن ينقلنا عنوان كتاب بارت إلى الأسطرة بمعناها التقليدي، فليست الأسطورة هنا "حكايات الخوارق"، وهي لا تتحدد بموضوعها، وإنما بطريقة تناولها لذلك الموضوع. إنها منظومات تضمر تمثلات ذهنية جماعية. وما تسعى السيميولوجيا إلى أن تكشفه هو ما تنطوي عليه هذه المنظومات الدالة التي ترمي إلى أن تجعل من ثقافة طبقة بعينها طبيعة كونية. ذلك أن الأسطرة هنا هي تلك الآلية التي تسعى إلى أن "تحول الثقافة إلى طبيعة".
لذا، حاول بارت إعمال الفكر "في بعض أساطير الحياة اليومية"، والبحث عما "ليس يوميا في الحياة اليومية"، ووضع اليد، فيما وراء ما يبدو طبيعيا، على التاريخي الذي يعتمل خلفه. إنه إذا بحث عن التاريخ في ما يعلق بالأسطورة، أي، تحديدا، في ما يحاول الانفلات من الزمن التاريخي، بحث عن الزمني في ما ينحو نحو السرمدي.
ها هنا تبرز مهمة نقد مغاير لا يقتصر على الثقافة كإبداع وأشكال سامية، وإنما يتصيدها في أتفه تجلياتها، ويضبطها وهي تعمل قبل أن تصوغ نفسها في مفاهيم مجردة وأشكال راقية رفيعة، كي يتعقب "ما ليس يوميا في الحياة اليومية".
على هذا النحو، عندما تنصب الفلسفة على اليومي، وعندما تغدو نوعا من "سيميولوجيا الحياة اليومية"، عندما تولي اهتمامها إلى الصحافة والملبس والرياضة والمأكل والمشرب والإشاعة والإشهار والكليب... فذلك سعيا وراء الفصل بين "الطبيعة والتاريخ"، بحثا عن التاريخي في الميثولوجي، وعن الجديد في المستجدات، وعن الغرابة في الألفة.
قد يقال إن هذا لا يتطلب إعمال فكر عميق، وإنه أقرب إلى انشغالات الصحافة، أو اهتمام رجال السياسة، وفي أقصى الأحوال فهو أقرب إلى النقد الأيديولوجي. يلاحظ صاحب "أسطوريات" أن هناك أشكالا ثقافية "تخترق" حياتنا اليومية من غير أن تستغرقها السياسية ولا حتى الأيديولوجيا. لذا فهي تعيش في مأمن من نضال السياسي، وفي حمى من نقد المحلل الأيديولوجي. وعلى رغم "تفاهة" هذه الأشكال، فإنها تشكل مجتمعة ما يدعوه صاحب "أسطوريات" "الفلسفة العمومية" التي تغذي طقوسنا وشعائرنا اليومية، و"تحدد" لباسنا وحلاقة شعرنا، وتنظيم مطبخنا وحفلاتنا، وتدبير شؤوننا الاعتيادية بما فيها من قراءة للصحف وارتياد للمسارح ودور السينما، وتجاذب أطراف الحديث عن أحوال الطقس وأخبار الإجرام والرياضة.
ما تعمل عليه الحياة اليومية وما تكرسه "الفلسفة العمومية" هو أسطرة هذه المعاني، و"إخراجها" من التاريخي، وجرها نحو "السرمدي". ومهمة "فلسفة اليومي" هي التصدي لهذه "الأسطرة"، وفضح لعبة توليد المعاني، وسعيها نحو الترسخ، انفصالا عن بادئ الرأي واستعادة للزمن الفعلي.
عن مجلة : المجلة