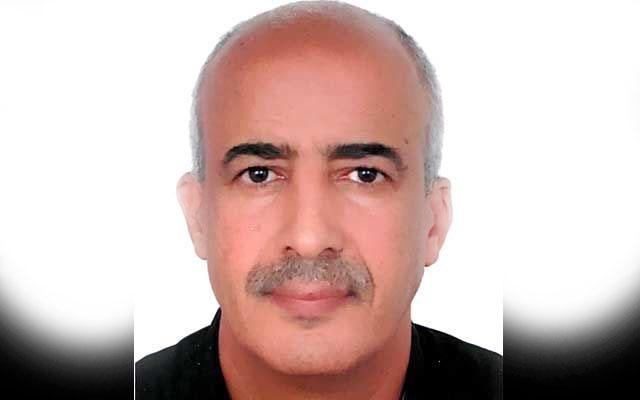وها قد بدأ العد العكسي بالنسبة للمنتجات المحلية كي تدرج في منظومة الاحتفاء الموسمي المتكرر.
وليس الأمر هنا مجرد انطباع عابر، بل يقين مؤسس على تجارب متراكمة وشواهد ميدانية لا يمكن تجاهلها. فكل المبادرات والمهرجانات والمعارض التي ترفع شعار “التنمية المستدامة” و“تنشيط الاقتصاد المحلي باتت، في أغلبها، تتحرك داخل حلقة مغلقة من التكرار الشكلي، حيث يعاد إنتاج نفس الخطاب التنموي دون أن يلمس أثر فعلي على حياة المنتجين الحقيقيين خصوصا في المناطق القروية التي تقوم عليها الفلاحة الصغيرة والصناعة التقليدية.
وليس الأمر هنا مجرد انطباع عابر، بل يقين مؤسس على تجارب متراكمة وشواهد ميدانية لا يمكن تجاهلها. فكل المبادرات والمهرجانات والمعارض التي ترفع شعار “التنمية المستدامة” و“تنشيط الاقتصاد المحلي باتت، في أغلبها، تتحرك داخل حلقة مغلقة من التكرار الشكلي، حيث يعاد إنتاج نفس الخطاب التنموي دون أن يلمس أثر فعلي على حياة المنتجين الحقيقيين خصوصا في المناطق القروية التي تقوم عليها الفلاحة الصغيرة والصناعة التقليدية.
فمنطقة سوس ماسة، على سبيل المثال تشهد خلال السنوات الأخيرة حركية ملحوظة في تنظيم التظاهرات ذات الطابع التنموي أو الثقافي أو التجاري...ورغم أن هذه المبادرات تقدّم كجزء من الدينامية الجهوية الجديدة الرامية إلى تثمين الموارد المحلية، فإنّ المتأمل في نتائجها يجد أن المنتجين والفلاحين والصناع التقليديين يظلون في الهامش، خلف الواجهة، بعيدين عن دوائر القرار والتمويل والتأثير.
إنهم أصحاب المنتوج... لكن ليسوا أصحاب الكلمة!
تبدو المفارقة واضحة: المشاريع تقام باسمهم، الدعم يعلن لصالحهم، لكنهم في النهاية لا يجنون من الحدث سوى لحظة حضور رمزي، سرعان ما تنتهي بانتهاء الافتتاح الرسمي...
وخلف تلك الصور التي توثّق “النجاح” يتكشّف واقع مختلف:
فراغ مؤسسي يمتد لشهور، غياب للمواكبة، وانقطاع لأي عملية تقييم أو قياس للأثر...!
فراغ مؤسسي يمتد لشهور، غياب للمواكبة، وانقطاع لأي عملية تقييم أو قياس للأثر...!
وكأن الدورة التنموية تختزل في حدث إعلامي موسمي، ثم تطوى صفحته حتى موعد الموسم القادم.
هذه الإشكالية ليست استثناء محليا، بل تندرج ضمن ما يسميه أنطونيو إسكوبار بـ “التنمية الاستعراضية” أو “الاستعراض التنموي”، حيث يتحوّل الفعل التنموي إلى خطاب وصورة، بدل أن يكون عملية تراكمية تمس حياة الأفراد.
فحين تستبدل الأهداف البنيوية بالمخرجات الظرفية، يصبح التركيز على ما يمكن تصويره أكثر من التركيز على ما يمكن بناؤه.
فحين تستبدل الأهداف البنيوية بالمخرجات الظرفية، يصبح التركيز على ما يمكن تصويره أكثر من التركيز على ما يمكن بناؤه.
من جهة أخرى، لا يمكن فصل هذه الظاهرة عن التقاطعات السياسية والمؤسساتية التي تجعل بعض المبادرات التنموية مجالًا لتبادل الشرعية بين الفاعلين المحليين والجهات الممولة أو المنتخبة.
وفق ما يذهب إليه بيير بورديو (1994)، فإن “العمل الرمزي” كثيرًا ما يُستثمر لإنتاج رأس مال سياسي جديد، إذ تستخدم المشاريع المحلية كوسيلة لإعادة إنتاج النفوذ، لا لتحقيق التمكين الاقتصادي.
وبذلك تصبح المبادرات التنموية وسيلة لتعزيز الظهور السياسي بدل أن تكون رافعة لتقوية القدرات المجتمعية.
انا بالنسبة للنتيجة فهي مجرد نوع من انواع التحوير الوظيفي للمفهوم الأصلي للتنمية:
من مشروع يهدف إلى تحرير الإنسان من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية... إلى آلية رمزية لتوزيع الحضور والمكاسب الاعتبارية بين الوسطاء.
تدار المبادرات كملفات مؤقتة لا كمشاريع مستمرة، ويُقاس نجاحها بمدى الاهتمام الإعلامي لا بمدى التحول الاقتصادي.
من مشروع يهدف إلى تحرير الإنسان من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية... إلى آلية رمزية لتوزيع الحضور والمكاسب الاعتبارية بين الوسطاء.
تدار المبادرات كملفات مؤقتة لا كمشاريع مستمرة، ويُقاس نجاحها بمدى الاهتمام الإعلامي لا بمدى التحول الاقتصادي.
أما الفلاحون و المنتجون، فهم يواجهون واقعا مغايرا تماما:
غياب التكوين العملي والمواكبة التقنية، صعوبة النفاذ إلى الأسواق، هشاشة الأطر التنظيمية وضعف وصعوبة التمويل البنكي والتعاوني.
كل هذا يجعلهم خارج الدورة الاقتصادية التي يفترض أن تكون موجهة نحوهم.
إنهم الحلقة الأولى في الإنتاج، لكن الحلقة الأخيرة في الاستفادة.
غياب التكوين العملي والمواكبة التقنية، صعوبة النفاذ إلى الأسواق، هشاشة الأطر التنظيمية وضعف وصعوبة التمويل البنكي والتعاوني.
كل هذا يجعلهم خارج الدورة الاقتصادية التي يفترض أن تكون موجهة نحوهم.
إنهم الحلقة الأولى في الإنتاج، لكن الحلقة الأخيرة في الاستفادة.
في هذا السياق، تشير دراسات التنمية التشاركية (Chambers, 1997; Mansuri & Rao, 2013) إلى أن تمكين الفاعل المحلي يمر عبر إشراكه الفعلي في التخطيط والتنفيذ والتقييم، لا عبر تمثيله الرمزي في الافتتاحيات.
كما توضح دراسات الاقتصاد التضامني (Ostrom, 1990; Duflo et al., 2012) أن استدامة المشاريع ترتبط بإعادة توزيع القيمة المضافة داخل التراب المحلي، وتثمين العمل الجماعي، وتحييد الوساطة غير المنتجة التي تستنزف الموارد دون أثر حقيقي.
كما توضح دراسات الاقتصاد التضامني (Ostrom, 1990; Duflo et al., 2012) أن استدامة المشاريع ترتبط بإعادة توزيع القيمة المضافة داخل التراب المحلي، وتثمين العمل الجماعي، وتحييد الوساطة غير المنتجة التي تستنزف الموارد دون أثر حقيقي.
لكن غياب آليات التتبع والتقييم طويلة المدى يعمّق الفجوة.
فما إن ينتهي الحدث حتى يبدأ عام كامل من الفراغ و السكون التنموي، لا يتغير فيه شيء في البنية الإنتاجية أو السوقية.
الزمن السياسي سريع، والزمن الفلاحي بطيء، والزمن الإداري متثاقل؛ وبين هذه الأزمنة الثلاثة تتآكل فرص التمكين...!!!
الزمن السياسي سريع، والزمن الفلاحي بطيء، والزمن الإداري متثاقل؛ وبين هذه الأزمنة الثلاثة تتآكل فرص التمكين...!!!
إن تجاوز هذه الإشكالية يتطلب مقاربة جديدة تُعيد توجيه الجهود نحو الأثر لا الحدث وتفصل العمل التنموي عن التوظيف السياسي.
ويبدأ ذلك من خلال:
إعادة هيكلة تمويل المبادرات ليُوجَّه نحو سلاسل القيمة والتسويق المحلي بدل النفقات التنظيمية.
إرساء آلية تقييم سنوية مستقلة تُقيس النتائج الملموسة لا الأنشطة المنجزة.
تحييد العمل التنموي عن الصراعات السياسية والانتخابية عبر إطار حكامة محايد ومبني على مؤشرات واضحة.
تحويل الفلاح من مستفيد سلبي إلى فاعل رئيسي في اتخاذ القرار، من خلال مجالس محلية أو تعاونيات ذات صلاحيات فعلية.
وأخيرًا، الانتقال من ثقافة التكوين السريع إلى ثقافة المواكبة الميدانية المستمرة.
إن التنمية ليست وعدا يلقى ولا شعارا يرفع...
هي سيرورة بطيئة لكنها حقيقية، تتطلب حضور الإنسان في الميدان لا حضوره في الصورة فقط...
فما دمنا لم ننتقل من منطق التجميل المؤسسي إلى منطق البناء الاجتماعي، ستظل المبادرات التنموية أشبه بعناوين جميلة على جدران لا تحمل مضمونا.
فالتمكين ليس حدثا يحتفى به،د بل مسارا يصنع بتواضع و في صمت الحقول… هناك، حيث يبدأ كل شيء، وحيث يجب أن تعاد كتابة المعادلة من جديد: من أجل الفلاح أولا، لا من أجل المشهد والمصلحة الخاصة...
بضعة أيام وسنرى نمودج حي من المبادرات الجهوية المصلحجية التي كانت ولا زالت تبني مجددها على ركام هوية في طريقها الى الانذثار...
نادية واكرار، باحثة في التنمية والتواصل المؤسساتي.