
عبد السلام بنعبد العالي: ما الذي يريد الغرب فهمه عن "الفلسفة الأفريقية؟"
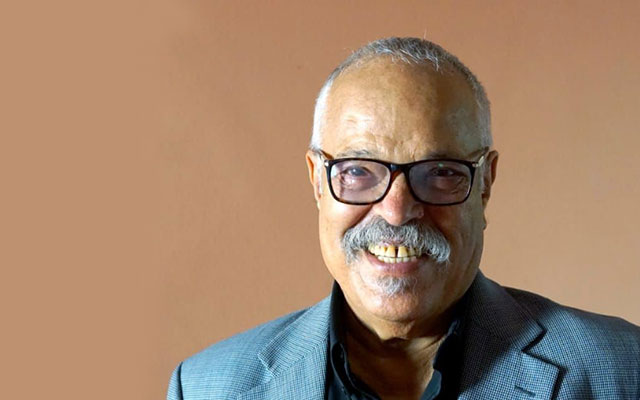 عبد السلام بنعبد العالي
عبد السلام بنعبد العالي 
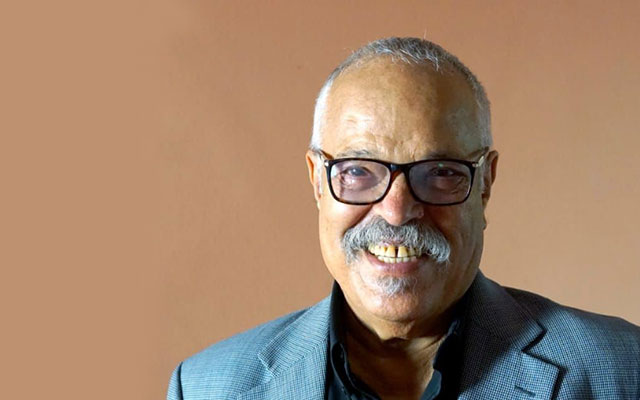 عبد السلام بنعبد العالي
عبد السلام بنعبد العالي الفكر المطالب بأن يبقى داخل أسواره
بداية، أستأذن القارئ في أن أنقل إليه تجربة رسخت عندي سؤالا لم أنفك أطرحه على نفسي يتعلق بما يمكن أن نطلق عليه "فلسفة أفريقية".
دعيت إلى المشاركة في ندوة فكرية أقيمت بهولندا تحت عنوان "الآخر وفكر الاختلاف". وكانت الندوة بالفعل فضاء للاختلاف بأكثر من معنى: اختلاف وجهات النظر المعروضة في طبيعة الحال، لكن، أساسا، اختلاف المدعوين، وتنوع مشاربهم وأوطانهم وجنسياتهم ولغاتهم، وإن كانت العروض ألقيت باللغة الفرنسية، إلا أن كلا من المتدخلين كان، في طبيعة الحال، يغذي فرنسيته بلغته الأم.
غير أن الأمر لم يقف، بالنسبة إليّ، عند هذا الحد، فقد كانت الندوة تجربة اختلاف عميقة، أو على الأصح "صدمة" اختلاف لا تخلو من مرارة.
ترددت كثيرا في اختيار موضوع بحثي. ما خطر في بالي أول الأمر، هو أن استدعائي كان، ولا شك، بقصد تنويع التجارب المعروضة في الندوة، والحديث عن تجربة الآخر من خلال منظور أفريقي -عربي إسلامي-ثالثي عاش تجربة الاستعمار والاحتكاك بالأجنبي، ويعيش تجربة مخلفات ذلك الاستعمار، ومحاولات التحديث... إلا أنني فضلت تناول موضوع نظري صرف كان يشغلني وقتئذ يتعلق بما آل إليه "مفهوم التناقض والجدل عند مفكري الاختلاف". ترددت كثيرا قبل الحسم في المسألة. وقلت في نفسي: إنهم ليسوا في حاجة إلى مثلي ليحدثهم عن قضايا الفلسفة المعاصرة، فهم معلمونا في هذا المجال. لكنني بررت المسألة بكوني سأتناول الموضوع بشكل تركيبي أربط فيه بين أسماء مفكرين ما عهدنا الربط بينهم، فضلا عن أن طبيعة موضوع الندوة نفسه كانت تستدعي إعمال الفكر في مفهوم "الاختلاف" نفسه، خصوصا أن كثيرا من الدول الأوروبية تروج، عمليا، لما يسميه الخطيبي "الاختلاف المتوحش".
خالجني بعض الاطمئنان عند بداية الندوة عندما تبينت أن الجميع تقريبا، يتحدث عن الفكر الفرنسي المعاصر. صحيح أن المساهمين الألمان كانوا يوظفون تراثهم الفلسفي الذي يعتبر مصدر الإشكالية المطروحة، إلا أنهم، حتى هم أنفسهم، كانوا يعرجون على مفكريهم عبر فكر "آخر"، عبر فوكو ولاكان ودريدا الذي تكرر اسمه كثيرا خلال الندوة.
والغريب أن فرنسا نفسها لم تكن ممثلة في الندوة إلا من طرف فلاسفة ذوي أصل غير فرنسي، وإن كانوا يدرسون في فرنسا ويكتبون بلغتها، أحدهم إغريقي والآخران من أوروبا الشرقية.
فكر آخر
كنا إذن في السلة سواء، وكان لكل منا آخره. الجميع، حتى أهل الدار من المشاركين الهولنديين، كان يتحدث عن "فكر آخر"، وبالتحديد الفكر الفرنسي. ولم يكن يشذ عن هذه القاعدة إلا أحد المساهمين الأفارقة الذي كان يدرس في إحدى الجامعات الألمانية، والذي فضل أن يتحدث عما دعاه "تاريخ الفلسفة في أفريقيا". ما أثار انتباهي، وربما قليلا من الغبطة، هو الاهتمام الشديد الذي لقيه العرض الذي قدمه، والنقاش المهم الذي أعقب تدخله، خصوصا في النقطة التي تحدث فيها عن فعل الكون وغيابه عند بعض اللهجات الأفريقية.
تحولت الندوة، بالنسبة إليّ، إلى نوع من التباري بين تأويلين متباينين لما يمكن أن يسمى "فلسفة أفريقية"، وما يمكن أن ينتظر من الانفتاح على الكونية: وجهة نظر الزميل الأفريقي، وجرأتي أنا على الانفتاح على الكونية.
عدا ملاحظة الفيلسوف الفرنسي-الإغريقي الذي أثنى على قدرتي التركيبية (وهو كوسطاس أكسيلوس)، لم يلق العرض الذي قدمته اهتماما كبيرا. أشعرني الجميع بأن ما تناولته ليس هو ما كان منتظرا مني، فكأنني حشرت نفسي في ما لا يعنيني، إذ كان من الأفضل، على الأقل، أن أطرق قضية "الآخر والاختلاف" في سياق تراثي الأفريقي-العربي-الإسلامي.
أعترف بأنني ملت أنا أيضا إلى مؤاخذة نفسي. لكنني كنت أرفض، في الوقت ذاته، أن أكون خلال الندوة مجرد عينة من العينات. غير أن ما لم أستطع فهمه جيدا هو مدى الانزعاج الذي خلفه العرض الذي قدمته لدى البعض، وقد أثار ذلك استغرابي لأن موضوع الندوة، ومضمون بعض الأفكار التي راجت فيها، والتي تعرضت لبعض منها، كان يتنافى مطلقا مع رد الفعل ذاك. تساءلت في نفسي: ربما يكون ما قلته عن "الاختلاف الساذج" قد أزعج الأوروبيين. لكن، سرعان ما اتضح لي أن مصدر الانزعاج لم يكن مضمون الأفكار أو منهج عرضها، وإنما اختيار الموضوع.
فلا أحد من المستمعين عارضني في نقطة بعينها، وإنما كان "الرفض" مبدئيا. لقد قبل المشاركون الأوروبيون الاستماع إلى المرجعية الفكرية ذاتها من فم فيلسوف إغريقي يتكلم الفرنسية، لكنه لم يكن ليعطيني أنا الحق نفسه. ذنبي هو أنني لم أحترم "المهمة" التي أناطني بها التاريخ، وهي أن "أمثل" "عينة"، وأجسّد خصوصية. وربما كل القضية هي أنني لم أميز بين خصوصية وأخرى. هناك خصوصية تمتزج بالكونية، صاحبها يتكلم باسم الجميع، باسم الإنسان، عندما يتحدث عن نفسه، ثم هناك خصوصية خاصة لا يمكن أن ترقى إلى مستوى الكونية. فأنا عندما تجاوزت "الحدود المرسومة"، ولم أكتف بتمثيل عينة، وعرض قضايا تاريخية تراثية، والحديث عن المشكل المطروح كما قد يعيشه المنتمون إلى القارة الأفريقية، فتجرأت على الخوض في الفكر المعاصر، وطرق قضايا نظرية، ومناقشة مفاهيم مجردة، عندما سمحت لنفسي بكل هذا، اقتحمت أبواب الكونية. فالمجرد والنظري والمعاصر، يجعلني في مستوى الشمولية، ويضعني ندا لند مع من يستمعون إليّ، وهذا عين المحظور.
ذنبي إذن، وبالضبط في هذه الندوة التي تطرق مسألة "الآخر وفكر الاختلاف"، والتي تتم على أرض هولندا، هو أنني تناسيت أنني هنا "كائن تراثي" حتى لا أقول "عجائبي"، وأن خصوصيتي ليست كخصوصية زميلي الإغريقي، هو يدخل ضمن دائرة الآخر الصغير، أما أنا ففي دائرة "الآخر الأكبر". هو آخر جغرافي فحسب، أما أنا فآخر جغرافي وتاريخي. ربما كان الأولى بي أن أنحو منحى زميلي الأفريقي، فأقدم "عينة" من عينات الفكر واللغة، وأقتصر على الحديث عما هو "عجيب غريب"، فأبقى ضمن أسواري التاريخية، وداخل دائرة الآخر الظريف الطريف.
ليعذر القارئ طول الحكاية، لكنني أعتقد أنها تجسّد، عمليا، مسألة العلاقة بين ما يمكن أن نطلق عليه الخصوصية الكبرى والخصوصية الصغرى. وهي تطرح بشكل ملموس مسألة "الفلسفة الأفريقية"، والدلالة التي يمكن أن تتخذها عند من كانوا في الأمس القريب مستعمرين، وعند من يعيش التردد بين أصالة "مجروحة"، ومعاصرة مقموعة.
ذلك أن السؤال عن إمكان الحديث عن "فلسفة أفريقية" يطرح إشكالا مركبا يتقاطع فيه البعد المعرفي بالبعد التاريخي والثقافي. نعلم أن الفلسفة، كما رسخها التقليد الغربي، تدعي احتكار الكونية، كما نعلم أن اقتحامها للمستعمرات الأوروبية جعل مفهومها ذاته محملا عند الأفريقي إرثا كولونياليا ومعايير مخصوصة للمعقولية والكتابة. ومن ثم، فإن التفكير في "فلسفة أفريقية" يواجه مفارقة مزدوجة: كيف يمكن استعادة فعل التفلسف انطلاقا من تجربة أفريقية مشروطة بالاستعمار واللغات الوافدة، من غير أن يتحول ذلك إلى تكرار للمركزية الأوروبية؟ وهل يمكن الفكر الأفريقي، في معاصرته، أن يؤسس فلسفة تعبر عن الذات الأفريقية وتشتبك في الوقت نفسه مع أسئلة الإنسان الكونية؟ هل نحن، عندما نبحث عن "فلسفة أفريقية"، لا نعمل إلا أن نعيد إنتاج المركزية الأوروبية؟ أم أننا نمارس بذلك مقاومة رمزية فنعيد تحديد الفلسفة انطلاقا من لغات وتجارب مغايرة؟
لا شك أن هدفنا من هذا التحديد هو الانخراط في قضايا عالم اليوم (التكنولوجيا، العنف، العولمة، الاستعمار الجديد...) لكن بلغة تنبع من تجربة أفريقية خاصة، تجربة لغوية، ووجودية. لكن ما الذي يعطي تلك التجربة خصوصيتها، وما الذي يجعل فلسفة بعينها "فلسفة أفريقية"؟ أهي موضوعاتها (الهوية، الاستعمار، العبودية)؟ أم أسلوبها؟ أم تجذرها في اللغات الأفريقية؟ أم هي طريقتها في النظر إلى الإنسان والعالم والزمن، تلك الطريقة التي تغذت على تجربة تاريخية ولغوية لم يتقدم لها مثيل؟
توترات
مهما كان الأمر، فإن الحديث عن فلسفة أفريقية معاصرة لا بد أن يتم في تقاطع توترات كبرى لعل أهمها:
التوتر بين الكونية والخصوصية: الفلسفة تقدم غالبا كخطاب كوني يتجاوز الجغرافيا، لكن التاريخ يبين أنها ولدت وتطورت داخل سياقات محددة، ونسجت مفهوماتها عبر لغات متعددة.
التوتر بين الوعي ما بعد الكولونيالي وإرث الاستعمار المعرفي: الفكر الأفريقي الحديث يعي أنه يفكر بلغات المستعمر (الفرنسية، الإنكليزية، البرتغالية...)، وبمفهوماته، داخل مؤسسات أكاديمية أنشأها المستعمر، فهل يمكن ضمن هذا الإطار إنتاج فكر متحرر يسمى "فلسفة أفريقية؟".
ورغم هذه التوترات، فإن الخروج من هذه التبعية لا يمكن أن يتم برفض الغرب أو إنكار إرثه، وإنما بخلق مسافة نقدية تسمح بإعادة امتلاك أدوات الفكر نفسها، أي تحويل المفهوم من "قالب مستورد" إلى أثر نابع من الوجود الأفريقي كما يتجلى في الذاكرة واللغة والأسطورة واليومي. حينئذ، وحينئذ فقط يمكن أن نتحدث عن فلسفة أفريقية تنتج مفاهيمها الخاصة، وتستعيض عن منطق الاقتباس بمنطق الإنصات إلى الذات والعالم في آن واحد.
يمكننا في هذا الإطار أن نتبنى مفهوم "النقد المزدوج" كما نحته المفكر المغربي عبد الكبير الخطيبي. سيعني هذا المفهوم في السياق الأفريقي، أن الفلسفة الأفريقية لا يمكن أن تتأسس لا على نفي الغرب، ولا على الارتماء في أحضانه، بل على مواجهة حقيقية بين التجربة الأفريقية والميتافيزيقا الغربية. في هذا المعنى يصبح الفكر الذي يصدر من الهامش ليس انصهارا في الكونية الغربية، بل إعادة تعريف للكوني من موقع الجرح الذي خلفه العهد الكولونيالي، والتعبير عن ذلك بلغة تلهج بما يعتمل في الذات الأفريقية.
إذا كانت الفلسفة لا تفكر إلا باللغة، فإن السؤال الأفريقي لا يمكن فصله عن إشكال اللغة التي يفكر بها، بين لغات استعمارية فرضت من الخارج، ولغات محلية تحمل الذاكرة والخيال الجمعي من الداخل. في هذا المعنى، يصبح الإبداع اللغوي فعلا فلسفيا بامتياز، لأن التفكير نفسه يعاد تشكيله في صميم اللغة التي يفكر بها. وهي، كما قال عنها إيمي سيزير: "لغة محرفة: بلا شك. لغة منحرفة: بالتأكيد. لكنها أيضا لغة مشحونة ربما، ومحملة بالطاقة".
حين تجرؤ الفلسفة الأفريقية على الكتابة بهذه اللغات الهجينة التي تحدث عنها سيزير، فإنها لا ترتمي في حضن الآخر، ولا تدافع عن هوية منغلقة، بل تؤسس لتفكير جديد ينشأ من التداخل اللغوي والثقافي، أي من "الترجمة الدائمة" التي هي السبيل الذي لا محيد عنه لبناء فكر مغاير.
عن مجلة: " المجلة "