في زمن كانت فيه الكلمة تقاس بميزان الدم، وكانت الصحافة تمارس بجرأة الشهداء لا بخفة المرتزقة، برز عبد الحميد جماهري كأحد أبرز الأصوات التي جمعت بين النضال والفكر والإبداع، بين الالتزام الوطني والأخلاقي والإنساني وبين الشعر والأدب والسياسة. لم يكن مجرد صحفي يكتب افتتاحيات ساخنة أو مقالات رأي لتمرير المواقف، بل كان مثقفا عضويا بالمعنى الغرامشي للكلمة، يربط بين قضايا الناس ومشاريع التحرر الاجتماعي والفكري، ويجعل من الصحافة منبرا للكرامة قبل أن تكون مهنة للعيش أو وسيلة للشهرة.
عرفناه في تسعينيات القرن الماضي، زمن التحولات الكبرى في المغرب، حين كانت الصحافة الوطنية تحبو نحو الانفتاح، وكان المثقف اليساري يبحث عن توازن صعب بين النقد والوفاء للمبادئ. في تلك المرحلة بالذات، كان عبد الحميد جماهري واحدا من الأصوات التي حافظت على بوصلة اليسار من الانحراف، وعلى وهج الفكرة الاشتراكية من التبدد. كان يكتب بروح المناضل الذي يحمل في قلمه مشروع التحرر، لا مشروع الذات. ومنذ أن بدأ ينشر مقالاته في “الاتحاد الاشتراكي” وغيرها من المنابر التقدمية، صار اسمه مرادفا للكلمة النظيفة، وللقلم الذي لا يساوم.
كان عبد الحميد جماهري مدرسة في الكتابة الهادئة العميقة، لا في الصخب ولا في المزايدات. يكتب كما يتحدث، بهدوء المتمكن، ودفء الصادق، ورصانة من يعرف التاريخ ويستشرف المستقبل. لم يكن يصرخ ليسمع، بل كان يجعل من الفكرة ما يكفي لتخترق جدار الصمت. كانت لغته ناعمة في ظاهرها، لكنها حادة في جوهرها، تتسلل إلى القارئ دون أن تصدمه، وتوقظه من غفلته دون أن تهينه. تلك كانت بصمته التي ميزته عن كثيرين ممن اعتادوا رفع الشعارات الفارغة.
أما على المستوى الإنساني، فكان الرجل تجسيدا للوداعة والأخلاق العالية. دماثة خلقه كانت جزءا من شخصيته العميقة شخصية إنسان الشرق الذي تربى في حاضرة دبدو، لا قناعا اجتماعيا. يلقاك بابتسامة صافية، ويحادثك كأنه يعرفك منذ زمن طويل، حتى وإن التقاك لأول مرة. كان يحترم خصومه قبل أصدقائه، ويؤمن بأن النقاش الفكري لا يدار بالسباب، بل بالحجة والرؤية. لذلك ظل محل تقدير حتى عند من اختلفوا معه سياسيا، لأنه كان صادقا في موقفه، ثابتا في خطه، وفيا لأفكاره.
في العقدين الأولين من الألفية الحالية، حين تهاوت كثير من القيم النضالية تحت ضغط السوق والإعلام التجاري، ظل عبد الحميد جماهري صامدا. لم يتنازل عن دوره كصوت نقدي داخل اليسار وخارجه. كتب عن قضايا الوطن والحرية والعدالة الاجتماعية بنفس الوعي الذي كتب به عن الفساد والانتهازية والتطبيع مع الرداءة. كان يعرف أن الصحافة ليست مهنة الخضوع، بل هي مهنة السؤال، وكان يحسن طرح السؤال في الوقت المناسب، دون أن يهرب من تبعاته.
في كتاباته اليومية، خاصة في عموده الشهير، كان يدمج السخرية الذكية بالتحليل العميق، يجمع بين الرهافة الأدبية والدقة السياسية، فيكتب عن حدث بسيط فيجعله مرآة لمأزق وطني، أو عن موقف عابر فيحوله إلى درس في السياسة والأخلاق. كانت عباراته تحمل بصمة الشاعر، لكن فكرته كانت دائما صلبة، كأنها صيغت من معدن المبدأ. فالشعر عنده لم يكن زخرفا لغويا، بل وسيلة للتعبير عن الأمل، عن الحلم الذي لم يغادره يوما رغم كل الانكسارات.
لم يغيره المنصب ولا الشهرة. بقي هو نفسه، ذلك اليساري المتصالح مع ذاته، المؤمن بالإنسان قبل الحزب، وبالفكر قبل الأيديولوجيا. لم ينزلق إلى المزايدة الشعبوية، ولم يبع قلمه عند أبواب السلطة. بل ظل يكتب كما كان في التسعينيات، بنفس الإيمان بأن الصحافة التقدمية لا تقوم على الولاء بل على النقد، ولا على الإشادة بل على مساءلة الذات. ولعل هذا ما جعل اسمه محفورا في ذاكرة كل من قرأه أو جايله أو عرفه عن قرب.
ولأن عبد الحميد جماهري شاعر أيضا، فقد كان يرى في الكتابة خلاصا من فوضى العالم. كان الشعر عنده موازيا للصحافة في التعبير عن القلق الإنساني، لكنه أكثر صفاء وصدقا. في قصائده، كما في مقالاته، يتجلى الإنسان الذي لا يخجل من ضعفه، والمثقف الذي لا يتعالى على الناس. كتب عن الحب كما كتب عن الوطن، عن الفقد كما كتب عن الأمل، وكأنه في كل مرة كان يكتب سيرة اليسار المغربي في مفرداته الصغيرة.
ومن اللافت أن عبد الحميد جماهري في كتاباته الأخيرة بعد أدائه لمناسك الحج، بدا كما لو أنه عاد من مقام الصفاء وقد تشرب من روح الصوفية ما أضفى على نصوصه بعدا روحيا جديدا. صار يكتب كما يتأمل، وكأن الحرف عنده أصبح تسبيحا، والكلمة وضوءا داخليا يربط بين جوهر الإنسان وخالق المعنى. هذا البعد الصوفي لم يكن انقطاعا عن مشروعه الفكري، بل امتدادا له في بعده الإنساني الأرحب، إذ أضاف إلى نبرة اليسار العقلانية نغمة القلب المتصالح مع ذاته، فصارت مقالاته مزيجا بين التأمل والالتزام، بين الفكرة والسكينة، بين العقل والروح.
من عرفه في الميدان السياسي والإعلامي يعرف أن هذا الرجل كان وفيا لرفاقه حتى آخر لحظة، لا يطعن من الخلف، ولا يتنكر لماضيه، ولا يساوم على المبادئ باسم الواقعية. عاش كما أراد: مثقفا ملتزما، وناقدا حرا، وإنسانا جميلا. لم يكن يبحث عن الأضواء، بل كانت الأضواء تتبعه لأنها وجدت فيه نموذجا نادرا في زمن شحت فيه القامات.
إن الحديث عن عبد الحميد جماهري هو حديث عن جيل كامل من المثقفين الذين جمعوا بين الفكر والموقف، بين النضال والأخلاق، بين الحلم والواقعية. جيل آمن بأن الوطن يبنى بالكلمة الصادقة قبل القرار السياسي، وأن الصحافة ليست سلطة رابعة فحسب، بل ضمير المجتمع. ولذلك سيظل عبد الحميد جماهري علامة مضيئة في تاريخ الصحافة الوطنية، وصوتا من الأصوات النبيلة التي لم تدنس قلمها، ولم تفرط في شرف الكلمة.
إنه باختصار رجل لم تغيره الأزمنة، لأن جوهره كان نبيلا منذ البداية. ظل كما عرفناه في التسعينيات: مناضلا، صحفيا، شاعرا، ورفيقا جميلا. وحين نقرأه اليوم، نكتشف أننا لا نقرأ مجرد كاتب، بل نقرأ سيرة وطن كتبها رجل بمداد الوفاء والصدق والإيمان بالإنسان.

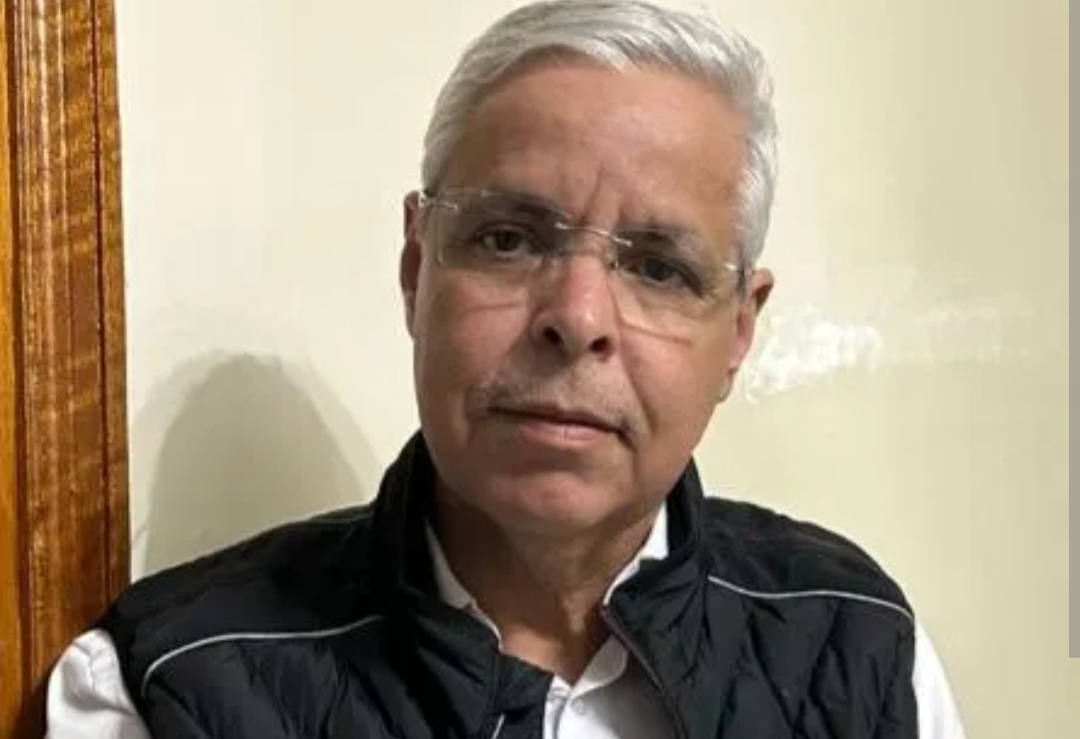 عبد العزيز الخبشي
عبد العزيز الخبشي 
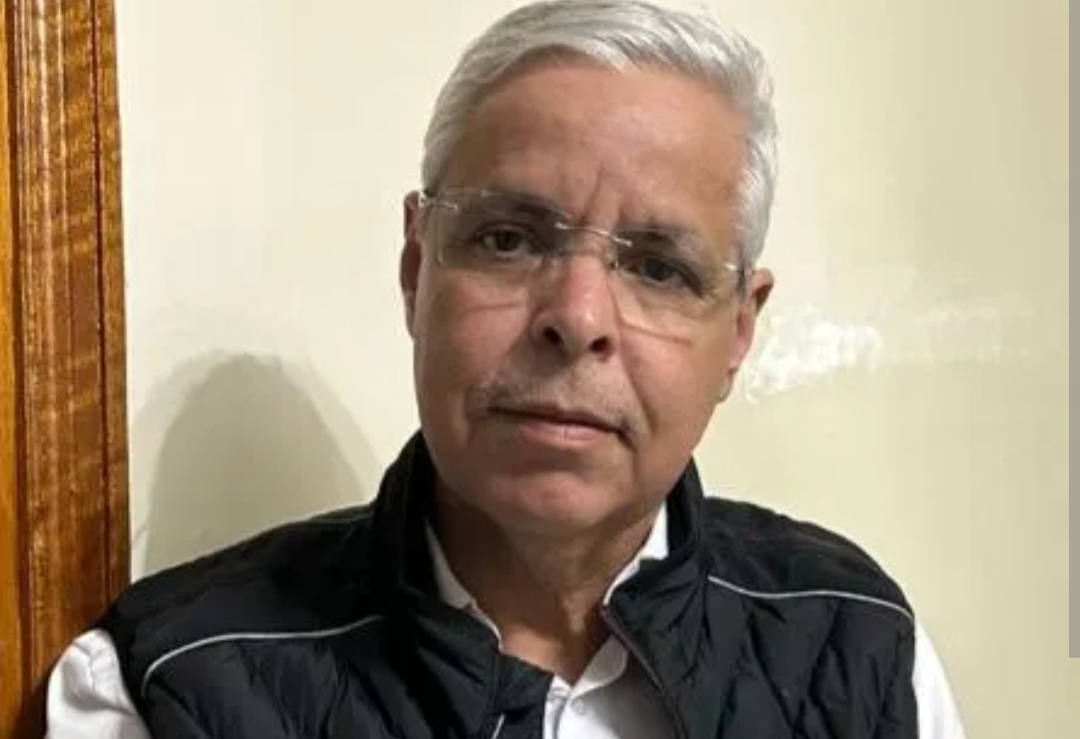 عبد العزيز الخبشي
عبد العزيز الخبشي