شتان ما بين الإسلامَين! الإسلام، كما قدَّمه ويقدِّمه لنا القرآن الكريم، كله لطفٌ واحترامٌ وأخلاق حميدة، وتسامح ورحمة ورأفة ويُسر وحِلم وتساكن وتعايش… وباختصار، الإسلام، كما نصَّ عليه القرآن الكريم، كله قِيَمٌ إنسانية نبيلة تجعل من الإنسان مخلوقا محبوباً عند الله وله قيمة عالية تجلَّت في الآية رقم 70 من سورة الإسراء : "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا".
أما الإسلام، كما جاء في كتب التراث، فهو دينُ عُسرٍ وقهرٍ وترهيبٍ وتخويفٍ وترعيبٍ وحروبٍ وسيوفٍ وقتلٍ وانتقامٍ وتفجيرٍ وظُلمٍ وتعصُّبٍ وكراهيةٍٍ وقطعٍ للأيدي والرؤوس وقسوةٍ ورجمٍ وعذابٍ وتكفيرٍ وتحريمٍ بالجُملة…
وعلى ذكر التَّحريم، من المُلاحَظ أن ما حرمه علماء وفقهاء الدين، عبر التراث الديني، أكثر بكثير مما حرَّمه اللهُ في القرآن الكريم. فكل ما يُخالف عقلِيات علماء وفقهاء الدين، القدامى والحاليين الذين ساروا على نهجِ هؤلاء القدامى، مآلُه التحريم.
كل هذه العيوب les défauts تجعل من الإسلامِ دينَ عنف une religion de violence ou qui prône la violence. بينما الإسلام الحقيقي هو الذي نصَّ عليه القرآن الكريم. السؤال الذي يفرض نفسَه علينا، هنا، هو : "هل الإسلام التراثي (الدين) هو الدين الذي أراده اللهُ، سبحانه وتعالى، للبشرية جمعاء؟
بالطبع وبكل تأكيد، ليس هذا هو الإسلام المنصوص عليه في القرآن الكريم. إنه إسلام صنعَه الكهنوت الديني الذي نصَّب نفسَه صِلَةَ وصلٍ بينه وبين الناس، لكن دون أن يستشيرَهم. بل نصَّب نفسَه عَنوةً، أي فرض نفسَه على الناس. لماذا؟
لأن علماءَ وفقهاءَ الكهنوت، من كثرة ما ألَّفوا من كُتُبٍ في مختلف المجالات الدينية، حوَّلوا الدينَ من عبادة ومعاملات، إلى تخصُّصٍ يُدرَّس في المعاهِد العُليا والكليات، وهم وحدَهم مَن لهم الحقُّ في الحديث عن هذا التَّخصُّص. صحيح أن تدريسَ العلوم الدينية في المعاهد العُليا والكلِّيات له فوائدٌ كثيرة. لا أحد بُعارض التَّعمُّقَ في فهم الدين، لكن دون نشر الفتنة والتفرقة. التعدُّدُ في فهم الدين شيءٌ طبيعي، لكن دون تجاوز ما نص عليه القرآن الكريم من عبادات ومعاملات وأحكام ومحرمات ونواهي، علماً أن هذا القرآن واضحٌ، وضوح الشمس، في هذه الأمور.
وما يٌستغرَب له، هو أن الدينَ، المنصوص عليه في القرآن الكريم، الذي هو الإسلام، دينٌ واحدٌ أوحد، بينما فهمُه وإدراكُه من طرف علماء وفقهاء الدين، عوضَ أن يوحِّدَ الناسَ حوله، زرع بينهم الفتنةَ والتفرقةَ. بمعنى أن الدين تفرَّعَ إلى مذاهب وطوائف وفرق. وكل مذهب وكل طائفة وكل فرقة تدَّعي أن فهمها للدين هو الصحيح. وهذا هو ما دفع علماءَ وفقهاء الدين للتَّنافس في الإنتاج الفكري الديني وفي الإنتاج الفكري الديني المُضادِّ.
وعوض أن يوحِّدَ هذا الإنتاج الفكري الديني المسلمينَ حول القرآن الكريم الذي هو المصدر الرئيسي للدين، فإنه أشاعَ، كما سبق الذكرُ، الفتنة والتفرقة. حينها، أصبح لكل مذهب إسلامُه ولكل طائفة ولكل فرقة إسلامُهما، كما جاء في الآيتين، أسفلَه، رقم 159 من سورة الأنعام ورقم 32 من سورة الروم :
"إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ" (الأنعام، 159).
"مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ" (الروم، 32).
في هاتين الآيتين، واضح أن الدينَ واحد. بل في الآية الأولى، الله، سبحانه وتعالى، يُبرِّئُ الرسول (ص) من أفعالِ الناس الذين "...فَرَّقُوا دِينَهُمْ…" قائلاً له، أي للرسول، "...لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ…"، ثم أخبره بأنه، عزَّ وجلَّ، سيُحاسبهم "...بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ". و واضح، كذلك، في الآيتين، أن الدينَ دبنٌ واحد لا يقبل التَّقسيم. بل لا يقبل التَّفرقة.
لو كان الهدف من الإنتاج الفكري الديني والإنتاج الفكري الديني المُضاد له، يسعيان إلى تقريب الدين من الناس وتبسيطه وتوعية الناس من أجل الانخراط فيه، لكان عملُ علماء وفقهاء الدين عملاً رائعا يُفِيد ويُستفادُ منه. وحتى أهل السنة والجماعة ليسوا على نفس المستوى في فهم الدين وإدراكِ معانيه. وهذا الاختلاف هو الذي أدى إلى ظهور المذاهب الأربعة (الشافعية، المالِكية، الحنفية والحنابلة).
ألم يقل، سبحانه وتعالى، في الآية رقم 103 من سورة آل عمران : "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ".
ما بهمني، في هذه الآية الكريمة، هو أن اللهَ، سبحانه وتعالى، يخاطب المؤمنين، قائلاً لهم: "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا…" الاعتصام هو التَّمسُّك. لكن التَّمسُّك بماذا؟ التمسُّك "بِحَبْلِ" الله، أي القرآن الكريم الذي هو الدين. ويقول، كذلك، عزَّ وجلَّ، "وَلَا تَفَرَّقُوا"، أي لا تجعلوا من فهم الدين سببا في تفرقتِكم. غير أن الإنتاجَ الفكري الديني والإنتاج الفكري الديني المضاد، عِوض أن يوحِّدَ الناس حول حبل الله، فرَّقهم.
والإنتاج الفكري الديني والإنتاج الفكري الديني المضاد شَمِلاَ مجالات واسعة، أذكر من بينها، شعر الزهد وشعر الإيمان والتَّأمُّل (مثلا في الحياة والموت) والقصص الدينية والمفاهيم الفلسفية المستمدَّة من الدين والمفاهيم المُتعلِّقة بالتوحيد والقدر والعدل والشورى، من وجهة نظر إلهية، وعلم الفلك وتحليل النصوص الدينية والفكر السياسي والاجتماعي وتفسير القرآن والحديث والمؤلفات الفقهية الضخمة واستخراج الأحكام الشرعية من القرآن وتوثيق الأحاديث…
وما أختم به هذه المقالة، هو أن هناك فرقا شاسعا بين الإسلام المنصوص عليه في القرآن الكريم والدين المنصوص علية في التراث الإسلامي (أي الإنتاج الفكري الديني والإنتاج الفكري الديني المضاد).
الإسلام المنصوص عليه في القرآن الكريم وكما سبق الذكر، دينٌ فيه رحمة ورأفة ويُسرٌ وتسامح وهداية وتضامن وعفو وعدل ومساواة وكرامة (الإنسان) وسلام وأمن وسعادة وصدق وإلتزام… وكل القيم الإنسانية التي تسير في اتِّجاه التعايش والتساكن في المجتمعات البشرية الإسلامية. بل القرآن الكريم يُعطينا صورةً عن الإله الحقيقي المتسامِح، العَفُوُّ، الغفور، الرحمان الرحيم… المُحبَّ لعبادِه ويريد لهم الخير. وليس الإله القاسي، المُنتظِر عبادَه حتى يُخطئوا ليُعاقبَهم وينتقم منهم.
ألم يدرك المسلمون أن اللهَ، سبحانه وتعالى، خلق الإنسانَ حرا وحباه العقلَ ليكونِ مسؤولاَ عن جميع تصرُّفاتِه في الدنيا؟ ثم، ألم يدرك المسلمون والناس أجمعين أن دخولَ الجنة مرتبط بالإيمان بالله وبالعمل الصالح وليس بالدين، مصداقا لقولِه،سبحانه وتعالى :
1."مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ" (غافر، 40).
2."وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" (البقرة، 82).
ولهذا، فالمسلمون ليسوا إلا جزأً من الذين آمنوا ومن المُؤمنين، مصداقا لقولِه، سبحانه وتعالى : "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ" (البقرة، 62).
أما الإسلام المنصوص عليه في التراث الديني الإسلامي، فكله، كما سبق الذكر، عدوان وقتل وانتقام وحروب وغزوات وسيوفٌ وعقاب وتعصُّب وقطع للرؤوس والأيدي ورجم وصُّراخ من المنابر وسب وشتم وتكفير ورُّعب وخوف وتخويف وكراهية غير المسلمين وسَّبي وتناحُر وعُنف وتَفجيرات ومُحرمات لا ذكرَ لها في القرآن وروايات كاذبة ومُلفَّقة…
وباختصار شديدٍ، علماءُ وفقهاءُ الكهنوت الديني فسروا القرآن والروايات حسب خلفياتهم الفكرية والاجتماعية التي كانت سائدة في عصرهم، وليس، على الإطلاق، حسب ما ورد في القرآن الكريم. وما لم يقبله علماء وفقهاءُ الدين، منذ وفاة الرسول (ص)، هو أن لكل جيل أو لكل مجتمع خلفياتُه الفكرية والاجتماعية التي تفرِض عليه طريقةَ تفكير وتحليلٍ معينة. ولا يمكن، على الإطلاق، أن يفكِّرَ أفرادُ المجتمع أو الجيل، خارجَ هذه الخلفيات. وعلماء وفقهاء الدين، القدامى والحاليون الذين ساروا على نهج هؤلاء القدامى، كبشرٍ يفكِّرون، لا يُستثنَونَ من هذه الحقيقة. كل عالمٍ أو فقيهٍ، هو ابن بيئته أو مجتمعه. غير أن هؤلاء العلماء والفقهاء يريدون فرضَ إنتاجِهم الفكري الديني على جميع المسلمين وفي كل الظروف، بمعنى أن إنتاجهم هذا صالحٌ لكل زمان ومكانٍ.

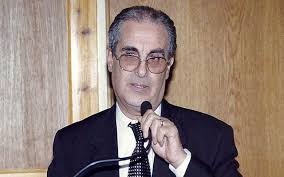 أحمد الحطاب
أحمد الحطاب 
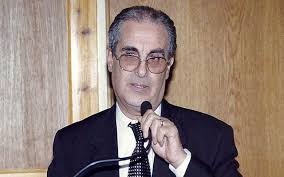 أحمد الحطاب
أحمد الحطاب